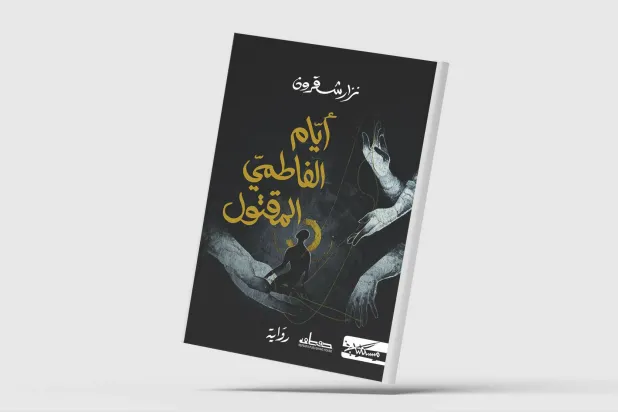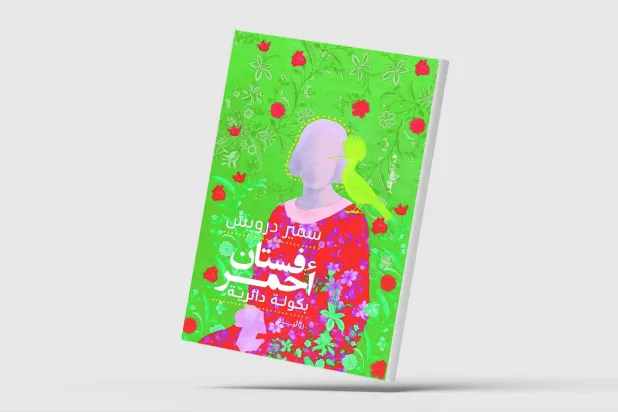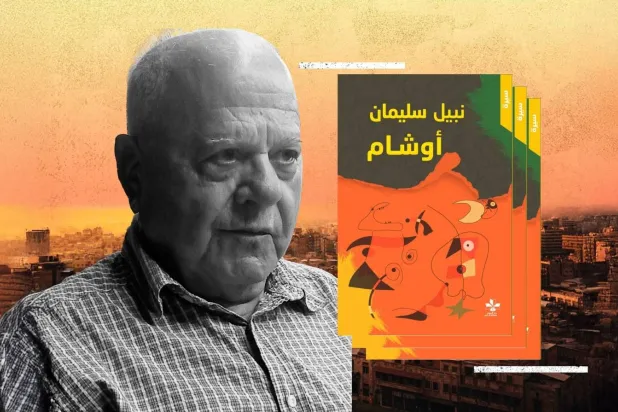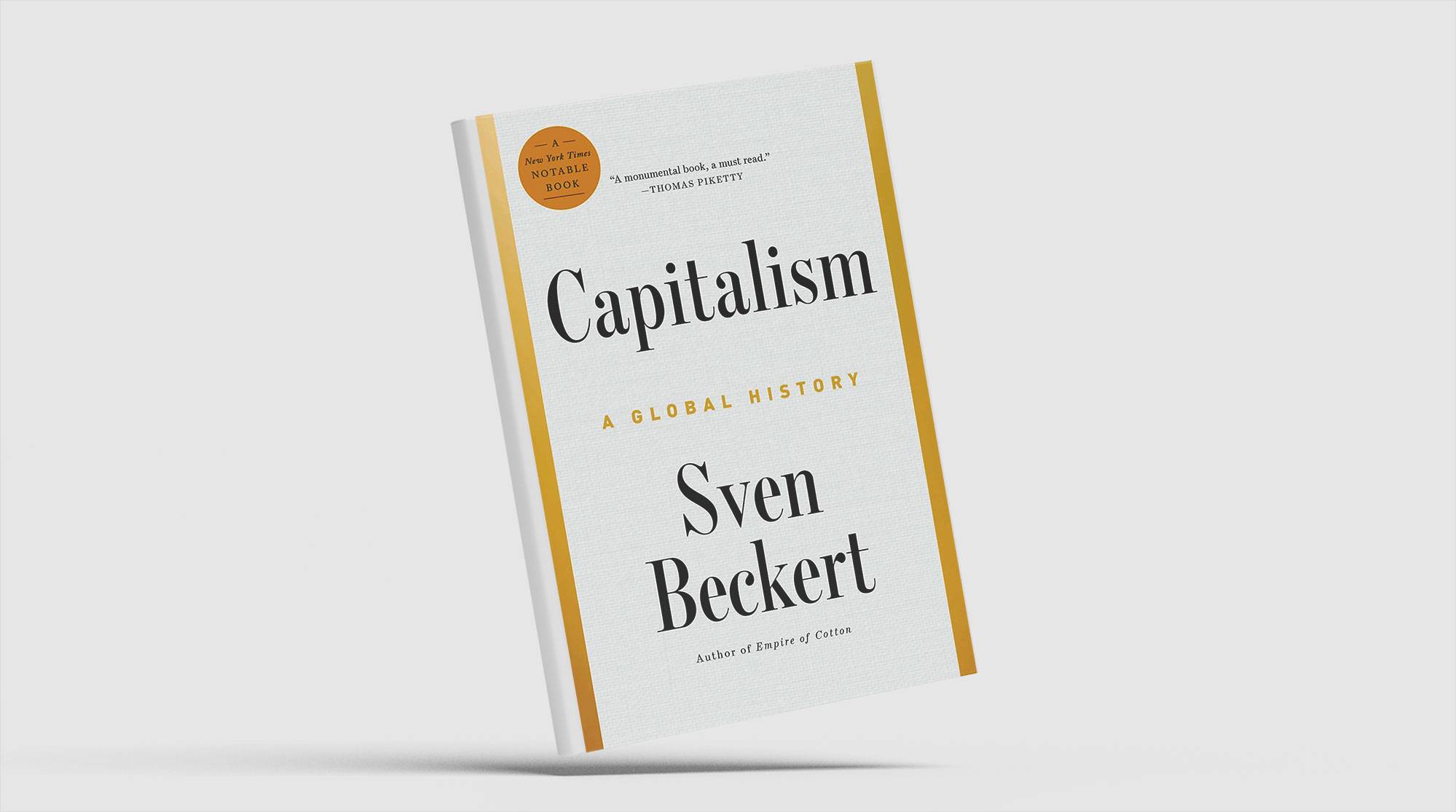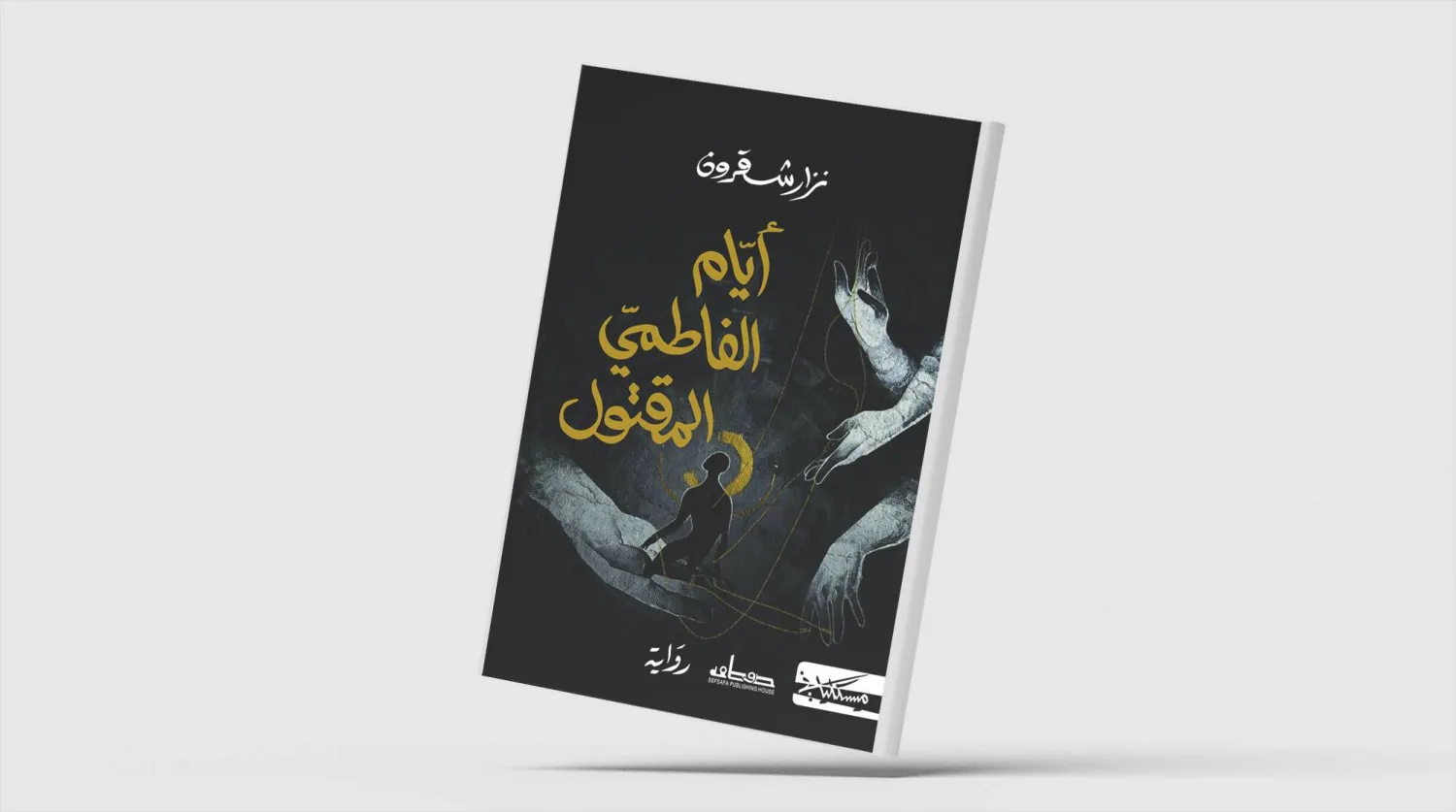يأخذ المفكر اللبناني مشير باسيل عون قارئه، في مؤلفه الجديد «استنطاق الصامت: مفاتحات فلسفية في الاجتماع والدين والسياسة» الصادر حديثاً عن دار «سائر المشرق»، في رحلة إلى عمق شخصيته وفكره ونظريته الفلسفية.
فأستاذ الفلسفة الألمانية في الجامعة اللبنانية درج على أخذ قرائه إلى أفكار كبار الفلاسفة والمفكرين، عبر أكثر من 30 كتاباً وعدد من الأبحاث وضعها خلال 40 عاماً، لكنه أراد لكتابه الجديد (207 صفحات من القطع الوسط) أن يكون رسالته المباشرة إلى القارئ، بلغته ونهجه ومفرداته، التي حمّلها أفكاره ورؤيته الفلسفية عبر استنطاقات (حوارات) أجراها معه باحثون ليعرفوا، وينشروا، خلاصة التصورات التي «استقرت في وعيي على تعاقب سنوات البحث الفلسفي والتعليم الجامعي والنضال الوجودي في جميع أبعاده».

وقبل أن يدخل القارئ إلى مفاتحات عون، يجده يطلب منه أن ينحي أفكاره المسبقة جانباً وألا يسلك طريقته الخاصة في النقاش والحوار والأحكام القَبْلية؛ لأن «كل واحد منا إذا راجع طريقته في محاورة الآخرين، اتضح له أنه، في كثير من الأحيان، يغترف الدليل من أنظومته الدينية، وفي ظنّه أنه يستمده من الشرعة الحقوقية العالمية التي يعترف بها معظم الناس. حينئذٍ يتعثّر الحوار، وتضطرب العلاقة، وتسوء النيات، وتفسد المقاصد. أما لو بذلنا جهداً يسيراً في استجلاء مصادر تصوراتنا وأفكارنا واقتناعاتنا، لتبين لنا أننا غالباً ما نفرض على الآخرين ما نعده أمراً مسلّماً به أو حقيقة ساطعة سطوع الشمس. وحده مثل هذا التمييز يجعل الناس والمختلفين يرتاحون إلى المجالسة والمحاورة والمباحثة، وفي يقينهم أن التلاقي تسوده رغبة الاحترام الصادق المتبادل وتؤيده مشيئة التقابس المغني».
وفي مقدمة كتابه أيضاً، يقول عون لقارئه أن يبحث عما يريد قوله في ثنايا فقراته وعليه أن «يضاعف اليقظة ويحبس الانتباه حتى يتقصى المرمى ويدرك المغزى المستتر في ثنايا الآراء المرسلة»، عازياً السبب إلى أنه يختصر في بضعة سطور أبحاثاً طويلة «أضناني إنشاؤها وأرهقني صوغها».
يذهب عون إلى القضايا الإنسانية، وربما أعسرها، محلياً وعالمياً، موضحاً أن «الفرق واضح بين الإفصاح عن الموقف الفلسفي العام، والدفاع عن بعض الأفكار الفلسفية في قضايا الوجود التاريخي، لا سيما في قرائن الاجتماع اللبناني والعربي».
فما هي هذه الأفكار التي يتبناها عون ويدافع عنها؟ يعنى عون، ومنذ سنوات طويلة من الانخراط الفكري في أوروبا ولبنان، بـ«تأصيل التعددية الكونية تأصيلاً فلسفياً». فهو يقول بأنثروبولوجيا الماهية الإنسانية المشرعة؛ أي بضرورة النظر في جوهر الإنسان نظراً تاريخياً يراعي التطور المطرد الذي يصيب كل الكائنات و«من جراء تسارع وتيرة الفتوحات العلمية، أعتقد أننا لن ننتظر طويلاً حتى نعاين صورة أخرى عن الإنسان الآتي في المقبل من العقود»، وفق تعبيره.
ويقول إنه عمد إلى البحث عن أفضل الأنظمة الحضارية التي تتيح للناس أن يتدبروا اختلافاتهم «فإذا بي أصوغ مفهوم العلمانية التي تميّز الحقل الاقتناعي الذاتي الشخصي الخاص من الحقل التنظيمي التدبيري التقني الجماعي المشترك العام».
وانطلاقاً من ذلك، ينصرف عون في أبحاثه إلى بناء نظرية فلسفية تقوم على 3 أصول:
التسالمية الحضارية المقترنة بالتعددية الكونية، وتكاملية القيم الإنسانية في تناولاتها التأويلية المتباينة، والحيادية الحاضنة في العلمانية الهنية.
لكن ما هي «العلمانية الهنية»؟ يجيب عون قائلاً صفة «الهنية» تجعل العلمانية ترعى بالحياد المتعاطف اختبارات الإنسان من غير أن تسوغ له فرضها على الآخرين، و«العلمانية الهنية وحدها تتيح للناس أن يصونوا اقتناعاتهم الإيمانية، ولكن من غير أن يفرضوا تفسيراتها القانونية وأحكامها التشريعية وتطبيقاتها المسلكية العملية (...) في نطاق المجال العمومي المشترك».
ولا يرى عون إلى هذا الأمر سوى الفلسفة سبيلاً «بالرغم من المشهد المأساوي».
إذا كان للفلسفة اليوم من رسالة استنهاض تلائم واقع العالم العربي فإنها رسالة تحرير الذات العربية من ذاتها
ولكن ما الذي يمكن أن تقدّمه الفلسفة للعالم العربي؟ يجيب عون، على الرغم من أن واقع الفلسفة في العالم العربي لا يشجعه على التفاؤل، قائلاً: «إذا كان للفلسفة اليوم من رسالة استنهاض تلائم واقع العالم العربي فإنها رسالة تحرير الذات العربية من ذاتها (...) وحدها الفلسفة، على ما تختزنه من طاقات تحرير الذات العربية، قادرة على استنهاض العالم العربي والتوثب به إلى آفاق التجديد والإبداع».
ويرى أن الفلسفة العربية المقبلة لن تقوم على الفتح الإبستمولوجي العالمي؛ لأن مختبرات العالم الأول تسلطت، فيما يشبه الاحتكار، على مصادر المعرفة العلمية المتطورة، ولن تنهض أيضاً على أسس القوميات الملتبسة لأن المجتمعات المعاصرة لم تعد تثق بالانتماء القومي حافزاً على الإبداع الثقافي، وطفقت تنحو اليوم منحى الأخوة الإنسانية المسكونية التي تتجاوز حدود العرق والمنبت واللغة، داعياً الإنسان العربي إلى «نحت هوية جديدة تستصفي أفضل ما في التراث من قيم وتعتمد أرفع ما في الحداثة من مكتسبات».
ولا يخفي عون دعوته إلى حوار مسيحي - إسلامي، موضحاً أن هذا الحوار يجب أن يكون سياسي المنحى ولا «يفلح فيثمر إلا إذا نشبت جذوره في حوار لاهوتي رصين موضوعي مجرد من غايات الاقتناص والاستعلاء والاحتواء»، ومستشهداً بزمن عربي قديم استطاع فيه المسيحيون والمسلمون أن يتحاوروا في صدق و«لا سيما في حقبات التسامح الديني الإسلامي».
ودعوته إلى هذا الحوار تستند إلى تجربة شخصية خاضها في إدارة مركز الأبحاث في الحوار المسيحي - الإسلامي؛ حيث عكف على استجلاء مسألة الحقيقة الدينية ومقامها في نطاق الأنظومة الفكرية التي تبتنيها الأديان التوحيدية الثلاثة (اليهودية والمسيحية والإسلام)، وخلص إلى «الاستنتاج اللاهوتي الذي يميّز بين الحق الإلهي في ذاته، والحق الإلهي في تجلياته»، مبتكراً اصطلاحاً لاهوتياً حوارياً سمّاه «الإطلاقية النسبية».