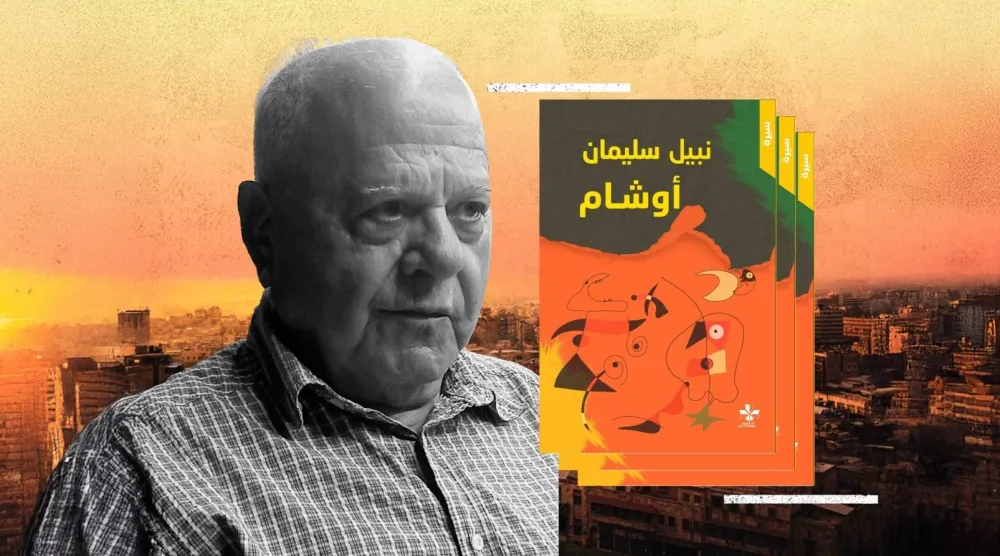تبدو فكرة كتابة تاريخ للعراق منذ بدايات الحضارات الأولى في حوض ما يعرف بمنطقة ما بين النهرين إلى اليوم ضمن متن كتاب واحد أقرب إلى مهمّة مستحيلة بحق. فالعراق بصفته دولة في إطار حدوده الحالية قد يكون من وجهة نظر كثيرين صنيعة بريطانيّة - فرنسيّة في سياق توافق القوى الإمبريالية على تقاسم تركة الدّولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى. ولقرون عدّة، كانت الأراضي التي تشكل العراق كما نعرفه الآن جزءاً من إمبراطوريات ودول أخرى، ومجرد إقليم يدار من عواصم بعيدة أو قريبة؛ إذ حكمها العثمانيون من إسطنبول لأربعة قرون بداية من القرن السادس عشر الميلاديّ، وفي فترة سابقة حكمها الأمويون من دمشق؛ ما يجعل كتابة تاريخ عراقيّ أمراً شديد التعقيد وربما غير عمليّ بحكم التّداخل مع تقلبات الأحداث في الكثير من الأمم الأخرى. ويستحضر كثير من الكتاب المسلمين مفهوم الجاهلية للفصل الصارم بين تاريخ للعراق قبل الإسلام وبعده. وفوق ذلك، فإن تاريخ هذه المنطقة الجغرافيّة على مدى خمسة آلاف عام شديد التنوع والثراء؛ ما يهدّد من يتصدى لمهمة سرده بالوقوع في شباك عدم تجانس مادته، وخطر الانتهاء إلى ما يشبه (كتالوغ) سياحياً أو موسوعة موجهة لصغار السن.

على أن ثمّة ما يغري دائماً بوضع نص يحاول الإمساك بخيط ذهبي يجمع بين حلقات كثيفة مذهلة أحياناً من النشاط البشري الذي كان مسرحه تلك المساحة الضيقة للأرض بين نهري العراق العظيمين: دجلة والفرات. أقله هذا ما يزعمه بارتل بول، في كتابه الصادر حديثاً بالإنجليزية: «أرض ما بين النهرين: تاريخ العراق في 5000 عام»* والذي يرى أن تلك الأرض - والعراق اسم مستخدم منذ القرن السادس الميلادي على الأقل، حتى قبل ظهور الإسلام - بقيت دائماً محوراً أساسياً للحراك الحضاري، ومقراً أو ممراً لكل إمبراطوريات الشرق، وأن أهم مدينة في العالم في مراحل متعاقبة منذ الخمسة الآلاف عام الماضية كانت مدناً عراقيّة: أور، وأوروك (الوركاء)، وبابل، ونينوى، وطيسفون، وبغداد. وبنى سلوقس، وريث الأجزاء الشرقية من أراضي كورش الفارسي والإسكندر المقدونيّ، عاصمته سلوقية على نهر دجلة، شمال بابل، ومنها استمر العراق الهلنستي لقرنين جسراً بين الشرق والغرب، ونموذجاً أرسطياً توفيقياً متسامحاً في الدين، وفضولياً بلا حدود في العلم - قبل أن يعمد الرومان إلى تدميرها في القرن الثاني للميلاد -.
ولا يجد المؤلف صعوبة تذكر في سوق الأدلة على ما ذهب إليه. ففي هذه الأرض تحديداً نشأت أول مجتمعات البشر الحضريّة المتقدمة - السومريون خلال الألفية الرابعة قبل الميلاد -، ومنها أيضاً جاءت الملكيّة، وبناء المدن، والقانون المكتوب، وسلك الكهنوت، وتجييش الجيوش، والدبلوماسيّة، وأصول المحاسبة، والشعر الملحميّ، والعجلة، والقارب الشراعيّ، وقنوات الريّ، والأدب - الذي استوحى منه كتبة العهد القديم الكثير من قصصهم المركزية كالطوفان -، وبناء القبب، والمعمار الرسميّ، والقوس والنشاب، ومهارات تشكيل المعادن، والنحت البارز والغائر، وأسس الرياضيات الحديثة (بما في ذلك ما نُسب زوراً إلى فيثاغورس اليوناني)، والنظام الستيني لحساب الوقت. وكانت مسرحاً لمواجهات التاريخ الكبرى من أيّام السومريين والآشوريين والآكاديين إلى صدام الإسكندر المقدوني بالفرس، وحروب الرومان والبارثيين، ولاحقاً فضاءً للانقسام الكبير في الإسلام بين الشيعة والسنة، ومركزاً لدولة الخلافة العباسيّة التي بقيت لما يقرب من خمسة قرون (750 – 1258) أهم إمبراطوريات العالم في زمانها، والعصر الذهبيّ لازدهار الحضارة الإسلاميّة.
نص «أرض ما بين النهرين» يبدو في مواجهة هذه القائمة الطويلة من الإنجازات الهائلة والأحداث الفاصلة متماسكاً، وقادراً على تقديم سردية مثيرة للاهتمام يمكن منها التّوصل إلى خلاصات واستنتاجات، على الرغم من هفوات هنا (مثل إهمال الديانة المندائية التي تعطي قيمة عالية لشخصية يوحنا المعمدان عند الحديث عن المساهمات في الفكر العالمي)، أو مبالغات استشراقية هناك (مثل التركيز على قصص المحظيات وصراعات القصور في بغداد الرشيد).
ينسج بول تلك السرديّة الآسرة عبر استدعاء حكايات شخصيات بارزة مرَّت بالعراق ومقاطعتها مع عوامل جغرافية وبيئية تأخذ عادة ببساطة، لكنها شكَّلت المنصة الدائمة للحدث التاريخي العراقي. وهنا تتوالى الحلقات التاريخيّة مستندة إلى أسماء مثل جلجامش (ملك الوركاء في الألفية الثالثة قبل الميلاد)، وهارون الرشيد (الخليفة العباسيّ الأشهر من القرن الثامن الميلاديّ)، وهنري لايارد (الرحالة والدبلوماسي في القرن التاسع عشر الميلادي الذي كان وراء اكتشاف الكثير من الآثار القديمة في نينوى والنمرود) وغيرها من الشخصيات المهمة فيما يبرز أهميّة الطبيعة المسطحة والمفتوحة للبلاد، الذي جعل منها ممراً سهلاً للعابرين، غزاة وتجاراً ومهاجرين، وفي الوقت ذاته بوتقة لتلاقح هائل بين الثقافات واللغات والحضارات والأعراق والأديان، وإن كان ذلك أحياناً نتاج صراعات كانت في بعض الأحيان شديدة العنف..
بول بمشروعه الطموح لتغطية فترة مديدة من التاريخ يترك القارئ المعاصر ودون مبرر ظاهر عند لحظة ثورة يوليو (تموز) 1958
ويشير بول إلى أن هذه الأرض - البوتقة أنتجت بالفعل وعبر المراحل التاريخية ثقافة وأفكاراً شكَّلت جزءاً كبيراً من مسيرة الفكر الإنساني، سواء في مخاطبة تجربة الوجود كما في ملحمة جلجامش، أو في التأثير الحاسم للزرادشتية على الأديان الإبراهيمية خلال مرحلة السبي البابليّ لليهود – مثل مفاهيم الروح والحياة الآخرة والملائكة والقيامة والتركيز العميق على الأخلاق والإرادة الحرة -، وكذلك الصراعات اللاهوتية والسياسيّة في الإسلام المبكّر، ولاحقاً في تجربة المعتزلة في بغداد العباسية حول فكرة خلق القرآن المتأثرة بأفكار مترجمة من اليونانية والفارسية.
ومع ذلك، فإن بول بمشروعه الطموح لتغطية فترة مديدة من التاريخ يترك القارئ المعاصر ودون مبرر ظاهر عند لحظة ثورة يوليو (تموز) 1958 والانقلاب على المملكة العراقية الهاشمية التي كان أسسها الملك فيصل الأول تحت الرعاية البريطانية، ويَقصر، باستثناء موجز متسرع، عن وضع عصر الجمهوريّة والغزو الأميركيّ واحتلال العراق وتغيير نظامه في سياق السردية التاريخية، بينما هي الحلقة الأقرب إلى ذلك القارئ، والأعمق صدى في أجواء الخمسين سنة الأخيرة؛ ما يفقد الكتاب فرصة ربما كانت مثالية لتشبيك التاريخ بالحاضر، وإنهاء الرحلة المثيرة والجديرة بالثناء عبر الأزمنة العراقية في ميناء الواقع الراهن.
LAND BETWEEN THE RIVERS: A 5,000-Year History of Iraq | By Bartle Bull | Atlantic Monthly Press, 2024