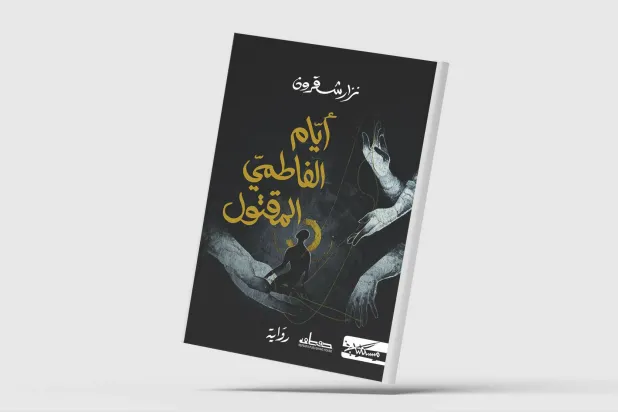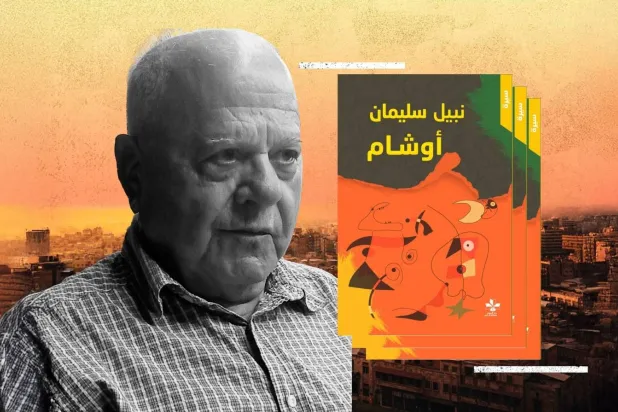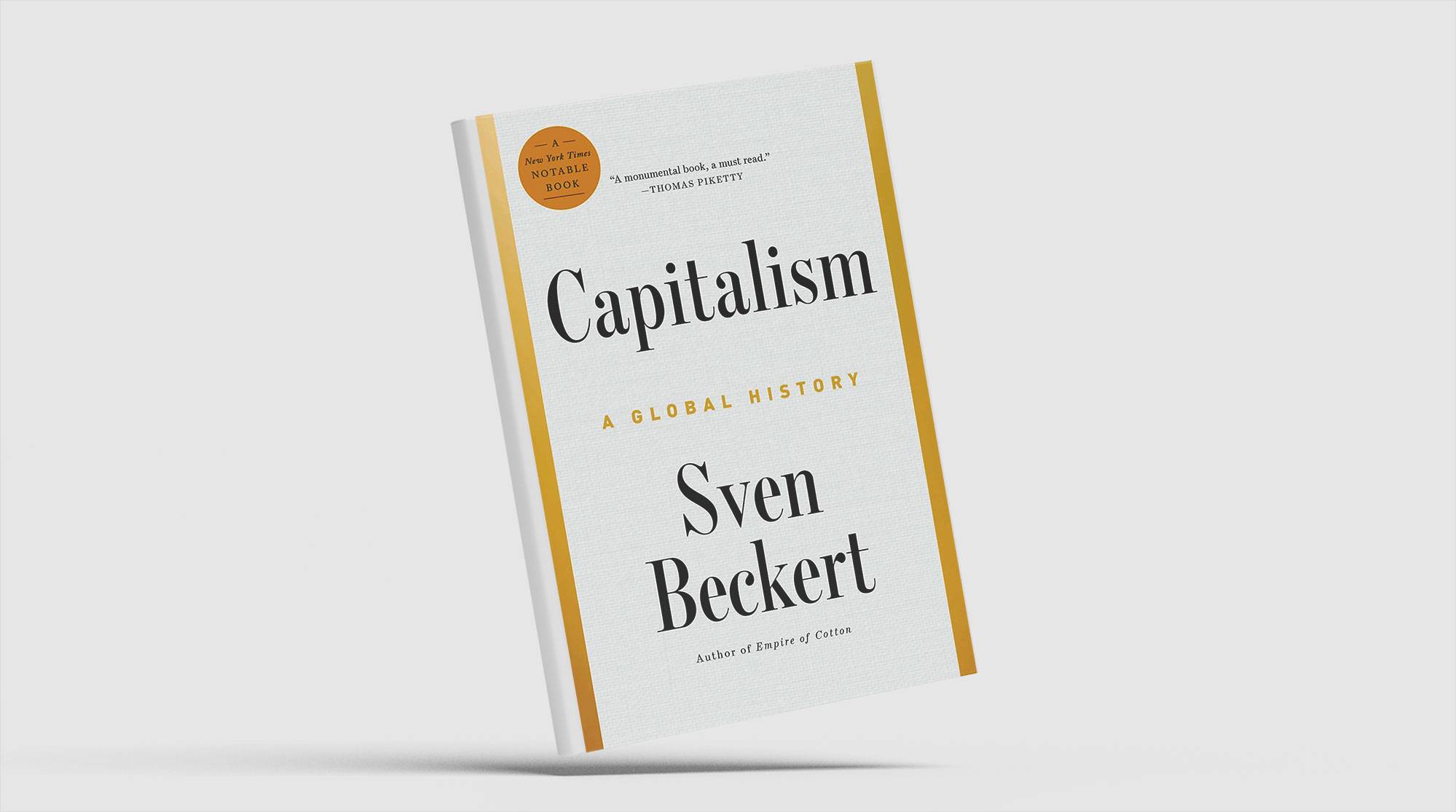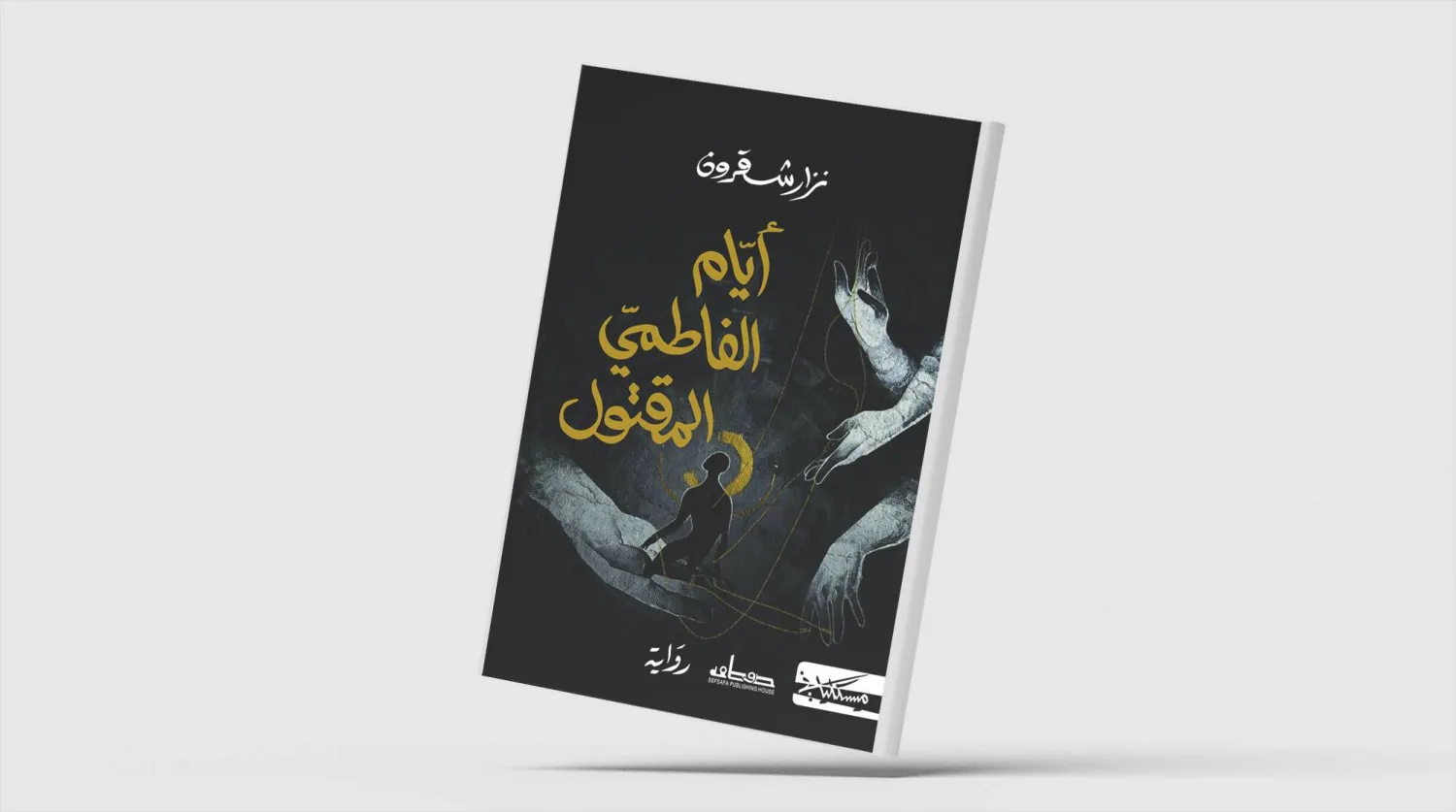تعود الكاتبة زينب فواز إلى الواجهة، مع صدور طبعة جديدة من روايتها «غادة الزاهرة»، التي نشرت لأول مرة عام 1899 في القاهرة. وتحاول ناشطات نسويات إعادة الاعتبار لهذه الكاتبة اللبنانية - المصرية، بوصفها صاحبة أول رواية عربية، لأن حقها قد أهدر، في نظرهن، بسبب الذكورية والتمييز الجائرين، والإهمال المتعمّد.
وتم تتويج محمد حسين هيكل واعتبرت روايته «زينب» هي الرواية العربية الأولى، مع أنها صدرت متأخرة 15 عاماً عن «غادة الزاهرة». وبصرف النظر عن القيمة الأدبية لكل من الروايتين، وأيهما تحمل خصائص الرواية أكثر من الأخرى، فإن زينب فواز، إضافة إلى مكانتها الأدبية، رائدة في مجال المطالبة بحقوق المرأة قبل قاسم أمين وكتابه «تحرير المرأة»، وشغلت الساحة الأدبية في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.
وتتساءل فاطمة الخواجا، محققة رواية «غادة الزاهرة» في طبعتها الجديدة الصادرة عن «دار نلسن» في بيروت، كيف أمكن تجاهل ليس فقط زينب فواز، ودورها المحوري وغزارة إنتاجها، ومكانتها في زمنها؛ بل كوكبة من النساء العربيات اللواتي توّج بهن القرن التاسع عشر، حيث تمّ إغفال ذكرهن، رغم أنهن شاركن بقوة وبزخم، في حركة النهضة العربية؟
نفض الغبار عن الإرث الأدبي النسوي
ونتيجة لذلك، فإن غالبية القراء، يعرفون الحركة النسائية الأدبية بدءاً من خمسينات القرن الماضي، من أمثال نوال السعداوي وغادة السمان وليلي بعلبكي، والأكثر اطلاعاً فقط هم الذين سمعوا عن ملك حفني ناصف، وصفية زغلول، وعائشة تيمور، وأخريات ممن سبقوهن.
ولنفض الغبار عن هذا الإرث الأدبي النسائي، الذي لم يُعطَ حقه، تسعى «جمعية نساء ذوات ثقافة مزدوجة»، منذ نشأتها في 2003، إلى إعادة نشره وترجمته لتقديمه لجمهور القراء العرب والأجانب في قالب يساعد على فهم مضمون النص كما مرامي كل كاتبة، وأهدافها الإصلاحية.
وبعد أن دعمت وساهمت هذه الجمعية النسائية في إصدار رواية زينب فواز والعديد من الكاتبات الأخريات، خاصة المنسيات، لا تزال ترحب بتلقي اقتراحات وأعمال لباحثين متميزين، خاصة في مجالات الكتابة النسائية في القرن التاسع عشر، من أدب، وصحافة، وشعر، ومقالات قد تكون سقطت سهواً أو عمداً، وذلك لرفد المكتبة العربية بكل حقول المعرفة النسائية التي سادت في تلك الحقبة من الزمن.
الصحافية التي تصور بمقلتيها
واكتشفت محققة «غادة الزاهرة»، خلال بحثها عن زينب فواز، أنها ليست فقط شاعرة وأديبة، بل أيضاً ناشطة اجتماعية وصحافية من العيار الثقيل «تهاجم كرومر وتؤيد سعد زغلول، وتردّ على الكتّاب مصوبة نظرتهم إلى المرأة». وتعتبر المحققة أن زينب فواز كانت «سفيرة الصحافة النسائية إلى القصور الخديوية والبيوتات الأرستقراطية، تصور بمقلتيها أفراحهم وتخطّ بقلمها مقتنيات جهاز العروس لتنقله إلى القراء على صفحات المجلات».
«غادة الزاهرة» التي صدرت أول مرة عن «المطبعة الهندية» في القاهرة، في 231 صفحة، و37 فصلاً، حملت اسماً ثانياً هو «حسن العواقب»، وتوالى إصدارها، أثناء حياة الكاتبة، عدة مرات بسبب نفادها، وكان آخرها عام 1903. وهي طبعة يمكن العثور عليها اليوم في «دار الكتب والوثائق القومية» في القاهرة.
ومن حينها باتت الرواية تنفد وتختفي، ثم يأتي من يتذكرها ويعيد طباعتها، فقد أعاد إصدارها «المجلس الثقافي للبنان الجنوبي» عام 1984 ضمن سلسلة «التراث العاملي»، حيث اعتبرت فوزية فواز، كاتبة مقدمة الطبعة، أن صاحبة «غادة الزاهرة» اقترن اسمها بأسماء الكبار الذين نبغوا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين».
كما أصدرت «الهيئة العامة للكتاب» طبعة أخرى، مصرية هذه المرة، عام 2013 ضمن سلسلة «رائدات الرواية العربية» كتب مقدمتها حلمي النمنم، وجاء على غلاف هذه الطبعة أنها «أول نص روائي عربي»، مما نسف ريادة محمد حسين هيكل وروايته «زينب» التي صدرت عام 1913، وأرخ بصدورها كبار النقاد لولادة أول رواية باللغة العربية، وتناولتها الأقلام طويلاً بالنقد والتشريح، والاهتمام، فيما لم تحظ رواية «غادة الزاهرة» بالعناية عينها.
وزينب فواز من قرية تبنين جنوب لبنان، من عائلة فقيرة. عملت لدى آل الأسعد، وكان علي بك الأسعد هو حاكم الإمارة، خلال الحكم العثماني. وعند آل الأسعد، وتحديداً عند زوجة الحاكم، تعلمت القراءة والكتابة، وتزوجت أحد أفراد الحاشية، ولكنها انفصلت عنه سريعاً. سافرت بعدها إلى دمشق وتزوجت ثانية وأيضاً طلقت، قبل أن تتعرف هناك على ضابط مصري، لتتزوج للمرة الثالثة، وتذهب معه إلى الإسكندرية؛ حيث درست الصرف والبيان والعروض على يد حسن حسني الطويراني صاحب جريدة «النيل»، كما درست على يد الشيخ محيي الدين النبهاني النحو والإنشاء، ثم ارتحلت إلى القاهرة. ورغم زيجاتها الثلاث لم ترزق بأولاد.
لقبت ﺑ«درة الشرق»، ونشرت مقالاتها في «النيل» و«الأهالي» و«المؤيد»، و«اللواء»، و«الفتى» وغيرها. ودعت إلى تعليم المرأة والإصلاح الاجتماعي، واعتُبرت من رائدات التيار النسوي، حيث قادت المعارك والمناظرات التي تدافع عن حقوق المرأة، وترفض كسر إرادتها، وفرض الحجاب عليها ومنعها من ممارسة دورها الاجتماعي، وقصر نشاطها على البقاء في المنزل. كما أنها طالبت مواطنيها بالتبرع للجزائر يوم تعرضت لأزمة اقتصادية كبرى، وهددتها المجاعة.
كتابة الواقع لا تخيله
وبالعودة إلى رواية «غادة الزاهرة» التي هي مثار جدل، فليست من نوع الروايات التي عرفناها مع تطور الحركة الروائية العربية، ولا يمكن أن تقارن بالصنف التخيلي أو الرومانسي، أو الذي يعكف على استقراء خفايا الدواخل الإنسانية، أو إبراز طوايا النفس وأسرارها، من خلال حركة الشخصيات.
وهذا بديهي، حين نتحدث عن الرواية الأولى، وهي قصة حقيقية تعرفها زينب فواز، وروتها ساردة أحداثها، خافية الأسماء والبلدان «حرصاً على شرف البيوت الكريمة التي دنّسها بعض أبنائها الذي هان لديه بذل شرفه في سبيل نوال شهرته». وتدور أحداث القصة في جنوب لبنان، أيام الحكم العثماني، في المكان الذي عاشت فيه زينب طفولتها ونشأت. أما الشخصيات فهم من أبناء تبنين وحكامها.
وفي مقدمة الرواية تشرح زينب فواز سبب عكوفها على كتابة هذا النوع الأدبي؛ لأن الرواية في رأيها «مرآة الأفكار، وتزول بلذتها غمام الهموم والأكدار، وتأخذ منها النفوس على قدر عقولها من الذكرى والاعتبار، وكان أجلّها قدراً وأسماها منزلة ومكاناً ما قرب من الواقع أو مثل حقيقة الوقائع».
«غادة الزاهرة» هي حكاية صراع مرير مليء بالشرّ، بين الأميرين تامر وشكيب على حكم منطقة جبل شامخ، وفيها من القيم الثقافية والاجتماعية الكثير ويظهر بقوة أثر تلك العلاقات والصراع الثقافي. وتعتبر الرواية بالنسبة للباحثين وثيقة أدبية وحتى شبه تاريخية، لفهم الحياة الاجتماعية، والعلاقات التي كانت سائدة في تلك الفترة في المنطقة.
ويلحظ القارئ أن الروائية عمدت إلى مزج حكايتها بالقصائد، بحيث أصبح الشعر جزءاً أصيلاً من نصها. ولا تتردد في جعل شخصياتها يجيب بعضها بعضاً شعراً، في شيء من المواءمة بين الأحداث والنبض الشعري للنص. هكذا يمتزج القصّ بالشعر، وكأنما يكمّل بعضهما بعضاً. وقد يعود ذلك لكونها شاعرة، أو لأنها أرادت أن تخلط نوعين أدبيين من باب التجريب، وكل هذا ممكن.
قصة الرواية
وفي الرواية نتابع حكاية أبناء العمومة شكيب وتامر. الأخير هو الأكبر سناً، وبالتالي تعود إليه الإمارة، لكنه لا يتحلى بالخلق ولا بحسن المعشر، فخطر لعمهم أن يوكل المهمة لشكيب؛ لأنه الأقدر عليها. لكن النتيجة البديهية، وتامر هو الأكبر والأحق عرفاً، وفي نفسه ما عرفناه عنه من شرّ وقدرة على حياكة الحيل وإيقاع الأذى، أنه سيبذل كل ما في وسعه ليمنع شكيب من بلوغ مراده، بأن يتآمر، ويدبّر الدسائس، ويشعل الحقد في القلوب عليه، ويكلّف من يستطيع لتنفيذ المؤامرات والتخلص من غريمه أي ابن عمه.
أما اللغة فهي وصفية، لكنها جزلة. فقد تمتعت أديبتنا بقوة في التعبير، وفصاحة وبيان، وقدرة على الانسياب في العبارة، وإن كان البعض يمكن أن يجد كتابة فواز قد أصبحت قديمة ويصعب فهمها أحياناً، إلا أنها لا تخلو من جمال.
من الظلم الحكم على رواية زينب فواز بمقارنتها بالروايات الحديثة المحترفة. إنما لا بد من الإشارة إلى أنها مع ذلك ترجمت إلى لغات أجنبية، ويستشهد بها من قبل المستشرقين عند التأريخ للرواية العربية. كما أن ثمة عناية خاصة بدورها في كتابة التراجم للنساء، وخاصة كتابها «الدرّ المنثور في طبقات ربّات الخدور» الذي أرخت فيه لـ256 امرأة. و«مدارك الكمال في تراجم الرجال»، وكتبت مسرحية هي «الهوى والوفاء» التي أعيدت طباعتها عدة مرات، و«كوروش ملك فارس» ومجموعة مقالات صدرت بعنوان «الرسائل الزينبية»، هذا عدا قصائدها وحسّها الشعري العالي.