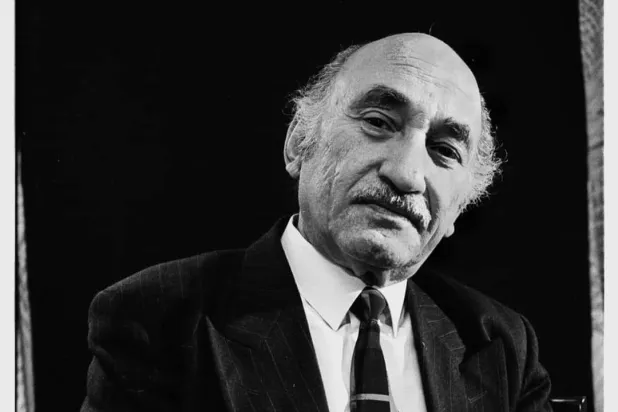كثيراً ما نميلُ إلى التفكّر الحثيث في تاريخنا البشري والطبيعي، ووضعه موضع الاستنطاق والمساءلة. يبدو أنّ المساءلة الشائعة لهذه التواريخ ستجعلنا ننتهي إلى ما يمكن تسميتها «سرديات كبرى (Grand Narratives)»: عصر التنوير والإصلاح الديني الأوروبي، ونشوء الحربين العالميتين الأولى والثانية، مثلاً، يمثلان سردية كبرى في تاريخنا البشري، مثلما أنّ نشوء الإنسان العاقل (Homo Sapiens) يمثل سردية كبرى في تاريخنا الطبيعي، وانبثاق الحضارة الصناعية بأطوارها المختلفة (بخارية، وكهرباء، ومحرك الاحتراق الداخلي...) يمثل سردية كبرى في تاريخنا التقني. تتشارك هذه السرديات الكبرى في خصائص مميزة: إنها أفعال كبيرة، حتمية محكومة بسلسلة سببية خطية صارمة؛ عقلانية. لعلّ مواريث عصر النهضة الأوروبية (الثورة الفيزيائية النيوتنية بالتحديد) هي السبب الأعظم الذي ساهم في التأطير المفاهيمي لهذه التواريخ ووضعها في هذا السياق النسقي الذي جاء مع «عصر الحداثة»، ثمّ مع حلول حقبة «ما بعد الحداثة» نُسِفت هذه السرديات الكبرى ولم تعُدْ تحتلُّ مواضعها المركزية السابقة في الفكر البشري. نحنُ في العادة نميلُ إلى التماهي مع سياق السرديات الكبرى؛ لما تنطوي عليه من حتمية وعقلانية وعناصر كبرى من الفعل تتفق مع رغبتنا البشرية في إضفاء الخصيصة العلمية الصارمة على أفعالنا التاريخية. السرديات الكبرى بكلّ أناقتها المفاهيمية وصِلاتها السببية الخطية توفّرُ علينا عناء البحث عمّا هو كامنٌ تحت السطح المباشر والمرئي للأحداث؛ لكنّ تراكماً من الوقائع في العالم المادي دفعنا دفعاً إلى مراجعة هذه السرديات الكبرى مراجعة شاملة.

يمكن عَدّ «نظرية الفوضى (Chaos Theory)» بداية خطّ الشروع في هذه المراجعة التاريخية الجذرية. «نظرية الفوضى» في أصلها هي محاولة علمية تُرينا كيف تتعامل النظم المعقدة بحساسية كبرى مع التغيرات الصغيرة التي تطرأ عليها. بعبارة أخرى: الأفعال الصدفوية الصغيرة (Flukes) يمكن أن تنشأ عنها تأثيرات كبيرة في النظم المادية (الفيزيائية). نحنُ في العادة لا نحبّذُ مدّ هذه الرؤية على النظم البيولوجية (الكائنات الحية) لاعتقادنا بأنها تخضع لمؤثرات أخرى؛ لكنّ التحليل الدقيق سيكشف لنا خطل هذه الرؤية. هذا ما يعتقده ويؤكّد عليه البروفسور براين كلاس (Brian Klaas) أستاذ «التاريخ العالمي (Global History)» في «الكلية الجامعة» بلندن، وقد عرض أفكاره في أحدث كتبه المنشور في يناير (كانون ثاني) 2024 بعنوان:
«الأفعال العشوائية الصغيرة: الصدفة... الفوضى... ولماذا أيّ شيء نفعله له أهميته المؤثرة».
يبدأ كلاس كتابه بمقدّمة مسهبة يكتب فيها عن الأفعال الصدفوية والعشوائية التي رافقت تشكّل تاريخنا البشري المعروف بموضوعاته الكبرى، ثمّ يقدّمُ شرحاً مكثفاً لحالة معاصرة - ليست بعيدة عنا – عندما تمّ القرار على إلقاء القنابل النووية على اليابان. هذه الحالة هي أقربُ إلى «دراسة الحالة (Case Study)» المعروفة في حقل الأدبيات الطبية، حيث تكون حالةٌ ما نموذجية دالة على حالات كثيرة؛ لذا سيكون من المفيد عرضُ تفاصيل قرار إلقاء القنابل النووية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين.
عندما تقرّر قصف اليابان نووياً في مايو (أيار) عام 1945 عقب نهاية الحرب على الجبهة الألمانية؛ اختير «بنك أهداف» من المدن اليابانية التالية: كيوتو، هيروشيما، كوكورا، نيغاتا، ثمّ أضيفت ناغازاكي خياراً إضافياً. هذا ما اعتمدته لجنة من كبار جنرالات الحرب الأميركيين؛ لكن عندما عُرضت القائمة على وزير الحرب هنري ستيمسون (Stemson) رفض بشدّة وَضْعَ كيوتو على قائمة الأهداف، متعللاً بأنّها مدينة تضمُّ كثيراً من كبار الطبقة المثقفة (الأنتلجنسيا) اليابانية الذين سيكون من المفيد التعامل معهم بعد نهاية الحرب مع اليابان. تكشّفت حقيقة الأمر لاحقاً: كان ستيمسون وزوجته قد أمضيا شهر عسلهما في فندق بمدينة كيوتو قبل تسعة عشر عاماً (عام 1926 بالتحديد)، وقد ساء ستيمسون أن يرى مظاهر الحزن على وجه زوجته عندما علمت بأنّ هذه المدينة ستؤول إلى محرقة نووية عمّا قريب، فعزم على إخراج المدينة من قائمة الأهداف المرشّحة للقصف النووي. جاهد الجنرالات الأميركان لحثّه على قصف مدينة كيوتو لأنها مركز لتجمّع صناعي مهم فضلاً عن أنها عقدة المواصلات اليابانية؛ لكنّ ستيمسون رفض بحزم. ماذا كانت النتيجة؟ دفع أهل هيروشيما ثمن النوستالجيا المؤلمة التي حرّكت عواطف زوجة وزير الحرب الأميركي.
حدث أمرٌ مشابه بعض الشيء عند قصف ناغازاكي... كانت مدينة ناغازاكي هي المرشّحة للقصف؛ تليها مدينة كوكورا؛ لكنّ تجمعاً كثيفاً من الغيوم دفع طاقم الطائرة القاصفة للعدول عن قصف ناغازاكي واختيار الهدف الثاني على لائحة القصف. استدارت الطائرة متوجهة نحو كوكورا؛ لكنّ عضو الطاقم المسؤول عن توجيه القنبلة لمح في اللحظة الأخيرة فتحة بين الغيوم بانت منها مدينة ناغازاكي؛ فأشار إلى قائد الطائرة بالعودة إلى المسار السابق وتنفيذ خطة القصف الأصلية، وهكذا حُرق أبناء ناغازاكي في الوقت الذي بقي فيه أهل كوكورا سالمين. ذهب هذا المثل تعبيراً عن كلّ ذي حظ عظيم؛ فيوصفُ بأنّ له حظاً عظيماً في الحياة مثل «حظّ كوكورا».
المثال الموصوف أعلاه يمثّلُ حالة نموذجية لأفعال صدفوية صغيرة صنعت تاريخاً كبيراً، وقد انطوت على كلّ الخصائص الجوهرية لهذه الأفعال من حيث إنها:
1- أفعال صدفوية صغيرة: لعلّ قضاء شهر عسل يمثلُ حدثاً كبيراً في تاريخ الأزواج؛ لكنه لا يعدّ حدثاً مؤثراً في تشكيل تاريخنا البشري. ماذا لو قرّر ستيمسون وزوجته قضاء شهر عسلهما في مدينة غير كيوتو؟ وماذا لو أنّ عضو الطاقم المسؤول عن توجيه القنبلة قرّر صرف النظر عن وجود فتحة في الغيوم تكفي لتحديد مدينة ناغازاكي بصرياً ومن ثمّ قصفها بالقنبلة النووية؟
2- غير محكومة بسببية صارمة: قانون السببية الخطية لا يبدو أنه يعمل في مثال القصف النووي الياباني. كانت طوكيو العاصمة - مثلاً - شبه محطمة بتأثير القصف الجوي الأميركي التقليدي بقنابل حارقة، وقد بدا القصف النووي على اليابان أقرب لاستعراض قوة أميركية موجّه إلى الحلفاء الآخرين وليس دفعاً لليابان للتوقيع على وثيقة الاستسلام غير المشروط.
3- لا عقلانية: نحنُ - لو تُركنا لحالنا ومخيلتنا الخصبة - فسنميلُ لتوقّع أنّ انتقاء الأهداف اليابانية جاء بعد مناقشات مستفيضة اتّسمت بعقلانية صارمة ومفرطة، خصوصاً أنّ الأميركان كانوا بصدد تجريب سلاح نوعي جديد ذي قدرة تدميرية ساحقة. هذا حدث بالفعل، وكانت العقلانية هي الحاكمة لمباحثات اللجنة المكلّفة انتقاء الأهداف؛ لكنّ القرار الأخير كان بمؤثرات غير عقلانية (نوستالجيا في مثال كيوتو، وتشكّل عشوائي للغيوم في مثال كوكورا).
بعد المقدمة المسهبة للكتاب، يتناول المؤلف موضوعات تؤكّدُ عناوينها أصل أطروحته. نقرأ في هذه العناوين: «تغييرُ أي شيء يغيّرُ كلّ شيء»، و«لا يحدث أيّ شيء بسبب محتّم»، و«لماذا تشوّه أدمغتنا الواقع؟»، و«السرب البشري»، و«قواعد هيراقليطس»، و«الحيوان الذي يروي الحكايات»، و«لكلّ منا تأثير الفراشة الخاص به»، و«عن الساعات والتقاويم»، و«معادلات الإمبراطور الجديدة»، و«هل يمكن للأمور أن تحدث بطريقة أخرى؟»... عناوين مثيرة من غير شك، وتُغري بقراءة الكتاب.
كلُّ كتابٍ يخالف السرديات الكبرى السائدة له سحره الخاص وإغواؤه الفكري الجاذب. أظنُّ أنّ السحر والإغواء لن يخفتا أو ينقطعا لدى القارئ الذي يقرأ أيّ فصل من فصول كتاب كلاس.
«الأفعال العشوائية الصغيرة: الصدفة... الفوضى... ولماذا أيّ شيء نفعله له أهميته المؤثرة»
Fluke: Chance, Chaos, and Why Everything We Do Matters
المؤلف: براين كلاس
الناشر:
«Scribner Book Company»
2024