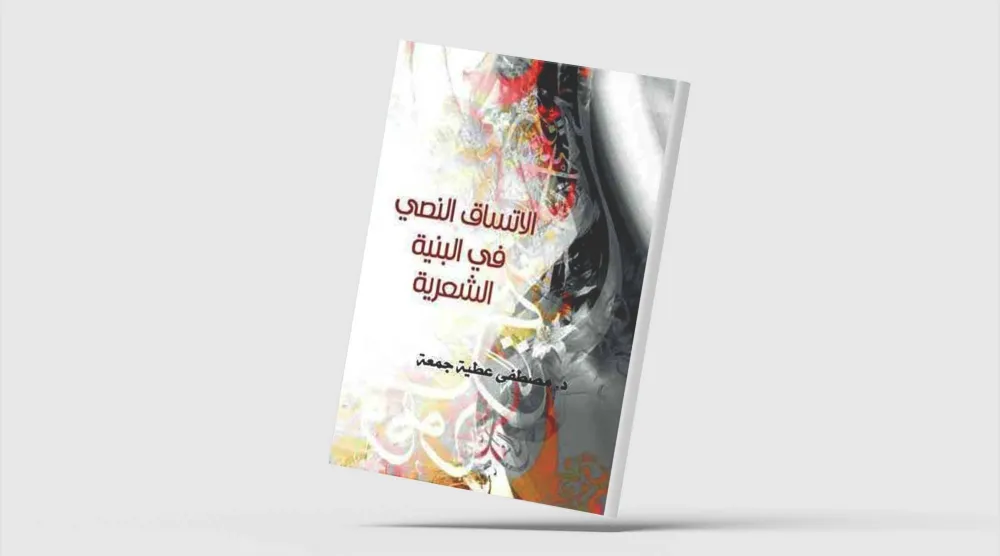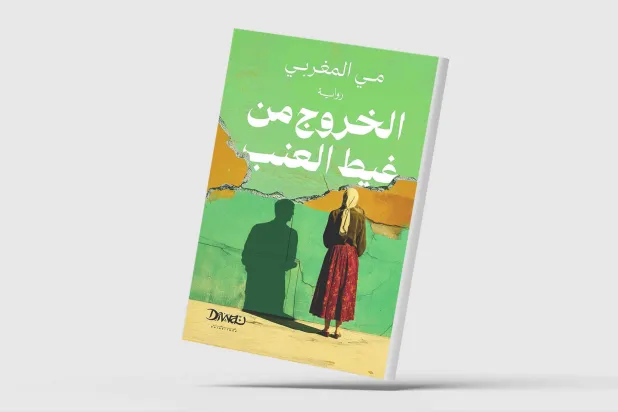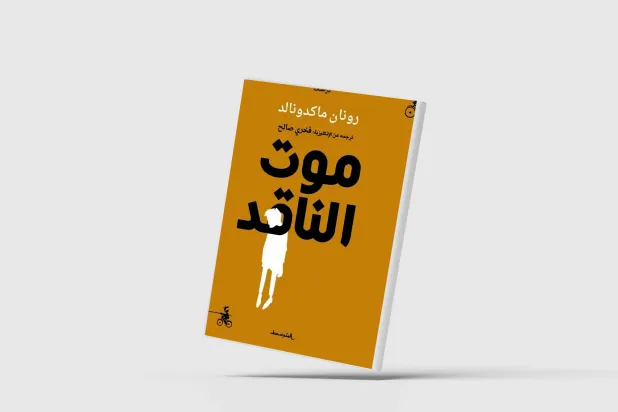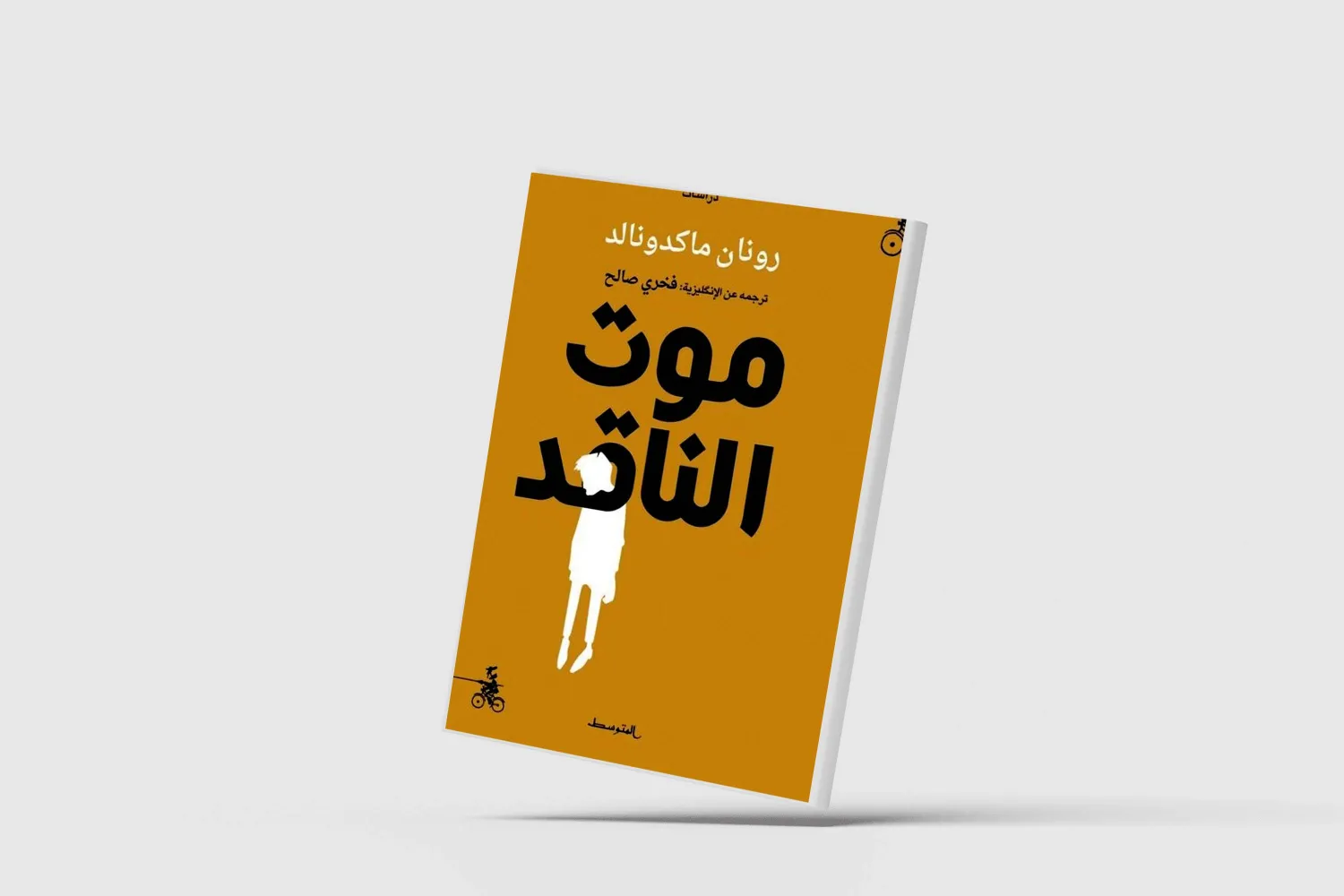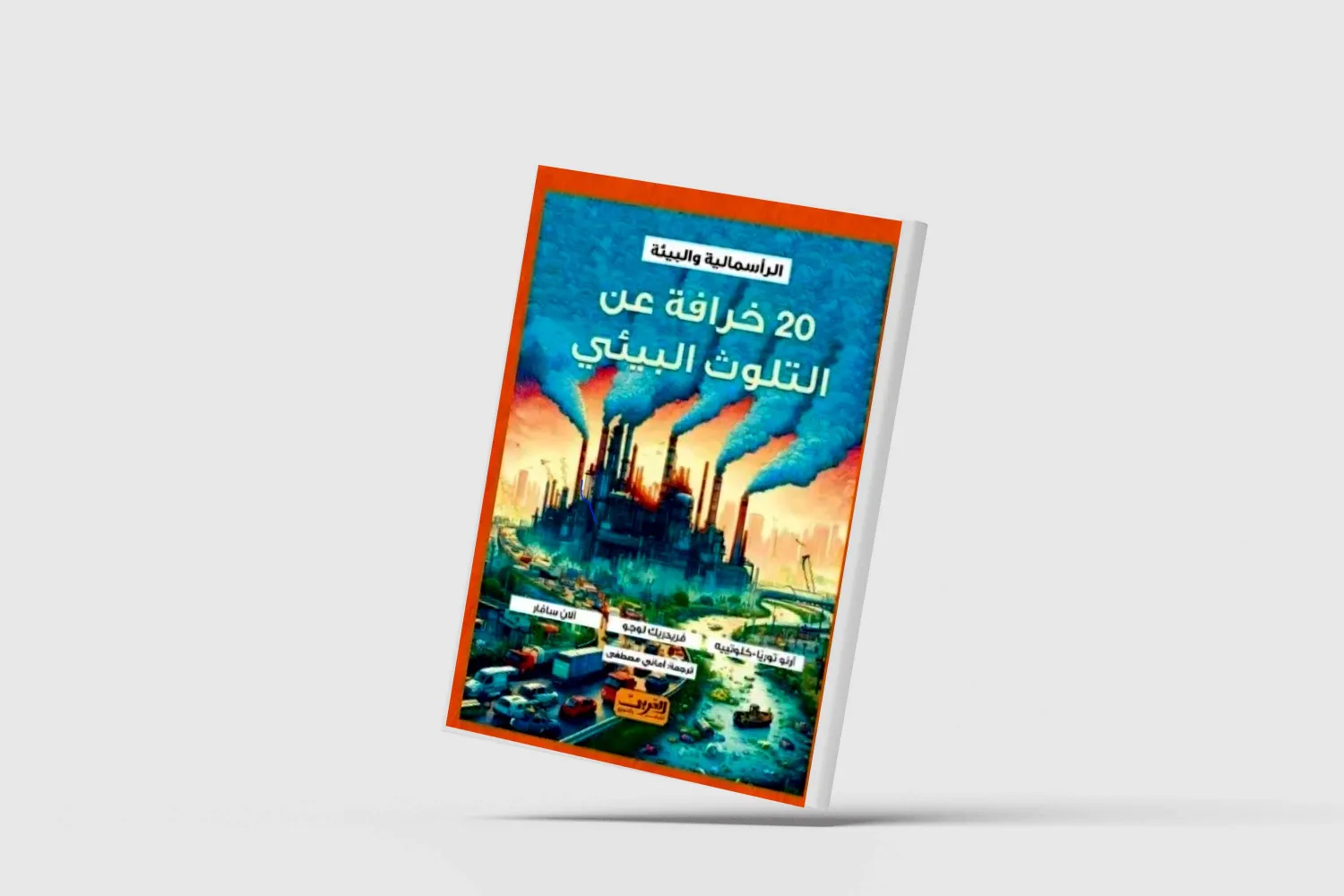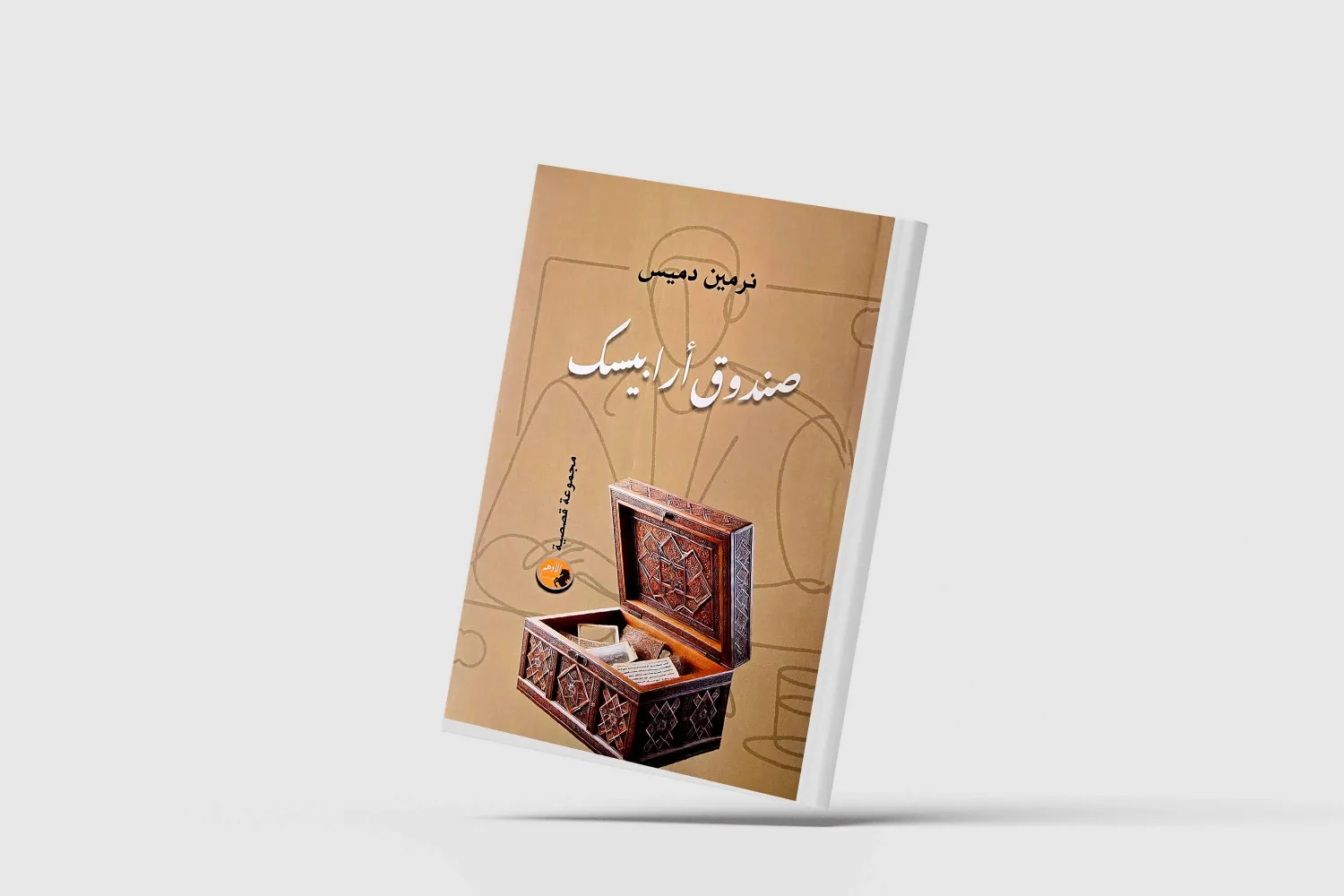لم يأخذ موضوع «الاستشراق» أهميته في المجالين السياسي والثقافي العربيين؛ إذ يُنظر إليه بوصفه ممارسة جرت في الماضي ينحصر الاهتمام بها في نخبة من الدارسين، حتى كتاب إدوارد سعيد «الاستشراق» رغم وجود ترجمتين عربيتين له عومل كأيقونة، بكل ما في الأيقونة من معاني شهرة العنوان والقداسة والبقاء في مكانة عالية وبعيدة لا يدنّسها التمعن في التفاصيل. وهذا تقصير يصل إلى حد الخطيئة الثقافية والسياسية، لأن الاستشراق فاعل ومؤثر في التوجهات الغربية تجاه المنطقة العربية إلى اليوم، وينبغي أن نفهمه لنفهم جذور التحيز الغربي في أدق وأهم قضايانا كقضية فلسطين.
مناهضة ذهنية الاستشراق، هي ما يحاول المستعرب المرموق بيتر جران أن يحققها من خلال دراساته الأربع المنشورة كلها في مطبعة جامعة «سيراكيوز» بنيويورك والمترجَمة كلها إلى العربية في القاهرة، وأحدثها «الاستشراق هيمنة مستمرة... المؤرخون الأنغلو-أميركيون ومصر الحديثة».
صدر الكتاب عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة في ترجمة رصينة للكاتبة سحر توفيق، ومراجعة المؤرخ عاصم الدسوقي.
لا يبدو أن جران بنزاهته ودأبه العلمي وصبره قد حظي بالاهتمام الذي يستحقه عربياً، ربما نال كتابه «ما بعد المركزية الأوروبية - المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة» بعض الاهتمام، لكن كتابيه «صعود أهل النفوذ»، و«الجذور الإسلامية للرأسمالية»، ليسا أقل من ذلك الكتاب، ومع الكتاب الجديد تبدو الكتب الأربعة مشروعاً مناهضاً للنموذج المهيمن في الرؤية الغربية لمصر والمنطقة والعالم.
حتى بعد أن جرت في نهر الدراسات الغربية للشرق مياه كثيرة، تدفقت من عمل إدوارد سعيد، الرائد، إلى أعمال تلاميذه من جيل مؤرخي ومنظِّري ما بعد الاستعمار، لم يزل نموذج «المستبد الشرقي» هو النموذج المسيطر في رؤية الغرب بنخبه الثقافية وصناع القرار السياسي فيه. وبدأبه المعتاد يتتبع بيتر جران أصل هذا النموذج ويحاول عبر فصول الكتاب تفكيكه.
حسبما جاء في العنوان، يرى بيتر جران الاستشراق الإنجليزي والأميركي مدرسة واحدة أسَّسها الإنجليز. لم يستطع المستشرقون الأميركيون التحرك بعيداً عن النموذج البريطاني. يرفض جران الرؤية السائدة لتوقيت بداية الاستشراق الأميركي بتوقيت بداية هذا المجال أكاديمياً بمعناه العلمي قبل الحرب العالمية الثانية، وهي الفترة التي شهدت إنشاء مراكز دراسات الشرق الأوسط. البداية بالنسبة له تسبق هذا بكثير، وكانت مرتبطة بالأهداف الاستعمارية بشكل مباشر، مثل كتاب «وصف مصر» الذي أنجزه باحثون وهواة صاحبوا حملة نابليون على مصر عام 1798، وكتاب «مصر الحديثة» للورد كرومر، الحاكم الإنجليزي بالقاهرة الذي ترك أثراً لا يُمحى على دراسات الاستشراق إلى اليوم. يَعدّ جران «مصر الحديثة» الكتاب المؤسِّس لهذه الدراسات نظراً لاتفاقه مع تقاليد الإمبريالية الإنجليزية والإنجيل في ذات الوقت.
تتداخل العوامل التراثية وأمور الهوية مع العوامل التاريخية في الشرق وفي أميركا ذاتها كما تتداخل مصادر تمويل الدراسات وهوية الكُتَّاب أنفسهم في صناعة الصورة.
ويَعدّ جران «سفر الخروج» النص الأقدم في رسم صورة «المستبد الشرقي» بالدراسات الأنغلو-أميركية كنمط أساسي إسلامي يستعصي على التغيير، وتُقدَّم مصر بوصفها نموذجاً لهذا النمط الذي يرسمه العهد القديم لفرعون مصر. وإلى جانب ذلك هناك الأساس الهيغلي من حيث شمولية الأفكار وأثره في رؤية الشرق.
ولا يفسر هذا الأساس التراثي وحده ثبات الدراسات المتعلقة بمصر، والإصرار على إغلاق العيون على نموذج ثابت دون غيره. يلاحظ جران من قراءاته في الحقبة الكولونيالية بالقرن التاسع عشر وحول قناة السويس أن إنجلترا كانت مهتمة بفكرة الإمبراطورية، مما يعني حاجتها إلى تأمين الطريق إلى الهند وتأمين طريق البترول إلى أوروبا، هكذا يبرز دور مصر كممر يجب أن يكون آمناً. ولم يكن نموذج «المستبد الشرقي» مطلباً أو سياقاً أنجلو- أميركياً فحسب، بل كانت العائلة المالكة المصرية والطبقة المهيمنة في مصر المرتبطة بإنجلترا من أقوى أنصار نموذج الاستبداد الشرقي. في نظر جران كان التفسير الماركسي فرصة لتغيير النظرة، لكنَّ أثره لم يستمر.
بيئة الدراسات في الجانب الأميركي نفسه لها دورها في رسم الصورة؛ ففي نهاية القرن التاسع عشر، الوقت الذي اتجهت فيه دراسات الاستشراق الأميركي إلى التخصص، كانت البلاد لا تزال تعاني من جراح الحرب الأهلية (1861 - 1865) وصعوبات صياغة عقد اجتماعي، وبرزت قضايا النوع والعِرق والطبقة والطائفة. أدى فشل الدولة في صياغة العقد الاجتماعي إلى عقد تحالفات صغيرة للحفاظ على هويتها في فترة تميزت بالعنف الذي وجد صداه في التعليم العالي وتخصصاته المختلفة.
وفي ظل هذا الصراع خسرت النساء والأميركيون من أصل أفريقي أمام الذكور البيض. ويعوّل بيتر جران على خصوصية صوت المرأة الذي سيعود إليه في دراسته للحالة المصرية، ليوضح كيف يتعرض للتغييب في دراسات التاريخ. ويستند جران إلى دراسات المؤرخة المصرية أميرة سنبل الأزهري التي تثبت أن النساء تمتعن بقدر أكبر من المساواة مع الرجال أكثر مما أتيح لهن بصعود الدولة الحديثة عندما تصادف تزامن اعتماد القانون الفرنسي مع مولد السلفية الدينية.
ويلاحظ جران أن الكُتَّاب في موضوع الحداثة المصرية يميلون إلى النخبة الذكورية ويضعون ثقافتها في تضاد مع ثقافة الفلاحين والقبائل وفقراء الحضر، ولا يزال هذا الانحياز قائماً، متشككاً في قدرة دراسات تخضع لهذا الاستقطاب في وصف الواقع.
يفترض نموذج الاستبداد الشرقي وجود فجوة هائلة بين الحاكم والمحكوم، وأن السلطة تتمركز في القاهرة، بينما هي محدودة أو غائبة تماماً على مستوى الأقاليم، والشعب بلا فاعلية كالفلاحين في العصور الإنجيلية، لهذا فالتاريخ المصري راكد، وفي أحسن الأحوال يدور في دوائر، وهكذا يمكن اعتبار عبد الناصر محمد علي جديداً والسادات ومبارك صدى لإسماعيل.
يرفض جران هذه الرؤية ويصل إلى فكرة أن البلدان ليست راكدة، ولكن الركود قد يصيب الدراسات أحياناً. ويدلل على مقولته بأن الصعيد كان مناوئاً لسلطة القاهرة في فترات طويلة، وكانت «جرجا» في قلب الصعيد تتمتع بثقل كبير، ولها أهميتها لدى الباب العالي العثماني بوصفها أحد مصادر الإمبراطورية في القمح.
من بين فرضيات نموذج الاستبداد الشرقي أن التغيير لا يأتي إلا من الخارج، وهذا الاعتقاد الأخير هو ما يجعل المستشرقين وجانباً من مدرسة التاريخ المصرية يصرّون على أن حملة نابليون كانت نقطة النور التي أضاءت التاريخ المصري. وعبر قراءات موسعة لكتب فردية وجماعية ينفي بيتر جران هذه الأسطورة، ويتفق مع الجيل الأحدث من المؤرخين المصريين مثل عاصم الدسوقي ونيللي حنا، على أن الحملة كانت تنبيهاً لكن ما سبقها لم يكن جموداً مطلقاً كما تروّج السردية الاستشراقية. جاء الفرنسيون بأسلحة متطورة شكَّلت صدمة لطبقة الحكم في مصر لكنّ عناصر الحداثة كانت موجودة في المجتمع ذاته، ويمكن تلمسها من ثقافة طبقة وسطى متعلمة تقتني الكتب، كما يمكن تلمسها من عقود البيع والشراء في تلك الفترة.
بعض الأطروحات الحديثة المتأثرة بالنظرية الاجتماعية استطاعت اختراق هذه الرؤية، ويشير جران إلى دراسة ليلى أبو لغد حول نساء قبائل أولاد علي، ورغم تبنيها نموذج الاستبداد الشرقي في البداية، فإن دراستها نماذج النساء وأشعارهن تُثبت سعي النساء إلى المقاومة وحيازة السلطة. المؤرخة زينب أبو المجد، بدورها ترفض اتخاذ الدولة القومية المصرية وحدة تحليل، مؤكدة في دراستها «إمبراطوريات متخيلة» أن الديكتاتور ملمح إمبراطوري وليس ملمح أمة. ويَعد جران كتاب زينب أبو المجد أول دراسة جادة لصعيد مصر الذي فشلت ثلاثة إمبراطوريات: العثمانية، والبريطانية، والأميركية في إخضاعه، وبالطبع فإن تاريخ المقاومة في الصعيد صفحة لا تحبذها الدولة القومية كذلك.
ومن الأميركيين يذكر جران صديقه تيموثي ميتشل، ويَعدّ كتابيه «استعمار مصر» و«حكم الخبراء» نموذجين للرؤية المضادة للنموذج السائد. متأثراً بالفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو، يقدم ميتشل مجادلة حول الطبيعة القسرية للدولة المعاصرة بشكل عام وليس في النموذج المصري فحسب، ولا تنفي طبيعة الاستبداد المصري ومساهمة الاستعمار في إعادة صياغة الدولة على هذا النحو، وجود معارضة في كل وقت. لا تقتصر تلك المعارضة على منطقة أو عِرق أو نوع، إذ يتوقف جران أمام ثورة 1919 طويلاً، ويذهب إلى الاستشهاد بفوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل للأدب، وهو الرجل الذي عاش يراقب الطبقات الشعبية ويكتب عنها... وهكذا فالحداثة ليست نموذجاً يُفرض من الخارج، وليست تحديث نخبة، وإنما عمل متوازن تتدخل فيه جميع العوامل.
للأسف، لم يزل هذا الفهم بعيداً عن دوائر السياسة الأميركية التي تعتقد أن مصر لديها نظام أبويّ، وقد تحب مساعدتها على أن تصبح ديمقراطية. وعلى مدار سنوات تقدم مساعدات مع فصلٍ تام بين الإيمان بالطبيعة الديكتاتورية للنظام وبين التساؤل حول ما إذا كانت المساعدات تؤثر في الطبيعة التي يعمل بها النظام.
يرى بعض الكُتَّاب أن الديكتاتورية تُنتج الإرهابيين الذين يمثّلون تحدياً للغرب، وبعد ذلك يتفرقون بين جماعة تبحث عن طريقة لتغلغل الغرب في المجتمعات الديكتاتورية بغية إصلاحها وأخرى ترى من الخطأ طرح سؤال التغيير من أساسه، في تجاهل لكتابات قلة مثل الكاتب السياسي جايسون براولي الذي يستند إلى النظرية الاجتماعية الجديدة، ويؤكد في كتاب حديث له أن إفراد مصر لا معنى له، لأن الغالبية العظمى من البلدان التي تحاول التحول إلى الديمقراطية تتعثر عند نقطة ما، وينبغي دراسة تلك النقطة في كل حالة.
ويختتم بيتر جران كتابه بالدعوة إلى مزيد من الدراسات الأميركية في حقول مختلفة تفيد الباحثين في الدراسات المصرية، وعلى سبيل المثال دراسة التاريخ المعرفي الأميركي، إذ يقوم بعض العلوم بدور السدنة في الحفاظ على الأفكار القائمة، وليس بعيداً عن ذلك هندسة رواية التاريخ الأميركي بحيث تكون الولايات المتحدة هي «أميركا الشمالية»، واستبعاد أن يكون الإيروكوا وغيرهم من الأميركيين الأوائل جزءاً من الثقافة الرفيعة. ويلاحَظ أن ما يطبقه حراس البوابات على دراسة مصر تشبه ما يطبقونه على دراسة تاريخ فلسطين، حيث ينبغي على الدارسين تحاشي ذكر الفلسطينيين.