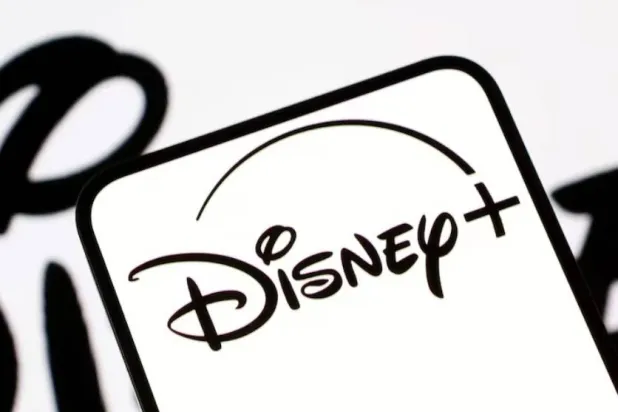تبلغ «حوريّة البحر الصغيرة» (The Little Mermaid) هذا العام سنتها الـ34. تحتفي بها شركة «ديزني» التي ابتكرتها عام 1989، من خلال منحها ولادة جديدة ضمن إعادةٍ لأحد أفلام الرسوم المتحرّكة الأشهر على الإطلاق.
تعود «أرييل» في نسخة واقعية تجسّدها الممثلة والمغنية الأميركية الصاعدة هالي بايلي (23 عاماً)، إلى جانب مجموعة من الممثلين المعروفين مثل خافيير بارديم بدور «الملك ترايتون»، وميليسا ماكارثي التي تؤدي دور الساحرة الشريرة «أورسولا». تزيّن المشهد وتخفّف ظلاله شخصيات متحرّكة كالسلطعون «سيباستيان»، والسمكة «فلاوندر»، والطير «سكاتل».
«أرييل الجديدة»... ما لها وما عليها
قد يكون من الظلم بحقّ النسخة الواقعية المستحدثة، مقارنتها بالنسخة الأصلية المتحرّكة من «حوريّة البحر الصغيرة». فذاك الفيلم شكّل ظاهرة في عالم الرسوم المتحركة داخلاً التاريخ، كما أنه منح شركة «ديزني» نهضةً كانت بأمسّ الحاجة إليها في نهاية الثمانينات. أما ما يقوم به المخرج روب مارشال في النسخة الجديدة، فهو مزاوجة التقنيات الحديثة مع روح قصة الكاتب الدانماركي هانس كريستيان أندرسن.
ربما يبدو مستغرباً بالنسبة إلى جيلٍ عرف «أرييل» ورفاقها مرسومين، أن يشاهدهم بشراً حقيقيين يتحرّكون تحت المياه، كما لو أن الشاشة عبارة عن «أكواريوم». قد تصاب كذلك «النوستالجيا» بخيبة، لفرط استخدام المؤثرات والصور المبتكرة بواسطة الكمبيوتر. لكن يحق للجيل الجديد أن يكتشف الحكاية ويتعرّف إلى بطلتها في إطار متطوّر، يتماشى مع ما اعتادت عيونهم عليه من تقنيات حديثة.

مشاهد أعماق البحار داكنة في معظم الأحيان إلى درجةٍ تصعب فيها الرؤية ما يقتل سحر اللحظة، ولعلّ المنتجين لم يأخذوا في الحسبان أن ليست كل شاشة سيُعرض عليها الفيلم مزوّدة بنظام «دولبي» المتطوّر. هذا في الشكل، أما في المضمون فتُلام النسخة الجديدة على مدّتها المبالغ فيها (ساعتان وربع الساعة، مقابل ساعة و20 دقيقة للنسخة الأصلية). بعض الإضافات تبدو عديمة الفائدة، وبطيئة وطويلة.
رغم ذلك، يعوّض فيلم «الحوريّة» عن إخفاقات «ديزني» السابقة في نقل كلاسيكيات متحرّكة إلى نسخ واقعية، كما حصل مع «Lion King» و«Beauty and the Beast». هو الأنجح بين كل ما سبقه من محاولات، لا سيّما أنه حافظ على التناغم بين سحر الحكاية، وجاذبية الشخصيات، والصورة الجميلة، رغم بعض الهفوات.

عناصر الجذب
وحدها قصة الحورية الفضوليّة «أرييل» كافية لجذب الأنظار. من تمرّدها على والدها ملك البحار الذي لا يريد بينها وبين عالم البشر أي احتكاك، مروراً بالسحر الذي ترميه عليها عمّتها الشريرة «أورسولا» الطامعة بمملكة والدها، وليس انتهاءً بعلاقة الحب التي تجمع بينها وبين الأمير «إريك»، الذي يؤدي دوره البريطاني جوناه هاور كينغ.
للموسيقى في الفيلم حصّة كبيرة، وهو يستحق عن جدارة أن يوضع في خانة السينما الموسيقية، خصوصاً أن إعادات الأغاني التي طبعت «الحوريّة الصغيرة» فيها ما يكفي من المتعة السمعيّة والبصريّة. تفتتح بايلي بصوتها الناصع مجموعة أغانيها بنسخة ساحرة عن «Part of Your World»، ولأصدقائها السلطعون والسمكة والطير حصّتهم كذلك من الأداء اللطيف والمسلّي، كما في أغنية «Under the Sea».
إلى جانب الأغاني، يأتي أداء بايلي التمثيلي ليُدهش كلاً من النقّاد والمشاهدين. يليق بها دور الحوريّة السمراء بشعرها الأحمر الطويل، مهما علت الأصوات العنصرية الممتعضة من لون بشرتها. وتمدّ ميليسا ماكارثي «أورسولا» يدَها إلى بايلي لتمنحا معاً الفيلم بريقه. في المقابل، يبقى أداء الممثل الإسباني خافيير بارديم باهتاً بعض الشيء.
ومن بين عناصر الجذب، الرسائلُ الهادفةُ التي نجح الفيلم في تمريرها، كأزمة تلوّث المحيطات بالنفايات البشرية، التي تضيء عليها شقيقات «أرييل» الحوريّات الستّ ذات الزعانف الملوّنة البرّاقة. نَراهنّ وهنّ ينظّفن ما غرق من بقايا السفن، فيما تجمع «أرييل» الأغراض الغارقة وتخبّئها في مغارتها البحريّة التي تحوّلت إلى متحف للآثار البشرية.

الحوريّة في مواجهة العنصرية
دائماً ما تسحب المياه الحوريّة الصهباء إلى أعلى، ومن خلال وقوعها في حب الأمير الذي تنقذه من الغرق بعد احتراق سفينته، يمرر الفيلم رسالته الأساسية. ترمز حكاية «أرييل» و«إريك» إلى توحيد الاختلافات وتحويلها إلى نقاط ضوء.
تستحدث النسخة الجديدة من الفيلم تفصيلاً مهماً يقضي بأن يكون الأمير الأبيض، الابن المتبنّى للملكة السمراء. البشرة الملوّنة حاضرة إذن عبر هذه الشخصية وليس من خلال «أرييل» فحسب. من دون الغرق في المواعظ، يسجّل الفيلم هدفاً في مرمى التنوّع والتسامح. يجمع ما بين عالم البحار واليابسة المتخاصمين وفق مقتضيات السيناريو، أما وفق رؤية «ديزني» فيجمع ما بين الأعراق والألوان. وهو تقليدٌ درجت عليه الشركة منذ «بوكاهونتاس»، و«موانا»، و«إزميرالدا» وغيرهنّ.
إلا أن هذه المرة، لم تسلم «ديزني» ولا هالي بايلي من التجريح وسهام العنصرية. إذ ما إن انتشر خبر اختيار الممثلة السمراء لتكون «أرييل» الجديدة، حتى بدأت حملة مضادة وشرسة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار «هذه ليست أرييل». ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ انسحب إلى ما بعد انطلاقة الفيلم في دور السينما.
انخفضت المراجعات الإيجابية على مواقع التقييمات، ومعها انخفضت الإيرادات. وقد اتّضح أن جيوشاً إلكترونية جُنّدت خصيصاً لإعطاء الفيلم تقييمات سلبية، ما اضطرّ موقع «IMDB» الشهير إلى تعديل نظام التصنيفات الخاص به.
بعد مرور 3 عقود على النسخة الأولى من أحد أشهر أفلام «ديزني»، تعايشَ المنتقدون مع فكرة حوريّةٍ تتحوّل زعانفها إلى قدمين بشريتين. غير أنهم فشلوا في تقبّل تحوّل بشرتها من بيضاء إلى سمراء.