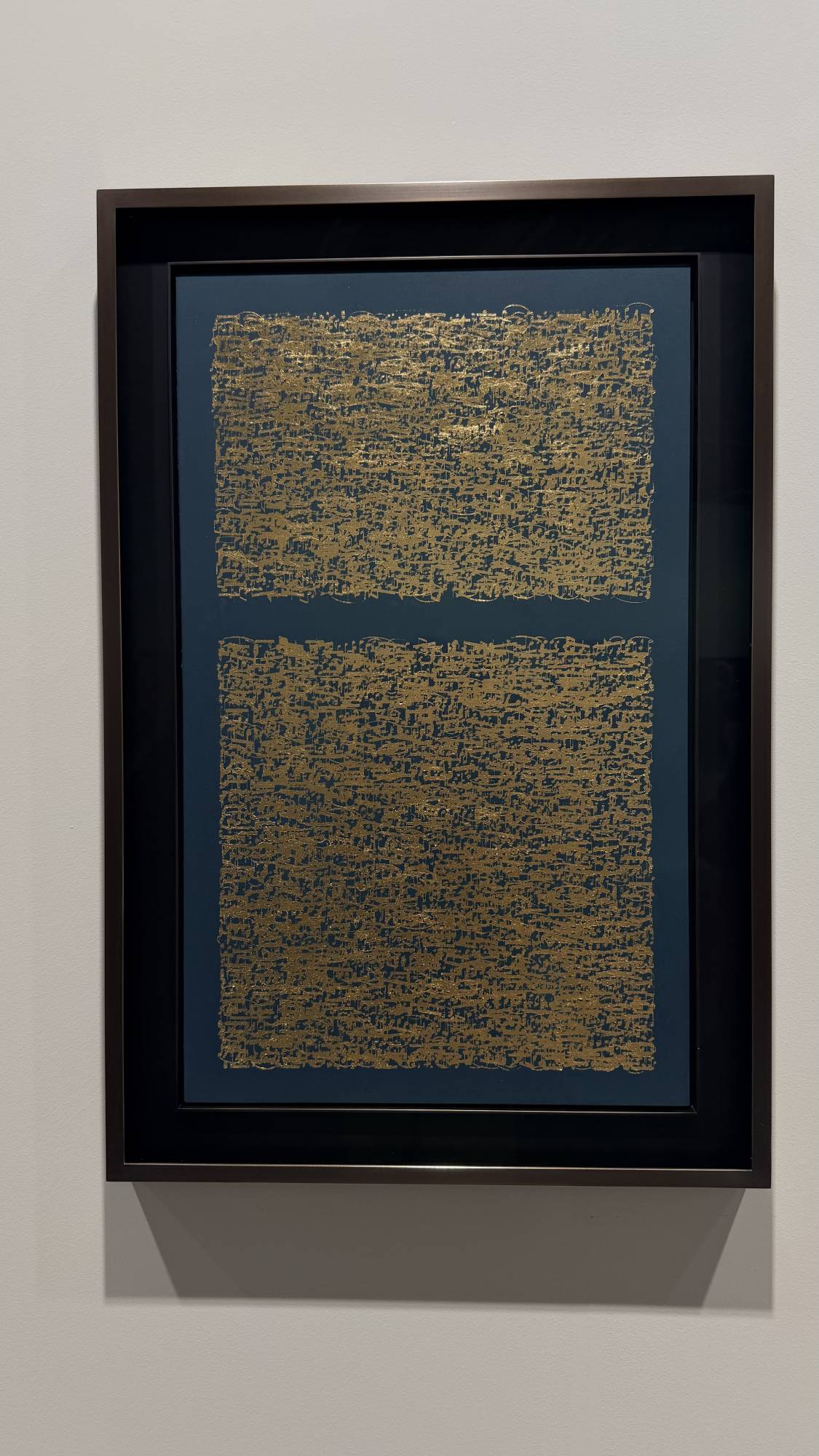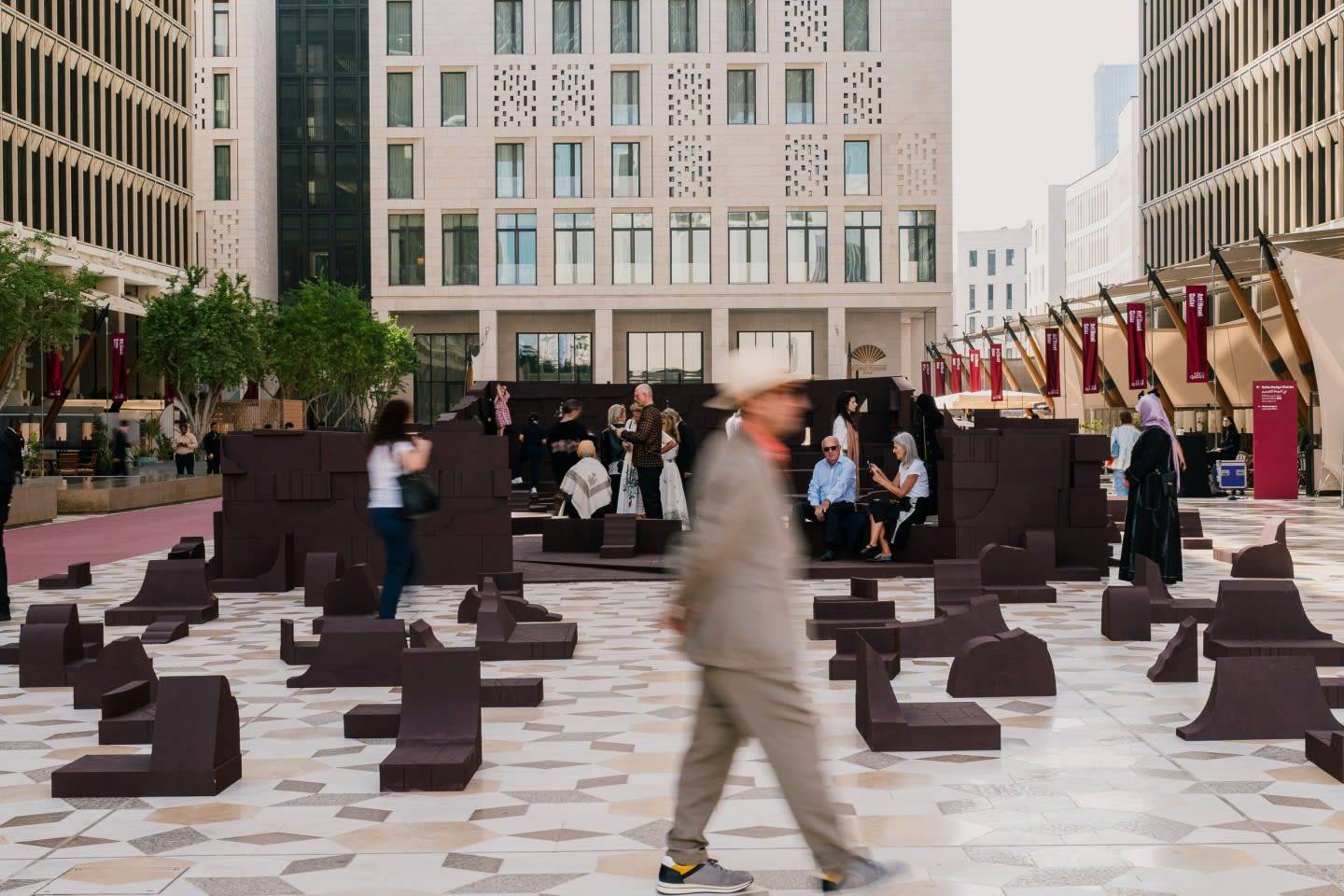تستقبل دور العرض السينمائية في مصر، الأربعاء، فيلم «درويش» الذي يعد أحدث الأفلام المنضمة لموسم الصيف السينمائي، وتدور أحداثه في أربعينات القرن الماضي، تحديداً عام 1943، خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر من خلال مواقف تحدث بشكل متسارع في غضون أشهر قليلة.
الفيلم الذي كتبه وسام صبري، ويخرجه وليد الحلفاوي، يقوم ببطولته عمرو يوسف مع دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، وأحمد عبد الوهاب، مع محمد شاهين صاحب الحضور الخاص في الأحداث التي تتضمن ظهور بعض ضيوف الشرف على غرار هشام ماجد، والإعلامي محمود سعد، والفنانة يسرا التي يصاحب صوتها الفيلم من بدايته حتى النهاية، مع ظهورها ضيفةً في مشهد واحد وبشكل تطل فيه بمرحلة متقدمة في العمر.
تنطلق أحداث الفيلم من خلال «درويش» عمرو يوسف، اللص البارع الذي يعمل بذكاء مع عصابته التي تضم شريكته «زبيدة» دينا الشربيني، و«عدلي» مصطفى غريب، بالإضافة إلى «رشدي» أحمد عبد الوهاب، لينطلق الرباعي في عملية سرقة ناجحة من مهراجا هندي، لكن نجاح السرقة لم يمنع من تعرض درويش للخيانة وسرقة الجوهرة منه وملاحقته من جانب الشرطة.

تتسارع الأحداث وسط مطاردات لا تتوقف، يجد «درويش» نفسه متهماً بقتل مسؤول بريطاني بارز، بالإضافة إلى 3 جنود آخرين، ليصدر عليه حكمٌ بالإعدام، في مقابل بروز اسمه بالشارع في مصر رمزاً للنضال والوطنية ومقاومة الاحتلال، فيما يحاول إثبات براءته من قتل المسؤول البريطاني لكن دون فائدة.
يتحرر «درويش» من محبسه بعملية نفذتها كتيبة «طالوش» للمقاومة التي تحمل اسم قائدها «طالوش»، خالد كمال، التي يتعرف فيها على «كاريمان»، تارا عماد، وتتوالى الأحداث مع تغير مسار حياته، فشعار «درويش» في الحياة «فكر بسرعة وتحرك أسرع» يحاول تطبيقه باستمرار في كافة المواقف التي يتعرض لها، مع دخوله في عالم لا يشبهه، بين اتفاقات ملتبسة وقصة حب لم تكن في الحسبان ومطاردات وشكوك لا تتوقف من كل صوب.
الفيلم المقرر عرضه في الصالات العربية يوم 28 أغسطس (آب) الحالي، يقدم توليفة درامية تمزج بين الإثارة والكوميديا مع علاقات شديدة التعقيد ومواقف متلاحقة يتعرض لها «درويش» الساعي لتغيير حياته من الفقر إلى الثراء، لكن القدر يضعه في اختبارات عديدة مع اكتشاف العديد من الأمور التي تغير نظرته للحياة.
بطل الفيلم عمرو يوسف أكد إعجابه بفكرة الفيلم عندما قرأها لدى السيناريست وسام صبري قبل أكثر من 4 سنوات، لكن خروجها للنور تأخر لكونها كانت بحاجة لجهات إنتاجية تؤمن بها، مضيفاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الفيلم استلزم العمل لفترة طويلة من التحضيرات قبل التصوير، وأيضاً احتاج وقتاً بعد التصوير ليخرج بالصورة التي سيشاهدها الجمهور».

وعبرت تارا عماد عن سعادتها بتجربة «درويش»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «تحمست كثيراً للظهور في حقبة الأربعينات، وانجذبت لدور (كاريمان) منذ حديث المخرج وليد الحلفاوي معي عن الدور»، لافتةً إلى الحرفية الشديدة المكتوب بها العمل والتحضيرات التي ساعدت على خروجه بصورة جيدة.
ويصف الناقد السينمائي المصري أندرو محسن فيلم «درويش» بأنه «من أكثر أفلام الموسم الحالي تماسكاً من الناحية الفنية»، وأشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود العديد من الجوانب الإيجابية، وتميز أبطاله في أدواره، خصوصاً دينا الشربيني وتارا عماد اللتين قدمتا الشخصيتين بصورة تتناسب مع طبيعتيهما»، لافتاً إلى أن «أداء محمد شاهين اتسم بالمبالغة التي ربما جاءت بشكل أكبر من المطلوبة لدوره في الفيلم».
وأضاف أن «السيناريو والفكرة التي يقدمها العمل جاءت قوية في النصف الأول من الفيلم مع إيقاع سريع وسلاسة في الأحداث، وقدرة على الجذب، وهو أمر تراجع نسبياً في النصف الثاني، خصوصاً مع كثرة الأفكار التي طرحت والتعقيدات التي ربما كان يمكن معالجتها بشكل أفضل».
«ورغم وجود بعض الملاحظات على التفاصيل الفنية الخاصة بحقبة الأربعينات التي تدور فيها الأحداث»، وفق كلام محسن، إلا أنه يرى «المجهود الكبير المبذول في الصورة والملابس، أظهر اجتهاد فريق العمل لتقديم صورة أقرب للواقع، بما يجعل هناك مساحة للتغاضي عن بعض المبالغات».