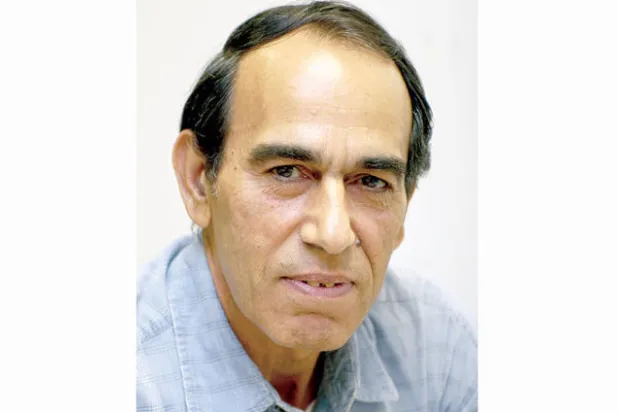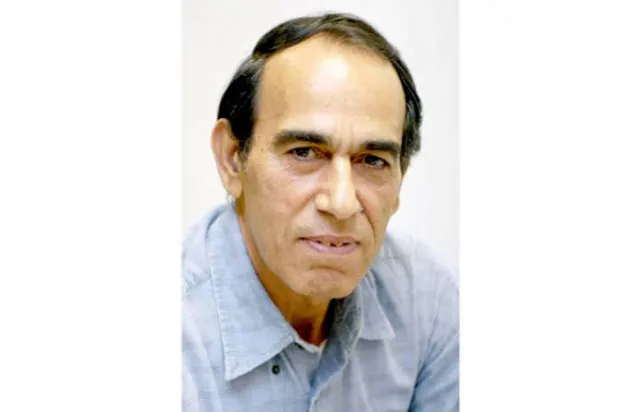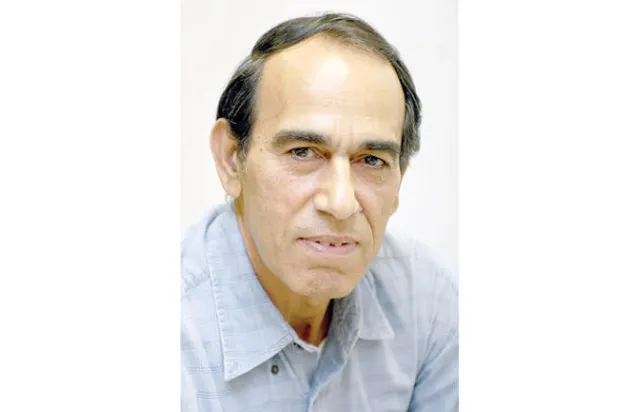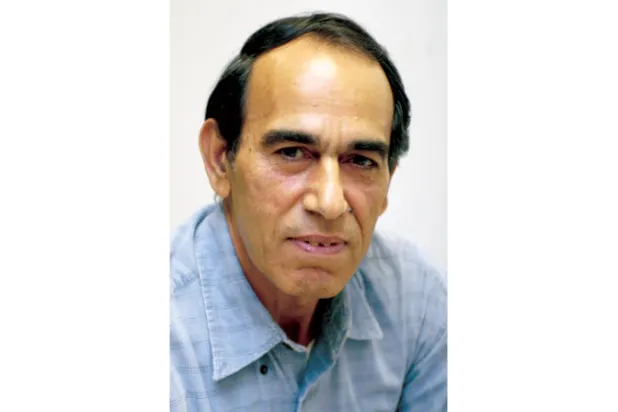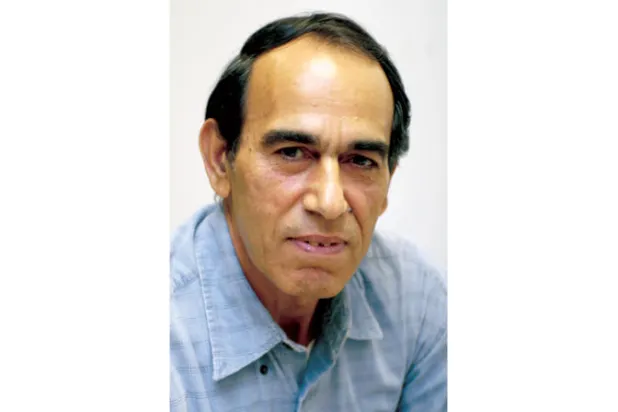فاضل السلطاني
تتشكل في منعطفات حاسمة في التاريخ، وفي ظروف اجتماعية وثقافية معينة، أجيال شعرية وفنية يمكن أن نسميها بـ«الأجيال الذهبية»، التي تقلب ما قبلها، وتشكل ما يأتي بعدها من أجيال في عملية انقلابية حقيقية. وهي تسمى بـ«الأجيال» تجاوزاً، فهي ليست محصورة ضمن فترة زمنية محددة، كما أنها ليست مجرد مجموعة ضمت أسماء محددة، أو مدرسة تدعو لأساليب أو أشكال معينة تتزامن مع أساليب أخرى، وهي كذلك ليست اتجاهاً جمالياً يتزامن مع اتجاهات مغايرة. حصل هذا، مثلاً، في إسبانيا في 1927، مع المجموعة التي سميت بـ«مجموعة 27»، التي ضمت شعراء مثل خورخي غيين، بيدرو ساليناس، رافائيل ألبرتي، فيديريكو غارثيا لوركا، وبيثنتي أليكساندره
الشعر ليس لغزاً. وإذا كان كذلك، فإنه سينتمي إلى أي حقل آخر... حقل كيميائي أو فيزيائي أو رياضي، ولكن بالتأكيد ليس إلى حقل الشعر. لكن الشعر، في الوقت نفسه، لا يخلو من معادلاته الداخلية الخاصة، الني لا تحتاج إلى جهد كبير من القارئ لقراءة شفراتها... إنها تتطلب فقط نوعاً من «الكرم الذاتي» من قبلنا نحن القراء، أي أن يدخل القارئ إلى عالم القصيدة بوجداننا وعقولنا، وأن «نمنح» أنفسنا لهذا العالم، حتى نصبح جزءاً منه، أو فنقل أصدقاء له. وبتحقيق ذلك، ستتحول عملية القراءة، كلما توغلنا أكثر في النص، إلى عملية داخلية، وليس خارجية تتم من خلال العينين فقط.
تنتج العزلة دائماً بعض أسئلتها المريرة عن أنفسنا والآخرين، وعن العالم الذي بدأت تضيق المسافة بينه وبيننا، فيبدو وكأنه فارغ تقريباً. نحن هنا وهو هناك. تزورنا أشباحه فقط. تحوم في غرفنا، ثم تختفي حتى قبل أن نتعرف على شيء من ملامحها. ولكن هل كنا حقاً نرى ذلك العالم قبل أن نغلق أبوابنا علينا؟ هل كنا يوماً في داخله، نسمع صوته، ويتغلغل في نسيجنا ضوؤه السابح في الميادين والساحات والشوارع، المتراقص بين الفضاء والأرض؟ لم نكن نرى.
هل الشهرة، أو بعضها على الأقل، نتيجة سوء فهم؟ يبدو أن الأمر كذلك في حالات كثيرة في التاريخ الأدبي، ويساهم الزمن والقارئ في سوء الفهم هذا. فقد اشتهر كثيرون لدورهم في نشوء حركات أدبية في فترات زمنية معينة، وليس بسبب القيمة الأدبية لنتاجاتهم ذاتها، كما حصل في الأربعينات والخمسينات مع ولادة الشعر الحديث أو الحر، وكما حصل أيضاً مع قصيدة النثر في الستينات.
في لقاء لنا مع الكاتب البرازيلي بابلو كويلو، في لندن، بعد خمسة أشهر من سقوط صدام حسين في أبريل (نيسان) عام 2003، ذكر أنه سيزور العراق قريباً ليكتشف بنفسه «إن كان هناك في البلد شعراء وكتاب وثقافة وليس فقط (رجال بشوارب غليظة)، وقتل وسيارات مفخخة». قلنا له: «لكن لا حاجة للسفر حتى تعرف ذلك».
قال آينشتاين مرة: «لا أدري بأي أسلحة سيجري خوض الحرب العالمية الثالثة، لكن المؤكد أن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة». ولكن يبدو أن هناك حرق مراحل في الحروب، كما في السياسة. وواضح أننا حرقنا مرحلة الحرب العالمية الثالثة، بعد أن أيقنت البشرية أنه لن يكون هناك غالب ومغلوب، وأن الأطراف جميعها ستستعر في جحيمها؛ فقنبلة «الأخ الصغير»، التي دمرت هيروشيما في الحرب العالمية الثانية، أصبحت الآن في ملكية الجميع تقريباً، وأن توازن الرعب قد صار حقيقة. أدرك الجميع ذلك. صارت القنبلة النووية «خردة» يأكلها الصدأ في مستودعها. تجاوز الزمن الحرب الكونية الثالثة. لم يعد يحتاج إليها.
كلما أعلن عن الفائز بجائزة نوبل، ارتفع الصراخ العربي، الذي قلما نسمعه في أي مكان من العالم، وكأن ظلماً عظيماً قد ألحق بنا. إننا نتوهم أن هناك أسماء عربية معينة مرشحة للجائزة، وتبقى في حالة ترقب قصوى، بل حالة حمى. وحين لا يتحقق هذا الوهم تتضاعف خيبتنا كل عام، وتنهال اتهاماتنا على الأكاديمية السويدية التي تناصب العداء لكل ما هو عربي. وكأننا، من حيث لا ندري، نريد اعترافاً بنا وبأدبنا، نابعاً من شعور يفضح نفسه، رغم كل قناع: شعور بالدونية لا ينتهي إلا باعتراف الآخر بنا.
لا مدينة غير بيروت كانت مفتوحة أمامنا، حين تضيق بنا الأرض، وتطردنا تلك الأوطان التي كنا نصدّع رؤوسها بـ«لغونا»، وهو حقاً مجرد لغو، عن الحرية والخبز والمساواة والحق في الحياة كما نشتهي على هذه الأرض. لم تسألنا بيروت عما نحمل في رؤوسنا وأرواحنا، ولم تفتش في حقائبنا عن منشورات سرية وكتب ممنوعة، ولم تعرف حتى أسماءنا. لا مفتاح سحرياً لباب بيروت، إنه مشرع دائماً، ولا شرط لبيروت على أحد.
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة