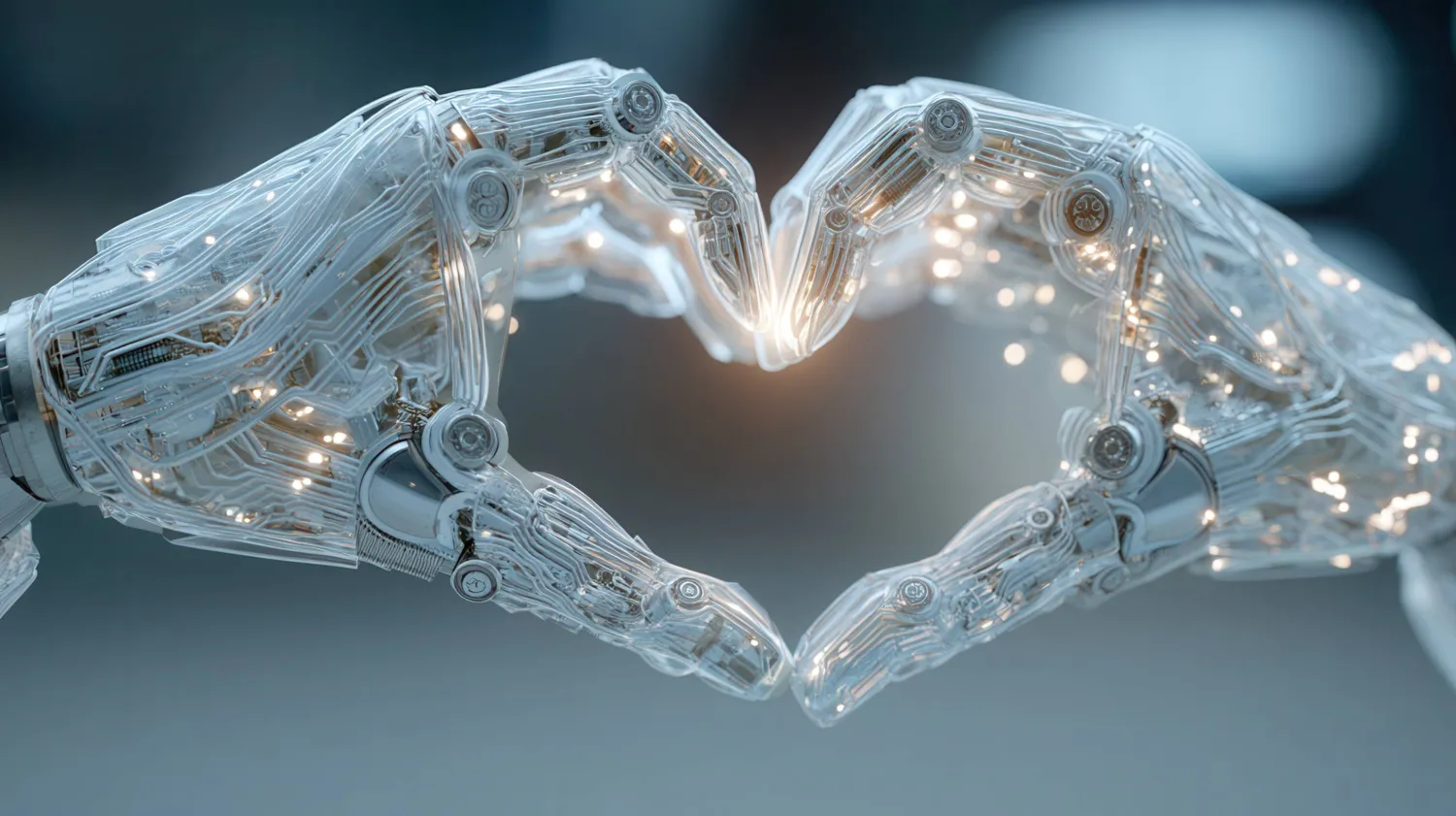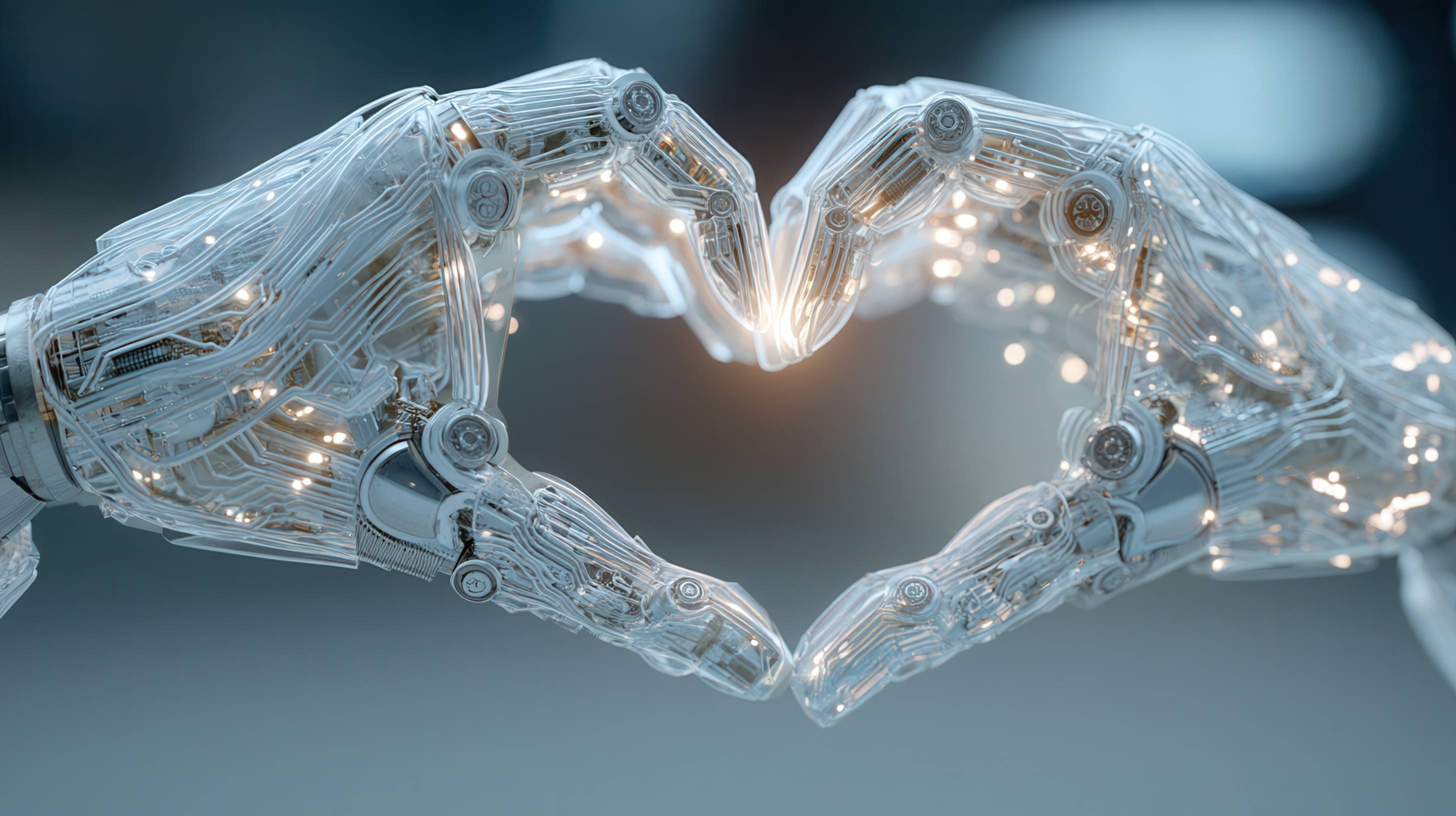إن كنت تبحث عن هاتف بشاشة كبيرة، فإن السوق مزدحمة بالخيارات، مثل: «آيفون 7 بلاس»، و«غالاكسي إس 8 بلاس»، و«جي 6»، و«مايت 9». ولكن هناك هاتفاً متخصصاً بالتصوير يستطيع حفظ اللحظات بأجمل الألوان، وبدقة عالية في تصميم جميل وأداء متقدم، وهو هاتف «بي 10 بلاس» P10 Plus من «هواوي»، الذي أطلق في المنطقة العربية أخيراً، والذي اختبرته «الشرق الأوسط»، ونذكر ملخص التجربة.
تصميم جديد
أول ما سيلاحظه المستخدم أن الهاتف يحتوي على مستشعر البصمة في المنطقة الأمامية عوضاً عن الخلفية، وهو مستشعر يقدم 3 وظائف، بحيث يلمس إصبع المستخدم الزر الرقمي مرة واحدة للعودة إلى الشاشة السابقة، أو الضغط مطولاً للعودة إلى الشاشة الرئيسية، مع القدرة على تحريك الإصبع من اليمين إلى اليسار للتنقل بين التطبيقات التي تعمل في الخلفية، أو تحريك الإصبع إلى الأعلى للبحث من خلال تطبيق «غوغل».
وقد يشعر المستخدم في البداية بأن هذه الميزة غريبة وليست ضرورية؛ لأن شاشة الهواتف الجوالة تعرض هذه الأزرار في المنطقة السفلية، إلا أن هذا الزر من شأنه إزالة الحاجة لذلك القسم المخصص من الشاشة، وفسح المجال للحصول على شاشة تعرض المحتوى بالكامل، ليشعر المستخدم بأنه يحصل على شاشة أكبر مما كان في السابق. هذا، ويعمل الزر نفسه كمستشعر سريع جداً للبصمة وبدقة عالية، بحيث لم يخطئ بالتعرف على البصمة بعد تجربته لأكثر من 25 مرة متتالية، مع ميلان الإصبع بزوايا مختلفة في كل مرة.
* هاتف تصويري متطور
الميزة المهمة في الهاتف هو تقديمه لـ3 كاميرات تعمل بتقنيات عدسات شركة «لايكا» الألمانية، اثنتان منها في الجهة الخلفية وأخرى في الجهة الأمامية. ويقدم الهاتف أحدث تقنيات التصوير لالتقاط صور «بورتريه» Portrait تضاهي التصوير الاحترافي لأغلفة المجلات، حيث تعمل الكاميرا الأمامية بصحبة برمجيات متطورة للتعرف على عدد الأشخاص الذين يتم التقاط صورتهم الذاتية «سيلفي»، وتكبير أو تصغير الصورة تلقائياً، والتركيز على أوجه الأشخاص آلياً، وبكل سهولة. ويقدم الهاتف مزايا تصويرية عالية، مثل تقنية التعرف المُجسّم على الأوجه (للتعرف على 190 نقطة في الوجه بهدف رفع سرعة التصوير والدقة) وفلاتر (راشحات) لتحسين الصور الملتقطة والإضاءة الحيوية، كما تمتاز عدسة الهاتفين باستخدام مستشعر ألوان RGB بدقة 12 ميغابيكسل ومستشعر اللون الأحادي بدقة 20 ميغابيكسل، ناهيك عن خوارزميات الدمج المطورة للصور للحصول على صورة نهائية خلابة.
وتجتمع هذه المزايا مع حلول التثبيت البصري للصورة Optical Image Stabilization OIS، وأول كاميرا مزودة بعدسة مزدوجة وتقنية جمع البيكسلات لتقديم نظام تصوير متقدم لالتقاط الصور الليلية، أو في ظروف الإضاءة الخافتة. ويستخدم الهاتف برمجيات تستند إلى نتائج الأبحاث المطولة التي أجرتها «هواوي» على أشكال الوجوه المختلفة وألوان البشرة المتنوعة. وبعد فهم الصفات المميّزة لكل وجه والأنواع المتفردة لكل بشرة، تستطيع البرمجيات المتخصصة إجراء تحسينات للصور الملتقطة بطرق مبتكرة وطبيعية للغاية. كما تتيح مزايا الإضاءة الحيوية إمكانية إعادة اختيار الإضاءة المناسبة للصورة بشكل احترافي.
وسيستطيع محبو مشاركة الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي نشر صور فنية تخطف أبصار الأصدقاء، حيث أضافت الشركة إلى عدسة الهاتف أدوات تصوير مماثلة لأدوات التصوير الاحترافي ومؤثرات الإضاءة المتوفرة في استوديوهات التصوير، مثل اللون الطبيعي واللون الأحادي لتأثيرات Bokeh البصرية، بالإضافة إلى تقنية التركيز الهجين Hybrid Zoom، وهي أدوات احترافية سهلة الاستخدام، من شأنها إضفاء لمسات طبيعية وألوان حيوية إلى الصور الشخصية. كما تتيح البرمجيات المتقدمة للكاميرا تحسين مظهر البشرة في الصور، وتجعلها تبدو أكثر إشراقاً وحيوية وبالألوان الطبيعية، وسيشعر المستخدم بأن الفريق الذي طور تطبيق التصوير هو فريق احترافي في مجال التصوير وليس في البرمجة فقط.
مواصفات تقنية
ويبلغ قطر شاشة الهاتف 5.5 بوصة وهي تعرض الصورة بالدقة الفائقة 2560x1440 بيكسل، وبكثافة 540 بيكسل في البوصة، وهناك إصدار مصغر بشاشة يبلغ قطرها 5.1 بوصة اسمه «بي 10» P10 يتشابه في الغالبية العظمى للمواصفات التقنية مع إصدار «بي 10 بلاس». ويقدم الهاتفان مستويات أداء مرتفعة بسبب استخدام 4 و6 غيغابايت من الذاكرة، وتوفير 32 و64 و128 غيغابايت من السعة التخزينية المدمجة التي يمكن رفعها بـ256 غيغابايت إضافية، من خلال بطاقات الذاكرة المحمولة «مايكرو إس دي». ويعمل معالج «كيرين 960» Kirin 960 ثماني النواة بسرعات تصل إلى 2.4 غيغاهرتز، مع قدرته على معالجة الرسومات، وتشغيل تطبيقات الرسومات المتطلبة بكل سهولة. كما يدعم الهاتفان استخدام شريحتي اتصال في آنٍ واحد. تصميم الهاتفين أنيق وفاخر ومتين، وتبلغ سماكتهما 7 مليمترات، ويبلغ وزنهما 165 و145 غراما.
ويقدم الهاتفان تقنيات حصرية وعناصر تصميم مميزة تتضمن واجهة الاستخدام المطورة EMUI 5.1 كليا، مع عمل البطارية بقدرة 3750 ملي أمبير في الساعة في هاتف P10 Plus وبقدرة 3.200 ملي أمبير في الساعة في هاتف P10. واستخدام تقنية الشحن الفائق SuperCharge التي تسمح بشحن 60 في المائة من البطارية خلال 30 دقيقة فقط، وشحن البطارية بالكامل من الصفر في خلال 90 دقيقة فقط. ويدعم الهاتف تشغيل شريحتي اتصال في آنٍ واحد.
كما يقدم الهاتفان نظام الحماية Super Safe 5 - gate الذي يضبط الفولتية والتيار والحرارة بشكل متواصل، بهدف رفع مستويات السلامة وإطالة عمر البطارية. وتسمح هذه التقنية للهاتف بـ«التحدث» مباشرة مع الشاحن لتعديل شدّة التيار المطلوبة لشحن البطارية عبر عدة مراحل، وتعديلها في أي وقت وفقاً لدرجة حرارة البطارية ونسبة شحنها. ويستطيع الهاتفان معرفة ما إذا كان هناك تسريب للتيار الكهربائي على شكل حرارة إضافية وخفض شدة التيار فوراً، الأمر الذي يرفع من سرعة شحن البطارية، ويحمي المستخدم والبطارية من مخاطر ارتفاع الحرارة، وبأعلى مستويات الكفاءة الكهربائية الممكنة.
الهاتفان متوفران في السعودية والمنطقة العربية بألوان: الأزرق المتلألئ والأسود المطفي والذهبي، بسعر 2499 ريالاً سعودياً (666 دولاراً) و1899 ريالاً سعودياً (506 دولارات).
منافسة حادة
ويتنافس «بي 10 بلاس» مباشرة مع «غالاكسي إس 8» الذي سيطلق في وقت لاحق من هذا الشهر، و«آيفون 7 بلاس» و«جي 6» من حيث المواصفات التقنية وقطر الشاشة. ويقدم «بي 10 بلاس» القدرة على التعرف المجسم على الأوجه وتعديل الإضاءة آلياً بعد التقاط الصور، وتعديل ألوان البشرة وفقا لنتائج الأبحاث على الأوجه الحقيقية، بالإضافة إلى وجود مستشعر متخصص باللونين الأبيض والأسود، واستخدام كاميرا أمامية بعدسات «لايكا»، وهي جميعاً مزايا غير موجودة في «غالاكسي إس 8»، بالإضافة إلى أن «بي 10 بلاس» أقل سماكة (6.98 مقارنة بـ8.1 مليمتر) ووزنه أقل (165 مقارنة بـ173 غراماً)، وبطاريته أعلى قدرة (3750 مقارنة بـ3500 ملي أمبير في الساعة) وهو أقل سعراً (666 مقارنة بـ829 دولاراً).