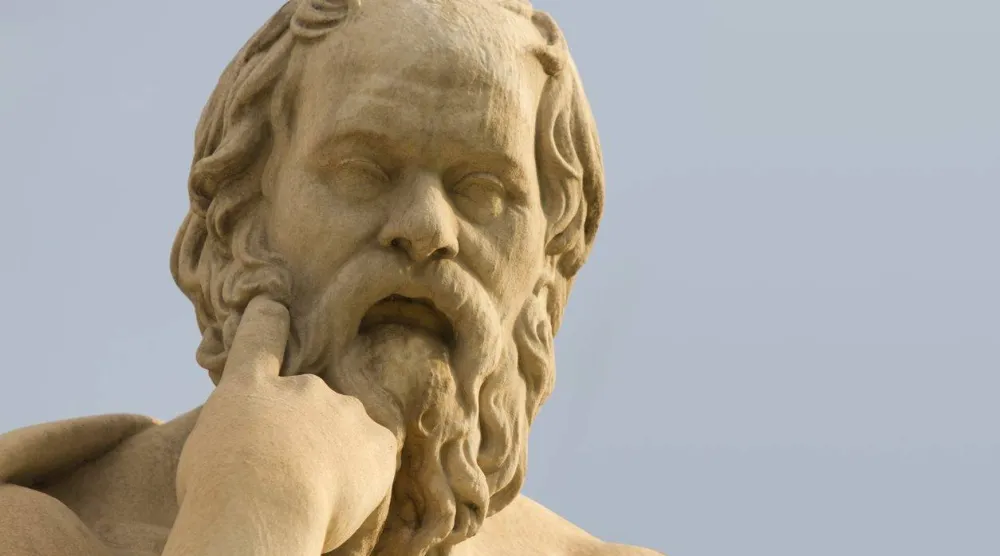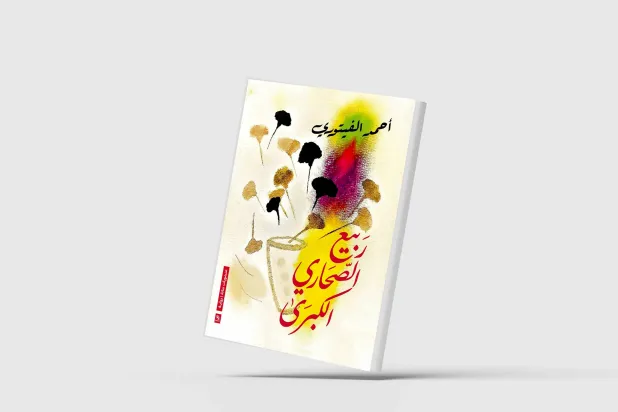يصعب على أي متتبع لموضوع الحب وتجلياته في الشعر العربي الحديث أن يقفز فوق تجربة الشاعر اللبناني أنسي الحاج، سواء تعلق الأمر بالرؤية المتميزة إلى المرأة، أو بالافتتان المفرط بالأنوثة، أو باحتدام العاطفة وفوران اللغة وجدة الأسلوب. فأنسي الذي كان ينظر إلى الحب نظرته إلى جوهر الوجود ومعناه، جعل منه حجر الرحى الأكثر صلابة الذي تدور حوله قصائده ونصوصه، مضيّقاً المسافة بين لغته وأعصابه، ومندفعاً نحو هدفه كالسيل حيناً، وجارحاً كالصقر حيناً آخر، وهشاً كالفراشة أحياناً كثيرة.
وإذا كان موضوع الحب بتعبيراته المختلفة يشكل العمود الفقري لتجربة أنسي الشعرية، فإن ذلك لا يعني أن صورة المرأة وطبيعتها وعلاقة الشاعر بها كانت واحدة في مجمل أعماله. إذ يكفي أن نلقي نظرة متفحصة على «لن»، مجموعة أنسي الأولى، لكي نشعر بأن الرجل العاشق والمرأة المعشوقة أشبه بكائنين بريين ومحتشدين بالغرائز، وأن العشق نفسه أشبه بحلبة صراع بين طرفين بالغي الضراوة، يعمل كل منهما على هزيمة الآخر، كما في قوله «أتهمكِ أنكِ خلسة تدحرجين وجهك الحقيقي لتهزميني. كشمعة تولولين ويصعد منكِ تيار الحريقة. اعقدي خنصرك في خنصري كعداوة».

إلا أن نبرة النزق الشهواني تلك سرعان ما بدأت تأخذ في مجموعاته اللاحقة أشكالاً أقل قسوة وتوحشاً، بحيث نحت لغة الحب عنده نحو خطاب مأهول بالصدق والشفافية، دون أن تتخفف من لغتها الفائرة وحماسها القديم. وإذا كانت المظاهر الأولى لهذا التغير قد بدت جلية في المجموعة اللاحقة «ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة»، فهي قد بلغت ذروتها الدراماتيكية مع «الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع»، حيث أخذت العلاقة بالمرأة شكلاً من أشكال الوجد والوله القلبي. وهو باستهلاله المجموعتين بكلمتي «منكِ» و«مغلوبك»، أراد أن يعلن في الأولى بأن امرأته المعشوقة هي علة الكتابة ومصدرها، ويعلن في الثانية غلبة الأنوثة على الذكورة، منذ آدم وحواء وحتى آخر السلالة.
والمفاجئ أن أنسي الذي كان يستخدم في «لن»، وبتأثر واضح ببودلير، لغة «بيولوجية» صادمة، وعارية من أي غلالة رومنسية، كقوله «ستطْبق عليكِ العلامات. سوف تنْسل نسلة نسلة حتى يبرز لحمك العاري ويسفر عن عظامك»، سيقلب المعادلة، ليكتب بعد ذلك «أنتِ مولودةٌ لتغلَق الكتب، مولودةٌ لتمتقع التماثيل، مولودةٌ لتصححي الحياة».
كما أن الخطاب العشقي في نسخته الجديدة لا يكف عن التأرجح بين ما هو طقوسي قبل ديني، ومترع بالسحر والتعازيم، وبين ما هو لاهوتي إيماني، تتحول المرأة فيه إلى أنثى شبه معبودة ومانحة للحياة، فيما تطغى على أسلوب الشاعر صيغ الشغف المحموم والغنائية الجارحة والتضرع الابتهالي. ولأن العشق مغامرة ثقيلة الوطأة لا قِبل له باحتمالها، فهو يحاول الإفادة من التجارب التي اختبرها العشاق السابقون، ولا يتوانى عن الاستعانة بالنصوص التي خلّفها شعراء المكابدات القلبية للأجيال اللاحقة. فإذ يرد في «نشيد الأناشيد» بأن «الحب قوي كالموت والغيرة قاسية كالهاوية»، يعلن أنسي بأن «الجبل أخفّ حملاً من الشوق والأرض أقصر من الغيرة». وإذا صرخ ريلكه «مَن، لو صرختُ، سيسمعني في مراتب الملائكة؟»، بردد أنسي بعده «إلى مَن أصرخ فيعطيني المحيط، صارت لغتي كالشمع، وأشعلت لغتي، وكنتُ بالحب». وإذا تنبأ أراغون بلسان مجنون غرناطة، بأن إيلسا قادمة بعد قرون لإعادة الأرض إلى رشدها بالحب، أعلن أنسي بأن حبيبته هي «الدرّة المصقولة بتوالي عذاب الأجيال، وصلتْ مختارة دون نقيصة»؟ وإذا هتف جبران بالحرية «من أعماق هذه الأعماق نناديك أيتها الحرية فاسمعينا»، هتف أنسي بحبيبته «أناديك من الجبال من الأودية، أناديك من الصخر والينابيع، اسمعيني آتياً ومحجوباً وغامضاً».
الأرجح أن إلحاح أنسي على استخدام ضمير المخاطب الجمعي في معظم نصوصه العاطفية، ليس سوى انعكاس لقناعته بوجوب أن نزف الحب إلى العالم، كما لو أنه موعد مع تفتح الحياة أو بشارة بالقيامة. فإذا كانت شرعية الزواج تُكتسب من وجود شاهدين اثنين لا أكثر، فإن الحاج يريد، لكي يُكسب عشقه الشرعية، ولكي يكون جديراً بالحب، أن يستقدم العدد الأكبر من الشهود، فيهتف قائلاً:
أنقلوني إلى جميع اللغات
لتسمعني حبيبتي
أعيروني حياتكم لأنتظر حبيبتي
أنا شعوب من العشاق
ما صنعت بي امرأةٌ ما صنعتِ
رأيتُ شمسكِ في كآبة الروح
وماءكِ في الحمى
على أن أنسي، شأنه شأن الكثير من المبدعين، لا يقيم إلا في الخلاء العاصف، ولا يستقر، في ظرف ما، على حالة أو مقولة، إلا وينقضهما في ظرف مغاير. فالشاعر الذي يريد للبشر أجمعين أن يشاطروه احتفاله العشقي، وينصب سرادقه العاطفي تحت شمسٍ مكتملة السطوع، هو نفسه الذي يرفع، على طريقة سلفه ديك الجن الحمصي، لواء غيرته المرضية على المرأة التي يحب، مؤثراً إقامتها في العزلة التامة، وحجْبها التام حتى عن صورتها في المرآة:
أغار عليك من الطفل الذي كنتِ
ستلدينه لي
من المرآة التي ترسل لك تهديدكِ بجمالك
من شعوري بالنقص أمامك
من حبكِ لي، من فنائي فيكِ
من الماء الذي يُتوقَّ أن تشربيه
وإذ يستهل الشاعر مجموعته «الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع»، المؤلفة من قصيدة واحدة ذات بناء ملحمي، بعبارة «هذه قصة الوجه الآخر من التكوين»، فلكي يعيد تذكيرنا بأن كل قصة حب حقيقية بين طرفين هي ليست ولادة أخرى لهما فحسب، بل إعادة تمثيل معدّل لواقعة الحب الأولى، وعودة رمزية إلى الصفر الينبوعي للأشياء.
وفي هذا السفْر الغنائي المفعم بالوجد، يتولى الحاج إعادة رسم العلاقة بين المرأة والرجل، من منظور الانتصار للأنوثة الكونية التي تكفلت عبر الزمن بتشذيب سلوكيات الرجل وتخليصه من رعونته. ورغم أن الرجل لم يكن رفيقاً بالمرأة التي انشقّ عنها، وعمل جاهداً على التنصل من الخطيئة الأصلية ليلصقها بها وحدها، ثم أسرف في تهميشها ورميها بالنقصان، وظل سادراً في بطشه الدموي، فقد تركته من جهتها يفرح بأوهامه، «لأنه الضعيف وهي القوية. ثم حضنت عذابها لتحضن معذِّبيها، فالكاذبون أطفالها ولو تزوجوها»، فيما الغابة التي اسمها الأرض، بدت «شقيةً بالأسد رضيةً بالفراشة».
إلحاح أنسي الحاج على استخدام ضمير المخاطب الجمعي في معظم نصوصه العاطفية ليس سوى انعكاس لقناعته بوجوب أن نزفّ الحب إلى العالم
وإذا كانت مناخات «نشيد الأناشيد» المنسوب لسليمان، واضحة تماماً في خلفية «الرسولة»، كما في نسيجها التعبيري ومناخاتها الفردوسية، فاللافت أن أنسي في هذه التجربة الاستثنائية لم يكتف بالانقلاب على الجموح الغرائزي الذي ظهر في بواكيره، بل ذهب أبعد من «العهد القديم»، في دفع الرغبات الجسدية المحمومة إلى الخلف، وصهرها بشكل كامل في أتون التوله الروحي.
الملاحظ أن أنسي يستعين لتظهير عشقه على النحو الأكمل، بكل ما في لغة الضاد من علامات التعجب والاستفهام والنداء والاسترحام والدعاء، مروراً بالتنقل بين الصيغ الكلامية، والعود على بدء، والتكرار الذي يعكس حرقة النفس ويرسّخ المعنى، وتأنيث ما لا يؤنث «الرسولة، الماءة»، واللعب بالضمائر «اختبأتْني، أطلَّتْني»، وصولاً إلى تكرار القسَم لمحو كل شك:
أقسم أن أنسى قصائدي لأحفظك
أقسم أن أسكُن دموعي في يدك
أقسم أن أكون فريسة ظلك
أقسم أن يطير عمري
كالنحل من قفير صوتك
أقسم أن أنزل من برق شَعرك
مطراً على السهول
ولا بد من الإشارة أخيراً إلى أن الطابع الابتهالي الصوفي لكتاب «الرسولة»، وحرص أنسي على تقديم صورة لامرأته المعشوقة موزعة بين البهاء المريمي وبين التفتح الرعوي للرغبات، هو الذي حدا بالكثيرين إلى التساؤل عن الهوية الحقيقية للمرأة التي تقف وراء قصيدته، التي تعتبر إحدى أكثر قصائد العشق تميزاً وفرادة في الشعر العربي الحديث. وإذا كان الشاعر قد ذهب بهذا السر إلى قبره، فالثابت وفق اعترافاته وحواراته الصحافية، أن عشقه للمرأة لم ينحصر في علاقة واحدة، وأنه ينتمي، في ما يتجاوز النساء اللواتي أحبهن، إلى الأنوثة الكونية التي تقيم مملكتها الساحرة على أرض سرمدية البهاء. ولأن الأمر كذلك، فهو يهتف بالبشر القانطين والمفتقرين إلى الحنو، كما بالمنكفئين على خوائهم العاطفي والروحي:
تعالوا، المملكة مفتوحة
أسراب الحساسين عند باب المملكة
تسرع للتحية
الكنوز وحيدة، الحياة وحيدة،
تعالوا كلِّلوا رؤوسكم بذهب الدخول
وأحرِقوا العالم بشمس العودة