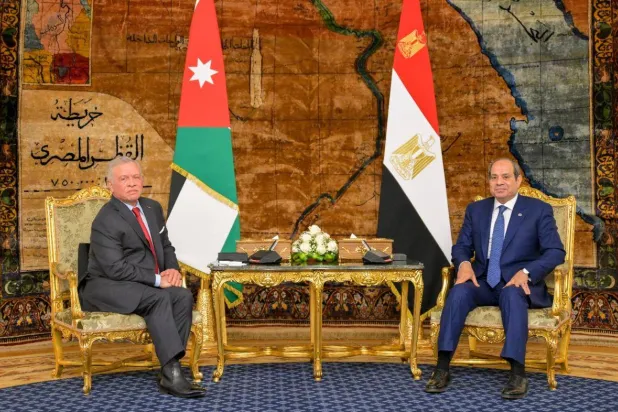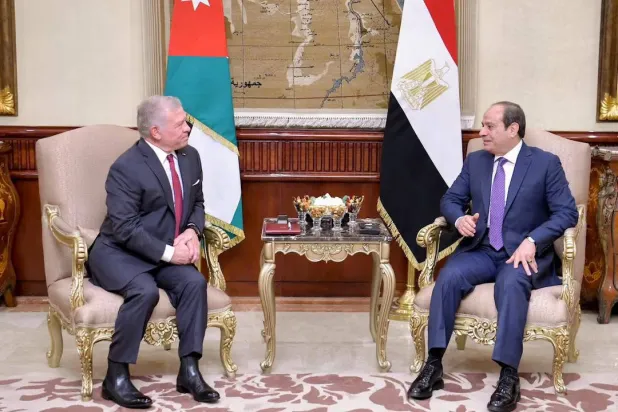لا يخلو تاريخ الأردن القريب من تحديات مصيرية هدّدت أمنه واستقراره، وسعت للتشويش على استقرار نظامه السياسي. فجملة التحديات التي فرضتها جغرافيا المملكة وتاريخها معاً صارت العناوين ذات الأولوية في مناقشة المصالح الأردنية في المدى المنظور. جولة على هذه التحديات تُمكّن المراقبين من تقدير الموقف الأردني وتعقيداته؛ فعلى جبهة الأردن الغربية عانت البلاد من حالة الطوارئ العسكرية على مدى السنوات والعقود الماضية بفعل الاحتلال الإسرائيلي، والتعامل مع نكبة هجرة الفلسطينيين عام 1948، ونكسة حزيران من عام 1967 التي تسبّبت بهجرة الفلسطينيين الثانية. والحال ليست بأفضل على الجبهة الشمالية مع سوريا، فخلال سنوات الحرب الماضية كانت الجبهة الشمالية ملفاً أمنياً - عسكرياً ساخناً، كما استقبل عبرها نحو مليون لاجئ سوري. وتستمر محاولات عصابات تجارة المخدّرات والسلاح في تهديد الأمن على الحدود في مشهد متكرّر دفع الأردن للقصف بالطائرات عدداً من مصانع المخدرات في الجنوب السوري، التي كانت تابعة لميليشيات محسوبة على «حزب الله» اللبناني وإيران و«الفرقة الرابعة» في الجيش السوري بقيادة ماهر الأسد. وأخيراً لا آخراً، على الشرق هناك الحدود البرية الطويلة مع العراق، وفي آخر 22 سنة ظلت هذه الحدود عنوان تهديد لأمن الأردن، كما حصل في أحداث تفجير الفنادق في العاصمة عمّان عام 2005، بالإضافة إلى محاولات أخرى أُحبطت قبل استكمال أهدافها.
في سياق التحديات المصيرية أمنياً وسياسياً، فإن الأردن تعامل مع ملف الحرب على غزة أو ما يُعرف بـ«طوفان الأقصى» منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 على أنه تهديد لمصير القضية الفلسطينية.
وأمام توسع الاعتداءات الوحشية لدولة الاحتلال، برزت للعلن خططها لإفراغ غزة من السكان ودفعهم بسلاح الجوع والخوف إلى الخروج منها. واليوم، ثمة تقديرات رسمية محلية ترى أن ما تقوم به إسرائيل هو «محاكاة تجريبية» لما قد يكون عليه الحال في الضفة الغربية مستقبلاً.
إذ أمام ما تشهده مناطق الضفة من اعتداءات وانتهاكات ومصادرات للأراضي، قد تكون الفرصة سانحة لحكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية في «فرض واقع جديد» على الأرض. وهذا، بالطبع، لن يكون في صالح تسوية عادلة قد تسمح بإعلان قيام دولة فلسطين على ترابها الوطني بناءً على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967. وبالتالي، يجد الأردن نفسه أمام مصدر قلق مضاعف.
طبول الحرب تُضعف صوت الاعتدال
في الأخبار هذه الساعات والأيام، تستدعي الولايات المتحدة أساطيلها في البحار، وتعزّز من جاهزية استخدام ترسانتها من الأسلحة في مواجهة نظام طهران، وهذا أمر بات متوقعاً بعد ما جرى من تحطيم القدرات العسكرية لوكلاء إيران في المنطقة. الواقع أن الحظ لم يخدم الإسرائيليين في منحهم المبرّرات للتعسّف في القضاء على حركة «حماس» في غزة.
إلا أن ضرب «حماس» شكّل سبباً لدخول «حزب الله» الحرب، التي أدت في النتيجة، إلى خسارته أبرز قياداته. وعلى الرغم من غياب تقديرات مؤكدة حول حجم إضعاف قدراته العسكرية، فلا شك في أنها تراجعت كثيراً، بينما تكفّلت واشنطن بملف ضرب قدرات الميليشيات الحوثية في اليمن الموالية هي الأخرى لطهران.
من جانب آخر، بدا أن سوريا كانت ضربة حظ مجانية لإسرائيل؛ إذ لم يكن أكثر المتفائلين من اليمين المتطرف الإسرائيلي أن يتخيّل السقوط - بل الانهيار - السريع للنظام السوري السابق، حليف طهران الموثوق، ليلة السابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وضربة الحظ هذه سمحت لسلطات تل أبيب اليمينية المتطرفة أن «تفرض واقعاً بديلاً» في الجنوب السوري من خلال الوجود العسكري الإسرائيلي، واستمالة أطراف للدخول في لعبة تقسيم سوريا لصالح توسيع رقعة الاحتلال الإسرائيلي.
تغيير الجغرافيا السورية
مخاطر الوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب السوري تعني بالنسبة للأردن تغييراً واضحاً للجغرافيا السورية، ووجوداً عسكرياً غير شرعي لدولة الاحتلال على حدوده الشمالية.
لهذا الأمر حسابات أمنية أردنية قد تدفع بخيارات عسكرية ليست سهلة، لا سيما في ظل عودة محتملة للفوضى إلى الجنوب السوري... لكن هذه المرة ليس لمناهضة نظام بشار الأسد، بل لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي لأراض عربية، واستدعاء محتمل خطر لنشاط خلايا تنظيمات إرهابية.
في ضوء ذلك، فُتح الباب أمام طرح أفكار تتعلّق بدخول عسكري أردني للسيطرة على ما هو أبعد من «المنطقة العازلة» على الحدود كدفاعات متقدمة للحدود الأردنية، ومنع تدفق كتل بشرية طلباً للجوء.
ثم إنه على الرغم من الانفتاح الرسمي الأردني «السريع» على النظام السوري الجديد، فإن الإجابة الشافية عن سؤال السرعة في الترحيب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع لم تتوافر حتى الآن. والحقيقة أن ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا لا تزال غامضة. هذا، ومع أن ثمّة مصلحة أكيدة في استدامة حيوية المصالح الأردنية، فإن الغموض العام للصورة قد يؤثر أيضاً على مستوى الثقة بإدارة علاقات عمّان الدبلوماسية على المستوى الإقليمي وسط أجواء التوتر والاضطراب.
وعليه، تبقى الأسئلة مطروحة حيال قدرات النظام السوري الجديد بقيادة الشرع في فرض سيطرته على كامل الأراضي السورية، وضمانه وحدة سوريا وتماسكها، ومستوى الرضى الشعبي العام عن الإدارة الجديدة، في انتظار الإجابات الصلبة في الآتي من الأيام، وسط المساعي الإسرائيلية المريبة الهادفة إلى تقسيم سوريا لـ«دويلات» عرقية وطائفية يسمح لحكام تل أبيب بالارتياح ومزيد من القضم.
الضفة الغربية والقدس
بلا شك، تُشكل الضفة الغربية والقدس ملفاً مهماً بالنسبة للأردن؛ إذ احتلت القوات الإسرائيلية تلك المناطق عام 1967 عندما كانت تحت السيادة الأردنية. ومن ثم، ظل هاجس استعادة هذه الأراضي المحتلة عبر تسوية سياسية من القضايا التي تعدّها عمّان في صدارة أولوياتها ضمن معادلة مصالحها الاستراتيجية.
غير أن الأردن لا يريد اليوم استعادة هذه الأراضي المحتلة كي تكون تحت سيادته، بل يريدها دولة للفلسطينيين. ذلك أنه بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة تتحرّر عمّان من مسؤوليتها التاريخية تجاه مشاركتها في «حرب يونيو/حزيران» عام 1967، واحتلال إسرائيل لتلك الأراضي، ولكن مع بقاء ملف الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس شأناً أردنياً بقبولين عربي وفلسطيني.
جدير بالذكر أنه يقيم في مناطق الضفة الغربية حالياً نحو 450 ألف مواطن يحملون أرقاماً وطنية أردنية (الجنسية)، وهؤلاء تهدد إسرائيل بإخراجهم ودفعهم نحو الضفة الشرقية. لذا رأى الأردن أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية يشكّل تهديداً مباشراً لمصالحه الاستراتيجية. ويهمّه كثيراً منع أي خطط تهجير تستهدف الفلسطينيين ودفعهم خارج بلدهم الأصلي.
في الواقع، تدعم عمّان «السلطة الوطنية الفلسطينية» التي جاءت نتيجة «اتفاق أوسلو» الذي وقعه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق الراحل إسحق رابين. وعلى الرغم من إضعاف السلطة وتقويض حكمها في الضفة والقطاع، ما زال الأردن يعلن دعمه لها بمختلف المجالات.
ثم إن السلطات الأردنية تُدرك أن إسرائيل تتعمد «فرض أمر واقع» في مناطق الضفة الغربية عبر مصادرة المزيد من الأراضي، والتوسّع الاستيطاني الذي يهدّد الحياة اليومية للفلسطينيين. وينعكس هذا سلباً على أي فرص لتسوية عادلة تعود بموجبها الحقوق الفلسطينية إلى أصحابها الشرعيين. بيد أن الممارسات والاعتداءات المتكررة التي تنفّذها دولة الاحتلال يعدّها الأردن تهديداً لمصالحه، لا سيما وسط الدعوات اليمينية الإسرائيلية المستمرة في أن يكون الأردن «وطناً بديلاً» للفلسطينيين. وهكذا، تؤثر الضفة الغربية والتطورات المتسارعة على المزاج العام في الشارع الأردني، وتنعكس ردود الفعل شعبياً على شكل «متوالية» مسيرات ومظاهرات تتقدمها «جماعة الإخوان المسلمين» - غير المرخّصة في البلاد - وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذي يمثله في مجلس النواب الحالي 31 نائباً.
موقف «الإسلاميين»
هذا، وتستثمر «الجماعة» من منبر دعم القضية الفلسطينية في معارضة السياسة الرسمية الداعية لتسوية سياسة لحل القضية الفلسطينية. وفي حين ترفض عمّان رسمياً أن تكون الأراضي الأردنية منطلقاً لأي عمليات عسكرية تستهدف الحدود الغربية، في حين تستمر دعوات الحركة الإسلامية لمناصرة الشعب الفلسطيني سبباً في صدارة «جماعة الإخوان» للشارع الأردني، والتي يجد فيها محللون أنها أداة يستخدمها النواب الإسلاميون للضغط على الحكومات، وحصد مزيد من الشعبية عبر الخطاب الديني. ويعكس أداء نواب الحركة الصورة الحقيقية لصراع الكواليس مع السلطات الرسمية.
هشاشة اقتصادية والشأن الداخلي
راهناً، يعاني الأردن من أزمات اقتصادية متراكمة، وسط ارتفاع ملحوظ في أرقام الفقر والبطالة وتضخم المديونية العامة. وبطبيعة الحال، فإن الاقتصاد الأردني مرتبط بأزمات المنطقة، ولم يخلُ عقد من تاريخ المملكة من أزمات اقتصادية تسبّبت بها الحروب والأحداث لـ«دول الجوار»؛ كالعراق وسوريا، ناهيك من احتلال الضفة الغربية.
وفي حين تبحث الحكومات عن معالجات لأزمات اقتصادية متراكمة، فإن الاتّكال على المساعدات الخارجية خلّف آثاره السلبية على هندسة موازنات المالية العامة. وأهم تلك المساعدات هي المساعدات الأميركية التي تُقدر بنحو 1.5 مليار دينار، موزعة بين مشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ومساعدات عسكرية للجيش الأردني.
وصحيح أن الأردن تسلم حصته من المنحة الأميركية لعام 2025، لكن تجميد عمل مشاريع الـ(USAID) في المملكة أدى إلى توقف رواتب أكثر من 20 ألف أردني من العاملين في تلك المشاريع. وقد يكون استمرار تجميد جانب من تلك المشاريع سبباً في مفاقمة الأزمة الاقتصادية للمواطن، وضغطاً إضافياً على الحكومة من أجل توفير البدائل للمتعطلين عن العمل.
مع هذا، لا ترحم المعارضة البرلمانية في انتقاداتها، بل تنطلق من مهاجمة السياسات الاقتصادية نحو التشكيك بالمواقف الرسمية. ولم تُنصف المعارضة البرلمانية التي يتقدمها نواب الحركة الإسلامية الجهود الأردنية في دعم سكان قطاع غزة بالغذاء والدواء إبان شهور العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على القطاع بهدف جعله غير قابل للعيش فيه، وبالتالي تهجير الغزيين في رحلة ثالثة بعد عامي 1948 و1967.
عملية البحر الميت
يوم 8 أكتوبر من العام الماضي، تسلل مسلحان من الأردن عبر الحدود جنوبي البحر الميت إلى الأراضي المحتلة في محاولة استهداف جنود إسرائيليين. لكن الشابين قتلا قبل تنفيذ العملية ضد الجنود، وتحفظت حينذاك المصادر الرسمية عن التعليق. لكن حزب «جبهة العمل الإسلامي» بارك العملية، معتبراً إياها «عملية بطولية نفذها اثنان من شباب الحركة الإسلامية في منطقة البحر الميت على الحدود الأردنية - الفلسطينية».
الحادثة المفاجئة والغامضة وغير المسبوقة التي لم يعلن الجانب الأردني عن أي تفاصيل متعلقة بها، فتحت على تحقيقات موسّعة مع عدد من شباب الحركة الخاضعين للتحقيقات الأمنية، ومن المنتظر إحالة ملف القضية إلى محكمة أمن الدولة (قضاء عسكري) بعد انتهاء التحقيقات خلال الشهر الحالي، وفق مصادر تكلمت إلى «الشرق الأوسط».
لكن يتوقع الآن أن تفتح هذه القضية على مواجهة رسمية مباشرة مع «الجماعة» و«جبهة العمل»، بينما يتحضّر رسميّون لتلك المواجهة بملف تحقيقي موسّع واعترافات مباشرة قد تغيّر قواعد اللعبة بين الحركة الإسلامية والسلطات. وهذا، في وقت تشعر فيه «الجماعة» بنشوة حصد الشعبية بعد تفوقها في الانتخابات النيابية الماضية وحصولها على نحو 500 ألف صوت على مستوى مقاعد القائمة العامة المخصّصة للأحزاب.