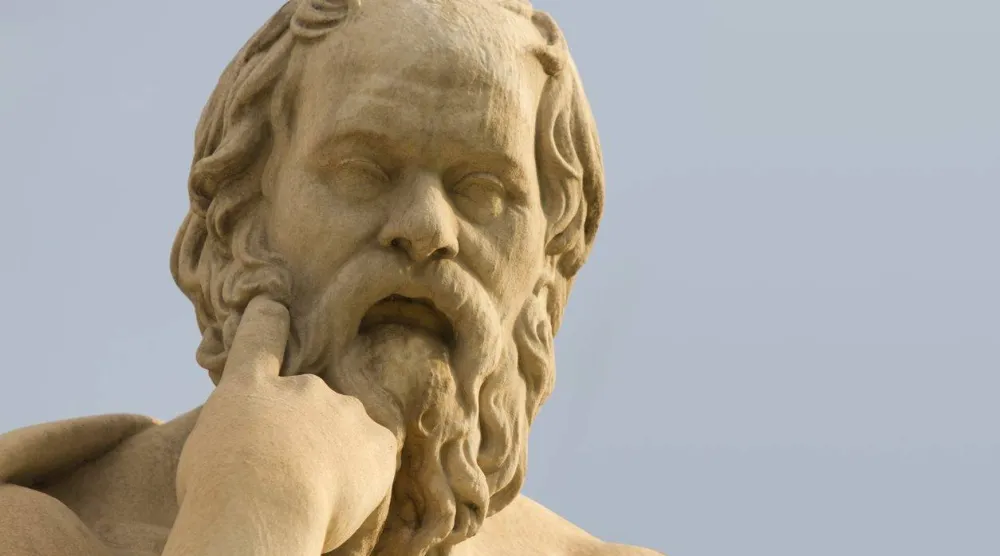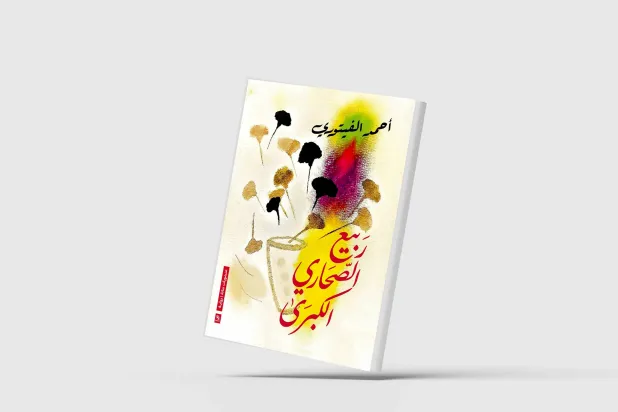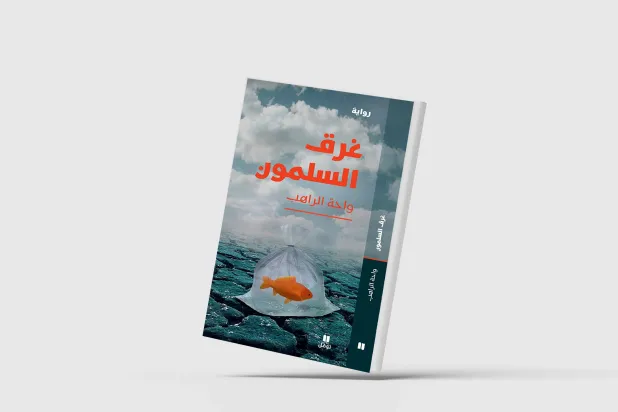عدت كثيراً إلى مقالة الكاتب الفرنسي - الجزائري المولد ألبير كامو، منذ اخترتها للتدريس ضمن مختارات من آداب العالم. عدت إلى المقالة أقارن عودتي إليها وإلى نصوص أخرى بعودة الكاتب إلى أماكن عاش فيها أو زارها من قبل. نحن في النهاية نعود إلى ما ألفنا ونقيس المسافات ليس في المكان بقدر ما في أنفسنا، في ما تبقى وما لم. يقول الشاعر الفرنسي إدموند جابيس، وهو يهودي ومصري الأصل معاً، إن العودة إلى النص بعد كتابته تشبه العودة إلى القاعة بعد انتهاء الحفلة. لكن ذلك لا يصدق دائماً، إنه لا ينسحب على النص الذي سبق أن قرأنا، ليس بالضرورة على الأقل. أو أن ذلك ليس ما شعرت به وأنا أعود إلى كامو، ولا ذلك بالتأكيد ما يقوله كامو نفسه عن عودته إلى البلدة التي قضى فيها شطراً من طفولته وشبابه ضمن الفرنسيين الكثر الذين استوطنوا الجزائر بدعم من الحكومة الفرنسية التي عدت الجزائر آنذاك جزءاً منها.
نشرت مقالة كامو «العودة إلى تيبازة» عام 1953، أي قبل عام واحد من بدء الثورة الجزائرية. وما سيستوقف القارئ فيها، كما أظن، وهو بالتأكيد ما استوقفني، جانبان: علاقة كامو بالمكان، واللغة الشعرية البديعة التي تتخللها.
أسئلة الانتماء
يقول كامو إنه سبق أن زار تيبازة، المدينة المتوسطية أو البلدة آنذاك، الواقعة على بعد 75 كيلو متراً إلى الشمال من الجزائر العاصمة، مرة عام 1930 وكان حينها شاباً في السابعة عشرة (ولد كامو عام 1913)، وهو يعود إليها الآن وقد بلغ الأربعين. المقالة تأمل في ما آلت إليه البلدة وما آل إليه هو، ما أصاب البلدة من تغيير وما أصابه هو من تغيير أيضاً. لكن مدار الحديث هو ما عنته وتعنيه له تيبازة أثناء ذلك كله. كانت الزيارة الثانية في ديسمبر (أيلول)، لكن الشتاء لم يغير شيئاً بالنسبة للكاتب. كان المطر يغرق البحر نفسه، كما يقول كامو، لكن «الجزائر كانت ما تزال بالنسبة لي مدينة الصيف»، الصيف كما يراه أوروبي يعاني من قسوة الشتاء، صيف الانطلاق والنزهات، وهو بالنسبة للكاتب ذكريات الشباب. لكن ذلك التوقع سرعان ما يواجه الخيبات. «كنت آمل، فيما أظن، أن أكتشف هناك للمرة الثانية الحرية التي لم أنس». لكن العودة لم تؤد إلى ذلك الاكتشاف. اكتشف الآثار التاريخية لحضارات قديمة كالفينيقية والرومانية، ليكتشف أيضاً أنها آثار باتت مقيدة بالسياجات. هو لا يسميها آثاراً وإنما خرائب. «لكن الخرائب الآن كانت محاطة بالسياجات الحادة ولم يمكن الوصول إليها إلا عبر مداخل رسمية».
جاء كامو إلى تيبازة يحمل تطلعات رومانسية تبعده عن أوروبا التي دمرتها الحرب العالمية الثانية، لكنه جاء أيضاً يحمل معاناة مرض السل الذي كان مصاباً به. أفسحت البلدة الجزائرية مساحة لحلمه بآثارها ومطرها وصيفها لكنها ظلت عصية على توقعاته ليس بالسياجات التي أحاطت بالآثار أو الخرائب وإنما بما حمله هو في داخله: «هذه المسافة، هذه السنين، التي فصلت الخرائب الدافئة عن السياجات، كانت في داخلي أيضاً...».
هذه الخواطر والذكريات تتمحور كلها حول مفهوم الوطن في مقالة كامو. يقول في نهاية إحدى الفقرات: «عدت إلى باريس، وبقيت هناك عدة سنوات قبل أن أعود إلى الوطن مرة أخرى». لكنه يعود بعد ذلك ليتحدث عن المطر الغزير في الجزائر ليقارنه بفيضان الأنهار في «بلادي»: «ألم أكن أعلم أن المطر في الجزائر، مع أنه يبدو وكأنه سيستمر إلى الأبد، يتوقف فجأة، مثل الأنهار في بلادي التي يرتفع منسوبها لتفيض في ساعتين مدمرة الهكتارات من الأرض ثم تجف في لحظة؟»، من الصعب فهم «بلادي» على أنها غير فرنسا لتنشأ من ذلك مقابلة غير معلنة بين الوطن والبلاد، بين الجزائر وفرنسا.
لم ولن ينسب كامو إلى الجزائر، حتى إن ولد ونشأ فيها، تماماً مثله في ذلك مثل الآلاف من الفرنسيين، وبعضهم من مشاهير الفلاسفة مثل لوي ألتوسير وجاك دريدا. لن يقول أحد إن دريدا جزائري وإنما أنه ولد في الجزائر، الجزائر التي تركت أثرها في تكوينه كما أكد هو في نصوص ومواقف ليس هذا مكان الإشارة إليها. مقالة كامو مهمة من هذه الزاوية التي تجعل ذلك الكاتب في موقف مقابل لكتاب عرب وأفارقة عاشوا ازدواجية الانتماء وأزمة الهوية ثم تناولوا ذلك بالتحليل، كما هو الحال لدى الجزائرية الأصل آسيا جبار واللبناني الأصل أمين معلوف.
الهروب من الحاضر
مقالة كامو حول عودته تطرح أسئلة الانتماء تلك. الرحلة إلى تيبازة ليست رحلة ذهاب وإنما رحلة عودة، ليست رحلة اليوناني كفافيس إلى إيثاكا، حيث الطريق أهم من الوصول. هي عودة الأصول، العودة المهمومة بالجذور. إننا لا نذهب إلى جذورنا ولكننا نعود إليها. لا نذهب إلى مراتع الطفولة وإنما نرجع إليها. هي دائماً هناك في ماضٍ محاط بقداسة البدايات. نلمس ذلك في ارتفاع المد الغنائي في كتابة كامو حين يتحدث عن العودة: «أصغيت إلى صوت كاد ينسى في داخلي، كما لو أن قلبي توقف منذ زمن طويل وعاد الآن بهدوء لينبض مرة أخرى. والآن وقد استيقظت تعرفت على الأصوات الغامضة، واحدة بعد الأخرى، تلك التي صنعت الصمت: الصوت العميق المتواصل للطيور، الأنين القصير الخفيف للبحر عند أقدام الصخور...»، تستمر تلك الصور الشعرية لتصل إلى ذروتها حين تتجه إلى الداخل الإنساني: «وشعرت أيضاً بأمواج السعادة تعلو داخلي. شعرت أنني أخيراً عدت إلى الميناء، للحظة على الأقل، وأنني من الآن فصاعداً لن أنتهي».
ثم يتبين أن العودة ليست مطاردة بالبحث عن ماضٍ فحسب وإنما هي أيضاً هروب من حاضر بائس، من أوروباً تهطل عليها الكراهية ويحيط بها التناحر وتسيل فيها الدماء. «ذلك ما يجعل أوروبا تكره النهار ولا تستطيع أن تفعل شيئاً سوى مواجهة ظلم بآخر». وليس الهروب وحده وإنما البحث عن ملاذ لإنسانية الإنسان، للأمل: «لكي أحول دون جفاف العدالة، دون تحولها إلى لا شيء سوى برتقالة رائعة بلب جاف مر، اكتشفت أن على الإنسان أن يحتفظ داخله بعذوبة ما ومصدر نقي للبهجة... هنا عثرت مرة أخرى على جمال قديم، سماء شابة، وقست حظي الحسن وأنا أدرك أخيراً أنه في أسوأ الأعوام من جنوننا لم تفارقني ذكرى هذه السماء. كانت هذه هي التي أنقذتني في نهاية المطاف من اليأس. أدركت دائماً أن خرائب تيبازة كانت أكثر شباباً من مرافئنا الجافة أو أنقاضنا».
هذه العودة إلى الخرائب العذبة بجمالها ونبلها، تذكر بعودة الإنجليزي وردزورث إلى كنيسة تنترن آبي أواخر القرن الثامن عشر (كما أشرت في المقالة الماضية)، حيث يلتقي به كامو عند الأثر العميق المثري الذي تتركه العودة إلى الأماكن القديمة. لكن ثمة فرقاً كبيراً يتضح في نهاية مقالة كامو. إنه يعود إلى فرنسا وأهله أو شعبه عودة واقعية لا رومانسية فيها، إذ يؤكد: «إنني لا أستطيع أن أعزل نفسي عن أهلي. أعيش مع أسرتي التي تعتقد أنها تحكم مدناً غنية وبشعة، مبنية من الحجارة والضباب». ينتهي كامو إلى ذلك الواقع لا ليعترف به فحسب وإنما ليعتنقه أيضاً وإن كان مضطراً إلى ذلك.
ربما لم يتوقع كامو أن تيبازة التي غادرها ستشترك في ثورة تنتهي إلى طرد أهله وبلاده من الجزائر. ففي العام التالي من زيارته اشتعلت ثورة التحرر من الاستعمار، ولابد أن الكاتب الفرنسي وإن احتفى بجذوره الجزائرية أدرك أن تلك الجذور أكثر هشاشة مما توقع وأنه لن يجد أهلاً سوى أهله في مدن الحجارة والضباب.
رحلة كامو إلى تيبازة ليست رحلة ذهاب وإنما رحلة عودة، ليست رحلة اليوناني كفافيس إلى إيثاكا، حيث الطريق أهم من الوصول. هي عودة الأصول