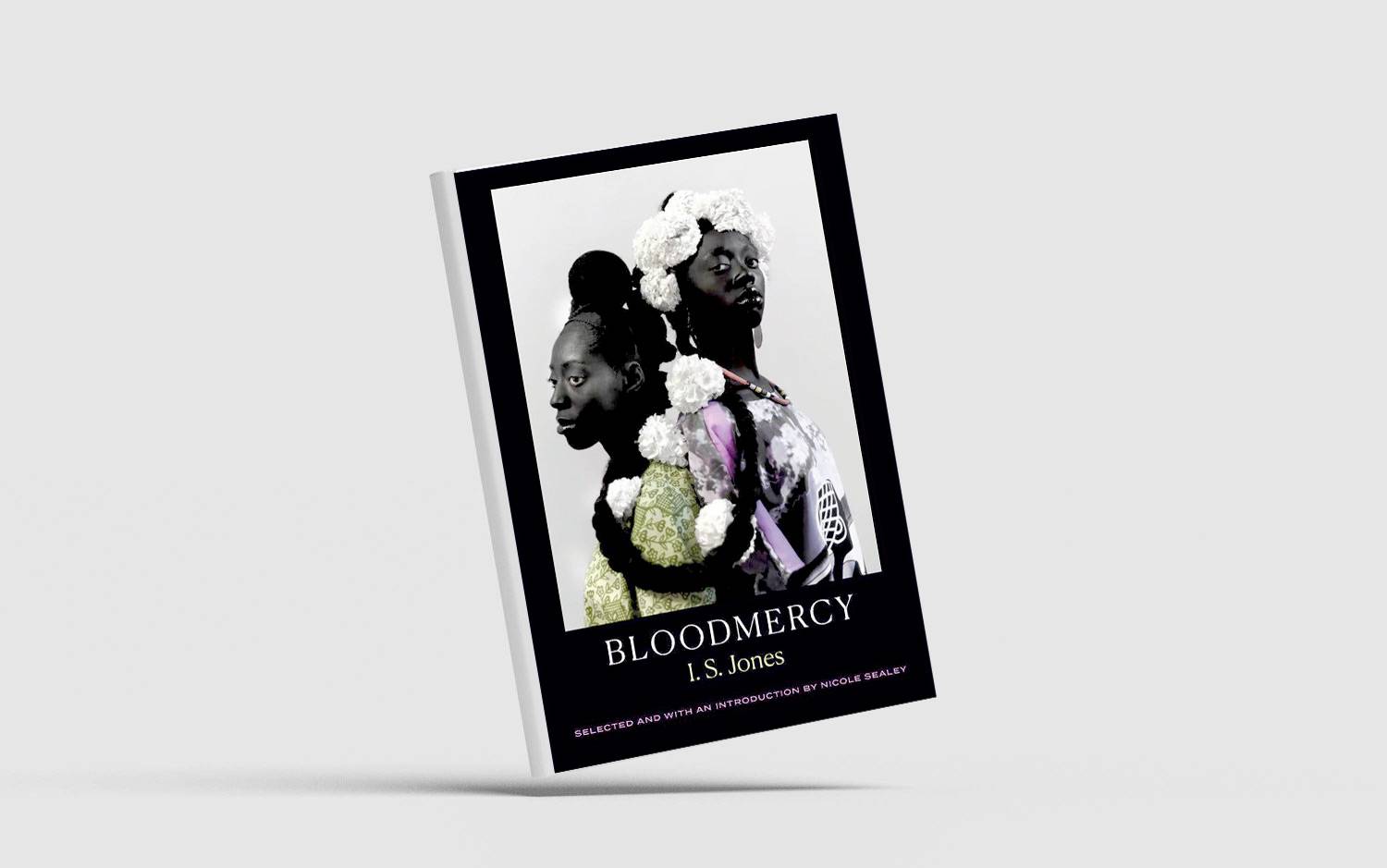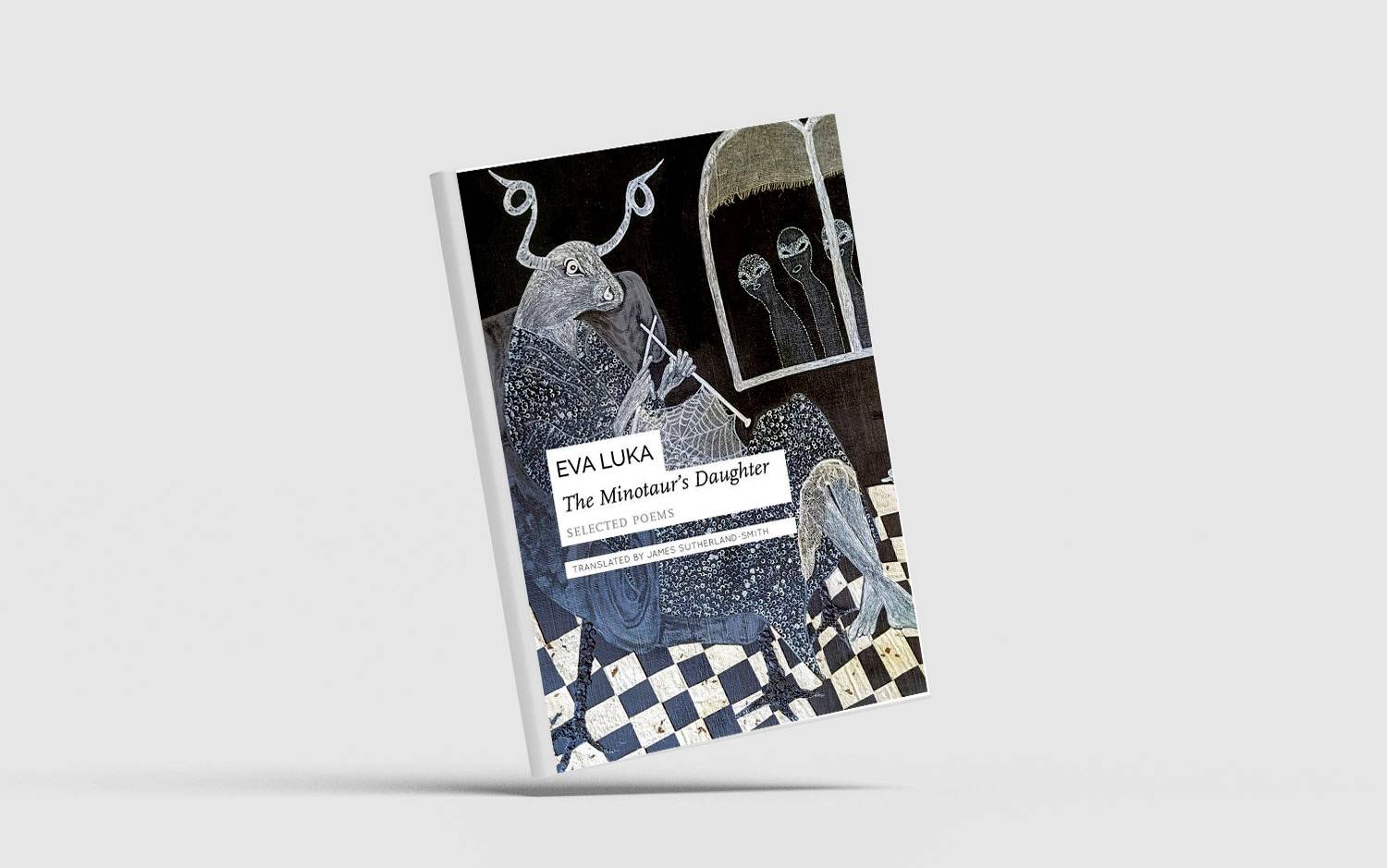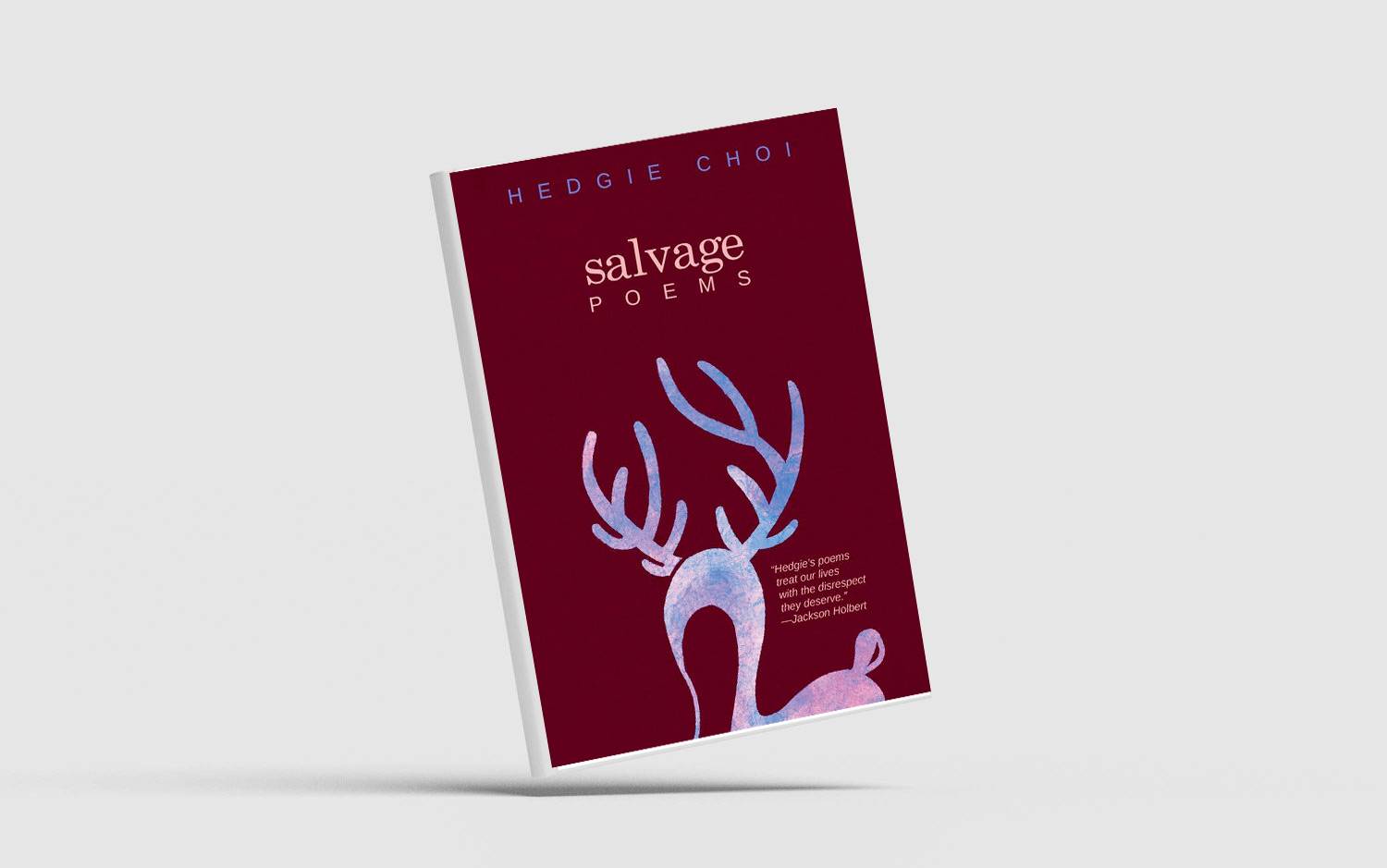خلال نصف القرن الماضي، شكَّل الجدل حول الحداثة «modernity» موضوعاً للسجال في المشهد الثقافي الخليجي. غير أن اللافت للنظر كون معظم أطراف الصراع ذوي خلفية شرعية أو أدبية. نظر «المطاوعة» إلى الحداثة بوصفها التغريب والكفر، فيما نظر الأدباء لكونها التنوير، وبين هذا وذاك غاب عن الجميع استكناه أصل المصطلح ومقاربته المشهدين الثقافي والاجتماعي في بلادهم.
بعيداً عن النظرة المتطرفة لـ«بعض» المتدينين، والتي تنمُّ عن جهل بفكرة الحداثة جعلهم يدخلون في مواجهة دونكيشوتية مع الأكاديميين، الذين قدم عدد منهم للتوّ - وقتها - من الغرب، بعد حصولهم على شهادات أكاديمية في الدراسات الأدبية، فإن المدافعين عن الحداثة، وقتها، لم يبيّنوا مفهوم الحداثة بالشكل الذي يستطيع بسيطو الاطلاع أن يفهموه. لقد كانت معركة أنتجت مصطلحاً مستفزاً - أي الحداثة - ما كان يجب أن تصل إلى ما وصلت إليه.
لقد ظهر مصطلح الحداثة ليدل على التغيرات الاجتماعية والثقافية، التي واكبت الثورة الصناعية، التي اتخذت من الآلة البخارية - والكهربائية لاحقاً - وسيلة لزيادة الإنتاج والتخصصية المؤدية لرفع مستوى الجودة. ولكن لكي نستوعب مفهوم الحداثة المواكب للصناعية، علينا أن نتناول مفهوم ما قبل الحداثة، المصاحب لمفهوم ما قبل الصناعية.
ترتبط حقبة ما قبل الحداثة بما قبل الصناعية، والتي مرت بثلاث مراحل تُلخص أساليب العيش التي انتهجها البشر في تدخلهم في الطبيعة وتطور تطويعهم لها:
> مرحلة الجامع الصياد «hunter-gatherer»، حيث يتعامل الإنسان مع الطبيعة بشكل مباشر، عن طريق اصطياد الطرائد البرية، وجمع الموارد النباتية البرية. في هذه المرحلة، يبحث الإنسان عن حاجته فقط، حيث يعيش الصيادون في مجموعات صغيرة، ولديهم سياسات بسيطة لتنظيم أمورهم في تراتبية أبوية يقوم فيها الرجل بجلب الطعام، فيما تقوم المرأة على رعاية الصغار. والمنافسة على الموارد ليست شرسة؛ كون الهدف هو تأمين الطعام لمدة قصيرة، فلا داعي للمنافسة الشرسة.
> مرحلة الرعوية «pastoral» والبستنة «horticultural»، والتي انتقل الإنسان فيها إلى مرحلة الاستقرار ببناء البيوت، وبالتالي فقد قرر أن «يجلب» الموارد الطبيعية لبيته. هنا تقدم الإنسان خطوة في تدخله في الطبيعة عن طريق استئناس بعض الحيوانات، وزرع بعض النباتات التي تمدُّه بالمواد الأساسية للغذاء والملبس. في هذه المرحلة تطور مفهوم الأسرة، وشاركت المرأة في عملية الإنتاج، ولكن الهيمنة تظل لقائد الأسرة.
> مرحلة المجتمع الزراعي «agrarian society»، حيث زاد الإنسان من تدخُّله في الطبيعة، عن طريق تطوير أساليب جديدة في الزراعة، ورعاية الحيوانات، حيث بدأ بزيادة المحاصيل، وتجفيف الفواكه والخضر، من أجل حفظها للشتاء، إضافة لصناعة الأجبان. هذه الخطوة في تحدي الطبيعة زادت من قوة الإنسان في مواجهة قسوة الحياة. واكب هذه المرحلة أهمية إنتاج أكبر عدد من الأطفال؛ من أجل توفير اليد العاملة للمزرعة، سواء كانت مملوكة أم مستأجرة بنظام الإقطاع. واحتفظ الدين بدوره في جمع الناس، في يوم إجازتهم، من أجل الصلاة وشكر الرب، إضافة للدعم المجتمعي وتفقُّد أحوال أبناء المجتمع الصغير.
حقائق
انتقلت المجتمعات الخليجية من مرحلة ما قبل الحداثة، المرتبطة بما قبل الصناعية إلى مرحلة الصناعية وما بعد الصناعية، خلال فترة وجيزة جداً جعلت العناصر الفاعلة في المشهد تتنازع حول مفاهيم غير واضحة
في كل هذه المراحل يهدف عمل الإنسان إلى إنتاج ما يستهلك أولاً، ويبيع (أو يقايض) الفائض؛ من أجل أن يحصل على ما ينقصه، ولم يكن جمع الثروة المالية هدفاً في حد ذاته، وإنما استُخدم لشراء المزيد من الأراضي لزيادة الإنتاج، وظلّ جمع كميات كبيرة من الذهب حِكراً على النُّخب الإقطاعية.
شكّل اختراع الآلة البخارية طفرة في تدخُّل الإنسان في الطبيعة عن طريق زيادة الإنتاج بشكل مكثف، حيث أصبح الهدف الأساسي للإنتاج هو البيع لا الاستهلاك. ولأن المصانع تحتاج إلى أيد عاملة، فقد أصبحت المدن هي مراكز استقطاب مَن أراد أن ينجو من الفقر ونظام الإقطاع. هنا تغيَّر شكل المسكن وأهمية التعليم الذي يرفع من سقف طموحات العامل ليتدرج وظيفياً في المصنع. تقلصت سلطة الأسرة، وتراجع دور الدين؛ كون المدن تقوم على مجتمع متنوع لا يتدخل أفراده، بشكل كبير، في خصوصيات بعضهم البعض. وهنا ازدهرت الحداثة، التي أعادت التفكير في المسلَّمات السابقة حول دور المؤسسات الاجتماعية التقليدية (الأسرة، الدين، الاقتصاد، والدولة). أصبحت فكرة «جمع الثروة» متاحة للجميع، وإن ظلت النخبة مهيمنة على الثروات، فإن النماذج التي تمكنت من الخروج من طوق الفقر إلى الغنى، قد شجّعت الكثيرين على بذل الجهد والمنافسة بصفتهم أفراداً، وهذه روح الرأسمالية التي لعبت دوراً محورياً في تكريس الفكر المادي، الذي ناسب الحداثة بوصفها ردّة فعل على التقليدية القائمة على أمور غير عقلانية (بحسب ما يراه الحداثيون)، ومنها الاعتماد على الغيبيات الدينية، أو السرديات الشعبية. جاءت الحداثة بوصفها ردّة فعل عنيفة على التقليدية، فأرادت إعادة هيكلة الأسرة، ورفع مستوى الندّيّة بين الرجل والمرأة، وتقييد دور الدين في المجال العام، وزيادة المنافسة في سوق العمل، وتسخير الدولة لخدمة الاقتصاد وليس العكس.
غيَّرت الحداثة موازين القوى، حيث استغلّت دفع الاقتصاد الصناعي المجتمع نحو التعليم، بأن رفعت سقف طموحات الطبقة العاملة للانتقال من الفقر والاعتماد على طبقة المُلّاك، إلى الطبقة المتوسطة. قلّص هذا التوجه دور المؤسسات الدينية المتحالفة مع القيادات التقليدية، لتزدهر العلمانية بوجهيْها الليبرالي الفردي، والاشتراكي الثوري، على اختلافهما الذي قد يصل إلى حد التناقض، ولكنهما يتفقان في إعادة صياغة المجال العام. هنا ازدهر المنهج البنيوي، القائم على مقاربة البنى الاجتماعية، واللغوية، والاقتصادية، والثقافية، عن طريق استكشاف العلاقات الداخلية للعناصر الأساسية في تلك البنى، والتعرف على المعاني التي تقوم عليها تلك البنى؛ من أجل خلق ثقافة مادية يمكن قياسها بشكل عقلاني بعيداً عن عالم الماورائيات.
لم يتوقف التطور التقني عند الآلة البخارية والكهربائية، فقد تطورت التقنية لتشمل الحوسبة، مُلغية بذلك كثيراً من الوظائف التي يقوم بها البشر، وأصبح لزاماً على الأفراد أن يبحثوا عن أعمال تتجاوز مسألة الإنتاج الذي هيمنت عليه الآلة. هذا ما يُعرَف بمرحلة ما بعد الصناعية «post-industrialism»، حيث تحوَّل سوق العمل إلى «الخِدمية»، بدلاً من «الإنتاجية». وبنظرة سريعة على سوق العمل في هذه المرحلة، سنجد معظم الوظائف، التي يقوم بها الإنسان، تُصنَّف في دائرة الخدمة وليس الإنتاج (طبابة، رعاية، تعليم، خدمة عملاء...). لقد تطورت التقنية بشكل مطّرد مع الذكاء الاصطناعي (بدءاً بالتطور الهائل للكمبيوترات في الستينات) لدرجة تجاوزت القدرة الاستيعابية للبشر لأن يواكبوا التطور التكنولوجي. هنا ينتقل الإنسان ثقافياً واجتماعياً إلى مرحلة ما بعد الحداثة «post-modernity»، والتي توجَّه فيها الفلاسفة إلى طرح التساؤلات على المسلَّمات المهيمنة.
تميزت مرحلة ما بعد الحداثة بالشكوكية العالية، والنسبية، والذاتية في الطرح. تحولت الحقائق الفكرية إلى مجرد وجهات نظر، ثم لحقتها الحقائق المادية، لتكون هي الأخرى وجهات نظر، وحصل فلاسفة ما بعد الحداثة على دعم مطّرد من بعض العلماء التجريبيين الذين رفدوا التشكيك المعرفي بجدل يقوم على الاستدلال المخبري (الكيميائي والحيوي). لنأخذ، على سبيل المثال، مسائل الهويات الجندرية والجنسية، والتي تحولت من مسلَّمات قطعية، كون المثلية مرضاً نفسياً يجب إخضاعه للعلاج إلى تطبيعه وتشخيص مَن يرفض «شرعيته» بأن عليه أن يتعالج من رهاب المثلية. لم يكن بوسع الفلاسفة، المناصرين لهذا التوجه، أن يتمكنوا من الدفاع عن هذا التوجه لو لم يتوفر لديهم دعم من باحثين في مجالات الأحياء والطب. يهدف هذا التوجه الجديد في المجال الإكلينيكي لأن يصوّر التقسيم التقليدي ذكر/ رجل، وأنثى/ امرأة، بأنه قد أضحى أمراً من الماضي الذي يجب تجاوزه. وهنا تتجلى لعبة ما بعد الحداثة فلسفياً في المجال التطبيقي، فلقد لعبت «التشكيكية» دور المُسائل عن شرعية التقسيم التقليدي، لترفدها «النسبية» بطرح فكرة كون الموضوع غير واضح، كما قد يعتقد البعض، لتأتي «الذاتية/ الفردية» معطية الحق للأفراد بأن يقرروا هوياتهم، بناء على شعورهم الذاتي، الذي يستند إلى نسبية الحقيقة التي تم التشكيك فيها. هذا المثال نستطيع طرحه على أمثلة أخرى حول الهويات الجديدة، التي يتم التسويق لها في أوروبا وشمال أمريكا بوصفها تحريراً للعقل من الموروث يتجاوز الفلسفة ليستشهد بالمختبر.
مما سبق نطرح تساؤلاً حول أصل فكرة الحداثة، التي شغلت المشهد الثقافي في الخليج، خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي، وكيف أن أطراف النزاع قد أغفلت السؤال الأهم؛ وهو: كيف لنا أن نفكر في الحداثة وقد وصلتنا ممزوجة بما بعد الحداثة؟ فلقد انتقلت المجتمعات الخليجية من مرحلة ما قبل الحداثة، المرتبطة بما قبل الصناعية، إلى مرحلة الصناعية وما بعد الصناعية، خلال فترة وجيزة جداً جعلت العناصر الفاعلة في المشهد تتنازع حول مفاهيم غير واضحة.
* أستاذ علم الاجتماع بجامعة غراند فالي، وباحث غير مقيم في معهد الشرق الأوسط ـ واشنطن