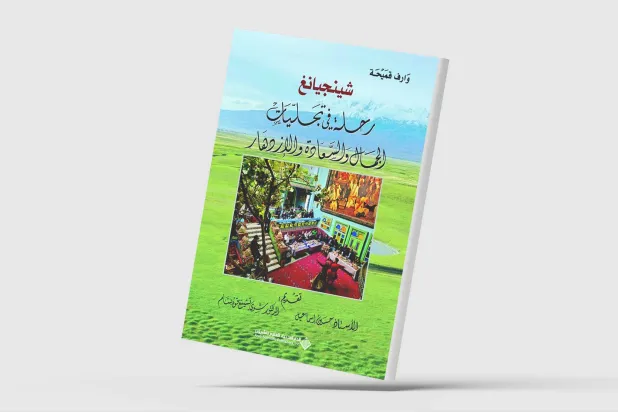«في قلب الأحداث» كتاب لوزير الخارجية المصري نبيل فهمي يستعرض فيه نصف قرن من الأحداث الدولية والإقليمية والوطنية، تابعها عن قرب بصفته مواطناً طموحاً وشاهداً مباشراً وممارساً دبلوماسياً ومسؤولاً سياسياً.
«الشرق الأوسط» تنشر فصولاً من الكتاب في ثلاث حلقات؛ تتناول الأولى معايشة فهمي من منصبه كسفير لبلاده في واشنطن، تجارب الإدارات الأميركية في البحث عن خليفة للرئيس المصري حسني مبارك بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 ومع تقدمه بالعمر.
ومن قلب الحدث، يسرد فهمي ما لمسه من المسؤولين الأميركيين في تقييمهم للمرشحين المحتملين لخلافة مبارك، وسط تجاذب بين «نشر قيم الديمقراطية» من جهة، والحفاظ على المصالح الأميركية واستقرار النظام المصري من جهة ثانية.
وهكذا يحكي فهمي كيف سقطت أسهم عمرو موسى، إذ كان شخصية قيادية ذات نزعة استقلالية، ما يجعل التعامل معه صعباً. إضافة الى مواقفه القوية المؤيدة للفلسطينيين.
بعده، ارتفعت أسهم اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات، ذي التوجه الوسطي مع نزعة براغماتية قوية، والذي حظي بمكانة جيدة لدى واشنطن، قبل أن تبرد الرغبة الأميركية به.
ثم حاول الأميركيون الرهان على جمال مبارك لخلافة والده، لكن لقاءً مباشراً معه مع الرئيس جورج بوش بدعوة شخصية من الأخير، أسقط هذا الرهان.
ودائماً كانت جماعة «الإخوان المسلمين» ورقة عند الأميركيين منذ بدأوا تقبل «الإسلام السياسي»، فنسجوا علاقات متعددة المستويات معهم، مثيرين حساسية نظام مبارك.
بسبب تشابك العلاقات الاقتصادية والسياسية الكبيرة في الشرق الأوسط في نهاية القرن العشرين، كانت الأطراف العربية والأفريقية والدولية تتابع عن كثب ما يحدث بمصر في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس مبارك. وكان هناك اهتمام غربي، خصوصاً من الولايات المتحدة، بالأوضاع السياسية في مصر. وكانت واشنطن تسأل بشكل مباشر، وأحياناً علناً، عن خليفة مبارك المنتظر. وازداد هذا الاهتمام مع تنامي القلق الأميركي من تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
كانت الفكرة السائدة في واشنطن هي أن انتشار الديمقراطية أفضل وسيلة لحماية المصالح الأميركية في الخارج على المدى البعيد. وبعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، أصبحت التحركات لنشر الديمقراطية في العالم أقوى وأشرس.
مع تقدم مبارك في السن، لم تعد واشنطن تراهن عليه، كجزء من مستقبل الشرق الأوسط. وهي كانت محبطة لعدم وجود خطة واضحة لانتقال السلطة أو لخلافته وفق جدول زمني مقبول. لذا أصبحت حريصة على متابعة كل ما يتردد في مصر من شائعات بشأن ترشح مبارك من عدمه في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في منتصف عام 2011، أو الشخصية المرشحة لخلافته إذا قرر التخلي عن السلطة. وقد رصدتُ لائحة لمرشحين محتملين لدى دوائر صناعة القرار في واشنطن. وأنا لا أستبعد أن يكون الأميركيون دعموا بعضهم، لكني لا أمتلك دليلاً مادياً على ذلك.
وفي أواخر التسعينات من القرن الماضي وأوائل عام 2000، كان عمرو موسى أول اسم مطروح لخلافة لمبارك، إذ كان يحظى بشعبية واضحة لدى مختلف قطاعات المجتمع المصري، لكنه لم يكن يحظى بدعم المؤسسات السياسية في الدولة، مثل الحزب الوطني الحاكم وأجهزة الأمن. ولو أجريت الانتخابات في 2000 و2005 بنزاهة ومن دون مشاركة مبارك، لكانت فرص فوزه كبيرة.
كسفير لمصر في واشنطن، كنت ألمس أن الأميركيين لا يحبون موسى. فقد كانوا يعتبرونه شخصية قيادية ووطنية ذات نزعة استقلالية، ما يجعل التعامل معه صعباً. إضافة إلى مواقفه القوية المؤيدة للفلسطينيين. وظهر هذا الموقف بوضوح في زيارته الأخيرة كوزير خارجية إلى واشنطن، قبيل انتقاله إلى جامعة الدول العربية في مارس (آذار) 2001.
وكان فريق عملية السلام في إدارة الرئيس بيل كلينتون أبلغ فريق خليفته جورج بوش، بأن وزارة الخارجية المصرية تتبنى مواقف متشددة وحماسية في الدفاع عن الحق الفلسطيني، وتعرقل الضغط على الفلسطينيين للقبول بما يُعرض عليهم لتسوية النزاع. لذلك كان عمرو موسى الأكثر استهدافاً من قبل الأميركيين والإسرائيليين.
بدا تأثير رسالة إدارة كلينتون واضحاً على تعامل مستشارة الأمن القومي الجديدة كونداليزا رايس مع موسى في أول لقاء لهما بعد تنصيب إدارة بوش. فقد تعاملت رايس معه بخشونة واضحة، وألقت عليه محاضرة سخيفة ومتعالية في طبيعة المشهد السياسي والمستقبل في الشرق الأوسط. وفوجئت شخصياً بصبر موسى وهدوئه، وتجنبه الدخول معها فيما يراه جدلاً لا طائل منه، مفضّلاً التركيز على التعاون المستقبلي مع واشنطن كأمين عام للجامعة العربية. وبعد هذا الاجتماع، أبلغت بوريس رايدل، الذي احتفظ بمنصبه كمساعد شخصي للرئيس وكبير مديري إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، بأن لقاء موسى ورايس كان سيئاً وغير مجدٍ، وبأن المستشارة أخطأت بحق مصر وبحق موسى كثيراً.
المرشح الثاني لخلافة مبارك كان اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة، وهو صاحب «خلفية عسكرية» وله خبرة كبيرة في العمل المخابراتي. وبناء على تعليمات مبارك، تواصل سليمان مع كثير من الشخصيات الدولية والأميركية بشكل خاص، من خلال منصبه كمدير للمخابرات.
عمر سليمان، ذو التوجه الوسطي مع نزعة براغماتية قوية، حظي بمكانة جيدة لدى واشنطن. وهو لعب دوراً مهماً في كثير من المواضيع المتصلة بالحرب على الإرهاب والعلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية، وبالتالي كان له دور مهم بالنسبة للعلاقات العربية - الإسرائيلية.
المهم بالنسبة للأميركيين كان إيمان عمر سليمان بأهمية العلاقات المصرية - الأميركية. وكانوا يفضلونه كخليفة لمبارك، مع أنهم لم يصرحوا ولم يوحوا بذلك أبداً في حدود معلوماتي، إلا أنني كنت أشعر بذلك من خلال الطريقة التي كانوا يسألون بها عنه. وعلى الرغم من أنه لم يكن الخيار المفضل من منظور التحول الديمقراطي المنشود في مصر، فإن العقلية الوسطية القادرة على قيادة المجتمع المصري والحفاظ على المصالح كانت أهم لدى الأميركيين من الديمقراطية.
سليمان اعتاد زيارة واشنطن منفرداً مرة كل عام على الأقل، في إطار التعاون مع نظيره في وكالة المخابرات الأميركية، فيلتقي مسؤولين أميركيين يتم تحديدهم حسب التطورات الدولية والاقليمية وتطور العلاقات بين البلدين. وكنتُ أحضر لقاءاته كافة، بما في ذلك مقابلاته مع نائب الرئيس ديك تشيني أو رايس، أو أعضاء الكونغرس، لكن ليس لقاءاته مع مسؤولي أجهزة المخابرات، مكتفياً في هذا الصدد بما يقدمه من ملاحظات لاحقة عن هذه اللقاءات في إطار التعاون العام مع السفارة المصرية في واشنطن.
في زيارة له إلى واشنطن عام 2004 وبعدما استمع مني عن تركيز مراكز البحث الأميركية الحديث عن الاحتمالات المختلفة لمرحلة ما بعد الرئيس مبارك، في ضوء اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مصر، مع مرور أكثر من عقدين على تولي مبارك السلطة، قال سليمان إن الأمور غير واضحة وكل شيء قابل للتغيير حتى آخر لحظة في مثل هذه الأمور، قبل أن يختم كلامه بأن الشائعات الخاصة بتعيينه نائباً لرئيس الجمهورية خلقت بلبلة وحساسية، وأن من الأفضل أن يعلن الرئيس قراره في هذا الشأن لتهدأ الأمور بصرف النظر عما سيتقرر لاحقاً بالنسبة لمنصب الرئيس. ومع مرور الوقت، تلاشت فرص سليمان وهدأت الشائعات مثلها مثل الشائعات التي سبقتها حول عمرو موسى.
المرشح الثالث المحتمل والأشد إثارة للجدل لخلافة مبارك، كان نجله جمال، باعتباره شخصية مثالية لـ«الأجندة الديمقراطية» الأميركية. فقد تلقى تعليماً غربياً وهو مؤيد للقطاع الخاص، وأصبح بدءاً من 2002 شخصية بارزة في الحزب الوطني الحاكم الذي يرأسه والده.
ولم يكن الأميركيون، الذين لا يحبون عمرو موسى وغير المتيّمين بعمر سليمان، حددوا موقفهم من فكرة وصول جمال مبارك إلى الحكم خلفاً لوالده. وكسفير لبلادي في واشنطن، كنت على تواصل دائم مع مراكز الأبحاث والمحللين في الولايات المتحدة لمتابعة النقاشات بشأن مصر، بما في ذلك ردود الأفعال على الشائعات بشأن المرشحين المحتملين للرئاسة. وكان المحللون الأميركيون يسألونني باستمرار عن المرشحين الثلاثة. وكما أتذكر، لم يسألني أي مسؤول أميركي حكومي عن جمال، مع أنهم بالتأكيد كانوا يتابعون صعوده السياسي الظاهر للعيان.
جمال مبارك زار الولايات المتحدة في مناسبات عديدة، أولاً كعضو غير رسمي أثناء زيارات والده السنوية، ثم كعضو في وفود غير حكومية خصوصاً تلك التي تمثل مجتمع الأعمال المصري. كما كان يأتي منفرداً في زيارات خاصة، ولكن بشكل نادر. وبمرور الوقت، لاحظت التغير في مزاجه العام ونبرته خلال هذه الزيارات. كان دائماً مهذباً، ومتحفظاً في حديثه عن الأحداث في مصر على مر السنوات. كما لاحظت أنه تحوّل من كونه محفزاً للتغيير، إلى شخص يؤكد الحاجة إلى استقرار نظام الحكم وأمنه. وفي واحد من آخر اللقاءات بيننا في واشنطن، سألته عن زيادة تركيزه على الأمن وما إذا كان ذلك يعكس هاجساً موجوداً في مصر، فلم يرد على السؤال بشكل مباشر، لكنه تحدث عن المخاوف من صعود التيارات الإسلامية وفي مقدمتها الحركات السلفية.
وخلال زياراته للولايات المتحدة، كانت سفارة مصر في واشنطن تراعي أنه نجل رئيس الجمهورية وتجنبه التعرض لمواقف حرجة، وتقدم له الخدمات والمجاملات المعتادة والعادية التي تقدمها السفارة لشخصيات المجتمع المدني المصرية التي تزور واشنطن. ولم يكن يطلب أكثر من ذلك، كما أنه لم يكن يحظى بأي معاملة استثنائية، أو يتم التعامل معه كشخصية رسمية، وأقصى صفة رسمية تم التعامل بها معه كانت باعتباره قيادياً في الحزب الحاكم.
ومع تجنب السؤال رسمياً عن مستقبله، لوحظ تنامي اهتمام المسؤولين الأميركيين بترتيب لقاءات مع جمال مبارك لتقييم توجهاته السياسية، أو لنقل رسائل غير رسمية لوالده.
وفي مايو (أيار) 2006، زار جمال مبارك الولايات المتحدة لتجديد رخصة طيرانه. وكما كان يفعل باستمرار، طار من القاهرة إلى مطار دالاس في واشنطن، ثم استقل طائرة في رحلة طيران داخلية إلى وجهته ثم اتخذ المسار نفسه في طريق عودته إلى مصر. وكان جمال مبارك يتصل بي عادة قبل وصوله إلى واشنطن، في طريق الذهاب والعودة. وفي زيارته تلك، تلقيت اتصالاً هاتفياً من مستشار الأمن القومي الأميركي ستيفن هادلي يطلب فيه مقابلة مبارك الابن عندما يصل إلى واشنطن في طريق عودته إلى القاهرة.
ونظراً إلى أن هذه المقابلة اتخذت طابعاً رسمياً، لأنني تلقيت طلباً بها من مسؤول أميركي، وبعد الحصول على إذن من الرئيس مبارك، رتبت الاجتماع، وذهبت مع جمال لمقابلة هادلي. ولم يكن هناك أي شيء سري في اللقاء. وكانت أغلب الأسئلة التي طرحها هادلي تتعلق بتطوير الحزب الوطني ودور القطاع الخاص في مصر. مع ذلك، سبّبت هذه الزيارة مهاترات عديدة وواسعة في القاهرة مع نشر تقارير إعلامية عما وصف بأنها المحادثات السرية التي أجراها جمال خلال وجوده في واشنطن. وزادت حدة الشائعات عندما قال البيان الصادر عن البيت الأبيض إن جمال مبارك كان في أميركا لتجديد رخصة طائرته وليس رخصة طيرانه. وتلقيت اتصالات هاتفية عديدة من وسائل الإعلام المصرية تسأل لماذا لم أصدر بياناً عن الاجتماع كما فعل البيت الأبيض، وكان ردي في ذلك الوقت وكما الحال دائماً: «أنا لا أصدر بيانات عن مقابلات المواطنين المصريين غير الرسميين في أميركا»، وأضفت أن «الأمر متروك لتقدير البيت الأبيض وللطرف المصري الآخر في اللقاء لإصدار بيان من عدمه». حينها أدركت أن الأميركيين باتوا يتعاملون مع جمال مبارك بصورة أكثر جدية، على الرغم من عدم طرح أي أسئلة مباشرة عن مسألة خلافة الرئيس.
وبعد عامين، وفي 2008 تحديداً، تلقيت اتصالاً هاتفياً غاضباً من الرئيس مبارك متحدثاً عن الهواة ومعدومي الخبرة من المسؤولين الأميركيين، الذين يعتبرون جمال خليفة له في الرئاسة. وبحرص، هدأتُ الرئيس لكي أفهم منه سبب غضبه، وأشار إلى وصول دعوة أميركية إلى جمال لزيارة البيت الأبيض ومقابلة الرئيس بوش. وبطريقة مهذبة، لكن صريحة، قلت له إنه لا فكرة لدي أبداً عن الدعوة واقترحت عليه سؤال جمال عنها. وبهدوء غيّر مبارك مجرى الكلام، وقال إن بوش أرسل الدعوة إلى جمال. وسألني عن كيفية التعامل معها. وبعدما تلقيت صورة من الدعوة من الرئيس، أدركت أنها كانت رسالة مكتوبة بخط اليد على أوراق بوش الشخصية.
وخلال دقائق عاد مبارك واتصل بي مرة أخرى وسألني عن رأيي، فأبلغته بأنها دعوة شخصية من حيث الشكل والمضمون، لذلك فإن قبولها أو رفضها يجب أن يكون من جانب جمال، وإن الزيارة إذا تمت فيجب أن تكون «زيارة شخصية»، حيث يلتقي جمال بمضيفيه من دون مرافقة أي مسؤول مصري من السفارة في واشنطن، فتريث الرئيس في الرد وأبلغني بأنه سيعاود الاتصال لاحقاً.
وبعد يومين، اتصل بي مبارك مجدداً، وقال إن جمال سيأتي إلى أميركا في «زيارة شخصية»، مشدداً على أنه يريد مني تحديد ما أعنيه بإجراءات زيارة شخصية، وبالتحديد التعامل معه بالمطار. وبدا في هذه المكالمة كأب وهو يسأل عن الجوانب اللوجيستية للزيارة. وشرحت له أن المساعدة التي ستقدمها السفارة ستكون فقط في حدود ترتيبات التنقلات بين المطار والفندق، كجزء من إجراءات المجاملة التي تقدمها السفارة لأي شخصية عامة مصرية تأتي لزيارة أميركا. وأوضحت له أن حصول أي مسافر على معاملة دبلوماسية في المطارات الأميركية يحتاج إلى حمله تأشيرة سفر دبلوماسية، أما في غير هذه الحالة فإن الشخص سيتلقى معاملة عادية، وقد يتعرض للتفتيش الذاتي من جانب رجال الأمن في المطارات.
وتمت الزيارة كما كان مخططاً لها من دون مشاركة من السفارة المصرية. وبعد انتهاء اجتماعاته مع بوش ونائبه ديك تشيني، وربما بعض المسؤولين الأميركيين الآخرين، اتصل بي جمال وطلب مقابلتي قبل عودته إلى مصر بعد ظهر اليوم التالي، فدعوته إلى الغداء في أحد مطاعم ميريلاند، ولم أسأله عن الاجتماعات، كما لم يتحدث هو عنها بالتفصيل، واكتفى بالقول إن الأميركيين طرحوا أسئلة عامة عن مستقبل مصر وليس عن أي شيء محدد. بالخبرة أدركت أن الأميركيين كانوا يريدون تقييمه.
وبعد أيام قليلة من الزيارة، تراجع الحديث داخل مجتمع مراكز الأبحاث الأميركية، أو على الأقل داخل المؤسسات البحثية المحترمة، عن خلافة جمال مبارك المحتملة لوالده. بالنسبة لي، كان الأمر بمثابة إشارة إلى أنه في حين كان الأميركيون يميلون إليه باعتباره شخصية ليبرالية مدنية، فإنهم بعد اللقاء أدركوا أنه لن يكون قادراً على إدارة دولة معقدة مثل مصر، في بيئة مضطربة مثل الشرق الأوسط، وأن المصالح الأميركية في الشرق الأوسط أكبر من أن تتم المخاطرة بها من أجل القيم الليبرالية. وأصبحوا يميلون إلى وجود مرشح قوى لخلافة مبارك يمكنه حماية مصالحهم في المنطقة، أياً كانت توجهاته.
وكان آخر الاحتمالات لخلافة مبارك بالنسبة للأميركيين يتمثل في جماعة «الإخوان المسلمون» وليس شخصاً محدداً. فقد أصبحت الإدارة الأميركية في عهد بوش، وبعده باراك أوباما، متقبلة لفكرة الإسلام السياسي، باعتباره مكوناً لا غنى عنه في المشهد السياسي بالشرق الأوسط. وباستثناء المحافظين الجدد، فإن كل أميركا في تلك اللحظة كانت مستعدة لاستيعاب الإسلاميين من دون دعمهم بشكل كامل. وازداد عدد أعضاء «الإخوان المسلمين» الذين يترددون على مراكز الأبحاث الأميركية ويشاركون في مؤتمرات حول أوضاع الشرق الأوسط، وأغلبها كان يعقد في قطر.
وتطورت علاقة السفارة الأميركية في القاهرة مع «جماعة الإخوان». فمنذ أوائل الثمانينات، ومع بداية حكم مبارك، بدأ اتصال السفارة بالجماعة عبر عناصر المخابرات، وبعد ذلك بدأت تختبر الموقف بشكل عرضي من خلال الدبلوماسيين التقليديين. وبمجرد قبول أوراق مرشحي الجماعة في انتخابات البرلمان المصري عام 2000، تغير الوضع وبدأ توجيه الدعوات للإخوان لحضور لقاءات في السفارة بشكل رسمي. المفارقة أن الحكومة المصرية التي تجاهلت الاتصالات الأولية بين السفارة والجماعة، بدأت تشكو منها عندما ازدادت اتصالات أعضاء البرلمان المرتبطين بالجماعة بالسفارة.
هذا التطور الجديد عزز نظريات المؤامرة لدى القيادة المصرية الأشد حساسية، في ظل تنامي حضور الإخوان السياسي. وأصبحت علاقة أميركا بالجماعة مصدر غضب للرئيس مبارك الذي أصبح أكثر تشككاً في نوايا الأميركيين. وازدادت الشكوك المصرية مع تصاعد دعوات الرئيس بوش إلى الإصلاح السياسي في مصر، وضرورة تغيير أنظمة الحكم في أماكن أخرى. وخلال سنواتي الأخيرة كسفير في واشنطن، زار مسؤولون مصريون كبار واشنطن بشكل متكرر، لسؤال الأميركيين مباشرة عن علاقاتهم بالإخوان. وعندما استقبل بوش رئيس الوزراء أحمد نظيف في المكتب البيضاوي في مايو (أيار) 2005، سأل الأخير الرئيس الأميركي عن الاتصالات مع الإخوان. وكان الأميركيون يراوغون وينفون وجود أي تقارب مع الجماعة، وهو أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة.
بعد ذلك أصبح ملف الإخوان حاضراً على جدول أعمال أي مسؤول مصري يزور أميركا. وكانت برقياتي للقاهرة تؤكد باستمرار أن واشنطن في الواقع لديها قنوات اتصال مع الإخوان. وأعدت تأكيد أن أميركا غيّرت طريقة تعاملها مع الدول الصديقة بعد الإطاحة المفاجئة بحكم الشاه في إيران عام 1979، فبدأت تتواصل مع الجميع. ونتيجة ذلك وبعد وقت قصير من زيارة نظيف لواشنطن عام 2005، عقد مبارك اجتماعاً رفيع المستوى مع المسؤولين المصريين، الذين زاروا الولايات المتحدة لمناقشة علاقة أميركا بالإخوان. كان مبارك منزعجاً جداً من التناقض بين الموقف الأميركي المعلن بعدم التواصل مع الإخوان، والاتصالات القوية السرية بينهما. وأمر مبارك السفير سليمان عواد الذي كان يشغل منصب المتحدث باسم الرئاسة، أن يتصل بي بشكل عاجل ويطلب مني إرسال مذكرتين؛ الأولى بشأن العلاقات بين أميركا والإخوان، والثانية كانت خاصة بالتعاون العسكري. وعندما سألته عن سبب العجلة في هذا الطلب، قال إن الرئيس يريد أن يناقش مع المسؤولين المصريين تقييمي لهذه العلاقة إلى جانب معلومات أجهزة المخابرات المصرية حولها.
والحقيقة أن قراءتي العامة للموقف الأميركي أثناء حكم الرئيس بوش الابن تجاه القيادة المصرية، وقبل عشر سنوات من خروج مبارك من الحكم، كانت تشير إلى أن الأميركيين كما هم دائماً نفعيون للغاية. ومع بداية القرن الحادي والعشرين، ووصول مبارك إلى سن 72 عاماً، كانت أميركا تستعد لمرحلة ما بعد مبارك. ولإنجاز هذه المهمة، بدأ الأميركيون يتابعون أي مرشح محتمل لخلافة مبارك ويمكنه حماية مصالحهم، بغض النظر عما إذا كان ديمقراطياً أم لا. وكان هذا هو سبب تفضيلهم لعمر سليمان على كل من عمرو موسى وجمال مبارك.
وكانوا يرون أنه في حال عدم وجود مرشح من المؤسسة الأمنية، سواء من الجيش أو الشرطة، فستكون أمام جماعة الإخوان فرصة جيدة للوصول إلى السلطة بفضل قدرتها على الحشد وقاعدتها الشعبية الواسعة. وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعل الرئيسين كلينتون وبوش يتابعان ثم يتقربان بحذر من الجماعة.