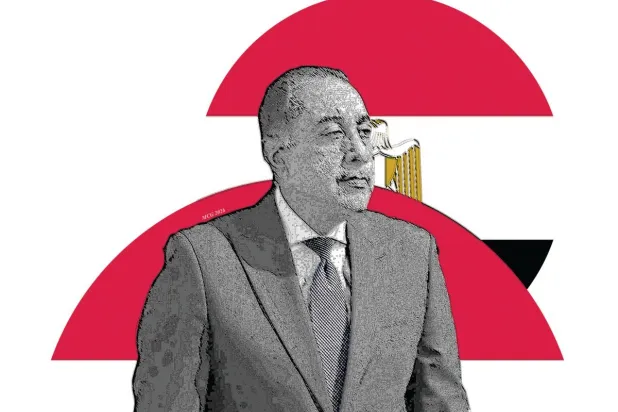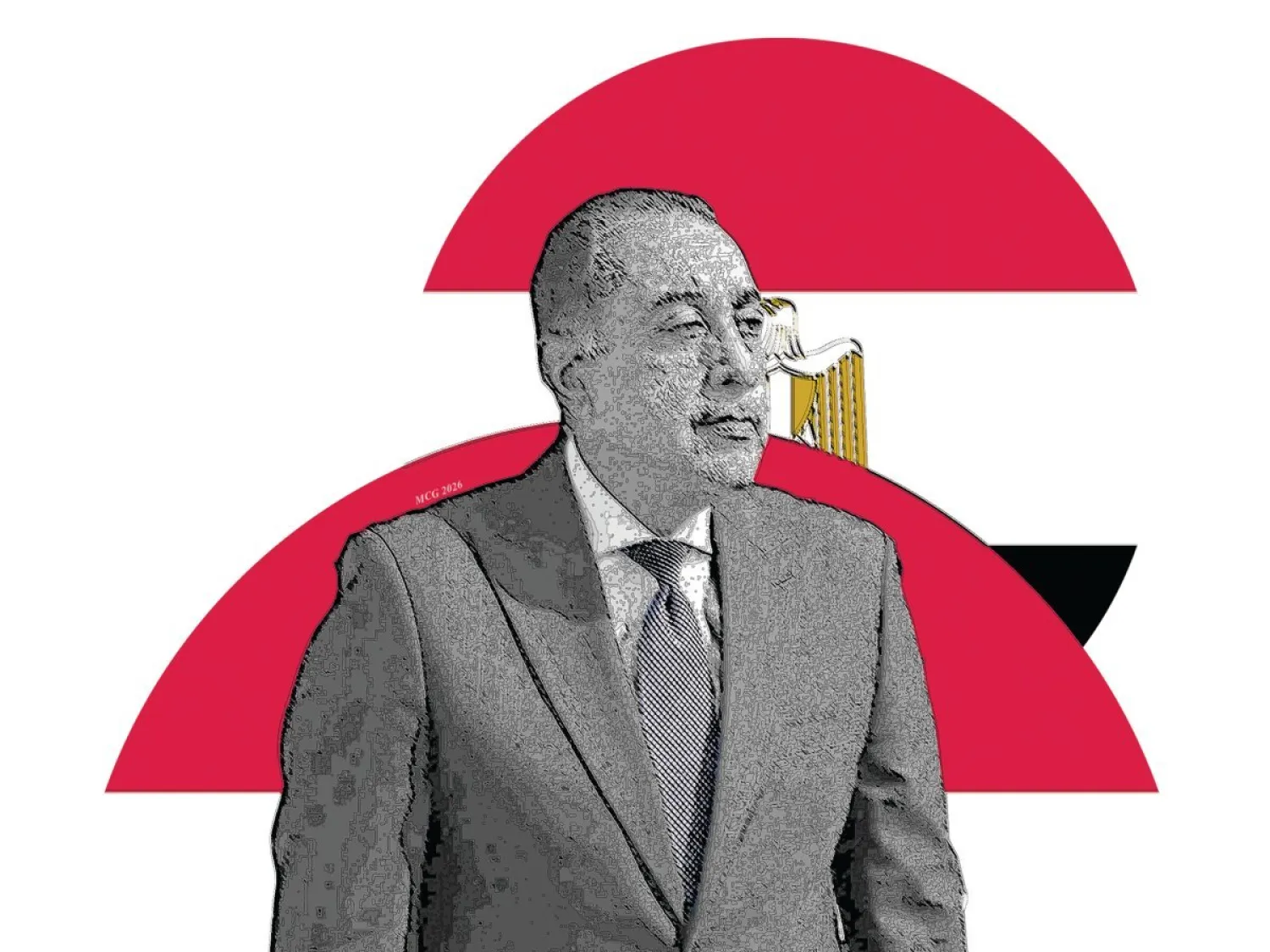وضعت تركيا رهانات سياستها الخارجية في السنوات الأخيرة على محاولة اللعب على التوازنات وتبديل التحالفات والتقارب مع روسيا، والصين أحياناً، من أجل إيجاد أوراق بديلة للتلويح بها في وجه الولايات المتحدة، التي خيم على العلاقات معها مناخ من التوتر في كثير من القضايا والملفات التي أدخلت العلاقات بين أنقرة وواشنطن مرحلة من الفتور الذي يتصاعد بين وقت وآخر إلى توتر يترك أول ما يترك بصمته على الاقتصاد التركي الذي تأثرت مؤشراته سلباً في 2018 و2019 بهذا المناخ.
أكبر ملفات التوتر وأبرزها منذ نهاية عام 2017 وحتى الآن، والمرشحة للتصعيد أيضاً خلال عام 2020؛ ملف اقتناء تركيا منظومة الصواريخ الروسية «إس 400» الذي اختلفت أنقرة وواشنطن في تقييمه، فتركيا تتذرع باحتياجها لتعزيز منظومة دفاعها الجوي وبعدم تجاوب الإدارة الأميركية السابقة برئاسة باراك أوباما مع الطلب التركي لاقتناء منظومة «باتريوت»، بينما واقع الأمر أن المنظومة كانت رمزاً للتقارب والانفتاح التركي على المعسكر الشرقي الذي أرادت به أنقرة أن تعلن بوضوح أنها لن تتوقف عن توجهها لتنويع محاور سياستها الخارجية والظهور على أنها قوة فاعلة تستطيع أن توازن بين ارتباطاتها مع القوى الكبرى في العالم بما يحقق مصالحها.
في المقابل، عدّت الولايات المتحدة الخطوة التركية والإصرار عليها محاولة روسية لإضعاف حلف شمال الأطلسي (ناتو) باستخدام تركيا كمخلب قط في هذه اللعبة الخطرة. ومن هنا ألقت تركيا بنفسها في مرمى العقوبات الأميركية التي ظلت لفترة تعتقد أنها لن تسقط في مصيدتها اعتماداً على الاعتقاد بأنه يمكن اللعب على التناقضات القائمة بين الكونغرس والإدارة الأميركية والتعويل على التفهم الذي أبداه الرئيس دونالد ترمب لخطأ سلفه أوباما عندما امتنع عن تزويد تركيا بمنظومة «باتريوت».
ورغم نجاح أنقرة في تأجيل سلسلة العقوبات التي تنتظرها على مدى ما يقرب من عامين، فإن الأسابيع الأخيرة من عام 2019 حملت معها عدداً من القرارات التي أكدت أنها لن تنجو من نيران العقوبات في الفترة المقبلة، منها قانون الاعتراف بإبادة الأرمن على يد الدولة العثمانية في 1915، ومشروع قانون العقوبات بسبب «إس 400»، ومشروع السيل التركي «تورك ستريم» لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي تركيا، وعملية «نبع السلام» العسكرية التي استهدفت الحلفاء الأكراد لأميركا في شمال شرقي سوريا والتي تدخلت واشنطن لوقفها بعد انطلاقها في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بثمانية أيام فقط، ورفع الحظر على السلاح لقبرص.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل عارضت أميركا التفاهمات التركية مع حكومة السراج في ليبيا بشأن التعاون العسكري والأمني وتحديد مناطق السيادة في البحر المتوسط، وعدّتها «استفزازية» و«مقلقة جداً».
وقابلت تركيا هذه الخطوات بالتهديد بطرد القوات الأميركية من قاعدة إنجيرليك الجوية في أضنة، جنوب البلاد، وإغلاق قاعدة كورجيك للرادار التي يستخدمها حلف الناتو في مالاطيا (شرق).
ولعبت قاعدة إنجيرليك دوراً محورياً وكبيراً خلال الحرب الباردة، إذ كانت طائرات التجسس الأميركية تنطلق منها لتحلق فوق أجواء الاتحاد السوفياتي السابق، وكانت تضم 150 رأساً نووياً نشرتها الولايات المتحدة في القاعدة، فيما تتحدث تقارير عن تخزين 50 رأساً نووياً في القاعدة حالياً.
وبنظرة فاحصة إلى النهج التركي في محاولة اللعب بورقة العلاقات مع روسيا كنقطة قوة في العلاقات مع أميركا، يبدو أن تركيا أدخلت نفسها في مأزق ووضعت نفسها تحت ضغط مزدوج، فقد أبدت تركيا انفتاحاً كبيراً على روسيا من أجل تحقيق مصالح اقتصادية، خصوصاً في مسعاها لأن تصبح ممراً للطاقة إلى أوروبا، فضلاً عن التنسيق في الملف السوري من أجل تحقيق أهدافها في إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا تبعد الأكراد عن حدودها الجنوبية.
وحتى في هذا الملف حاولت أنقرة أن تكسب من الطرفين باللعب على التوازنات، لكن بدا أن ما يتحقق لها لا يلبي أياً من طموحاتها، وأهمها إقامة المنطقة الآمنة وسحب قوات وحدات حماية الشعب الكردية بعيداً عن الحدود الجنوبية لتركيا إلى عمق 30 كيلومتراً.
وبنظر كثير من المراقبين، أجهضت واشنطن وموسكو معاً طموحات تركيا ووضعت لها سقفاً منخفضاً جداً، وأسهمتا معاً في إنهاء عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شرق الفرات دون أن تحقق أهدافها، وهو ما أكدته وزارة الدفاع الروسية منذ أيام، حيث اعتبرت أن دخول قوات الأسد إلى مناطق في شرق الفرات ومحاصرة العملية التركية هو الحدث المحوري الأهم في سوريا عام 2019. رغم التنسيق التركي - الروسي في كل خطوة.
وقال قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا، ألكسندر تشايكو، خلال اجتماع في مقر وزارة الدفاع يوم الجمعة الماضي: «يتمثل الحدث المحوري عام 2019 بمساعدة الحكومة السورية في بسط السيطرة على أراضٍ واقعة في شرق الفرات... هذا الإنجاز المهم يشمل أيضاً محاصرة منطقة تنفيذ عملية (نبع السلام) التركية العسكرية مع تسيير دوريات روسية - تركية مشتركة، إضافة إلى تنفيذ مهمات خاصة بالدوريات الجوية والبرية». وأشاد بإنجاز قواته الذي سمح لقوات النظام السوري بضم مزيد من الأراضي إلى مناطق سيطرته.
ودخلت قوات الأسد للمرة الأولى إلى قرى وبلدات في شمال شرقي سوريا منذ عام 2012 بعد عملية نبع السلام التركية التي أطلقتها تركيا في 9 أكتوبر الماضي ضد الوحدات الكردية في المنطقة، وتفاهمات النظام السوري مع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) برعاية روسية عقب اتفاق سوتشي مع تركيا في 22 من الشهر ذاته.
ولم تخفِ أنقرة امتعاضها من الموقف الروسي في الأيام الأخيرة وتكررت الانتقادات الصادرة عنها بشأن الهجوم الواسع للنظام في إدلب الذي يقترب من نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد هناك، وكذلك لعدم الالتزام الروسي - الأميركي بشأن انسحاب الوحدات الكردية من شرق الفرات. وكان من النادر في السنوات الثلاث الأخيرة صدور مثل هذه الانتقادات لروسيا بأي شكل من الأشكال، وهو ما يدل، في نظر مراقبين، على عمق المأزق الذي تجد تركيا نفسها فيه بين الضغوط والعقوبات الأميركية والمناورات الروسية.
9:48 دقيقه
مأزق تركيا بين عقوبات أميركا ومناورات روسيا
https://aawsat.com/home/article/2059696/%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7



مأزق تركيا بين عقوبات أميركا ومناورات روسيا

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان يتحدثان في مؤتمر صحافي بسوتشي حول المنطقة الآمنة في سوريا 22 أكتوبر (أ.ب)
- أنقرة: سعيد عبد الرازق
- أنقرة: سعيد عبد الرازق

مأزق تركيا بين عقوبات أميركا ومناورات روسيا

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان يتحدثان في مؤتمر صحافي بسوتشي حول المنطقة الآمنة في سوريا 22 أكتوبر (أ.ب)
مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة