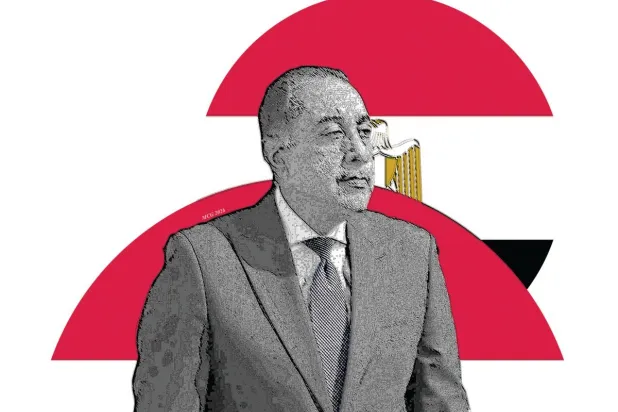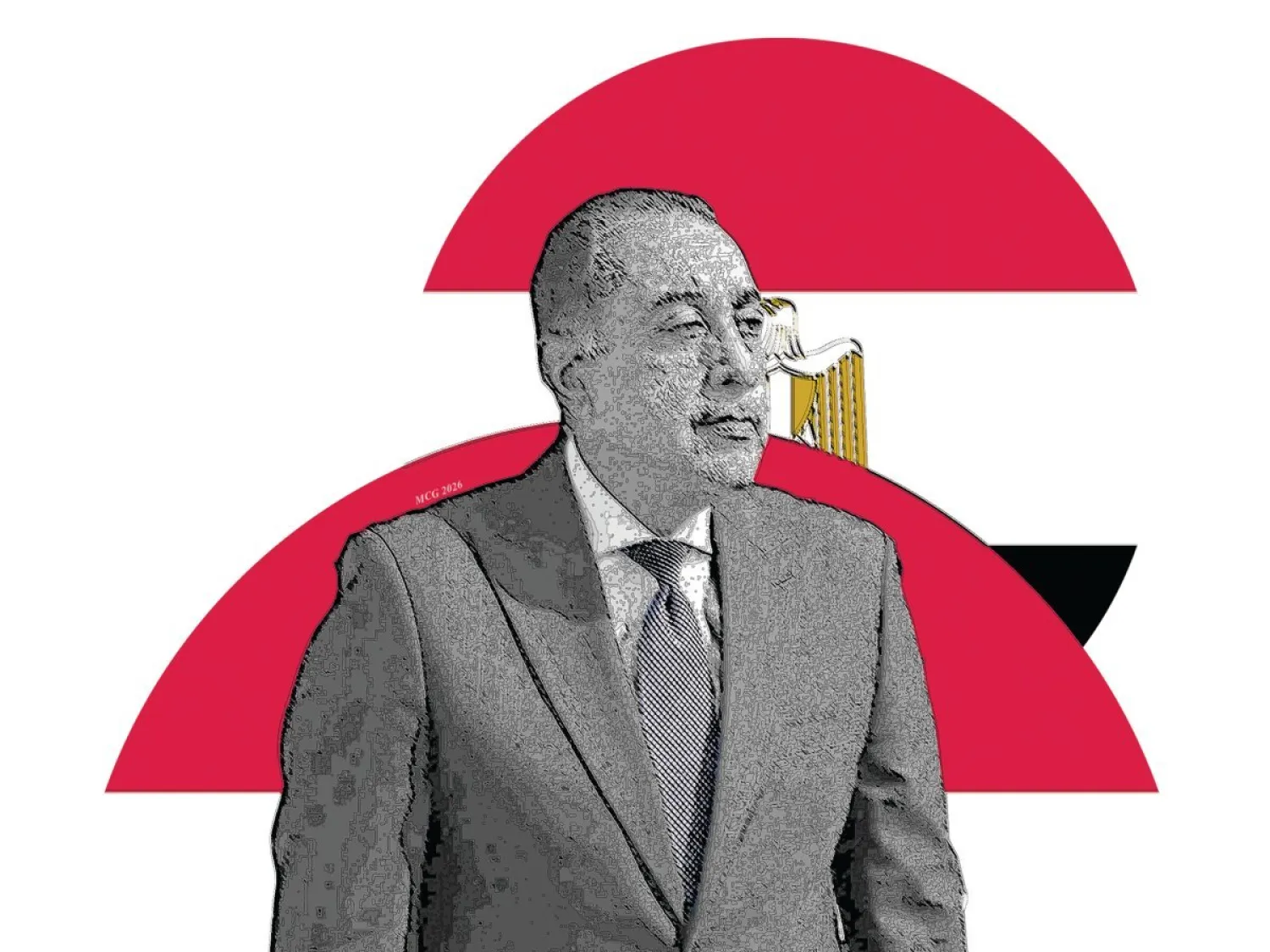ثمّة بلدان تبدو محكومة بقَدَر الطغاة. يتعاقبون عليها فصولاً من القهر والعذاب. يأكلون من لحم أبنائها، ويطردون الأحلام من أهدابهم كلّما أطلّت مواسم التغيير والآمال. نيكاراغوا من هذه البلدان، التي ما إن تطوي مأساة حتى تبدأ بالاستعداد لمواجهة أخرى. تهدر فيها الفرص والطاقات، وتحرق الوعود المؤجلة باستمرار.
خلال زيارتي الأولى إلى نيكاراغوا بعد انتصار «الثورة الساندينية» عاينت بلداً من أجمل بلدان القارة الأميركية، وشاهدت كيف كانت عائلة الطاغية أناستاسيو سوموزا تمارس الحكم بوحشية لا نظير لها، وتتصرّف كما لو أنها تملك البلد بأكمله، لا رقيب أو حسيب. على فظائعها مطمئنة إلى دعم الولايات المتحدة التي كانت يومها تعتبر أميركا اللاتينية بأسرها «حديقتها الخلفية»، لها فيها الربط والحلّ.
كان مستحيلاً ألا تتفجر ثورة في كل شبر من تلك الأرض المعذّبة. كانت مسألة وقت، إلى أن قامت مجموعة من الشبان الجامعيين والمزارعين بتأسيس «الجبهة الساندينية للتحرير الوطني» عام 1961، مستلهمة نضال الجنرال أوغوستو ساندينو، الذي تمكّن على رأس مجموعة من الثوّار من طرد القوات الأميركية التي كانت تحتل نيكاراغوا عام 1934. لكن واشنطن كانت قد عمدت قبل سحب قواتها إلى تشكيل قوة عسكرية عالية الدربة هي «الحرس الوطني»، وعيّنت قائداً لها الجنرال سوموزا، الذي كان اغتيال ساندينو أولى العمليات التي نفذها بعدما تسلّم مهامه.
طويلة ومكلفة كانت حرب العصابات التي شنتها «الجبهة الساندينية» من الأرياف في نيكاراغوا، ضد نظام الطاغية السابق أناستاسيو سوموزا. وفي نهاية المطاف، اضطر سوموزا للهرب من العاصمة صيف عام 1979، ليدخلها ثوار «الجبهة»، وعلى رأسهم «الكوماندانتي» دانييل أورتيغا، الذي كان سوموزا قد أفرج عنه قبل سنوات، في أعقاب اعتقاله إثر محاولة للسطو على أحد المصارف مع مجموعة من الثوار. ومن ثم، جرت مقايضة أورتيغا وعدد من رفاقه مقابل إفراج «الجبهة الساندينية» عن مسؤولين كبار احتجزتهم، بعدما اقتحمت إحدى مجموعاتها المسلحة منزل حاكم البنك المركزي، الذي كان يستضيف السفير الأميركي وشقيق سوموزا.
ترأس أورتيغا «حكومة الإعمار الوطني» التي تشكلت في نيكاراغوا بعد سقوط سوموزا، وتولّى شقيقه أومبرتو قيادة القوات المسلحة حتى إجراء الانتخابات الأولى عام 1984. في هذه الانتخابات فاز دانييل أورتيغا ليصبح أول رئيس للجمهورية، ويعلن قيام نظام اشتراكي ماركسي – لينيني، كان يتلقّى الدعم الفني والعسكري من كوبا، ومساعدات مالية سخيّة من ليبيا التي منحته «وسام القذافي الدولي لحقوق الإنسان»!.
إلا أن سياسات الاقتصاد الموجه التي انتهجها أورتيغا، وعملية الحصار الخانق الذي فرضته عليه واشنطن كالذي كان مفروضاً على كوبا، أدّت إلى أزمة اجتماعية ومعيشية خطيرة، تصاعدت معها الضغوط الإقليمية والدولية عليه، إلى أن أُجبر على الدعوة إلى إجراء انتخابات عام 1990. في هذه الانتخابات فازت قوى المعارضة بقيادة رفيقته السابقة في «الجبهة» فيوليتا تشامورو، التي كانت قد انشقت عنه مع نائبه سيرجيو راميريث، الكاتب المعروف الذي فاز بجائزة ثرفانتيس العام الماضي.
- أورتيغا: المنعطف الكبير
تلك الهزيمة في الانتخابات كانت المنعطف الذي بدأت عنده مرحلة التحوّل الشخصي والسياسي الأعمق والأغرب عند أورتيغا، ومعها رحلة الابتعاد عن الجذور والانتماءات الآيديولوجية الأولى.
إذ راح الزعيم الثوري ينأى عن دائرة التأثير الكوبي، وينسج علاقات مع مراكز النفوذ المالي والاقتصادي والحركات الدينية المحافظة. كذلك قرر الاستعاضة عن نشيد «الجبهة الساندينية» بسيمفونية بيتهوفن التاسعة. ثم عاد ليفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2006، ويعيّن رفيقته آنذاك وزوجته حالياً، روزاريو موريّو نائباً له، بعدما كان معظم رفاق دربه قد انشقّوا عنه أو انضموا إلى المعارضة.
وعندما فاز مجدداً في انتخابات عام 2011، كان أورتيغا قد رسّخ أسس نظام حكم ديكتاتوري يمسك فيه بمقاليد القرار السياسي والعسكري والمالي، ملغياً هامش المناورة وقنوات الحوار مع الخصوم والمعارضة، ومصرّاً على قمع الاحتجاجات أيا كانت مصادرها أو دوافعها.
أخذ يتجاهل كل الانتقادات التي تستهدف أسلوب حكمه التوتاليتاري، والقمع الذي تمارسه أجهزة الأمن التابعة له مباشرة في حق المعارضين، والثروة الطائلة التي جمعتها أسرته، والفساد المستشري حوله، والتهم التي وجهتها ضده مؤسسات دولية بالتعامل مع المنظمات الإجرامية لتهريب المخدرات، مثل «كارتل» بابلو أسكوبار الكولومبي، لتمويل حزبه وأعوانه. ورغم التحذيرات والنصائح التي وجهتها لأورتيغا جهات إقليمية ودولية عدة، إزاء تدهور الأوضاع المعيشية والاجتماعية، وارتفاع مستوى الفقر ومنسوب الاستياء الشعبي، فإنه ترشّح للانتخابات مرة أخرى عام 2016، وفاز بنسبة 75 في المائة من الأصوات، ما أثار موجة عارمة من الاحتجاجات أخمدها بيد من حديد بسرعة قياسية.
- مفتاح ما يجري اليوم
هذه الوقائع التاريخية التي تعاقبت منذ سنوات في مسرى دانييل أورتيغا السياسي والشخصي، هي المفتاح الوحيد لقراءة ما يحصل اليوم في نيكاراغوا، ويهدد بإغراقها مجددا في حمام آخر من الدم والدمار.
يوم 18 أبريل (نيسان) الماضي، أصدر أورتيغا مرسوماً رئاسياً بتعديل نظام الضمان الاجتماعي؛ بحيث يخدم مصالح أصحاب العمل، ويحرم الطبقات الفقيرة والفلاحين والطلاب من تعويضات مالية وخدمات أساسية باهظة التكاليف في القطاع الخاص. تلك كانت الشرارة التي أشعلت النار في هشيم الأوضاع المتأزمة من سنوات، فانطلقت مظاهرات حاشدة في معظم أنحاء البلاد، يتقدمها الطلاب والفلاحون مطالبين بإلغاء المرسوم الذي لم يناقش في البرلمان، وباستقالة أورتيغا، والدعوة إلى إجراء انتخابات حرة بمراقبة دولية.
لم يستطع أورتيغا أن يتحمّل مشهد المظاهرات الحاشدة التي تطالبه بالاستقالة في كل أنحاء البلاد، والتي عادت به سنوات إلى الوراء، عندما كان يتزعّم الاحتجاجات ضد نظام سوموزا، فأمر قواته بقمعها من غير رحمة. وأدى القمع الدامي إلى سقوط أكثر من 80 قتيلاً خلال الأيام الثلاثة الأولى، معظمهم من الشباب الذين أصيبوا بطلقات نارية في رؤوسهم أو صدورهم.
الشهود الذين عاينوا عمليات القمع أصيبوا بالهلع إزاء تلك المشاهد التي استحضرت عهد سوموزا، بينما سارعت الكنيسة الكاثوليكية النافذة في نيكاراغوا إلى مطالبة أورتيغا «بسحب قواته فوراً من الشوارع، ووقف أعمال القتل والاعتقال العشوائي» كشرط أوّلي لبدء الحوار مع القطاعات المحتجة.
- تفاوض تحت الضغط
وبعد ثلاثة أسابيع من المماطلة والتسويف والمراهنة على تراجع حدة الاحتجاجات التي لم تهدأ، أعلن أورتيغا أنه مستعد «للتفاوض من أجل التوصل إلى مخرج من الأزمة السياسية» التي بدأت تضرب الاقتصاد الضعيف. إذ قدّر البنك المركزي أن الخسائر التي نجمت عن الاضطرابات بلغت 350 مليون دولار، وأن ودائع بمقدار 300 مليون دولار قد سُحبت من المصارف في الأسابيع الثلاثة الماضية. هذا، وكان الفلاحون والمنظمات الطلابية قد قطعوا معظم الطرقات الريفية المؤدية إلى العاصمة التي ما زالت شبه معزولة عن بقية المناطق. وطالبت الكنيسة أورتيغا بالإسراع في الإقدام على خطوات إصلاحية توسّع إطار الحريات والديمقراطية.
أما رئيس اتحاد المنتجين والمزارعين، فهو يرى أن المفاوضات لا بد أن تؤدي إلى «تنحّي أورتيغا أو استقالته، وتشكيل حكومة جديدة تعيد النظام والاستقرار، وتدعو إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة». وهدّد، في حال فشل المفاوضات، بشل الحركة الإنتاجية في البلاد، والدعوة إلى «إضراب عام مفتوح إلى أن تسقط الحكومة».
في المقابل، توقّف المراقبون باستغراب عند التصريحات الأخيرة التي صدرت عن أورتيغا، عندما قال إن حكومته تسعى إلى الحوار والسلام، مشيراً إلى المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي أخيراً، وذهب ضحيتها عشرات القتلى من الفلسطينيين في غزة. إلا أنه لم يتطرّق إلى عشرات القتلى الذين سقطوا في نيكاراغوا برصاص قوات الأمن والقناصة، والجماعات شبه العسكرية الموالية له في الأسابيع الأخيرة، بل سقط أمس فقط أكثر من 100 قتيل.
- الغالبية مع رحيله
وفق استطلاع للرأي نُشر أخيراً، أفاد الاستطلاع بأن 70 في المائة من المواطنين يؤيدون رحيل أورتيغا، نصفهم من «الساندينيين» الذين يعتبرون أنه قد خان مبادئ الثورة، وأنه يدفع بالبلاد نحو وضع مشابه لوضع فنزويلا.
ومن جانب آخر، يحذّر مراقبون دبلوماسيون في العاصمة ماناغوا، من أن الجنوح الديكتاتوري في مسار أورتيغا، وسيطرته الكاملة على أجهزة الأمن والقوات المسلحة، من العوامل التي قد تدفعه إلى تصعيد القمع، إذا ما شعر بأن استمراره في الحكم بات مهدداً، ومن ثم، يفتح أبواب الأزمة على مصاريعها وأسوأ احتمالاتها.
واللافت أن أورتيغا يتنقّل منذ بضع سنوات في سيارة فاخرة مصفّحة، بعكس ماضيه الثوري، عندما رافقه كاتب هذه السطور في إحدى جولاته الانتخابية بالمناطق الريفية على صهوة حصان، ويصافح مؤيديه من غير حراسة.
كل المراقبين الذين يتابعون عن كثب تطورات الأزمة في نيكاراغوا، يجدون صعوبة في تحديد التوقعات بشأن الخطوات التي يمكن أن يُقدم عليها أورتيغا، الذي تنقّل بسهولة وبراعة - ونجاح حتى الآن - في كل السيناريوهات السياسية الممكنة. ثمّة من يرجّح نزوعه إلى استخدام مزيد من العنف لقمع الاحتجاجات، مراهناً على تراجع حدتها مع مرور الوقت، والإنهاك الطبيعي للمشاركين فيها. ولقد تعرّضت مظاهرة سلمية حاشدة لأمهات الذين سقطوا في احتجاجات الأسابيع الماضية، كانت تجوب الوسط التجاري في العاصمة يوم الأربعاء المنصرم، إلى قمع وحشي على يد أجهزة الأمن ورصاص القناصة، بينما كان الرئيس يعلن من مقر قيادة القوات المسلحة: «نيكاراغوا لنا جميعاً، وفيها سيبقى جميعنا»، في رد مباشر على المطالبين برحيله. إلا أن آخرين يرون أنه إذا ما أحسن قراءة الأحداث، وأصاب في تقدير تفاعلاتها - انطلاقاً من تجربته الخاصة - سيخلص حتماً إلى أن أيامه ستكون معدودة، ما لم يسارع إلى تقديم تنازلات وإجراء إصلاحات جذرية في نظامه.
- عنصر الشباب
صحيح أن السواد الأعظم من الذين يخرجون إلى الساحات في المظاهرات الحاشدة ويسقطون برصاص قوات الأمن، هم من الشباب الذين لم يعرفوا عن «الثورة الساندينية» سوى القليل مما سمعوا أو قرأوا عنها. غير أن الثورة هي في الحامض النووي للنيكاراغويين الذين يعرفون أنها قامت قبل أي شيء لأسباب أخلاقية، ضد طاغية أمعن لسنوات طويلة في قتل الشباب المعارضين الذين كانت أجسادهم تُرمى في حفرٍ مكشوفة عند أرباض العاصمة، حيث كانت الأمهات يتهافتن كل صباح بحثاً عن المفقودين من أولادهن.
بعض الشعارات التي يرفعها المتظاهرون العُزل اليوم في وجه قوات الأمن، تكفي لإعطاء فكرة عن تصميم «أحفاد» الثورة، على إسقاط الذي قادها وأصبح اليوم أكبر خائنيها.
أحد الذين سقطوا في اليوم الأول من الاحتجاجات كان قد كتب على قميصه «أخذوا منّا كل شيء، بما في ذلك الخوف»... بينما كانت شابة حامل تتقدم إحدى المظاهرات في ماناغوا، وعلى بطنها الجملة التالية: «... فلتستسلم أمّك؛ لأن أمي لن تستسلم».
- أضواء على نيكاراغوا... وبطلها القومي ساندينو
> تقع نيكاراغوا في أميركا الوسطى، بوسط البرزخ الذي يفصل بين المحيط الهادي والبحر الكاريبي. وتمتّد على مساحة 130 ألف كيلومتر مربع فوق أرض بركانية استوائية المناخ، تهطل عليها الأمطار الغزيرة بانتظام كل ظهيرة، لتروي حقول البنّ الذي يشكّل عماد الاقتصاد (65 في المائة من الصادرات)، وتغذّي بحيرة كوثيبولكا... أكبر خزّان للمياه العذبة في عموم أميركا الوسطى.
لا يختلف تاريخ نيكاراغوا كثيراً عن تاريخ شقيقاتها في الأميركتين الجنوبية والوسطى، من حيث حقبة الاستعمار الإسباني، وحروب التحرير الوطنية، والنفوذ الواسع للولايات المتحدة في شؤونها السياسية والاقتصادية. إذ نزل فيها المستعمرون الإسبان مطالع القرن السادس عشر الميلادي، وأتبعوها مباشرة بالإدارة المركزية للإمبراطورية حتى أواسط القرن التاسع عشر، لتغدو بعد ذلك إحدى المقاطعات الملحقة بالإمبراطورية المكسيكية الأولى، بموجب مقايضة بين المكسيك وإسبانيا.
بعد هزيمة المكسيك في حربها ضد الولايات المتحدة، نالت نيكاراغوا استقلالها عام 1838، ودخلت في دوّامة طويلة من الاضطرابات السياسية والعنف الأهلي بين المحافظين والليبراليين. ومهّدت هذه الدوّامة لتمدّد نفوذ واشنطن الذي استمرّ حتى ظهور البطل القومي أوغوستو ساندينو، الذي تمكّن بعد حرب عصابات طويلة، من طرد القوات الأميركية نهائياً عام 1933، ليترك بصماته على كل الأحداث التي تعاقبت على نيكاراغوا إلى اليوم.
- ساندينو... البطل التاريخي
وُلد أوغوستو سيزار ساندينو في بلدة نيكينومو عام 1895، وكان ابناً غير شرعي لأحد مزارعي البن الأثرياء وخادمة كانت تعمل في منزله. هجرته أمه وهو بعد في التاسعة، فذهب ليعيش في كنف جدته، ثم عاد إلى مزرعة والده، حيث اضطر للعمل في حقول البن مقابل قوته ومسكنه. ولقد جاء في سيرته أن الحادثة التي غيّرت مجرى حياته - لشدة تأثيرها فيه - كانت عندما شاهد جثة قائد القوات المتمردة على النظام الذي كانت تدعمه واشنطن، ممددة على عربة يجرّها ثوران، ويواكبها عدد من المزارعين الحفاة، في الطريق إلى دفنه في مسقط رأسه.
عام 1921 اضطر ساندينو للهرب من نيكاراغوا بعد إطلاقه النار على أحد وجهاء بلدته، كان قد عيّره بوالدته. وراح من ثم يتنقّل من هندوراس إلى غواتيمالا والمكسيك، حيث عمل في حقول النفط ومزارع الموز وقصب السكّر. وفي المكسيك - بالذات - نضجت أفكاره السياسية المناهضة للإمبريالية، وعاد إلى نيكاراغوا عام 1926 بعدما سقط الحكم القضائي عنه بالتقادم، وانضمّ إلى القوى المعارضة للتدخل الأميركي، وبدأ نضاله المسلح مع مجموعة من رفاقه، زّودتهم بالبنادق بعض المومسات في ميناء بلدة كابيثاس.
وبينما كانت أعداد الثوار التابعين لحركته تزداد، كان عدد قوات «المارينز» (مشاة البحرية) الأميركية في نيكاراغوا قد وصل إلى خمسة آلاف، يؤازرهم 460 من الضباط والخبراء العسكريين المشاركين مباشرة في المعارك ضد القوات المتمردة.
في عام 1928، أبرم الليبراليون الذين كانوا يدعمون القوات المتمردة ضد الحكومة المحافظة، صفقة مع الأميركيين، تسلّموا الحكم بموجبها مقابل سحب تأييدهم للثوار. لكن ساندينو رفض الصفقة وانسحب إلى معقله والقاعدة الرئيسية لقواته، وقال جملته الشهيرة: «إنا لا أُباع ولا أستسلم. الحرية لبلادي أو الموت». وتقاطر التأييد عليه من الأرياف والمناطق الفقيرة، حتى بلغ عدد المقاتلين بإمرته ستة آلاف خلال أقل من ثلاثة أشهر، بسبب الغضب الذي كان يجتاح المناطق التي تحتلها قوات «المارينز» نتيجة لأعمال التنكيل والاغتصاب في حق المواطنين. ولذا اضطر الأميركيون إلى استخدام الطيران لقصف المناطق السكنية، في المدن التي كان ثوار ساندينو يحاصرون «المارينز» فيها.
وفي حين كانت قوات «المارينز» تتأهب للانسحاب من نيكاراغوا، بفعل الهزائم المتلاحقة اللاحقة بها، كان الرئيس تيودور روزفلت يحاول إنهاض أميركا من الأزمة المالية الكبرى، فأعلن سياسة «حسن الجوار»، وقرّر سحب القوات الأميركية من منطقة الكاريبي، بما فيها نيكاراغوا. وبعد انسحاب القوات الأميركية عرض ساندينو السلم على رئيس الجمهورية والانصراف إلى الإعمار، فتجاوب الرئيس مع الطلب، وأعلنت نهاية الحرب في 2 فبراير (شباط) 1922.
في تلك الفترة كان على رأس القوات المسلحة في نيكاراغوا الجنرال أناستاسيو سوموزا، العميل الأول لواشنطن، الذي كان يخطط منذ أسابيع لاغتيال ساندينو. ويوم 2 فبراير 1934، بينما كان ساندينو يغادر مع بعض معاونيه منزل رئيس الجمهورية (والد زوجة سوموزا) ألقت القبض عليه ثلّة من العسكريين، واقتاده أفرادها خارج العاصمة، حيث أعدم رمياً بالرصاص أمام حفرة كانت معدّة سلفاً لدفنه.
غير أن موت ساندينو لم ينهِ إرثه؛ بل صار عنواناً للوطنية، وحملت اسمه الجبهة الثورية التي أسقطت بعد عقود ديكتاتورية عائلة سوموزا.
نيكاراغوا أمام خياري الإصلاحات... أو المجهول
ما تبقى من تجربة دانييل أورتيغا «الثورية» أمام الامتحان الأصعب


نيكاراغوا أمام خياري الإصلاحات... أو المجهول

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة