حينما ينفجر مفهوم في لحظة تاريخية محددة وفي حقل معين، فإنه لا ينبثق فجأة وبشكل مباغت، بل يكون قد تم الإعداد له على نار هادئة. بمعنى آخر نقول إن المفهوم ليس شيئاً يسقط كوحي على عقل عبقري نحته وأطلقه للوجود، بل هو يتشكل في مرجل التاريخ، بحيث نجد له جذوراً وأصولاً مهدت له وأسهمت في إخراجه إلى حيز الوجود، أو لنقل بكلمة أوضح، إن كل مفهوم هو بالضرورة كائن تاريخي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن انطلاق المفهوم وتشكل دلالته واحتلاله موقعاً وحيزاً في عقول المفكرين، لا يعني أن الأمر انتهى وتم إغلاقه. بل العكس هو الذي يحدث، إذ يأخذ الأمر مساراً آخر. فيتشتت المفهوم كشظايا تصيب ميادين وحقولاً معرفية أخرى، ليكتسب، في النهاية، دلالات مختلفة عن المعنى الأصلي للحقل الذي انفجر فيه أول مرة. إن المفهوم إذن، له لحظة انطلاق تكون عبارة عن وعي كامل بدلالاته وصلاحياته للفهم والتفسير. لكن هذا المفهوم ليس مبتوراً، بل متجذر في الماضي، وله إرهاصات سابقة عليه سمحت بظهوره، وفي الوقت نفسه، له امتدادات في المستقبل، بحيث يجري توظيفه في مجالات متعددة، فندخل فيما يمكن أن نسميه: حقبة هيمنة المفهوم وسيطرته على العقول.
ولكي لا يبقى كلامنا فضفاضاً وعاماً، ولفهم أدق لحركية المفهوم وتجواله وانتقالاته، سنأخذ نموذجاً تمثيلياً هو مفهوم «اللاشعور» الذي شغل بال الفكر المعاصر في القرن العشرين. وسنعتمد بالأساس، على دراسة قام بها الدكتور عبد الرزاق الدواي بعنوان «مفهوم اللاشعور... نماذج من انتقالاته في الفكر المعاصر»، التي جاءت ضمن كتابه «حوار الفلسفة والعلم والأخلاق» شركة المدارس الدار البيضاء، 2004. هنا تفاصيل ذلك:
* ما قبل فرويد
إن كل من يسمع كلمة «اللاشعور»، يستحضر في ذهنه مباشرة، الطبيب والمحلل النفسي الشهير سيغموند فرويد (1856 - 1939). وحقاً، هذا الرجل هو من أعلن بوضوح، تأسيس فرع جديد في علم النفس، جاعلاً اللاشعور النفسي مركزه. كما طور منهجاً متميزاً للكشف عن تجلياته، وكذلك بعض التقنيات لعلاج الاضطرابات النفسية التي تسببها رواسب اللاشعور. لكن على الرغم من كل ذلك، ففي حقيقة الأمر، نجد أن مفهوم اللاشعور لم يظهر بهذه الفجائية في حقل محدد هو التحليل النفسي. بل نجد له تمهيدات في الفلسفة الأوروبية خلال القرن التاسع عشر. ففكرة أن هناك مضمرات وقوى خفية نفسية غائرة وغائبة متحكمة في وعي الإنسان، كانت رائجة، خصوصاً عند الفلاسفة الألمان الذين نبهوا إلى وجود قوى مجهولة وعارمة لها السيادة على السلوكيات الإنسانية، وغالباً ما نسبوها إلى الجانب العضوي الفسيولوجي لدى الإنسان.
وإذا ما أخذنا الفيلسوف والتربوي وعالم النفس الألماني فريدريك هربارت (1776 - 1841)، سنجد أن ظاهرة «اللاشعور»، بل حتى فكرة «الكبت»، كانت متداولة في كتاباته، وإن لم ترقَ إلى مستوى الاستخدام الفرويدي، لكنها كانت مقدمة أولية شكلت اللمسات الممهدة للتحليل النفسي. لقد كان هربارت يرى أن وحدات النفس البشرية وظواهرها، هي «تمثلات» بينها تعارض وصراع يؤدي إلى إقصاء واحدة على حساب الأخرى. بعبارة أخرى، خلال سيرورة الصراع النفسي بين التمثلات، تطغى أفكار وتظهر على سطح «الشعور»، وفي الوقت نفسه، تكبح أخرى، أي تكبت وتقذف في أعماق «اللاشعور». أو لنقل إن هربارت، يرى للتمثلات اتجاهين؛ اتجاه صاعد إلى مستوى الشعور واتجاه نازل إلى مستوى اللاشعور. فيمكن الحديث عن تمثل مستقر في الشعور إذا كان واضحاً ومتميزاً. وبالعكس، يمكن الحديث عن تمثل مستقر في اللاشعور، إذا كان مكبوحاً أو مكبوتاً أي غامضاً. ولعل العارف البسيط ببعض أفكار فرويد، يتبين له كم أن هربارت له السبق بل الفضل في نشأة أهم مفاهيم المشروع الفرويدي، ونقصد «اللاشعور» و«الكبت».
وفي الحقيقة ليس هربارت وحده من تشكلت عنده النواة الأولى لفكرة اللاشعور، بل نجدها عند كثير من الفلاسفة الذين آمنوا بوجود قوة لا شعورية محركة للعالم، نذكر منهم فريدريك هيغل (1770 - 1831)، بفكرته عن «المطلق» كروح محركة للتاريخ، وكذلك شوبنهاور (1788 - 1860)، بفكرته عن «الإرادة» كقوة مجهولة وعارمة وغير معقولة هي مبدأ الوجود. وأيضاً هارتمان (1842 - 1906)، بكتابه «فلسفة اللاشعور»، حيث يجعل من اللاشعور روحاً كونية تسري في كل شيء. ولنقف عند شوبنهاور تحديداً، نظراً لاعتراف فرويد بتأثيره.
تقول أطروحة شوبنهاور إن «العالم المرئي يخفي تحته عالماً أكثر حيوية وأكثر دفقاً. فالحفر تحت السطح سيكشف لنا عن حقل من القوى والغرائز العمياء، وهي دوافع بمثابة سراديب لا واعية. تظهر في الطبيعة الخام كقوة الجاذبية مثلاً، وتظهر كقوة حيوية لدى النباتات والحيوانات، وتظهر عند الإنسان في إرادة بقائه التي ليست بقراره أبداً». هذه الأفكار الداعمة لوجود أعماق لا شعورية، جعلت فرويد نفسه يعترف بسبق الرجل (الفلسفي طبعاً) إذ نجده يقول: «لقد بقيت أعتبر هذه الفكرة (يقصد فكرة الكبت)، جديدة وأصيلة إلى اليوم الذي أطلعني فيه أوتو رانك (تلميذ وزميل لفرويد)، على صفحات من كتاب شوبنهاور (العالم كإرادة وتمثل)، يعرض فيها الفيلسوف تفسيراً لظاهرة الجنون».
وفعلاً، عندما نقرأ بعض نصوص شوبنهاور، نكتشف لمسات واضحة لآلية الكبت التي تتوافق وما قدمه فرويد في نظريته، ومن أمثلة ذلك، نذكر قول شوبنهاور: «عندما تستيقظ فينا بكيفية فجائية إحدى الذكريات الماضية القاسية والمؤلمة، فإننا غالباً ما نعمل على استبعادها في الحين، بطريقة تكاد تكون آلية: إما عن طريق التلفظ بكلام مبهم، وإما بإتيان بعض الإشارات. ونحن نتوهم أننا بهذه الطريقة تمكنا من التخلص منها وإقصائها تماماً».
إننا نعلم أن فرويد يعطي أولوية هائلة للجنس لفهم بعض سلوكيات الإنسان. ولهذا نجده يشير مرة أخرى إلى شوبنهاور باعتباره من الأوائل الذين نبهوا إلى ذلك. فهو بيّن أهمية الغريزة الجنسية، باعتبارها إرادة للبقاء، في شرح كثير من الأشكال السامية من العواطف والعفة والطهارة.
وقبل مغادرة شوبنهاور، لا ينبغي نسيان أن هناك نقطة التقاء أخرى له مع فرويد، تتجلى في إعطاء الأولوية للجسد على حساب العقل، وله قول مأثور في ذلك: «إن الإرادة (يقصد بها الجسد كموطن للغريزة) هي السيد، أما العقل فهو مجرد عبد». فنحن بحسب شوبنهاور، لا نريد شيئاً لأننا وجدنا له أسباباً، بل نحن نجد أسباباً له لأننا نريده. فالعقل مجرد مخطط ومبرمج وباحث عن الاستراتيجيات لبلوغ الرغبة. فهو خادم طيع في يد إرادة البقاء. وهذه كما نعلم، هي خلاصة فرويد الذي أكد أكثر من مرة، أننا مجرد كائنات غريزية مفعول بها، وما يبدو من فاعلية لدى الإنسان، هي، في الحقيقة، مجرد أوهام.
* اللاشعور بعد فرويد
بدأ مفهوم «اللاشعور»، كما رأينا، كحدس وكتأمل فلسفي، في القرن التاسع عشر، ليستقر كتصور واضح في التحليل النفسي، مع مؤسسه فرويد، بل سيصبح اللاشعور وفرويد، وجهين لعملة واحدة. إلا أن هذا المفهوم سيتعرض لتغير دلالي، وسيسافر من عالم النفس ليستغل ويستثمر بطرق متعددة. وهذا ما حدث مثلاً، مع المدرسة البنيوية التي خرجت من اللاشعور النفسي، الذي يحيل إلى الرغبة والكبت والدوافع الغريزية، نحو اللاشعور البنيوي، أي البحث عن البنية العقلية المشتركة المتحكمة في التفكير. فكل طفل يحمل منذ ولادته الرصيد الكلي للإمكانيات أي البنيات الذهنية الأولية. وهذا ما حاول كلود ليفي ستروس (1908 - 2009) تأكيده، معلناً أن أشكال الثقافات البشرية تصدر عن الأصل نفسه، أي عن إمكانيات لا شعورية لعقل بشري له هوية ثابتة دوماً. فالطبيعة البشرية الخام، هي رقعة الشطرنج، لكن هناك صيغاً من اللعب لا تنقطع هي الثقافة. باختصار، يريد ستروس بإنتروبولوجيته البنيوية، أن يثبت أن الفكر قد بدأ بالطبيعة قبل الإنسان، ومن ثمة نحن نشتغل وفق برمجة سابقة علينا. وهذا ما سمح له بأن يعلن أن الحرية محال، وسقف إمكاناتنا محدد ومؤطر سلفاً. ولنقل إن هناك لا شعوراً بنيوياً متحكماً في الاجتماع البشري.
وبالطريقة أعلاه، سيوجه الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو (1929 - 1984)، مفهوم «اللاشعور» وجهة معرفية، بنحته مفهوم «الإبستمي»، ويقصد به ذلك النظام الخفي المستثمر بصمت أثناء الممارسة العلمية، الذي يحدد شروط المعرفة في حقبة تاريخية معينة، التي بمقتضاها يعترف لخطاب عن الأشياء بأنه الحقيقة، فهو نظام لا أحد يفكر فيه ولكن يخلق شروط التفكير. ولقد استخدمه فوكو بمرادفات متعددة، كالنسق، والبنية، وفضاء للتنظيم والأرضية الإبستمولوجية، وشروط الإمكان وأوليات تاريخية. وكلها تجمع على معنى واحد، هو أن هناك «لا شعوراً معرفياً»، أي ذلك المستوى المتخفي والعميق، وتلك الطبقة التحتية التي تشكل شروطاً قبلية لإنتاج المعرفة في زمن ما. وهو ما عبر عنه أيضاً، الفيلسوف توماس كون (1922 - 1996) بـ«الباراديم»، وهو مفهوم يدل على النموذج الموجه أو الإطار النظري والأساس المضمر الذي يسمح بطرح المشكلات وطرق حلها عند متحد علمي ما. بعبارة أخرى فـ«الباراديم» يعني مجموع القواعد والمسلمات والمفاهيم والأدوات التي يتحرك من داخلها العلماء. فالعلماء ينظرون إلى الواقع بعين هذا «الباراديم». فهو بمثابة الخلفية التي تسمح برؤية دون أخرى. ولنقل ببساطة، إن العلماء يشتغلون وفق لا شعور معرفي.
نخلص إلى أن المفاهيم ليست ملقاة أو جاهزة أو نتاج عبقرية معينة، بل هي لها تاريخ وجذور. تبدأ حدسياً وتأملياً، ثم تتضح وتنجلي مع مرور الوقت في حقل محدد. لتنتقل بعد ذلك، إلى بقية الحقول وإن بدلالات مختلفة، إذ تكسو المفاهيم طبقات جديدة من المعاني، تجعلها أكثر إجرائية. لهذا نقول لمن يجمد المفاهيم، إنه يسير عكس المنحى الطبيعي للأشياء. فليتدبر.
«اللاشعور» ما قبل فرويد وما بعده
تجميد حركية المفاهيم هو سير عكس طبيعة الأشياء
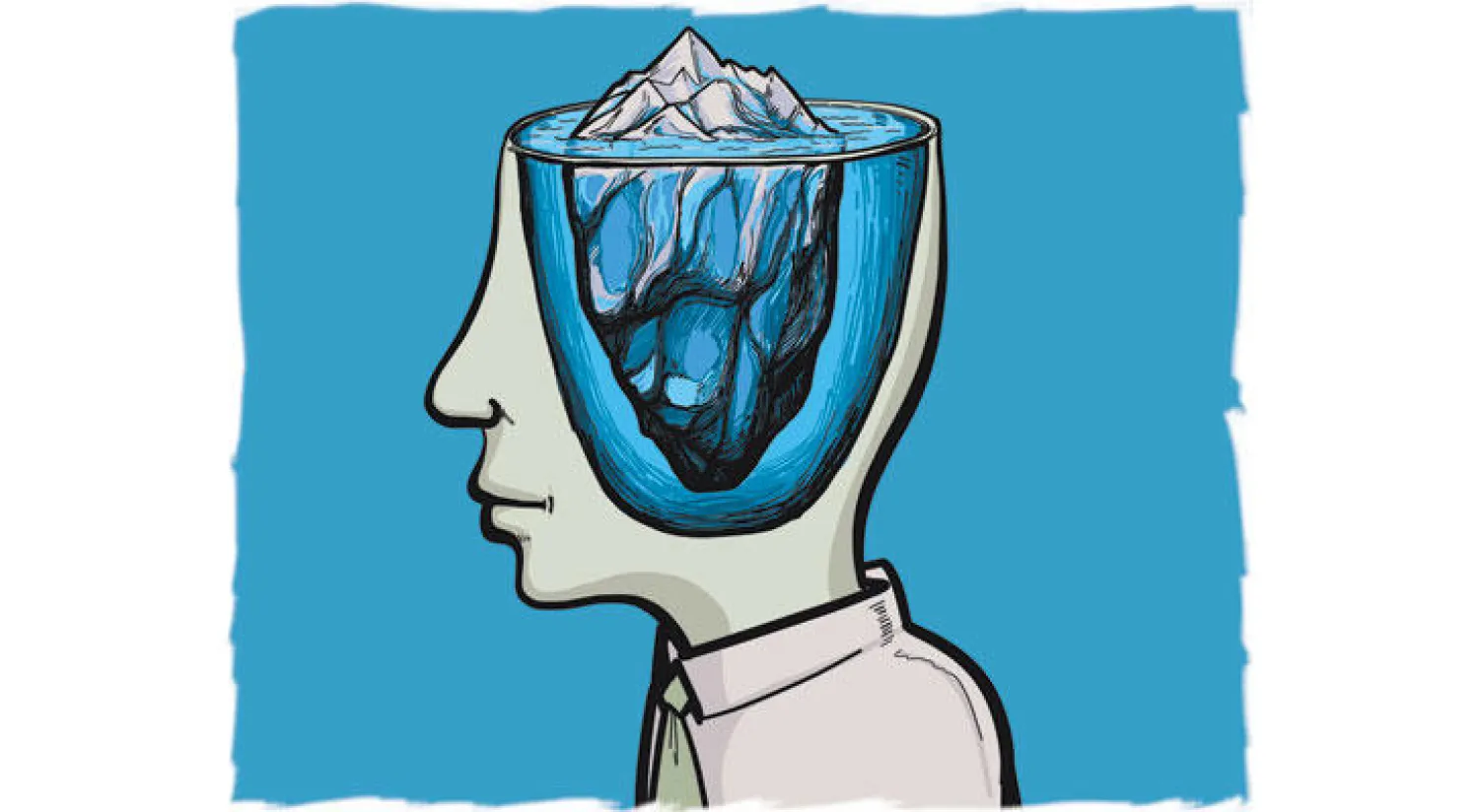

«اللاشعور» ما قبل فرويد وما بعده
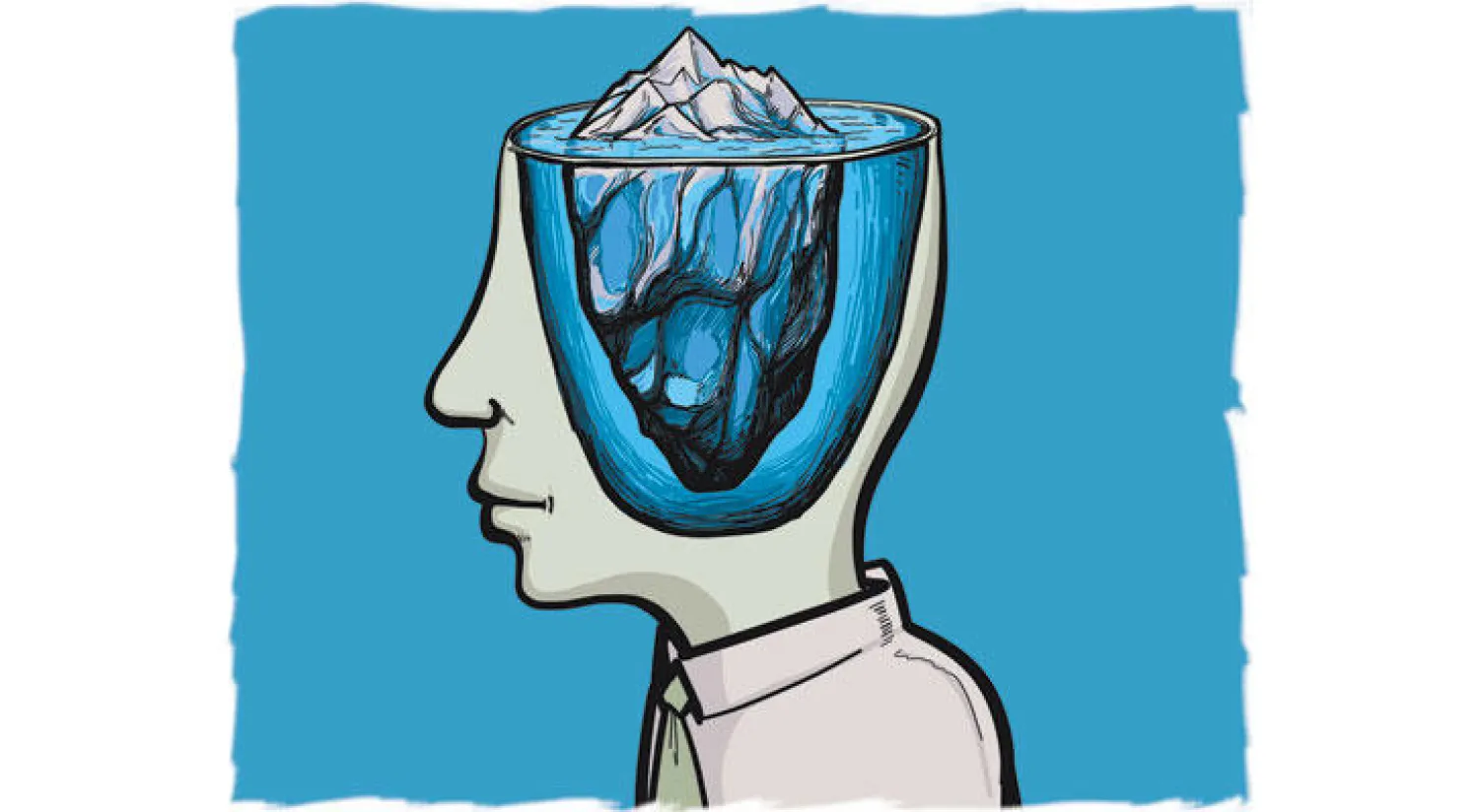
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة








