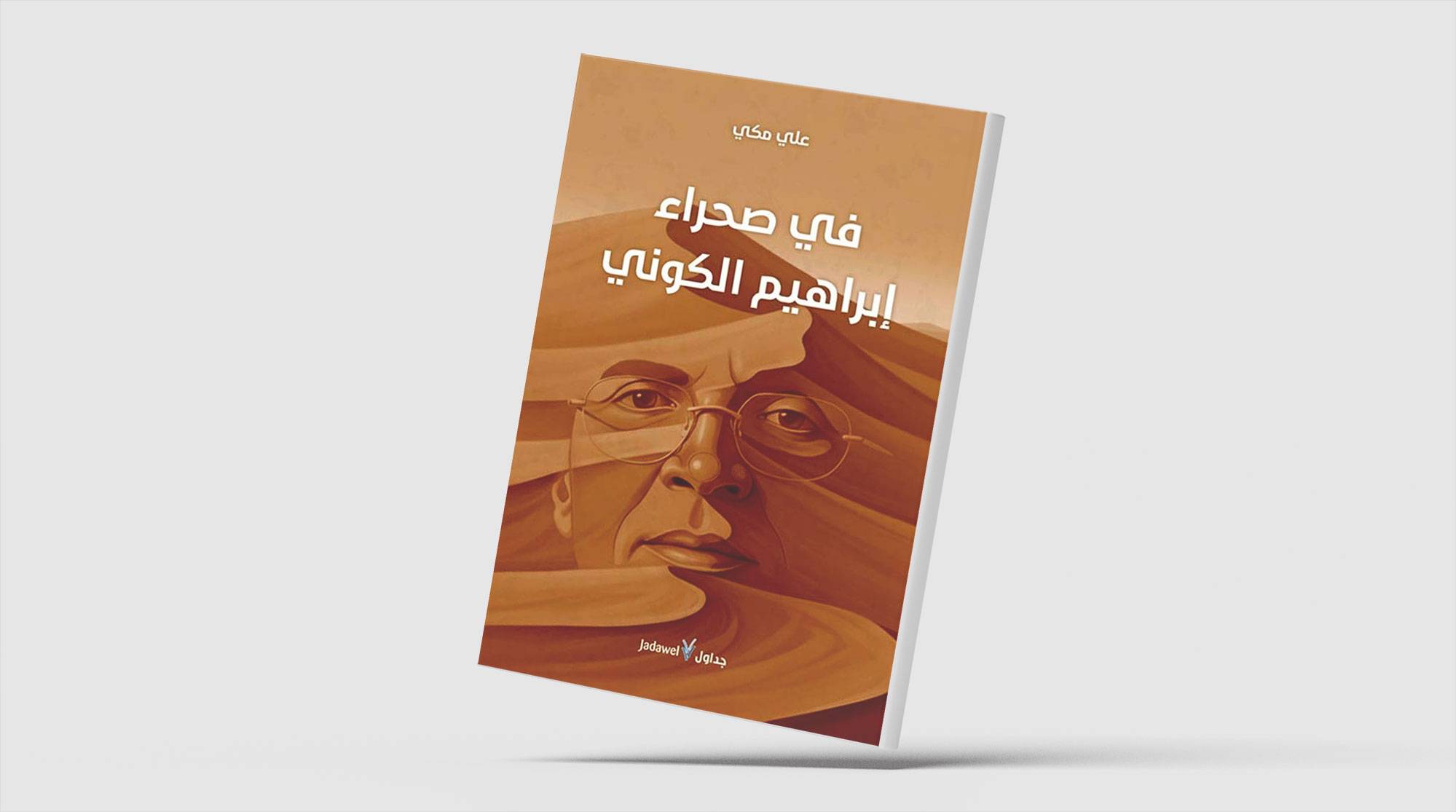بحسب موسوعة جامعة ستانفورد الفلسفية فإن ديفيد هيوم هو أهم فيلسوف كتب بالإنجليزية على مر العصور. هيوم المولود في 1711 للميلاد في أدنبره هو أحد الفلاسفة الشكاك الكبار لدرجة أن فلسفته الشكية أيقظت الفيلسوف الكبير إيمانويل كانت من سباته الدوغمائي، حسب تعبير كانت، كما أدت لسقوط الموازين والمعايير من عيني جيرمي بينثام، حسب تعبير بينثام نفسه. كان هيوم أيضا مؤرخا، فقد كتب تاريخ إنجلترا كما كتب مقالات ودراسات كثيرة لم ينشر بعضها إلا بعد وفاته خوفا على حياته. هيوم أيضا كان على علاقة وثيقة بعدد من الفلاسفة المهمين في عصره وعلى رأسهم آدم سميث وجان جاك روسو الذي عاد معه إلى إنجلترا هربا من مطاردات قانونية في سويسرا. توفي هيوم بهدوء في 1776 في منزله الذي بناه في أدنبره بعد عمر من التجوال والنشاط في أوروبا انتهى بسنين هادئة مع أصدقائه وأحاديثهم الودودة كل مساء.
لو أردنا وضع عنوانا لفلسفة هيوم أو مبدءا جوهريا لمنطقها فإنه بإمكاننا القول بهذا الشعار: «المعرفة متهمة حتى تثبت براءتها». في المقابل نجد لدى فلاسفة الحس المشترك كتوماس ريد مثلا أن «المعرفة بريئة حتى تثبت إدانتها». هذا المبدأ سيكون له تطبيقات كثيرة سأقتصر هنا على ذكر بعض الجوانب المتعلقة بالميتافيزيقا والمنطق، وهي المجالات التي أحدث فيها هيوم تأثيرات جوهرية. في المبحث الميتافيزيقي لا بد من التوقف عند رأي هيوم في السببية، وهي العلاقة الجوهرية الوحيدة التي تمكننا من الوصول لما وراء الأدلة التي نحصل عليها من الحس المباشر. يتساءل هيوم عن العلاقة السببية ولأي أنواع التفكير تنتمي. بمعنى هل عندما نقول إن «أ» سبب لـ«ب»، فنحن ننطلق من تفكير استقرائي أو استنباطي؟ المنطق الاستنباطي ضروري منطقيا بمعنى أن النتيجة تنتج ضروريا من المقدمة وإلا وقعنا في التناقض. مثلا حين نقول إن كل إنسان له قلب ونقول إن سقراط إنسان فإنه من الضروري القول إن سقراط له قلب. هذه النتيجة ضرورية منطقيا لأننا لو وصلنا لنتيجة مثل «سقراط بلا قلب» ستحدث تناقض وإشكال في التفكير مع المقدمات الأولى. هذا هو التفكير الاستنباطي الذي نستنبط فيه النتيجة من المقدمة. في المقابل التفكير أو المنطق الاستقرائي يتحرك بمنطق مختلف فهو قائم على ملاحظة أحداث معينة ثم استنتاج نتيجة لها. مثلا ممكن أن نلاحظ أن نسبة البطالة عند أصحاب الشهادات العليا أقل منها عند من لا يملكون شهادات عليا، ونستنتج من ذلك أن الشهادات العليا سبب لانخفاض البطالة. أو أن نلاحظ أن نسبة أمراض السكر عند من يمارسون الرياضة أقل منها عند من لا يمارسونها، وبالتالي نستنتج أن الرياضة سبب للحماية من أمراض السكر. الملاحظ في التفكير الاستقرائي أنه دائما ناقص.. بمعنى أنه لا يمكن جمع كل العينات التي يفترض أن ينطبق عليها القانون. لم يجمع أحد كل أصحاب الشهادات العليا ولا كل ممارسي الرياضة في الأمثلة السابقة. بمعنى أن النتيجة فيها تعميم تجاوزي غير مدعوم بالكامل ببراهين. كذلك نلاحظ أن نتيجة المنطق الاستقرائي غير ضرورية منطقيا. بمعنى أنه لا توجد علاقة منطقية بين الرياضة والسكر أو بين الشهادة العليا والتوظيف. أعني بذلك أننا لن نشعر بالتناقض حين نفكر بإنسان يجمل شهادة عليا وعاطل في الوقت ذاته، أو رياضي مصاب بالسكر. قد نقول إن هذه نتائج غريبة واقعيا ولكنها مقبولة منطقيا. سؤال هيوم هنا هو إلى أي هذين النوعين تنتمي علاقة السببية؟ الجواب عنده أنها علاقة استقرائية وبالتالي فهي ناقصة وغير ضرورية منطقيا. فعلا الحرارة تمدد المعادن ولكن هذه علاقة قائمة على التجربة وليست علاقة قبلية. هنا يقطع هيوم مع التفكير المثالي القائم على النظر على أن السببية منطق قبلي، وعقلي، سابق على أي تجربة. ما يقوله هيوم هنا جوهري جدا لأن نتيجته تقول إن العقل الإنساني دون التجربة يفتقد لأهم آليات تفكيره: العلاقة السببية. السببية في الأخير وباعتبار أنها ليست علاقة ضرورية منطقية، فهي ناتجة فقط عن ملاحظة تكرار تتابع الأحداث. بمعنى أننا استنتجنا تمدد المعادن بسبب الحرارة بسبب تكرار هذه الظاهرة أمامنا على مدار زمن طويل. لا يوجد شيء في فكرة الحرارة وفكرة المعادن يربطهما بعلاقة التمدد. كل ما هنالك هو علاقة تكرار مستمرة جعلت لدينا نوع من الثقة باستمرار هذه العلاقة. بحسب هيوم لا توجد ضمانة على إشراق الشمس غدا إلا مجرد ثقتنا في تكرار الحدث الذي شهدناه على مدار سنين طويلة. لا يوجد مانع منطقي لوجود عالم تشرق فيه الشمس من الغرب أو لا تشرق أبدا.
ما يقوله هيوم هنا هو أن أي مفكر لا يمكنه التفكير دون تجربة. التجربة هنا ليست فقط مصدرا للمعلومات الضرورية للتفكير بل هي مصدر لأهم علاقة في التفكير البشري وهي العلاقة السببية. العلاقة التي تتيح لنا الربط بين الأحداث وتؤدي بنا إلى استخلاص قوانين وقواعد. النتيجة المهمة الأساسية الأخرى التي تعود بنا إلى لب فلسفة هيوم التشككية وشعاره «كل معرفة متهمة حتى تثبت براءتها» هي أن المعرفة الإنسانية برمتها قائمة على معرفة ناقصة بالضرورة وغير ضرورية. إذا كانت السببية وهي العلاقة الأم للتفكير الإنساني نتيجة لفكر استقرائي خاضع لما يجري الآن، وهنا فإنه من غير الحكمة إعطاء نتائج هذا التفكير أبعادا متجاوزة للآن وهنا. يجادل هيوم هنا الفكر المثالي الذي يقدم دعاوى أنه وصل لمعرفة نهائية ضرورية صالحة لكل زمان ومكان. هذه الدعاوى لا أساس لها ما دام منطق التفكير الإنساني قائم على التجربة والخبرة والتي هي بطابعها مشروطة وكل التعميمات الناتجة عنها خاضعة بالضرورة لتلك المشروطية.
9:30 دقيقه
هيوم و«المعرفة المتهمة حتى تثبت براءتها»
https://aawsat.com/home/article/61456



هيوم و«المعرفة المتهمة حتى تثبت براءتها»

ديفيد هيوم

هيوم و«المعرفة المتهمة حتى تثبت براءتها»

ديفيد هيوم
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة