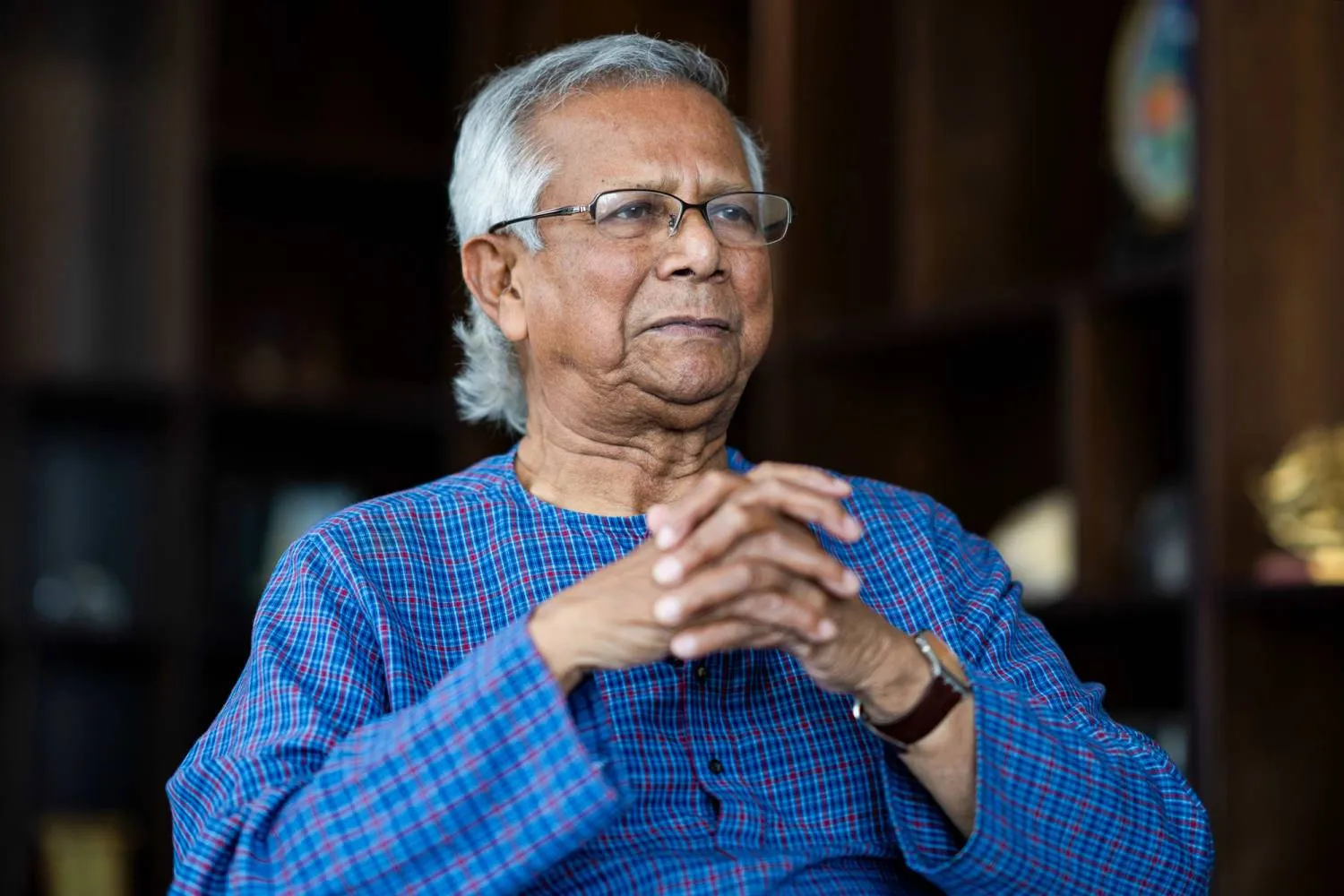رُفع العلم الفلسطيني أخيرًا أمام منظمة الأمم المتحدة في الذكرى السنوية السبعين لتأسيسها، بحضور الرئيس محمود عباس (أبو مازن). وكانت لهذه الخطوة رمزيتها الكبيرة، لا سيما أنه أتيح لعباس أيضًا أن يتطرّق في كلمته أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية إلى المصاعب التي تعترض سبيل قيام الدولة الفلسطينية السيدة المستقلة، في ظل مواصلة اليمين الإسرائيلي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء مفاعيل «اتفاق أوسلو»، ونسف أي إمكانية لتحقيق ما هدف إليه. ومعلوم أن نتنياهو، الذي تعتمد حكومته الائتلافية على دعم غلاة المستوطنين والجماعات التوراتية والتوسعية المتطرفة، لم يؤمن يومًا بمبدأ «الأرض مقابل السلام»، وهو يغض الطرف حاليًا عن انتهاكات المتطرفين للمسجد الأقصى، وتهديداتهم المعلنة بهدمه.
«لقد قلت لإسحق (رابين)، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إنه في حال كان متمسكا فعلا بالسلام فعليه أن يصافح (ياسر) عرفات (الرئيس الفلسطيني الراحل) لإثبات ذلك (...) تنهّد رابين وقال بصوته المتعب: (إننا لا نبرم اتفاقيات السلام مع أصدقائنا)، فسألته: (ستصافحه إذن؟)، فرد بلهجة جافة: (حسنًا، حسنًا، ولكن من دون عناق)».. هذا ما قاله الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في مذكّراته حول المصافحة التاريخية بين الرجلين في عام 1993. وأضاف كلينتون: «تحوّلت باتجاه إسحق رابين الواقف على يميني وصافحته بشدة ثم أمسكت بيد عرفات الواقف مبتسما إلى يساري، فانحنى قليلا في تلك اللحظة وتابع حركته مادًا يده بتردّد واضح باتجاه رابين. وبعد لحظات قصيرة من التردد أمسك رابين بيد عرفات الممدودة لمصافحته».
اليوم بعد مرور 23 سنة على المصافحة الباردة يتضح أن هذا التردد من «ثعلبي» السياسة «الفلسطينية» و«الإسرائيلية» كان له ما يبرره، إذ ظل الاتفاق الذي تصافحا معلنين ولادته للعالم، أي «اتفاق أوسلو»، مثل خنجر بلعه الطرفان، لم يجلب الأمن للإسرائيليين ولم يجلب الدولة للفلسطينيين.
كان يفترض أن يكون «اتفاق أوسلو» مؤقتا ينتهي بإقامة دولة فلسطينية بعد 5 سنوات من توقيعه، أي في عام 1998. لكن الاتفاق الأم بقي حيًا يقاوم الموت، وجرّ خلفه اتفاقات عديدة يراها غالبية الفلسطينيين مشؤومة وتكبل أيديهم، من دون أن تقربهم قيد أنملة من دولتهم المنشودة.
فما هو «اتفاق أوسلو»؟
إنه «اتفاق إعلان المبادئ - حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية»، وتم توقيعه في 1993/9/13. ولقد نص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل من الضفة الغربية وقطاع غزة وإنشاء «سلطة حكم ذاتي فلسطينية مؤقتة» لمرحلة انتقالية تستغرق خمس سنوات، على أن تُتوج بتسوية دائمة بناء على القرار رقم 242 والقرار رقم 338.
كذلك تحدث الاتفاق عن وضع «حد لعقود من المواجهة والنزاع»، وعن اعتراف كل جانب «بالحقوق الشرعية والسياسية المتبادلة» للجانب الآخر.
وجاء في النصّ: «من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم نفسه وفقا لمبادئ ديمقراطية، ستجرى انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس تحت إشراف متفق عليه ومراقبة دولية متفق عليها، بينما تقوم الشرطة الفلسطينية بتأمين النظام العام. وسيتم عقد اتفاق حول الصيغة المحددة للانتخابات وشروطها وفقا للبروتوكول المرفق كملحق؛ بهدف إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، على أن تشكل هذه الانتخابات خطوة تمهيدية انتقالية مهمة نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة».
أما عن الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم، فتم الاتفاق على:
أ - تبدأ فترة السنوات الخمس الانتقالية عند الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا.
ب - سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن، ولكن بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.
ت - من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، واللاجئون، والمستوطنات، والترتيبات الأمنية، والحدود، والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين، ومسائل أخرى ذات اهتمام مشترك. وفي بنود لاحقة جاء أنه سيراجع الطرفان بشكل مشترك القوانين والأوامر العسكرية السارية المفعول في المجالات المتبقية.
وتمخض الاتفاق، كذلك، عن تشكيل لجنة الارتباط المشتركة الإسرائيلية - الفلسطينية من أجل معالجة القضايا التي تتطلب التنسيق وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، والمُنازعات. وتطرق الاتفاق إلى التعاون الإسرائيلي - الفلسطيني في المجالات الاقتصادية كذلك.
ويتضح من النص أنه كان اتفاقا سياسيا وأمنيا واقتصاديا وينظم العلاقة بين الطرفين. ولكن ما الذي طُبّق منه على الأرض؟
بعد سنوات قليلة فقط توقفت إسرائيل عن استكمال عملية انسحاب قواتها المقررة من المناطق، وبدلا من ذلك زادت من نشاطاتها الاستيطانية في كل مكان، بل واستباحت المناطق المصنفة «أ» وهي الأراضي الواقعة تحت الولاية الأمنية الفلسطينية الكاملة.
وخلال السنوات اللاحقة رفضت إسرائيل مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية التي تتحكّم بقدرة الاقتصاد الفلسطيني على التطوّر والاستقلال، واتخذت إسرائيل إجراءات أدّت إلى تعطيل المرحلة الانتقالية الهادفة إلى تحقيق الاستقلال.
لكن مسألة واحدة لم تخلّ بها إسرائيل أبدا، هي النقطة الأمنية، إذ استمرت في التنسيق الأمني مع السلطة. وهذا الوضع الذي يرفضه كثيرون من الفلسطينيين وضع الاتفاق محلّ جدل كبير. ويرى قسم من الفلسطينيين أن الاتفاق كان شرًا لا بد منه، ويصفه آخرون بـ«الخياني» و«المشؤوم».
إسرائيل تمسّكت بما يحلو لها من الاتفاق، وحاولت السلطة الفلسطينية تطبيقه بالكامل، بينما عملت مجموعات مثل «حماس» و«الجهاد» على إسقاطه بالقوة، لكنه ظل يحاصر الجميع. ولكن اليوم فقط وصل الفلسطينيون إلى قناعة تامة بأنهم تأخروا كثيرًا في لفظه.
لكن لماذا يريد الفلسطينيون الآن التخلص من «أوسلو»؟
صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يمكن استمرار الوضع الراهن أبدا. وأضاف: «إسرائيل تريد السلطة من دون سلطة، وتريد احتلالا من دون تكلفة، وتريد أن تجعل غزة خارج الفضاء الفلسطيني. نحن نقول إن السلطة ولدت لنقل الفلسطينيين من الاحتلال إلى الاستقلال ولن تكون لها وظيفة ثانية. وإذا اعتقد البعض أنه سيحول وظيفة السلطة إلى تنسيق مالي وأمني فهو مخطئ. السلطة مهمتها أن تنقل الشعب الفلسطيني إلى الاستقلال، فإما تكون هكذا وإما لا تكون».
وكان عريقات قد كتب دراسة قبل 3 سنوات وقدّمها للقيادة، وجاء فيها: «إن هذه السلطة ولدت لنقل الشعب الفلسطيني إلى الاستقلال. نتنياهو يحاول تغيير وظيفة السلطة. السلطة لن تستطيع الصمود، ستنهار. لدينا بدائل. اللجنة التنفيذية هي الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين، والمطلوب عمله في انتخابات مستقبلية هو انتخاب برلمان دولة فلسطين وقيام دولة فلسطين، وعلينا أن نكرّس الدولة، ولكن هذا يتطلب تطبيق المصالحة قبل أي عمل آخر، وتعزيز عمقنا العربي».
ويمكن القول إنه بعد كل هذه السنين تبنّى عباس الفكرة.
عباس قال في خطابه أمام الأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي بشكل واضح: «ما دامت إسرائيل مصرّة على عدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة معنا، التي تحولنا إلى سلطة شكلية من دون سلطات حقيقية، وما دامت إسرائيل ترفض وقف الاستيطان والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى وفق الاتفاقات معها، فإنها لا تترك لنا خيارا، سوى التأكيد على أننا لن نبقى الوحيدين الملتزمين في تنفيذ تلك الاتفاقيات، بينما تستمر إسرائيل في خرقها. وعليه فإننا نعلن أنه لا يمكننا الاستمرار في الالتزام بهذه الاتفاقيات، وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتلال، لأن الوضع القائم لا يمكن استمراره. وأذكّركم بقرار الجمعية العامة 19/67 لعام 2012، الذي أكد أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستكون الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين، وأن المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان دولة فلسطين. مرة أخرى، إن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار».
كان الخطاب في نيويورك لكن الصدى كان في إسرائيل بطبيعة الحال.
وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تطبّق من «اتفاق أوسلو» شيئا، فإن بندا واحدا في الاتفاق وهو (التنسيق الأمني) جعلها تهدّد وتوعد. إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون: «لا أظنهم قادرين على وقف التنسيق الأمني، فلولا جيشنا في الضفة الغربية لانهارت السلطة».
ولم يتوقف التنسيق الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين مطلقا منذ «أوسلو»، لأن كلا الطرفين يعتقد أنه يشكل مصلحة عليا. والتنسيق الأمني يعني عمليًا التعاون بين أجهزة الأمن الفلسطينية والإسرائيلية لإحباط أي أعمال «عنف» في المنطقة. ويوازي هذا التنسيق تنسيق آخر مدني يعنى بشؤون السكان الفلسطينيين من تصاريح عمل وتحويلات طبية ولمّ شمل وتجديد وثائق.
وبسبب الخوف من وقف إسرائيل كل أشكال التعاون، بما في ذلك قطع الأموال وإغلاق الحدود، ووقف توريدات السولار والكهرباء للفلسطينيين، تبدو فكرة إلغاء «أوسلو» أو ما تبقى منه مرعبة لكثيرين.
وحول هذه النقطة قال جوناثان رينولد، من مركز «بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية» الإسرائيلي: «اتخاذ خطوة كإنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل قد يؤدي إلى فوضى في الضفة الغربية. وهناك أيضًا خطر أن يدفع ذلك إسرائيل إلى زيادة وجودها في الضفة الغربية، على الرغم من أن البعض يشك في استعدادها لتخصيص الأموال والقوى البشرية الضرورية لذلك».
جدير بالذكر أنه منذ 3 سنوات، على الأقل، تريد القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني، لكن من دون أن تتخذ قرارا. وما زال الجدل في محيط عباس قائما حتى بعد إلقائه الخطاب في الأمم المتحدة. إذ قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور نبيل شعث إنه «من الصعب على السلطة إلغاء اتفاق أوسلو بالكامل، لأن هناك الكثير من العلاقات المتشابكة والمترابطة التي تحتاج إلى تفكيك». وأضاف: «نحن الآن مرتبطون بالاقتصاد الإسرائيلي والكهرباء والماء والطاقة، ولنتمكن من تفكيك هذه العلاقة نحن بحاجة لخطة عمل».
وتابع الدكتور شعث، في حديث مع «راديو أجيال» المحلي في رام الله، أن «إسرائيل تنفذ اتفاق أوسلو بشكل انتقائي، وأنه على السلطة العمل بالطريقة ذاتها»، موضحا: «لا يوجد شيء اسمه حل السلطة، وإن السلطة تدريجيا ستغير استراتيجيتها وطريقتها في العمل، وستصبح سلطة مقاومة وليست سلطة منفذة لـ(أوسلو) فقط».
لكن محمود الهبّاش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأحد المقربين منه، ذكر أن «الجانب الفلسطيني لا يتحدث عن إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وفق (أوسلو)، وإنما يطالب بتنفيذ متبادل لها».
أما واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فقال إن خطوات مهمة كبيرة ستتخذ في القريب العاجل، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «أهم الخطوات التي سيعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس كرئيس لدولة فلسطين، تنفيذا لخطابه في الأمم المتحدة، هي إعلان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كحكومة مؤقتة للدولة الفلسطينية المحتلة، على أن يصبح المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان الدولة». وأكد أبو يوسف، أن هذا ما يعنيه «إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال».
لكن أبو يوسف أوضح أن هذه القرارات لن تتخذ فورا، لكنها لن تتأخر إذا لم يستجب العالم لخطاب عباس. وأوضح أن «اتخاذ هذه الخطوات يعني بالضرورة انتهاء دور السلطة والإعلان عن الانتقال إلى دولة محتلة تقودها منظمة التحرير، تمهيدا لخطوات لاحقة». ثم شدد على أن الاتصالات بدأت مع الفصائل الفلسطينية بما فيها «حماس» و«الجهاد» لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام للنقاش واتخاذ قرارات حاسمة بهذا الصدد.
وكان عباس أعلن في خطابه في الأمم المتحدة أنه لن يلتزم بالاتفاقات مع إسرائيل إذا لم تلتزم هي. وحول هذا الجانب قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» شارحةً: «إن التحلل من الاتفاقات سيبدأ واحدا تلو الآخر وصولا إلى مواجهة سياسية شاملة تتوقعها السلطة ستؤدي في النهاية إلى انهيارها». وبحسب المصادر: «لا يوجد قرار بحل السلطة، وإنما إذا انهارت فستعلن السلطة أنها فشلت في نقل للشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، وستعلن دولة تحت الاحتلال تقودها المنظمة».
ولا يمكن للفلسطينيين الاحتفاظ بالسلطة في ظل إعلان الدولة، وذلك لأن السلطة «المؤقتة» إنما وُجدت لإقامة الدولة «الدائمة». وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، عقد الفلسطينيون اتفاقات أخرى مع إسرائيل يمكن وصفها بملاحق «أوسلو» أو «أولاد وبنات الاتفاق الأم».
* أبرز الاتفاقات الأخرى
* «اتفاق غزة – أريحا» (1994): أطلق عليه اسم «الاتفاق التنفيذي لأوسلو» الذي وُقع في 4 مايو (أيار) 1994، وتضمن الخطوة الأولى لانسحاب إسرائيل من غزة وأريحا وتشكيل السلطة الفلسطينية وأجهزتها، وأتبع باتفاقين تنفيذيين:
* «اتفاق باريس الاقتصادي» (يوليو/ تموز، 1994): ينظم العمالة الفلسطينية والعلاقات المالية والاقتصادية بين الطرفين.
* «اتفاقية طابا أو أوسلو الثانية» (1995): وعُرفت بـ«اتفاقية المرحلة الثانية من انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية»، إذ تعهدت إسرائيل بالانسحاب من 6 مدن عربية رئيسية و400 قرية في بداية عام 1996، وانتخاب 82 عضوا للمجلس التشريعي، والإفراج عن معتقلين في السجون الإسرائيلية.
وقسّمت «اتفاقية طابا» المناطق الفلسطينية إلى «أ» و«ب» و«ج» لتحديد مناطق حكم السلطة والمناطق الخاضعة لإسرائيل وغير ذلك.
* «اتفاق واي ريفر الأول» (1998): وينص الاتفاق على مبدأ «الأرض مقابل الأمن»، وأن إسرائيل ستنفذ مرحلة جديدة من إعادة الانتشار في 13 في المائة من الضفة الغربية مقابل قيام السلطة الفلسطينية بتكثيف حملتها ضد «العنف».
* «اتفاق واي ريفر الثاني» (1999): وقع في منتجع شرم الشيخ المصري في 4 سبتمبر (أيلول) 1999، وتم فيه تعديل وتوضيح بعض نقاط «اتفاق واي ريفر الأول»، مثل إعادة الانتشار وإطلاق السجناء والممرّ الآمن وميناء غزة والترتيبات الأمنية وغير ذلك.
* ثم جاءت «خريطة الطريق»: وهي عبارة عن خطة سلام أعدتها عام 2002 اللجنة الرباعية التي تضمّ كلا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا. وتركّز هذه الخريطة على نقاط من بينها إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية.. وعلى أن تتم التسوية النهائية بحلول عام 2005.
* «اتفاق أنابوليس» (2007): عقد الرئيس الأميركي جورج بوش الابن في الولاية الثانية من رئاسته مؤتمرا في القاعدة البحرية بمدينة أنابوليس، عاصمة ولاية ميريلاند الأميركية، في محاولة لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وصدر عن المؤتمر بيان مشترك بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، دعا إلى الانخراط في مفاوضات يكون هدفها التوصل إلى اتفاق سلام كامل بحلول نهاية 2008.
* في 2010: أطلق الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما، في 2 سبتمبر، محادثات مباشرة في البيت الأبيض جمعت بين محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن انتهاء العمل في إسرائيل بالتجميد الجزئي للاستيطان في 26 سبتمبر أدى إلى انهيار المفاوضات.
* في 2011: رفض نتنياهو دعوة أوباما إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 تضم الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
* في 2012: أجرى المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون جولات مفاوضات جديدة من دون نتيجة.
* في 2013: أطلق وزير الخارجية الأميركي جون كيري مفاوضات (9 شهور) لإعلان اتفاق سلام، لكنها انهارت بعد اللقاء الخامس. ولم تتجدد المفاوضات.
لم يلتزم الإسرائيليون بأي اتفاق عقدوه، لا سياسي ولا اقتصادي ولا على الأرض. ولم ينسحبوا من الضفة، ولم يسلموا المناطق، ولم يسمحوا بإقامة الدولة، ورفضوا أي تطوير حتى على الاتفاق الاقتصادي، فقط التزموا بالتنسيق الأمني.
ولا يخفي مسؤولون فلسطينيون أنهم يفهمون أن إسرائيل أرادت منذ البداية «شرطيًا» على حدودها، لكنهم يقولون إنهم ليس بينهم «لحد» - في إشارة إلى أنطوان لحد قائد ميليشيا «جيش لبنان الجنوبي» العميلة لإسرائيل في جنوب لبنان - وإن دولة كل الفلسطينيين ستقوم في نهاية الأمر، على الرغم ممّا يعتقده «المارّون بين الكلمات العابرة».