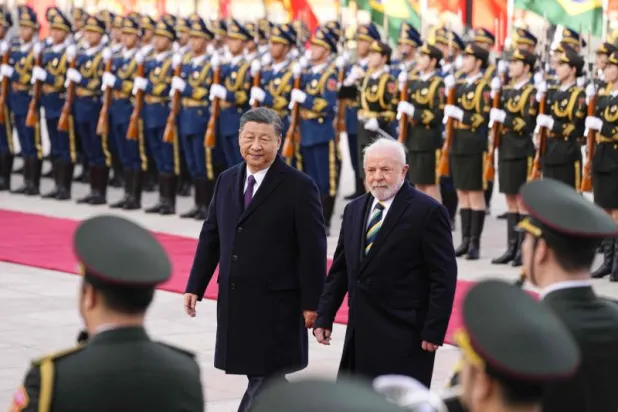منذ أيام يسيل حبر غزير في التحليلات والتعليقات حول «محاولة الانقلاب» الفاشلة في البرازيل، التي نفذتها مجموعات يمينية متطرفة مناصرة للرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو. وقد أسفرت «المحاولة» عن دمار واسع في المقرات الرئيسية للسلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، في العاصمة برازيليا، التي صممها المهندس الشهير، أوسكار نيماير، وسط منطقة غير مأهولة، مطالع ستينات القرن الماضي. لكن تبيّن، أخيراً، في اعترافات الموقوفين الذين يجري التحقيق معهم منذ أيام، أنه، إبان عملية الاقتحام التي وقعت (على ما يبدو) بتواطؤ من الجيش وتغاضي الشرطة، كان المقتحمون يردّدون «أناشيد دينية»، وهم يحطمون كل ما طالته أيديهم من أعمال فنية وأثاث، هاتفين: «الله فوق كل شيء». وهو الشعار الذي كان يرفعه بولسونارو في المهرجانات الانتخابية التي نظمها أنصاره من أتباع كنائس الإيفانجيليين (أو «البروتستانت - الإنجيليين الجدد»). من هنا، تستحيل دراسة الحركة اليمينية المتطرفة التي جاء بها بولسونارو، المطرود أصلاً من الجيش بسبب ميوله الانقلابية، من دون التوقف عند الدعم الذي وفرته له الكنائس الإيفانجيلية المتطرفة، التي حشدت له ملايين المؤيدين لانتخابه رئيساً للجمهورية... وقائداً لحملة صليبية اختاره الله لمحاربة «اتفيد آخر الإحصاءات بأن أتباع الكنائس الإيفانجيلية يزيدون اليوم على 30 في المائة من سكان البرازيل، التي كانت، حتى أواخر القرن الماضي، تُعدّ خزّان «الكثلكة» في العالم. وتفيد أيضاً بأن عدد دور العبادة التابعة لها يزيد على 178 ألفاً، ويتردد عليها 70 مليوناً من البرازيليين الذين صوّت غالبيتهم الساحقة لبولسونارو، وهم ينصاعون بصورة عمياء لتوجيهات القساوسة الذين يتمتعون بنفوذ واسع، وبين هؤلاء عدد من كبار الأثرياء في البرازيل والعالم.
كان لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (لولا)، الرئيس العائد، يدرك هذا الواقع، منذ أن قرر خوض المعركة الرئاسية ضد بولسونارو، كما أنه كان يدرك جيداً أن المتدينين المسيحيين، بمن فيهم بعض أتباع الكنيسة الكاثوليكية الذين كانوا يؤيدونه في السابق، قد جنحوا نحو اليمين المتطرف، بعدما اقتنعت غالبيتهم بإحدى الرسائل الأساسية في برنامج اليمين الانتخابي، وهي أنه، في حال فوز مرشح «الشيوعيين» (أي «لولا») سيبادر إلى إقفال دور العبادة، ويرفع جميع القيود المفروضة على الإجهاض، ويفتح الباب على مصراعيه أمام زواج المثليين.
وبعدما تيقّن «لولا» من أن الفوز لن يُكتَب له في الانتخابات من دون دعم بعض الكنائس الإيفانجيلية غير المتعصبة لبولسونارو، نشط في التواصل معها لكسب بعض الأصوات التي ساعدته على الفوز بفارق لا يزيد على مليوني صوت. وليس معروفاً بعد عدد الأصوات التي استطاع «لولا» أن يستميلها من هذه الجماعات، وما الحجج والوسائل التي استخدمها لذلك. لكن ما لا شك فيه أنه عقد «صفقة» مع بعض هذه الجماعات، كما يُستدلّ من القرار الذي اتخذه بعد أيام من فوزه، بتعيين القس الإنجيلي باولو مارسيلو شالنبيرغير عضواً في حكومته، مكلّفاً من مكتبه في القصر الرئاسي، باستقطاب أتباع الكنائس الإيفانجيلية الصغيرة، وهي كثيرة، التي ليست مرتبطة بالطوائف الكبيرة المؤيدة للرئيس السابق.
استنساخ تجربة ترمب
جدير بالذكر أن الكنيسة الكاثوليكية، التي كان أتباعها يشكلون 85 في المائة من المسيحيين في البرازيل، كانت دائماً أقرب إلى الطبقات الفقيرة والأحزاب التقدمية عندما كانت الأبرشيات (الأسقفيات) البرازيلية من المراكز الرئيسية لحركة «لاهوت التحرر» في ستينات وسبعينات القرن الماضي. لكن مع مرور الوقت، والحصار الذي تعرّضت له هذه الحركة من «الفاتيكان» والجناح المحافظ، راحت الكنيسة الكاثوليكية البرازيلية تجنح نحو الطبقة البورجوازية في المدن الغنية، بينما أخذت الكنائس الإيفانجيلية توسّع دوائر انتشارها بين ملايين الفقراء الذين يعيشون في أرباض هذه المدن.
وتفيد صحيفة «أو غلوبو» بأن عدد المعابد الإيفانجيلية التي لا ينتمي أتباعها إلى أي من الطوائف الكبرى، يزيد على 75 ألفاً. وهي التي وضعها «لولا» ضمن استراتيجيته لملء الفراغ الذي تركته الكنيسة الكاثوليكية، بعدما صارت أقرب إلى الخط اليميني المحافظ الذي يقوده بولسونارو.
وراهناً، يعترف المقربون من «لولا» بأن هذا الموضوع يشكّل أحد المحاور الأساسية بين اهتمامات الرئيس الجديد، وأنه يستدعي نشاطاً دؤوباً طويل الأمد لن يعقد ثماره قبل سنوات كثيرة. ويتفق المراقبون على أنه، بعد سنتين بالضبط من اقتحام أتباع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مبنى «الكابيتول» في واشنطن (عاصمة الدولة التي تعدّ نفسها زعيمة العالم الحر)، ليس من باب المصادفة أن يتكرر المشهد ذاته في برازيليا مع أتباع بولسونارو على بُعد 6 آلاف كيلومتر من واشنطن. ذلك أنه، منذ انتخاب بولسونارو رئيساً عام 2018، دأب هذا الأخير على تقمّص شخصية ترمب، مكرراً أمام أنصاره أنه «الناطق الحقيقي» باسم الشعب. ومثله أيضاً عمد خلال السنوات الأخيرة إلى إقناع اتباعه بألا يثقوا في نتائج الانتخابات إذا أسفرت عن فوز خصومه، لأن «النظام الانتخابي فاسد».
هذا المشهد كان يقلق المحللين والمراقبين السياسيين قبل الانتخابات الرئاسية التي أُجريَت أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكانوا يحذّرون من أنه في حال فوز بولسونارو بولاية ثانية سيُتاح له مجال واسع لتقويض منظومة المراقبة والمحاسبة على مؤسسات الحكومة وأدائها. بل حتى في حال خسارته أمام خصمه اللدود (لولا) سيبقى هذا الخطر سيفاً مسلطاً على النظام، ربما أكثر منه بوجوده في منصب الرئاسة، وذلك نظراً لرسوخ شعبيته بين أنصاره الذين يشكلون نصف الناخبين تقريباً، ثم إن هؤلاء أظهروا استعدادهم غير المشروط لاستخدام العنف من أجل عرقلة عملية تسليم السلطة إلى «لولا»، وحتى لاستدعاء الجيش من أجل «إنقاذ البلاد» من الحكم الجديد... وثمّة معلومات تحدثت عن أن انقلاباً عسكرياً كان بين الاحتمالات الواردة.
موقف القوات المسلحة
وعلى غرار ما حصل مع ترمب، خسر بولسونارو الانتخابات بفارق ضئيل، بينما كانت القيادات العليا في القوات المسلحة التي أغدق عليها المزايا وامتدحها طوال ولايته، تنأى عن مواقفه وتصريحاته المتطرفة، وتؤكد أنها ضد أي لجوء إلى الحل العسكري.
أيضاً قرر بعض الحلفاء الأساسيين السابقين لبولسونارو، مثل تارشيزيو دي فريتا، الحاكم الجديد لولاية ساو باولو، التخلي عنه، ورفض السير وراءه في المغامرة التي كان يعدّ لها، وهكذا وجد نفسه مضطراً للتراجع، وطلب من أتباعه ومساعديه التعاون لنقل السلطة إلى الرئيس الجديد. ولكن خلال فترة الشهرين التي انقضت منذ انتخاب «لولا» حتى تسلُّمه السلطة (مطلع الشهر الحالي) وقعت سلسلة من الأحداث التي أطلقت صفارات الإنذار مجدداً في الأوساط السياسية:
- رفض بولسونارو الاعتراف بشرعية هزيمته في صناديق الاقتراع.
- تكرار بولسونارو مزاعمه بأن الشعب لم ينتخب «لولا»، بل المحكمة العليا الانتخابية هي التي أوصلته إلى السلطة «بمؤامرة» شاركت فيها بعض مراكز الثقل الاقتصادي ووسائل الإعلام الكبرى.
- خروج أنصار بولسونارو بأعداد كبيرة في مظاهرات واعتصامات، اتسم بعضها بعنف شديد، أمام الثكنات العسكرية في جميع أنحاء البرازيل، مطالبين الجيش بالتدخل.
- قبل يومين من تسلّم «لولا» مقاليد السلطة، مطلع هذا الشهر، كان بولسونارو يغادر البرازيل في الطائرة الرئاسية مع مجموعة من مساعديه إلى الولايات المتحدة، حيث كان قد استأجر منزلاً بالقرب من «منتجع ديزني» في أورلاندو، وذلك خشية إحالته إلى المحاكمة، بسبب المخالفات التي ارتكبها خلال ولايته، بعدما سقطت عنه الحصانة القضائية.
اليوم ثمة مَن يرى، في محيط «لولا»، أن النسخة الاستوائية من أحداث اقتحام «الكابيتول» في واشنطن قد تشكّل فرصة كبيرة أمام الرئيس اليساري العائد لتوسيع دائرة تحالفاته وشعبيته، وبالتالي سلطته، لمحاصرة «الحركة البولسونارية».
للعلم، كان «لولا»، في مسعاه لتحاشي المواجهة الصدامية مع القوات المسلحة التي كانت تجاهر بدعمها لبولسونارو، قد عيّن في منصب وزير الدفاع جوزيه موشيو، الذي يُعتبر من المؤيدين المعتدلين للرئيس السابق، إلا أن موشيو لم يتردّد في وصف الاعتصامات المطالبة بتدخل الجيش أمام الثكنات العسكرية بأنها «مظاهرات ديمقراطية»، بينما كان قادة أسلحة البر والبحر والجو يغيّرون مواقيت بدلهم كي لا يُضطروا لأداء يمين الولاء أمام الرئيس الجديد.
وعندما طالب المقرّبون من «لولا» بإقالة وزير الدفاع، بسبب تخلفه عن القيام بواجباته الأمنية لمنع عملية الاقتحام وردعها، مع أن أجهزة الاستخبارات كانت قد حذرت من وقوعها، ردّ بالقول: «إذا قررتُ إقالة وزير كلما ارتكب هفوة، لن تنتهي سلسلة التناوب على الحقائب في الحكومة. ولذا يبقى في منصبه».
فشل التعامل الحذر
غير أن خيار الحذر الذي اعتمده «لولا» في التعاطي مع الذين يؤيدون الانقلاب العسكري، لم يعد يستقيم بعد الأحداث الأخيرة. ولقد قال في تعليقاته الأولى عليها إنه ما عاد يثق بكثير من أفراد القوات المسلحة التي اتهمها صراحة بالتواطؤ مع المقتحمين الذين أظهرت الاستطلاعات الأخيرة أن 90 في المائة من البرازيليين يرفضون سلوكياتهم. وعند إعلانه عن تسليم السلطات الفيدرالية مهام الحفاظ على الأمن في العاصمة، ألقى «لولا» بالمسؤولية على عاتق بولسونارو. وقال عنه إنه «هو الذي حرّض، وما زال يحرّض، أنصاره والجيش، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هو المسؤول الرئيسي، إلى جانب الأحزاب التي تؤيده، والتحقيقات ستكشف ذلك سريعاً».
من ناحية أخرى، كان عدد من القيادات السياسية البارزة المؤيدة لبولسونارو، مثل رئيس مجلس النواب، آرثر ليرا، قد أدانوا عملية الاقتحام، وأيدوا القرارات التي اتخذها «لولا»؛ إذ دعا ليرا إلى اجتماع مع الرئيس الجديد يضمّ رؤساء مجلسي الشيوخ والنواب والمحكمة العليا، بهدف «التأكيد على أن السلطات الثلاث متحدة لدعم النظام الديمقراطي»، بينما كان عدد كبير من حكام الولايات الموالين لبولسونارو يعربون عن تضامنهم مع «لولا»، ورفضهم عملية الاقتحام.
بناءً عليه، يتبدّى من قراءة هذا المشهد أن «لولا» بات عملياً «يحتكر» الديمقراطية في البرازيل، لا سيما بعدما صار الاصطفاف بجانب بولسونارو «وصمة» سياسية تثير الشكوك... وبعدما غدا خصوم الرئيس اليساري العائد يمتدحون مبادرته السريعة والحازمة للدفاع عن المؤسسات، ويلطّفون انتقاداتهم له كي لا يُحسبوا في عداد الانقلابيين، وهذا بينما أمرت القيادات العسكرية بالتفريق الفوري للاعتصامات أمام الثكنات. وإذا استطاع «لولا» اقتناص هذه الظروف، يتوقع متابعون أنه سيتمكن من توسيع دائرة نفوذه، وتضييق الخناق على الجماعات المتطرفة المؤيدة لبولسونارو، الأمر الذي سيوفّر له الشرعية السياسية اللازمة لاتخاذ تدابير ضد «الحركة البولسونارية»، مثل زيادة الإنفاق الاجتماعي العام، ومعاقبة الشركات التي تستغل مناجم الذهب وغابة الأمازون بصورة غير شرعية. وأيضاً، لم يعد مستبعداً أن الاحتجاجات التي قام بها أنصار بولسونارو، وهدفت إلى ضرب قدرة «لولا» على الحكم وتنفيذ برنامجه الإصلاحي، قد تشكّل في نهاية المطاف ضربة قاضية على صدقية الرئيس السابق، حتى بين حلفائه. لكن تقييم الخطر الذي يشكله زعماء التيارات الشعبوية، مثل جايير بولسونارو ودونالد ترمب، بكل أبعاده، لا يمكن أن يقتصر على شخصية الفرد الحاكم في السلطة، القادر على التعبئة الواسعة ضد النظام القائم ومـؤسسات الشرعية، بل يتوجب مقاربته انطلاقاً من التحليل العميق للحركات الشعبوية التي تتنامى وتترسخ في كثير من النظم الديمقراطية منذ سنوات.
فالشعبويون يصرون دائماً في خطابهم على أنهم يمثلون الإرادة الحقيقية للشعب. ومن هذا المنطلق يعتبرون أن ذلك يمنحهم الحق في رفض نتائج أي انتخابات لا تأتي لصالحهم؛ إذ من المستحيل (في رأيهم) أن ينهزم صوت الشعب في صناديق الاقتراع. وإذا حصل وانهزم هذا الصوت، يعتبرون أن المؤسسات الانتخابية هي التي زوّرت النتائج.
هل تصمد الأنظمة الديمقراطية أمام التيارات الشعبوية؟
> شهد العالم خلال السنوات الأخيرة تطورات تبعث على الاطمئنان حول قدرة الأنظمة الديمقراطية على مقاومة الصعود الشعبوي؛ إذ منع الناخبون زعماء شعبويين من تجديد ولاياتهم، كما حصل في الولايات المتحدة والبرازيل، لا سيما أن الشعبويين عادة يترسخون لفترة طويلة في السلطة، على غرار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
إلا أن العبرة الرئيسية التي يجب استخلاصها من تاريخ الظاهرة الشعبوية الحديثة، ليس فحسب في الولايات المتحدة والبرازيل، بل أيضاً في بلدان مختلفة عن بعضها، مثل إيطاليا وتايلاند والأرجنتين، هي تمكُّن الشعبويين من الحفاظ على مواقع بارزة لهم في النظام السياسي، حتى بعد هزيمتهم في الانتخابات، والسبب أن الزعيم الشعبوي يحافظ (حتى في أصعب الظروف) على ولاء قاعدة وطيدة من المؤيدين. وما إن يعجز الخصم السياسي عن الوفاء بوعوده الانتخابية أو يواجه أزمة اقتصادية أو فضيحة كبيرة، حتى يكون الزعيم الشعبوي جاهزاً للعودة إلى السلطة.
من هذا المنطلق، يشكّل التمرد الشعبي الذي شهدته البرازيل أخيراً، رغم أنه اقتصر على بضعة آلاف من الأشخاص، مؤشراً مثيراً للقلق حول ما يمكن أن يحصل في أي انتخابات مقبلة؛ إذ إن البرازيل ما زالت في حالة انقسام سياسي واجتماعي عميق. وإذا ما ارتكبت حكومة «لولا» أخطاءً فادحة، أو تعرّضت لفضيحة فساد كبرى، كما حصل في السابق على عهد ديلما روسيف (التي خلفته في المنصب وزعامة تحالفه اليساري)، فإن جايير بولسونارو قد يعود ظافراً من فلوريدا. وحتى في حال فقدان بولسونارو ثقة أنصاره ودعمهم، فسيظهر زعيم شعبوي آخر يستغل مواطن الضعف التي تركها هو في النظام السياسي، ويصعد بالتالي من خلالها إلى السلطة.
لذا يرى معلقون أنه لا بد أن يستهدف «العلاج» أصل الداء الشعبوي بذاته، وليس أعراضه الخارجية فقط، لأن الحركات الشعبوية ليست في جوهرها سوى انعكاس لمرض أعمق بكثير من ظواهرها.