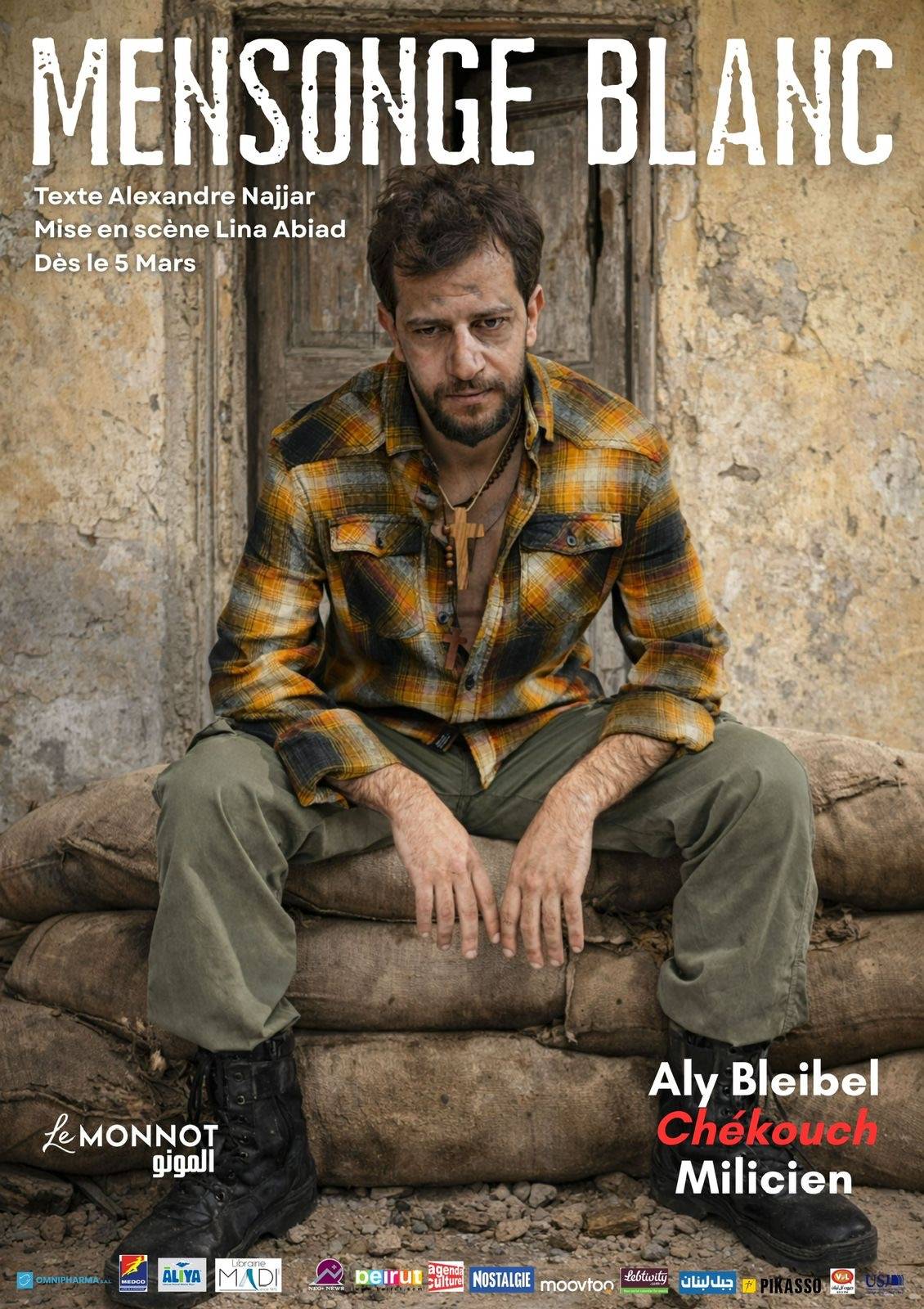في كل الثقافات العالمية وآدابها تظهر تقيمات للأدباء الموتى والأحياء، لا سيما بعد الموت، وبتشديد أكثر عندما تكون هناك فترات مظلمة في حياة الشاعر المعروف، أو الكاتب الشهير. نحن نعرف أن الأكاديميات والصحف الرئيسية، لا سيما التي تُصدر ملاحق كبرى، مثل ملحق «التايمز»، تعيد تقييم الأسماء الأدبية ونصوصها، من حين إلى آخر، ولا مشكلة. جامعة أوكسفورد، مثلاً، أعادت طبع مسرحيات شهيرة لشكسبير وأضافت اسم كريستوفر مارلو، بعد أن وصل البحث العلمي إلى مصاف اليقين بعدم أصالة شكسبير في كتابة بعض المسرحيات المنسوبة له، فأضيف اسم «مارلو» إلى جانب اسم شكسبير. وكذلك فعلوا مع كتاب «أوفيد في المنفى»؛ فالدراسات الأخيرة ترفض فكرة نفي الشاعر الشهيرة، ولم يظهر من يهدد أو يقاضي أو «يسخر» ممن أنجز هذه الدراسات العظيمة.
في ألمانيا كذلك، وحتى بعد أكثر من خمس وسبعين سنة، تعكف مؤسسة الأرشيف الألماني على التدقيق في الأرشيف الأدبي للكتاب الألمان المعاصرين لهتلر، فإذا ما وجدوا ما يشير إلى «النازية» يوصون في الحال بحجب الكتاب عن التداول، ويُرفع من التداول في المكتبات. وكلنا يتذكر الضجة التي أثارها تصريح غونتر غراس عندما تحدَّث عن التحاقه بصفوف منظمة «الفتوة» النازية، ولم يكن له سوى سبع عشرة سنة. ولقد وصل الأمر بكتاب ونقاد ألمان حد المطالبة بحجب كتب غراس من التداول. المضحك أن بعض من كتبوا المقالات الرئيسة عن حالة غونتر غراس، ونشروها في الصحف العربية الكبيرة، وقد عبّروا فيها عن إعجابهم الشديد بشجاعة غراس، نجدهم الآن يغضبون عندما تتحدث «قلة» قليلة عن حالة عراقية مماثلة. هذه مفارقة عربية ذات صيغة عراقية مركبة تدفعنا للتشكيك بمرامي تلقي «الحالات» العالمية، عربياً، مما يتصل بشجب سلطة الديكتاتور، بل وتمجيد الكاتب المعادي للديكتاتور؛ فقد لا يخلو كتاب لأحدنا، أو مقالة أو بحث من مقولة «ثورية» تندد بـ«القتلة» وتحث «الكتَّاب» على تشريح حياتهم وسيرهم حتى لا يتكرروا. لكن الحالة ذاتها سنجد لها ألف تفسير عندما تتصل بحياتنا العربية العراقية المعاصرة، لا سيما عندما يمسُّ الكلام شاعر - «نا» المفضل، أو شاعر الحزب، أو الشاعر الذي ينتمي إلى «طائفتنا».
سرطان السياسة...
سرطانات الأدب والثقافة
في وقت مبكر من لحظة «نيسان 2003» كنا نقول، معترضين، لزملاء وأصدقاء إنه لا بد لنا من معيار نحتكم إليه في التقييم والحكم. لكن هذه الرغبة طارت ولم تجد أرضاً صلبة تقف عليها. «فلان الفلاني»، مثلاً، كان مدَّاحاً لصدام ونظامه. يصمت الغاضبون من حالة «الشاعر - السيد»، في حين تثيرهم حالة «رئيس» القسم «البعثي»؛ فأعرف أنهم صمتوا لأنه «السيد» ابن عائلة دينية كبيرة. يرتقي «الشاعر الدكتور» أعلى مناصب دولة ما بعد صدام حتى صار وزيراً، في حين يذهب «الأستاذ» البعثي ذو الأصول «الطائفية» المختلفة للنسيان. ثم «يموت» الشاعر يوسف الصائغ فيرفض اتحاد الأدباء والكتَّاب ببغداد نعيه؛ بتهمة إنه كان «خائناً» للحزب والشعب والشعر والوطن. والرفض ذاته نسمع عنه عندما مات، في مغتربه، شاعر صدام الأول «عبد الرزاق عبد الواحد». لكننا «نصحو» على نعي حار برحيل سامي مهدي، النصف البعثي مع خالد علي مصطفى من البيان الشعري الستيني الشهير. ولا أحد يتطوع ويفسر لنا؛ لماذا؟
ولا تفسير، أيضاً، لحالات الجمع بين مطرب شهير مثل كاظم الساهر، لا سيما بعد حديثه الأخير في حفلة وداع سامي مهدي الدامية حد قتال الشوارع في المدن المنكوبة بالحقد والكراهية، شهدنا ما لم نعرف ونسمع من قبل. فجأة تحوَّل «مواطنو» صفحة الشاعر «المحبَّون» له إلى شامتين به وناقمين عليه وعلى شعره. وفجأة، أيضاً، تحول «شعراء» و«مفكرون» و«كتاب قصة أو رواية أو مسرح»، كانوا، حتى البارحة، يكتبون الشعر وينشرون القصص والمقالات الجميلة المنددة بالطغيان والمستبدين وشعراء الحروب ألعابثة إلى مادحي تراث «الراحل» الشعري والنقدي. وإذا كانت «هجمة» بعض مثقفي اليسار العراقي، لا سيما الذين أجبرهم «إرهاب» الدولة البوليسية التي كان سامي مهدي يدير مؤسساتها الثقافية ويكتب المقالات والشعر المادح لـ«رئيسها» على الفرار من البلد، مفهومة، وربما مسوَّغة بحكم تاريخ العلاقة الشائكة بينهما، فإن حجم المغالطات والتنكر لصلة مهدي بما آل إليه وضع البلاد وانتقالها من «استبداد» الفرد الواحد إلى «احتلالات» أجنبية هو أمر غير مفهوم، ولقد حوَّل هؤلاء مهدي إلى «سيَّاف» السلطان الرهيب الذي لا يجرؤ أحد على شتمه، أو فضح أفعاله في حياته، فإذا «مات» صار أعداؤه يكتبون ضده.
ساعة السكرتير المنسية و«مدير الشعر»
منشوران ضائعان في عالم «فيسبوك» الشاسع، أو عالم النت الأوسع، كانا سبب هذه الحفلة الصاخبة. «نتفة» تركها الشاعر عبد الكريم گاصد عن «ساعة سلام عادل: سكرتير الحزب الشيوعي العراقي». لن أتخذ هذه القصة دليلاً على إدانة أحد، لكني أفكر بمئات المنشورات المنددة بما كتبه الشاعر گاصد في كتابه الأخير «رهان الستينات: نقد البيان الشعري، عبد الكريم گاصد، منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، بغداد، 2022»؛ فقط لأن كاتب «النتفة» لم يذكرها في حياة الشاعر الراحل؛ ليمكنه الرد على هذه «الكذبة». والحقيقة أن هذه القصة قد ذكر تفاصيلها گاصد نفسه في مقال عنوانه «خفة الشاعر التي تُحتمل»، نشره عام 2006 على موقع «الحوار المتمدن»، بل إن تاريخ نشر المقال يعود إلى زمن سابق؛ إذ إنه قد نُشر بصفته تقديماً لأحد كتب الكاتب السوري ممدوح عدوان. وفي ذلك المقال يتحدَّث گاصد عن لقاء جمعه بممدوح عدوان وعلي الجندي، وكان معهما سامي مهدي، ولقد أخبرهما مهدي، في ذلك اللقاء، أنه حصل على ساعة سلام عادل، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، بعد موته تحت التعذيب أثناء الانقلاب البعثي في شباط عام 1963، وأنه قد شهد وقائع التعذيب، لكنه لم يشترك به. تاريخ المقال، من ثمّ، لا يرتبط بتاريخ صدور كتاب گاصد «رهان الستينات: نقد البيان الشعري»، إنما يعود لأكثر من خمسة عشر عاماً. ولا يعنيني، هنا، صدق أو كذب واقعة ساعة السكرتير، إنما يهمني جداً أن أسفِّه «حمية» كل الذين كتبوا أن «القصة» ذكرت بعد موت الشاعر سامي مهدي، وأنه كان على صاحبها أن «يعلنها/ ينشرها» في حياة الشاعر. فالقصة معروفة ومعلنة ومسجلة في كتب الشاعر عبد الكريم گاصد، وهي ليست بنت اليوم أو البارحة. أما صدقها أو كذب صاحبها فهذا موضوع آخر، رغم أن أحد الشهود المذكورين «الشاعر علي الجندي» قد تُوفي عام 2009، بعد سنوات من نشر المقالة، حتى ممدوح عدوان فقد رحل عن عالمنا عام 2004.
لكن مقالة الكاتب علي بدر بعنوانها الهادئ «سامي مهدي بورتريه» هي المأثرة الأهم في حفلة الوادع الصاخبة. أقول العنوان الهادئ وهو خلاف مادته الصادمة والمكتوبة بمنطق «الخبير» بالشعر وكتابة السيرة، لِم لا؛ أليس هو، ذاته، صانع المصائر وكاتب سير شخصيات قصصه ورواياته. ولكن متى نفع كلام «الخبير» في بلاد دمرَّها «القتلة» و«الجهلة». في مقالة «بدر» ثمة تقييم نهائي للشاعر الراحل وشعره. يهمنا، هنا، تقييم بدر لشعر مهدي: فهو شاعر سلطة بامتياز، رغم أنه «لم يكتب الشعر السياسي»، ولقد ظل مؤمناً بالآيديولوجيا «البعثية/ القومية» حتى وفاته. ولم يكن موضوع الحرية يقلقه، «كما أنه لم تكن لديه ولا حتى أزمة ضمير إزاء الشعراء من جيله الذي انتهوا منفيين أو مسجونين أو مقتولين فهو كشاعر أو كمثقف أبعد ما يكون عن التعاطف».
وهو ذو شعر «يفقد للجذوة، يفتقر للروح، شعره مكتوب ببراعة لكنه مصنوع (...) هو شعر مكتب مبرد ومخدوم خدمة جيدة». وفي المقالة «البوست» ذاته سيشدد بدر أن شعر سامي مهدي «لم يكن مدرسة كاملة في الشعر له تلامذته ومقلدوه ومريدوه مثل سعدي يوسف، لقد عجز أن يجد شاعراً واحداً يتبعه، ولم نجد شاعراً واحداً نقول إن شعره تقليد واضح لشعر سامي مهدي». وسيكرر علي بدر بعض هذا الحقائق في «منشورات» لاحقة، بعد أن صار في واجهة نار المعترضين على تقييمه للشاعر الراحل.
«إحنه مشينا للحرب»
مثلما أن «الديكتاتور» يخلق بلاداً بحجم أوهامه وكوابيسه وأخطائه وجنونه، فإنه يخلق كذلك شعراءه وكتّابه ومثقفيه. ومثلما أن «الديكتاتور» يذهب إلى موته بلا اعتذار لشعبه عما فعله به، فإن شاعر السلطة يظل عند حدود يقينه بـ«عقيدتـ»ـه السياسية الصلبة حتى لحظته الأخيرة. وسامي مهدي شاعر خدمته سلطة الديكتاتور، وخدم هو، نفسه، تلك السلطة. هاتان حقيقتان لا يمكن إنكارهما، ولا يمكن فصلهما عن بعض، مثلما لا يمكن تفسيرهما بمنطق صراع الشيوعيين والبعثيين، أو كما يسوِّغ بعضهم «استخدام» السلطة المستبدة للأدب والثقافة في خداع الناس وإخضاعهم لها، وركون «الشعراء» و«الكتاب» لهذا المنطق كما لو أنه الحالة الطبيعية. وهو ما يريده أغلب المدافعين عن الشاعر الراحل. نحن نتحدث عن «شاعر» و«شعر» يفترض أن يعبّر عن الحق والعدالة، كما هو منطق الشعر في أغلب آداب العالم، لا أن يكون «أداة» لترسيخ سلطة «الديكتاتور» المطلق. وهذا الأمر حدث على مستوى الشعر نفسه، مثلما حدث على مستوى إدارة الشاعر لمؤسسات السلطة الديكتاتورية. لعل كثيرين سيوردون سيرة الجواهري، مثلاً، وسيقفون عند قصائد أو أبيات مدح بها الشاعر الشهير ملوك العراق و«قاسم» وحتى «البكر» وقادة بعثيين آخرين. وقد يتحدثون عن «منطق» الشعر العربي في مديح السلاطين، شأن أي شعر آخر في أمة أخرى، ولنا في سيرة الشاعر العربي الأعظم «المتنبي» مثلاً. بل قد نحتاج إلى كتب ومؤلفات كثيرة نحصي بها «كلام» المختصين، وغيره، عن جدل العلاقة بين «الأدب» و«السلطة» في تاريخنا العربي والعراقي. ولابأس؛ لكننا في حالة الشاعر الراحل نقف، ربما لأول مرة عند شاعر يسهم في بناء سلطة ديكتاتور. فلا المتنبي فعلها مع سيف الدولة الحمداني، ولا الجواهري مع الملك فيصل أو قاسم. نعم، لم يفعلها شاعر من قبل سوى شعراء الديكتاتور العراقي.