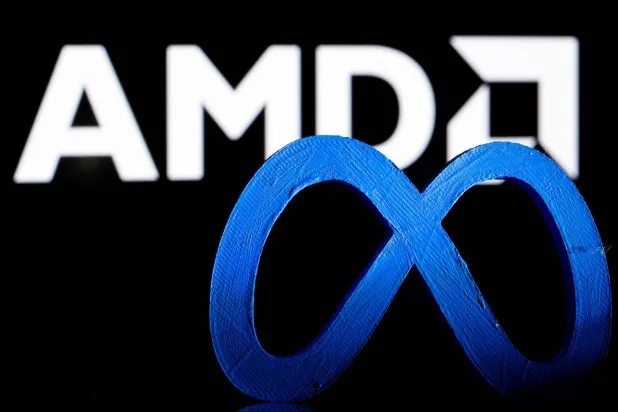خبر تسريح «غوغل» لأحد مهندسي الذكاء الصناعي لأنه أقّر بأن أحد الروبوتات يملك شعوراً و«وعياً ذاتياً» أحدث ضجة كبيرة وفتح الباب نحو أسئلة كثيرة؛ إذا كان الذكاء الصناعي قد تجاوز بالفعل القوة الفكرية للدماغ البشري، فأين نرسم الحدود الفاصلة؟ هل الآلة تكتفي بتطبيق ما طُلب منها أم أنها قادرة على الإبداع؟ وإن كان المبدع هو المخترع، فمن هو هذا الإنسان خلف الآلة؟ وماذا يريد؟ أسئلة قد تبعث على الابتسام وُتذكر بأفلام الخيال العلمي، على طراز «تيرميناتور». لكن الواقع أن مثل هذه الإشكاليات قد دخلت فعلاً ساحة النقاش في المجتمعات الغربية، ولا سيما أن الذكاء الصناعي أصبح يُستعمل في مجال الإبداع، وبخاصة الأدب.
خيالات الكُتاب أنفسهم انساقت نحو هذه النوعية من المواضيع، فكتب الفرنسي فيليب فاسي في روايته «نسخة العرض» عن «سكريبت ريجيناتور» البرنامج الذي أصبح حديث العالم، لأنه لا يكتب إلا الروايات الأكثر مبيعاً أو «البيست سيلر»! وأنتوان بيلو عن «أدا» الآلة التي بُرمجت لتأليف روايات رومانسية، لكنها تتمرد على مخترعها لتكتب بحرية، وأنتوني ألتمان في «الرواية الأخيرة» عن فيكتوريا الفتاة التي تفوز بفضل الشريحة المزروعة تحت جلدها، والتي تقوم بالكتابة بدلاً عنها. اليوم مثل هذه التجارب موجودة فعلاً على أرض الواقع، كما أن بعضها كُلل بالنجاح. في 2016 رواية بعنوان «اليوم الذي سيكتب فيه الكومبيوتر رواية» من إنجاز مختبر الذكاء الصناعي، التابع لجامعة هاكوداته اليابانية، انتهت في قائمة المتأهلين للتصفيات النهائية لمسابقة أدبية من بين 1450 مشاركاً، حتى إن لجنة التحكيم وصفت العمل المُرشح بـ«الرواية المنظمة للغاية». في 2018 نشرت إصدارات جان بويت «في الطريق»، وهي أول رواية كُتبت بواسطة الذكاء الصناعي في سيارة كاديلاك أثناء رحلة برية بين نيويورك ونيو أورلينز. ومؤخراً، اكتشف العالم بذهول الإنتاج الأدبي والشعري الذي طوّرته شركة «أوبن آي» التابعة لإيلون ماسك، الذي تقدم حسب اللّجان التي فحصته على الكتابة البشرية في الإمتاع والتشويق والتقارب في الدقة والاتسّاق. وقبل الخوض في القيمة الأدبية لهذه الأعمال، من المهم التذكير بوجود تحفظ شديد باتجاه فكرة وجود «أدب صناعي» ببساطة لأنه يتعارض مع الصورة التي ترسمها الذاكرة الجماعية عن الأدب، كحصيلة من التجارب والمشاعر الإنسانية المركبة التي لا يمكن تحديدها أو التنبؤ بها، وهو ما جعل فرويد يقارن «الإبداع الأدبي» بحالة أشبه بالعُصاب. تقول الكاتبة لورانس دو فيلار، في كتابها «رجال وروبوتات» (دار نشر بلون): «من هي الآلة القادرة على محاكاة أسلوب جين أوستن أو إيميلي برونت في تصوير المشاعر المركبة، أو سخرية فلوبير، أو الإبداع في مشاهد اللقاء عند تولستوي أو ستندال؟... وماذا يحدث حين نقرأ نصاً أدبياً يفتقد للروح البشرية، وللخيال الإبداعي الذي تحل محله تعليمات وحسابات الخوارزميات؟».
باسكال موجان، الجامعي ومدير دراسات الثقافة والذكاء الصناعي في جامعة باريس ساكلي، يلفت الانتباه في مقال بعنوان «هل يجب أن نخاف من كتب الروبوتات؟» إلى الصعوبة في تقبل فكرة «تفويض مُهمة الكتابة إلى آلة»، قائلاً؛ إذا كانت ورش عمل كبار النحاتين والرسامين قد عرفت ومارست هذا المبدأ لقرون، فإن أسلوب العمل الذي تكتب به برامج الذكاء الصناعي يتعارض مع الصورة المثالية للكاتب، ذلك «العبقري المنفرد» أو «المبدع المتميز» الذي يكتب في غياهب الليل وبمعزل عن العالم، ثم يضيف: «فكرة الاستعانة بمصدر خارجي أو تفويض قدراتنا الإبداعية إلى روبوت تبدو صعبة التوافق مع الشرعية الأدبية، ولذا فإن إنتاجات الذكاء الصناعي في مجال الأدب تعرف من البداية إقصاء آيديولوجياً، عكس ما يُلاحظ في مجال الموسيقى أو الرسم والفن السابع».
المواقف الرافضة لمثل هذه الإنتاجات غير مبررة، بحسب آخرين. الكاتب الفرنسي جيروم غام يقول في إحدى مداخلاته إن «علينا تمييز ما يمكن أن نحصل عليه من استعمال الذكاء الصناعي في مجال الأدب، فقد نحصل على كتابات من المفترض أن تكون من إنتاج بشري، أو على العكس من ذلك، فقد نحصل على كتابات لا يستطيع الإنسان إنتاجها. وبدلاً من تقليد الإنتاج البشري فإن الذكاء الصناعي سيبتكر أدباً لا يستطيع الإنسان إنتاجه، وهو ما قد يجعله متميزاً، ولنسميه «فناً مختلفاً» يستطيع أن يستحضر المفاهيم والأفكار أو يعرض نفسه ببساطة ليتم تقديره». الإشكالية الأخرى تتمثل في صعوبة الإقرار بأبوة «الإبداع» لهذه الآلات، وهو موقف مشروع، فإذا فرضنا أن الروبوتات تحتاج إلى تدخل بشري لتعمل، أي أنها غير مستقلة في العملية الإبداعية، فمن المبدع، الإنسان الذي يبرمج أم الروبوت الذي يكتب الرواية أو القصيدة؟ عن هذه المسألة تجيب لورانس دوفيلر في كتابها «رجال وروبوتات» بما يلي: «الروبوتات التي تعمل بواسطة نظام التعلم العميق (ديب ليرنينغ) تستخدم قاعدة بيانات، تستلهم منها لإنتاج العمل الإبداعي، مُعيدة دمج الأشكال والأنماط والمكونات الموجودة في البرنامج، ولهذا لا يمكن اعتبار هذه الروبوتات كأدوات بسيطة، فهي بدورها تصبح مبدعة، لأنها تستخدم شكلاً من أشكال الإبداع لإنتاج محتوى فني دون تدخل بشري في العملية». هذه المسألة حُسمت في قضية «بورتريه إدموند بيلامي» هذه اللوحة التي أنجزها برنامج ذكاء صناعي، وبيعت بأكثر من 400 ألف دولار في مزاد سوذبيز. الخبر الطريف أن اللوحة التي حصلت على إعجاب المشاركين حملت توقيع معادلة رياضية، لأن فريق مهندسي الذكاء الصناعي وخبراء الفن الذين أشرفوا على المشروع اعتبروا أن المعادلة التي استعملت في البرنامج هي من سمحت بإنجاز هذه التحفة.
على أن أكبر تحدٍ يمثله الذكاء الصناعي اليوم في مجال الأدب يبقى مدفوعاً بالربح المادي، والمكاسب الهائلة التي تعدُ بها الآلةُ الناشرَ الذي سئم من تماطل المؤلفين التقليدين ومطالبهم المالية المتزايدة، وهو ما يحدث فعلاً في الصحافة الإلكترونية التي يتم فيها استخدام الخوارزميات لكتابة القصص الإخبارية والنشرات القصيرة. تقول الروائية كاترين لانغ، في حوار مع موقع «إيجي بوك»: «لكم أن تتخيلوا مستقبلاً تكون فيه الرواية من توقيع كاتب معروف، لكن مهمة الكتابة توكل فيها لبرنامج الذكاء الصناعي الذي يحفظ في ذاكرته أسلوب الكاتب وتعابيره ويقلد كتاباته بطريقة جد مُتقنة»، وهو ما تقترحه فعلاً «ستارت أب» (شركة ناشئة فرنسية) بتطبيق يسمى «جيناريو» يساعد المؤلفين على الكتابة بواسطة الذكاء الصناعي، المُتمثل في قاموس «ذكي» يسمح بالغوص في آلاف الكلمات للعثور على الأسلوب والإيقاع المناسب، عبر جداول لتحليل الحبكة الروائية ومسار الشخصيات وتفاعلاتهم، إضافة إلى مكتبة افتراضية من ملايين القصصّ، تُمكن الكاتب من مقارنة موضوعات وشخصيات وهياكل سرد وأسلوب نصّه مع تلك الخاصة بأكبر الكتاب. أين الإبداع في كل هذا؟ وهل هذا يعني أن الكتابة الصناعية ستحل يوماً ما محل الكتابة البشرية؟ المتفائلون يجيبون بالنفي، لكن لا مفر من هيمنة الذكاء الصناعي على عالم النشر والكتب. فما يحدث اليوم هو أن الخوارزميات تختار لنا ما نقرأ في منصات بيع الكتب، وتتنبأ لنا بالرواية المُرجحة لأن تكون الأكثر «نجاحاً» بجداول وأرقام معينة، كما في موقع «أنكيت» الألماني. وفي النهاية، فقد يجد كُتاب الأجيال القادمة الذين يخضعون لحسابات هذه الخوارزميات أنفسهم وهم يقدمون أدباً متشابهاً يفتقد للأصالة والتنوع لأن الجميع يركض وراء الرواية «المثالية». الكاتب أنتوني ألتمان يطرح التساؤل نفسه على لسان أبطال قصته «الرواية الأخيرة»، في حوار يسأل فيه أحدهم صديقه الكاتب؛ ماذا سيحل بنا إذا استعملت الروبوتات في الكتابة بدلاً منا؟ فيجيب صديقه؛ سنصبح كالديناصورات، وكتبنا ستعرض... في المتاحف...