في رواية آمنة أحمد الأولى والمذهلة «عودة فراز علي»، يُطلب من رجل بوليس أن يغطي على مقتل فتاة صغيرة في حي الدعارة في لاهور، باكستان.
في مطلع الثمانينات، بعد فترة قصيرة من اغتيال الرئيس أنور السادات، كان أبي يسير ماشياً من عمله أثناء الليل باتجاه المنزل حين استوقفه جنديان. كانا صغيري السن ويشعران بالملل. قررا أن يختلقا له مشكلة. «أوراقك»، قال له أحد الجنديين.
كان أبي حينذاك يعمل محاسباً في أحد الفنادق وسط القاهرة، ما يعني أنه كان يعمل في قطاع السياحة، ولذا كانت لديه بعض الحرية ليتمشى في الليل، ليتحرك، ليعيش. أعطى الحارس أوراقه فما كان من الحارس إلا أن مزقها دون النظر إليها.
«أوراقك»، كرر الطلب.
من المغري أن ينظر المرء إلى الأنظمة المعطوبة - الأنظمة الحكومية، والطبقة، وكل الطرق الكبيرة والصغيرة التي نسمح لها بتنظيم حياتنا - بوصفها في المقام الأول عوامل للقسوة. ثمة لزوجة في القسوة: بمجرد أن تُمارس، فإنها تظل تحوم، ضيفاً منزلياً يتردد مقتحماً طوال السنين، على مدى الأجيال، يتغذى على الذاكرة. لكن القسوة أكثر ديمقراطية. يمكن للضعيف أن يكون قاسياً أيضاً، كما يمكن للفقير، حتى إن كان ذلك على ضعيف أو فقير آخر. الآلة الحقيقية التي تعمل في قلب الأنظمة المعطوبة، أكثرها التواءً، وتخفياً، ليست قسوتها: إنها الطريقة التي تمسح بها القوة ما ينتج عنها، الثقة التي لدى أولئك المسؤولين بأنهم، نتيجة لكون اللعبة مهيأة لتكون في صالحهم، سيخرجون منها دون أن يُمسوا بأذى.
تُموضِع آمنة أحمد روايتها الأولى والمذهلة «عودة فراز علي» في الفراغ الذي ينبغي أن تكون فيه النتائج - المذهلة ليس فقط لموهبة الكاتبة، الموهبة التي تكثر الدلائل عليها، وإنما لما فيها من إنسانية، للكيفية التي يتمكن فيها كتاب بالغ الجرأة في رسم الظلم الطبقي والمؤسسي أن يكون أيضاً بالغ النعومة.
إنه عام 1968 حين قتلت فتاة اسمها سونيا تبلغ 11 أو 12 عاماً في شاهي مُهلّا (الحي الملكي)، بالقرب من لاهور، باكستان، منطقة معروفة بحي للدعارة فيها (المنطقة الحمراء). يُرسل بوليس ذو رتبة متوسطة اسمه فراز علي إلى تلك المنطقة للتحقيق في جريمة القتل. الذي يرسل علي أبوه واجد، المتنفذ سياسياً، على الرغم من أن الاثنين لم تنشأ بينهما علاقة تذكر. أم علي، فردوس، تعمل في مُهلّا وكان واجد قد أخذ الولد منها في عمر مبكر ليتربى في مدينة جهيلم بين عائلة واجد الكبيرة وذلك لكي ينعم بمستقبل أفضل.
الآن، إذ تتضح معالم ذلك المستقبل، فإن واجد يوضح لعلي أن ثمة «حادثة» وقعت في مُهلّا: يبدو أن شخصاً أو شخصين مهمين لهما علاقة بالأمر، وأن علي لو عمل على إخفاء جثة الفتاة بدفنها سريعاً ودون كتابة تقرير للشرطة فإن مستقبله الوظيفي سيزدهر كثيراً. ولن يكون الأمر صعباً: يحدث ذلك باستمرار في هذا المكان. لكن لسوء حظ جميع المعنيين بالأمر، يسيطر على الضابط الموكل بتلك المهمة شيء يشبه الضمير.
هذه بصورة شديدة العمومية هي حبكة رواية «عودة فراز علي»، أو على الأقل لعبتها الافتتاحية. بالنظر إلى أن أكثر الحاضنات السردية احتواء للحياة الثقافية الأميركية قد يكون التحقيق الجنائي... فسيكون من السهل على القراء وباعة الكتب أن يصنفوا هذه القصة من زاوية انتمائها إلى ذلك النوع. غير أن آمنة أحمد اختارت نوعاً مختلفاً تماماً من القص. حتى منتصف الرواية، وبصفة خاصة عند نهايتها الهادئة ولكن المدمرة، تحيل الشخصيات المتكاملة بحيواتها المتقاطعة هذه الرواية إلى ما يتجاوز حكاية قتل غامضة.
تقفز الرواية عبر الزمن، عائدة في البدء إلى الحرب العالمية الثانية حيث يقع الشاب واجد أسيراً أثناء خدمته جندياً في الإمبراطورية البريطانية ويُلقى به في معسكر متهالك لأسرى الحرب في ليبيا. هناك يتأمل في قراره التخلي عن ابنه غير الشرعي في مُهلّا. بعد ذلك تمضي الحكاية قدماً نحو الصدمات العنيفة والعديدة للتقسيم، ولادة شعوب منقسمة، والحيوات التي لا تحصى ممن داستهم تلك العملية. الموضع الذي تغرق فيه الرواية هو ذلك الذي يترك فيه السرد تركيزه الشديد ليتوسع إلى ملحمة عابرة للأجيال. غير أن ذلك لا يتجاوز فترة قصيرة: الشخصيات حقيقية أكثر مما ينبغي، مثلما هو تصادم مؤامراتهم واستسلامهم وتجذر القصور فيهم.
الكاتبة آمنة أحمد، التي ولدت في لندن وتُعلّم الكتابة الإبداعية في جامعة سان هوزيه، غير معنية بأي إضافات غربية على جنبات قصتها. وبهذه الطريقة تمتلك الرواية ثقة بالذات تشبه ما في رواية «نحن أولئك الصغار» لبريتي تانيجا. لا يوجد هنا شرح معلن لوقت صلاة الفجر أو لعدد محطات القطار ما بين خولنا وغواليور. الرسالة الضمنية للقارئ هي ببساطة: كن في ذلك المكان أو لا تكن؛ ليس هناك من سيترجم لك العلامات.
إن من الصعب كتابة رواية كهذه دون مواجهة طيف واسع من العنف. ثمة بؤس هائل في هذا الكتاب. قامت آمنة بما عليها من البحث، والعالم الذي تبنيه - حيث النساء في مُهلّا ممتنات لولادة بنت لأن الطفلة، نتيجة للعمل الذي عليها أن تضطلع به لا محالة، يمثل ما يشبه خطة للتقاعد بالنسبة للأم؛ حيث يعد مقتل طفلة مثل تلك حدثاً مزعجاً - هو عالم متخيل لكنه مربوط بالعالم كما كان، وفي بعض الأماكن كما هو قائم. طوال الرواية، بينما يكافح علي للمصالحة بين مبادئه الأخلاقية والأوامر التي تلقى، وأثناء مطاردته أثناء ذلك للماضي العائلي الذي حيل بينه وبينه، يكشف أكثر أشكال البؤس وضوحاً عن نفسه من حيث هو إرث، شيء متحدر إليه.
على مستوى الجملة، لآمنة أحمد عادة تتمثل في إضفاء النعومة في مواجهة أكثر المشاهد إثارة للنفور، الأمر الذي يمنح تلك المشاهد حميمية كانت ستزول بفعل الضجيج. في بداية القصة، أثناء محاولته القضاء على أحد الاحتجاجات، يضرب علي أحد صغار المحتجين ضرباً مبرحاً: «كانت ثمة انفراجة في وجه الولد حين نظر إليه، في ملامحه، في تعابيره المستسلمة بسهولة، كما لو أنه لم يرد أكثر من ذلك، كما لو أنه كان يتحرر».
تعاطف آمنة أحمد واعتناؤها العميق بالتمايزات النفسية والعاطفية لدى شخصياتها تعاطف لا يخفت، بغض النظر عن مدى وحشيتهم أو درجة أنانيتهم أو مدى انهزامهم. يبقى ذلك التعاطف بينما علي يتألم جراء العقاب الذي ينتج عن رفضه تنفيذ الأوامر: النفي إلى شرق باكستان عشية استقلال بنغلاديش، الأمر الذي أدى إلى محو مستقبله الوظيفي. هو تعاطف يبقى بينما أخت علي، روزينا، التي كانت سيدة شهيرة ذات يوم، تعبر عراء الحياة بعيداً عن الأضواء. إنه تعاطف يستمر عبر أجيال وتحولات في المكان، حتى الوصول إلى الفصل الأخير المدمر، يستمر تعاطفاً إنسانياً بالكامل، ملتحماً بالكامل مع ما يجعلنا بشراً، مهما كان حجم الجراح أو درجة التحصين لدى أولئك الذين يتسببون بها. قد ينجو الأقوياء من النتائج في الغالب، كما ترينا آمنة أحمد، لكن الحياة من دون تلك تتحول إلى فقر خاص بها، إرث بائس نابع منها.
* عن «نيويورك تايمز»
جريمة قتل في «مُهلّا»
https://aawsat.com/home/article/3610626/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D9%85%D9%8F%D9%87%D9%84%D9%91%D8%A7%C2%BB
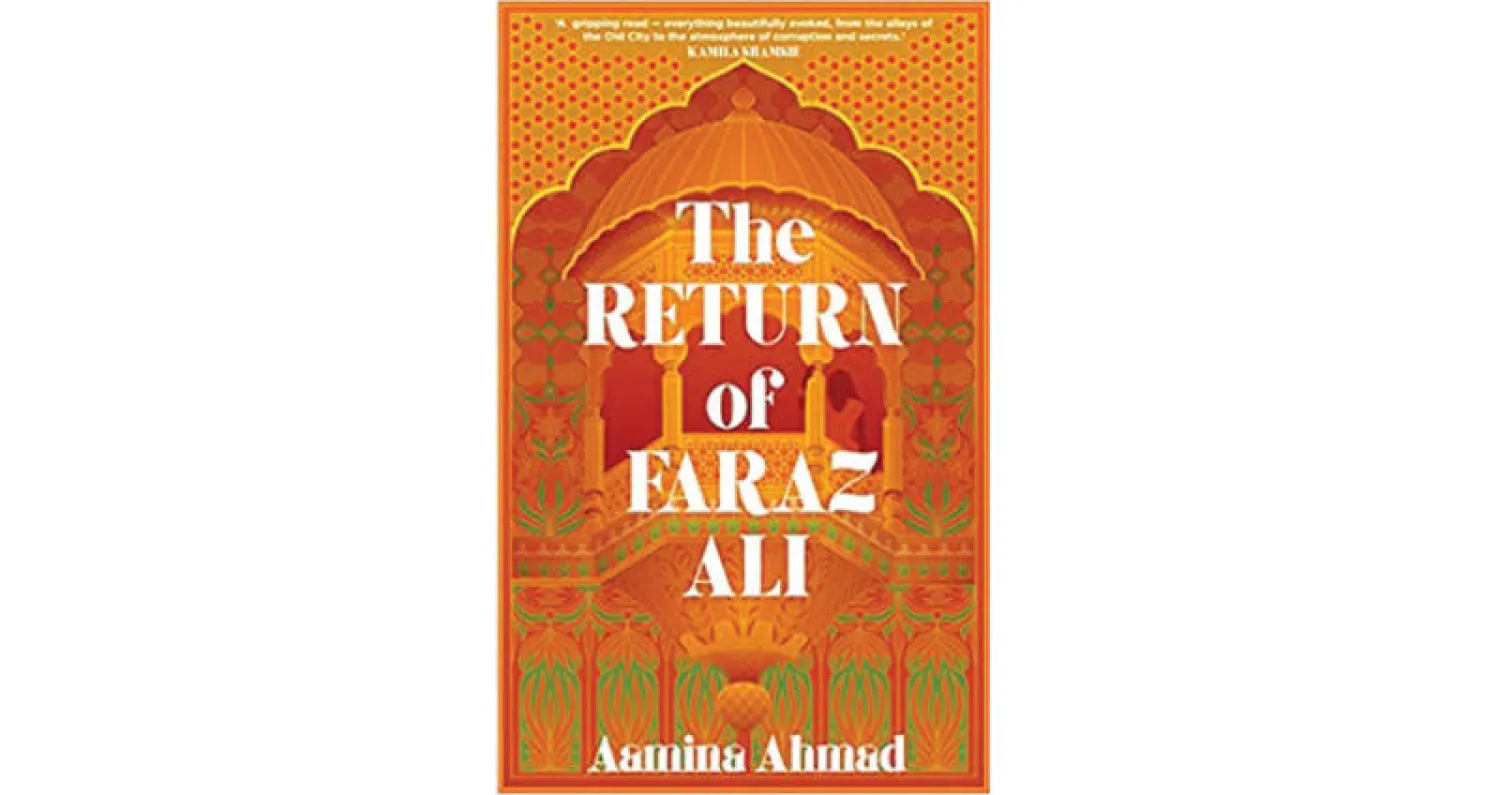

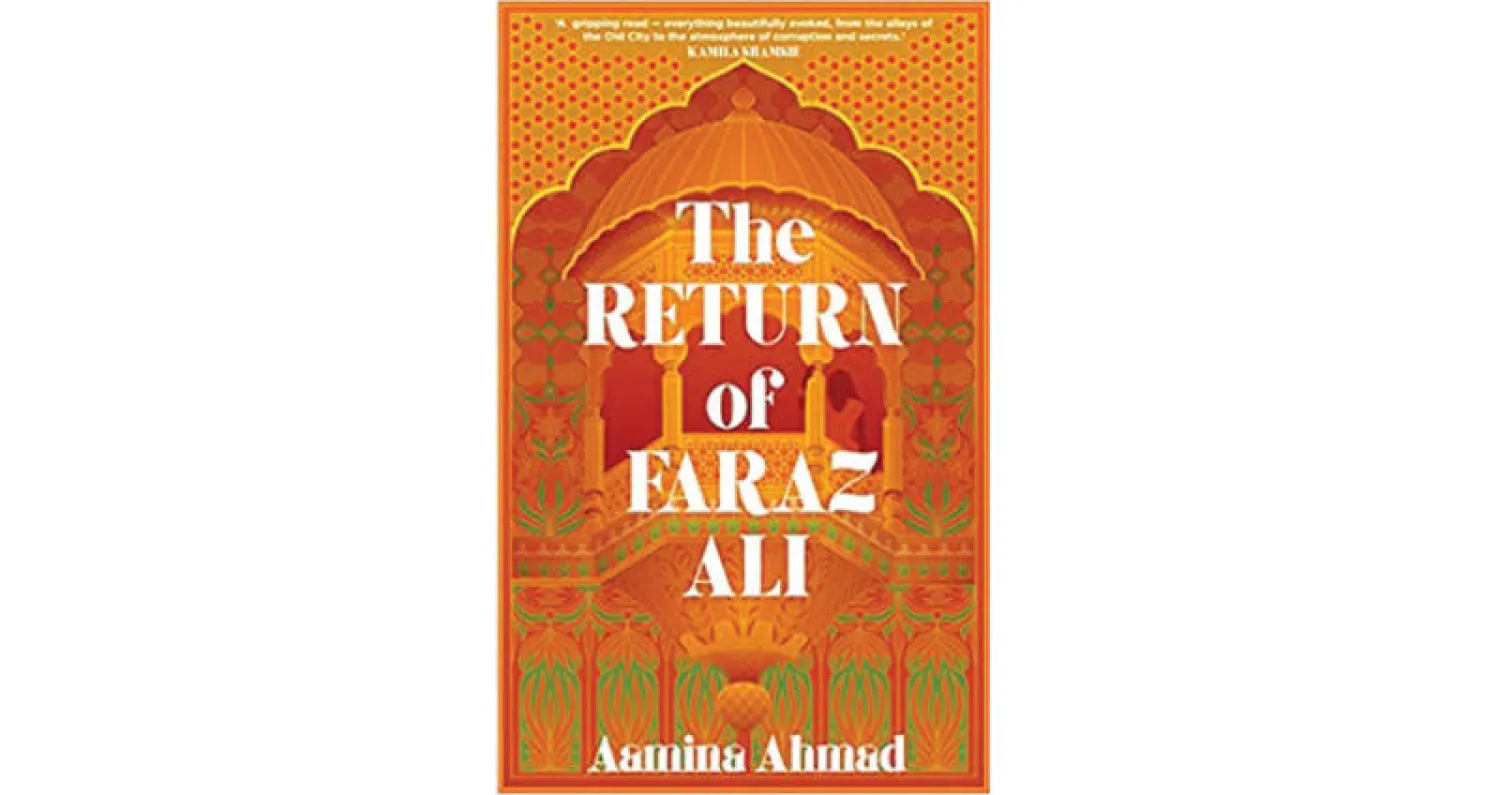
جريمة قتل في «مُهلّا»
الباكستانية آمنة أحمد تختار في روايتها الأولى نوعاً مختلفاً من القص
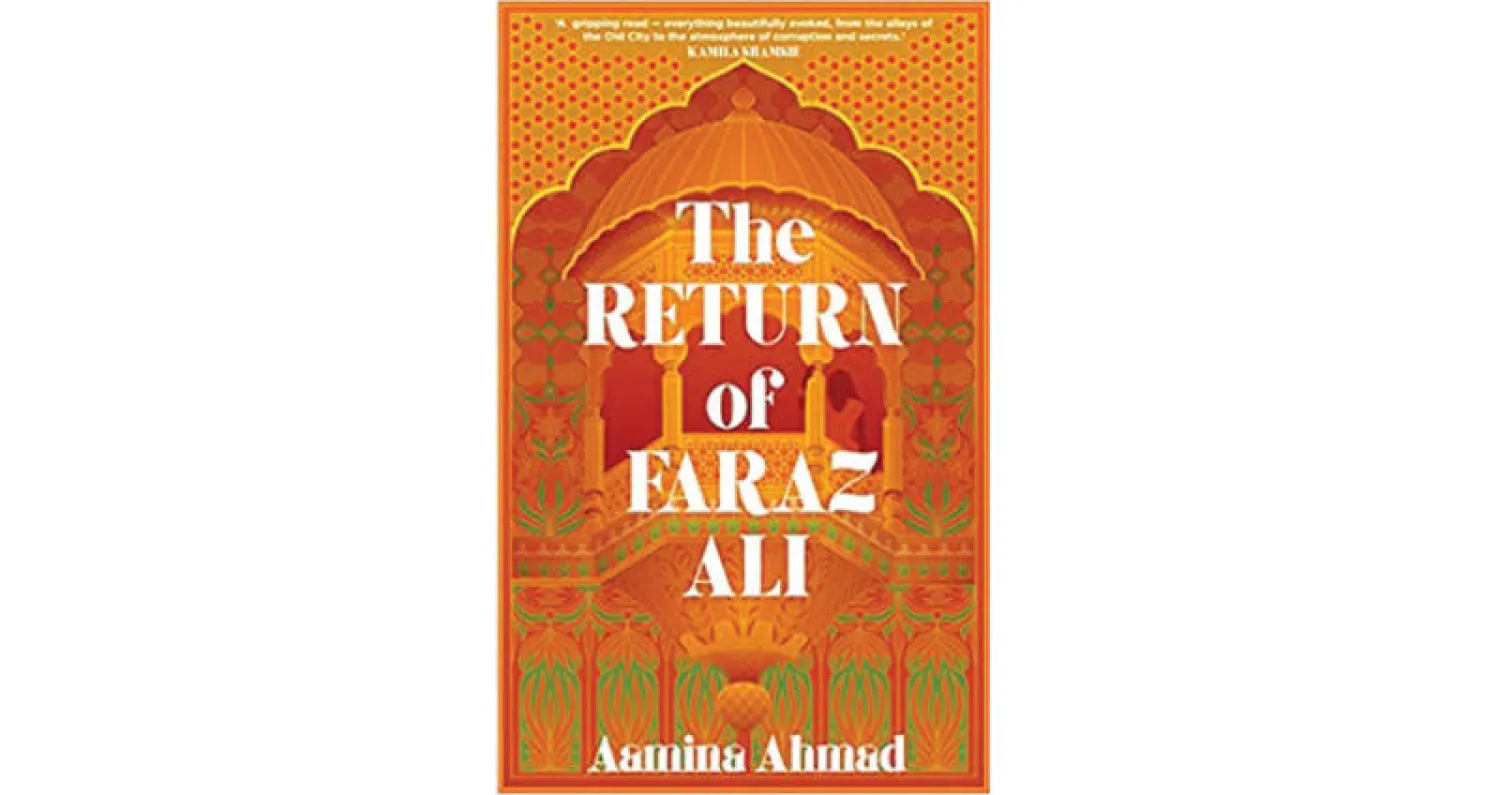

جريمة قتل في «مُهلّا»
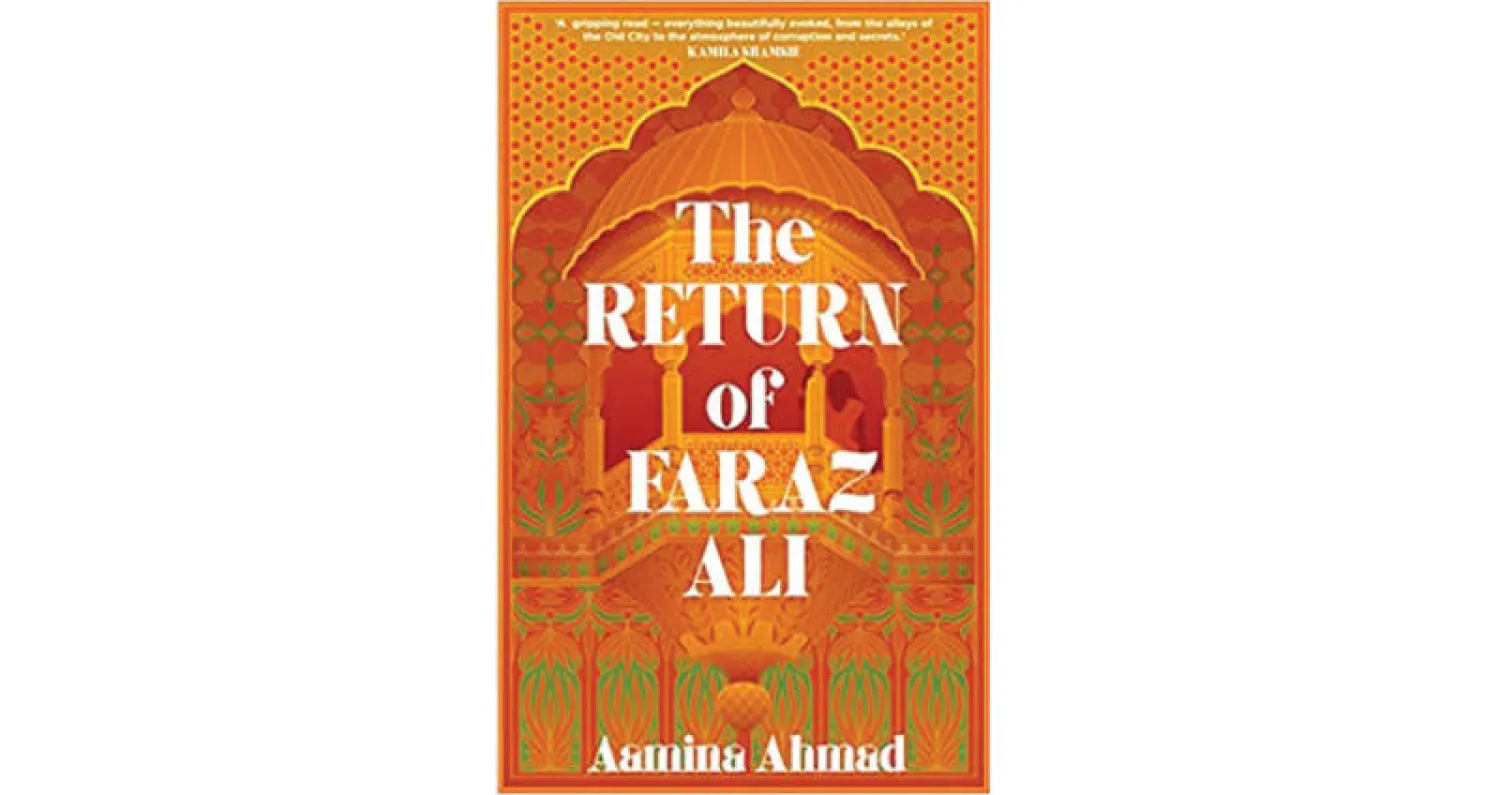
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة










