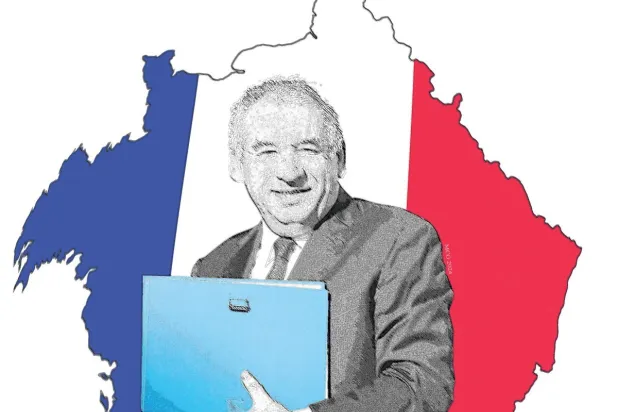تُعد المحكمة العليا في الولايات المتحدة واحدة من بين كبرى المؤسسات الأميركية التي «تضمن احترام الدستور، وتطبيق القانون، وتحقيق العدالة للجميع، والحفاظ على النظام الديمقراطي». غير أن الانقسام السياسي العميق الذي يضرب المجتمع الأميركي، سلّط الضوء على الواقع الجديد المتمثل في أن ملء منصب شاغر في المحكمة العليا في الوقت الحالي أصبح يعتمد على الحزب المسيطر على كل من البيت الأبيض ومجلس الشيوخ. حدث ذلك مع تعيين الرئيس السابق دونالد ترمب 3 قضاة محافظين، خلال فترة رئاسته وسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ. ليتكرر اليوم مع تأكيد تعيين كيتانجي براون جاكسون، التي رشحها الرئيس الديمقراطي جو بايدن لعضوية المحكمة العليا. غير أن الواقع الأخطر الذي يهدد حيادية المحكمة العليا، وضمان تحقيق وظائفها أعلاه، أن أحكامها القضائية، وبدلاً من أن تحتكم إلى القانون، صارت تحتكم إلى ما يريده الرأي العام، بحسب العديد من المراقبين وخبراء القانون الأميركيين. ومع فترة ولاية مدى الحياة، أصبح تعيين القضاة قضية بالغة الأهمية في تقرير مستقبل المحكمة العليا، التي باتت أحكامها تثير انقسامات شديدة لدى الرأي العام الأميركي.
ويطرح ذلك تساؤلات عن ضرورة «إعادة نظر» استراتيجية بشأن موعد تقاعد قضاة المحكمة العليا الذين تؤثر أحكامهم في حياة الأميركيين، بما يتناسب مع التغييرات الاجتماعية والسياسية واختلاف نظرة المجتمع إلى القوانين واتجاهات تطويرها وكيفية تطبيقها.
يُعتبر تعيين القاضية كيتانجي جاكسون، أول قاضية سوداء في أرفع محكمة أميركية، سابقة تاريخية ولكن في مسار تطور طبيعي يعبّر مباشرة عن تغيّر نظرة المجتمع الأميركي، رغم انقساماته، إلى قضية المساواة العرقية. كما عُدّ تعيينها «تطوراً طبيعياً»، للحياة السياسية الأميركية، منذ انتخاب باراك أوباما، كأول رجل أسود رئيساً للبلاد، وانتخاب كامالا هاريس كأول امرأة وأول امرأة سوداء نائبة للرئيس. لكنه في المقابل، أفقد «الرجل الأبيض» للمرة الأولى أيضاً، الغالبية في المحكمة، مع خمسة من أعضائها من غير البيض، واقتراب النساء من المساواة مع الرجال (4 نساء مقابل 5 رجال). ومع تولي القاضية جاكسون منصبها في 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ستكون المحكمة العليا قد شهدت أكبر تغيير في تاريخها في أقل من جيل واحد، وسيكون متوسط عمر قضاتها 61 عاماً، مقابل إدارة أميركية يبلغ فيها الرئيس 79 عاماً ورئيسة مجلس النواب 82 عاماً. وهو ما طرح نقاشات وتساؤلات عن ضرورة تحديد سقف عمري، ليس فقط لقضاة المحكمة العليا، بل ولقادة البلاد السياسيين أيضاً.
ومن نافل القول إن الرئيس بايدن قد حقق واحداً من وعوده الانتخابية المهمة، لناخبيه من الأميركيين السود، عندما قال إن المحكمة العليا في طريقها لتكون «أشبه بأميركا»، عبر تعيينه جاكسون أول قاضية سوداء في المحكمة العليا. لكن ورغم ذلك، لن يتمكن تعيينها هذا من كسر التوازن القائم في المحكمة، حيث 6 من أعضائها من المحافظين، مقابل 3 ليبراليين. ويذكر، في هذا الإطار، أنه رغم تعيين ترمب للقضاة الثلاثة نيل غورساتش وبريت كافانو وإيمي باريت، الذين غالباً ما كانوا على يمين رئيس المحكمة العليا المحافظ جون روبرتس، فإن أمله قد خاب منهم بعد تصويتهم في المحكمة على قرارات رفضت تأكيداته المبالغة عن امتيازه التنفيذي، وادعاءاته بشأن خسارته انتخابات 2020.
كما أن تعيين جاكسون لن يخفف من حدة الانقسام السياسي الذي يتجه للاحتدام، مع استعداد المحكمة العليا للنظر في قضايا تثير خلافات شديدة، على رأسها قانون الإجهاض، والتعديل الدستوري الثاني المتعلق بحمل السلاح، والتمييز العرقي في القبول في الجامعات، وحقوق المثليين مقابل الحرية الدينية وغيرها من القضايا التي ينقسم الأميركيون حولها بشكل حاد، على أسس حزبية أكثر مما هو عليه الأمر في المحكمة. غير أن مراقبين لأعمال المحكمة العليا يرون أنها ستواجه مشكلات في المستقبل، في ظل تآكل الموافقة العامة على خلفيات قضاتها، نتيجة الانقسام السياسي. وأظهر استطلاع أجرته مدرسة «ماركيت» للحقوق في مارس (آذار) الماضي، أن 54 في المائة من الجمهور يوافقون على أداء وظائف المحكمة (64 في المائة من الجمهوريين، مقابل 52 في المائة من الديمقراطيين و51 في المائة من المستقلين)، تراجعاً من 66 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2020، رغم ارتفاعه من 49 في المائة عام 2021، لكن حتى أدنى الاستطلاعات لا تزال تظهر أن المحكمة تتصدر مستوى شعبية بايدن أو الكونغرس. ومع تلك القضايا المعروضة على المحكمة، سيكون من الصعب الحفاظ على موافقة الحزبين، التي تستند بشكل عام إلى نتيجة القضية، وليس إلى منطق المحكمة. ويرجح أن تتعزز وجهات النظر الحزبية للمحكمة، عبر إصدارها مزيجاً من القرارات، أو لقرارات محدودة النطاق، قد لا تكون كافية للتخفيف من الانقسامات الحزبية، التي يمكن أن تهيمن على الحملات الانتخابية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الخريف المقبل.
- أوباما مهّد لجاكسون
في يوليو (تموز) 2009، عندما رشح باراك أوباما جاكسون لمنصب نائب رئيس لجنة إصدار الأحكام في الولايات المتحدة، بدا واضحاً أن عملية «إعداد وتأهيل» جارية للدفع بوجه أسود صاعد في عالم القضاء. في ذلك الوقت أكد مجلس الشيوخ تعيين جاكسون بالإجماع في فبراير (شباط) 2010، لتخلف القاضي مايكل هورويتز. وبقيت جاكسون في اللجنة حتى 2014، وفي سبتمبر 2012، رشّح أوباما جاكسون للعمل كقاضية في محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة عن مقاطعة كولومبيا (العاصمة واشنطن)، عن المقعد الذي أخلاه القاضي المتقاعد هنري كينيدي. تم تقديم جاكسون في جلسة التأكيد في ديسمبر (كانون الأول) 2012 من قبل الجمهوري بول رايان، أحد أقاربها من خلال الزواج، الذي قال: «قد تختلف سياستنا، لكن مديحي لفكر كيتانجي وشخصيتها ونزاهتها لا لبس فيه». وفي فبراير 2013، تم تقديم ترشيحها إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته، ليتم تأكيدها عن طريق التصويت في مارس، وأدت اليمين في مايو (أيار) أمام القاضي ستيفن براير الذي ستخلفه اليوم في منصبه في المحكمة العليا.
ولدت كيتانجي براون جاكسون (بروتستانتية) في العاصمة واشنطن، عام 1970، وترعرعت في ميامي بولاية فلوريدا. كان والداها من خريجي كليات وجامعات السود تاريخياً. والدها، المحامي جوني براون، تخرج في كلية الحقوق بجامعة ميامي، وأصبح في النهاية كبير المحامين لمجلس مدرسة مقاطعة ميامي ديد ذات الغالبية السوداء. عملت والدتها إليري مديرة في مدرسة العالم الجديد للفنون. في عام 1996، تزوجت كيتانجي براون (اسم عائلتها قبل الزواج) الجراح باتريك جاكسون، من بوسطن، ولديهما ابنتان ليلى وتاليا. تربطها علاقة قرابة مع رئيس مجلس النواب السابق بول رايان، الذي ترشح عام 2012 كنائب للرئيس مع المرشح الرئاسي الجمهوري ميت رومني. فصهرها متزوج بأخت زوجة رايان.
تخرجت جاكسون في مدرسة ميامي بالميتو الثانوية العليا عام 1988. في سنتها الأخيرة، فازت بلقب الخطابة الوطنية في بطولة الرابطة الوطنية الكاثوليكية للطب الشرعي في نيو أورلينز. درست جاكسون المحاماة وأعمال الحكومة في جامعة هارفارد، وشاركت في تقديم أنشطة ثقافية وأخذت دروساً في الدراما، وقادت احتجاجات ضد طالب قام بعرض علم الكونفدرالية من نافذة مسكنه الطلابي في الجامعة. تخرجت في جامعة هارفارد عام 1992 بدرجة امتياز كبير، عن أطروحتها بعنوان «يد القهر: عمليات المساومة بالذنب وإكراه المتهمين بارتكاب جرائم». عملت جاكسون مراسلة وباحثة في مجلة «تايم» من 1992 إلى 1993، لتكمل تحصيلها في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، حيث كانت محرراً مشرفاً لمجلة هارفارد للقانون، وتخرجت عام 1996 بدرجة دكتوراه في القانون بامتياز. وبينما كانت لا تزال طالبة في الكلية، حُكم على عم جاكسون، توماس براون جونيور، بالسجن مدى الحياة لإدانته بتعاطي الكوكايين من دون عنف. بعد سنوات، أقنعت جاكسون شركة محاماة بتولي قضيته مجاناً، وخفف الرئيس الأسبق أوباما عقوبته في النهاية. فيما خدم عم آخر، يدعى كالفن روس، كرئيس شرطة ميامي.
- جاكسون معارضة قوية لترمب
بدأت حياتها المهنية القانونية بثلاث وظائف كتابية، بما في ذلك واحدة مع القاضي ستيفن براير، الذي كان لا يزال مساعداً في المحكمة العليا. قبل ترقيتها إلى محكمة الاستئناف الأميركية عن دائرة العاصمة، عملت قاضية مقاطعة في محكمة مقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة من 2013 إلى 2021. منذ عام 2016، كانت عضواً في مجلس المشرفين في جامعة هارفارد. خلال فترة وجودها في المحكمة الجزئية، كتبت جاكسون عدة قرارات معارضة لمواقف إدارة ترمب. وفي رأيها الذي يطلب من دونالد ماكغان مستشار البيت الأبيض السابق في إدارة ترمب، الامتثال لأمر الاستدعاء التشريعي من مجلس النواب، كتبت أن «الرؤساء ليسوا ملوكاً». وتعاملت جاكسون مع عدد من التحديات لإجراءات بعض الوكالات التنفيذية التي أثارت تساؤلات حول القانون الإداري. كما أصدرت أحكاماً في قضايا عدة حظيت باهتمام سياسي خاص.
في 30 مارس 2021، أعلن الرئيس جو بايدن عزمه على ترشيح جاكسون للعمل قاضية في محكمة الاستئناف الأميركية عن دائرة العاصمة. في 19 أبريل (نيسان) 2021، أرسلت أوراق ترشيحها إلى مجلس الشيوخ، عن المقعد الذي أخلاه القاضي ميريك غارلاند، الذي استقال ليتولى منصب وزير العدل. في 28 من الشهر نفسه عقدت جلسة استماع بشأن ترشيحها أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ. وخلال جلسة التثبيت، تم استجواب جاكسون حول العديد من أحكامها ضد إدارة ترمب. في 20 مايو 2021، صوّتت اللجنة القضائية على ترشيحها بأغلبية 13 مقابل 9 أصوات. وفي 10 يونيو (حزيران) 2021، صوّت مجلس الشيوخ على ترشيحها بأغلبية 52 صوتاً. وبعد أربعة أيام، أكد مجلس الشيوخ تعيين جاكسون بأغلبية 53 مقابل 44 صوتاً، بعد انضمام أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري سوزان كولينز وليندسي غراهام وليزا موركوفسكي إلى جميع الديمقراطيين الخمسين. وفي أول قرار لها كقاضية في محكمة الاستئناف، ألغت جاكسون قاعدة صدرت عام 2020، عن الهيئة الفيدرالية لعلاقات العمل التي كانت تقيّد القدرة التفاوضية لنقابات العمال في القطاع الفيدرالي.
وفي 25 فبراير 2022، رشح الرئيس جو بايدن جاكسون لعضوية المحكمة العليا، لملء المنصب الذي سيشغر بعد إعلان القاضي ستيفن براير نيته التقاعد نهاية هذا الصيف، لتندلع مجدداً معركة تثبيتها على طول خطوط الانقسام الحزبية المتوقعة. وفي السابع من هذا الشهر، صوّت جميع الديمقراطيين وثلاثة جمهوريين، هم السيناتور ميت رومني وسوزان كولينز وليزا موركوفسكي، من أعضاء مجلس الشيوخ، لصالح ترشيحها، مقابل اعتراض 47 جمهورياً. وخلال جلسات الاستماع التي عقدت لتثبيت عضويتها، اتهمها الجمهوريون بالتساهل مع المجرمين، بعد دفاعها وإصدارها أحكاماً مخففة عن بعض المحكومين بجرائم القتل، رغم عدم تبنيها حتى الآن مع غالبية أعضاء المحكمة إلغاء عقوبة الإعدام، التي يدعو إليها القاضي براير. كما ذكرت وكالة بلومبرغ أن المحافظين المعترضين أشاروا إلى أنه في ربيع عام 2021، أخذت جاكسون قرارات تم نقضها في الاستئناف، بوصفها «عيباً محتملاً في سجلها». وأشاروا إلى أنه في عام 2019، حكمت جاكسون بأن أحكاماً في ثلاثة أوامر تنفيذية لترمب تتعارض مع حقوق الموظفين الفيدرالية في المفاوضة الجماعية. لكن دائرة العاصمة عكست قرارها بالإجماع. وفي قرار آخر عام 2019 يطعن بقرار لوزارة الأمن الداخلي بخصوص ترحيل غير المواطنين، تم عكسه أيضاً من قبل دائرة العاصمة. لكن مدافعين عنها قالوا إن في سجلها ما يقرب من 600 رأي قضائي، لم يتعرض سوى 12 منها للطعن.
- المحكمة الأميركية العليا سلطتها مطلقة في جميع القضايا الفيدرالية أو التي تخص الدولة
> المحكمة العليا الأميركية هي أعلى محكمة في القضاء الفيدرالي للولايات المتحدة. تتمتع بسلطة استئنافية نهائية وتقديرية إلى حد كبير على جميع قضايا المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات التي تنطوي على قضايا تخص القانون الفيدرالي، وكذلك على الولاية القضائية الأصلية على نطاق ضيق من القضايا. كما تختص على وجه التحديد في «جميع القضايا التي تؤثر في السفراء، والوزراء العامين، والقناصل الآخرين، وتلك التي تكون الدولة الأميركية فيها طرفاً». تتمتع المحكمة بسلطة المراجعة القضائية، والقدرة على إبطال القانون، لانتهاكه أحد أحكام الدستور. كما أنها قادرة على إلغاء التوجيهات والأوامر الرئاسية التنفيذية لانتهاكها الدستور أو القانون الوضعي. ومع ذلك، لا يجوز لها أن تتصرف إلا في سياق قضية في مجال قانوني لها اختصاص عليها. ويجوز للمحكمة أن تفصل في قضايا ذات مغزى سياسي. لكنها قضت خلال تاريخها بأنها «لا تملك سلطة الفصل في المسائل السياسية غير القابلة للتقاضي».
تأسست المحكمة العليا بموجب المادة الثالثة من دستور الولايات المتحدة. لكن قبل وضع هذه المادة الدستورية، تم إنشاء وتعيين إجراءات المحكمة العليا في البداية، من قبل الكونغرس الأول من خلال قانون القضاء لعام 1789. وبموجب قانون القضاء لعام 1869، حدد لاحقاً أن محكمة الولايات المتحدة العليا، تتكون من رئيس وثمانية قضاة مساعدين، يعينون لفترة مدى الحياة، ولا يغادرون منصبهم، إلّا في حالة الوفاة، أو التقاعد، أو الاستقالة، أو العزل. وهم اليوم، الرئيس جون روبرتس عينه جورج بوش الابن عام 2006، والقاضي كلارنس ثوماس عيّنه جورج بوش الأب عام 1991، ويعد الأطول في الخدمة، والقاضي ستيفن براير عينه بيل كلينتون عام 1994، وقد تقاعد أخيراً وتنتهي خدمته نهاية الصيف، لتحل مكانه القاضية كيتانجي جاكسون، والقاضي صاموئيل أليتو عيّنه بوش الابن عام 2006، والقاضية سونيا سوتوماير عينها أوباما عام 2009، والقاضية إلينا كاغان عينها أوباما عام 2010، والقاضي نيل غورساتش عينه ترمب عام 2017، والقاضي بريت كافانو عيّنه ترمب عام 2018، والقاضية إيمي باريت عينها ترمب نهاية 2020.
عندما شغور منصب فيها، يقوم الرئيس الأميركي، بترشيح قاضٍ شرط موافقة مجلس الشيوخ عليه. ورغم تعرض منصب القاضي «مدى الحياة» لانتقادات متزايدة، على خلفية تحول تعيينه إلى مسألة حزبية، وتخوفاً من «تحجر» آراء كبار السن، يقول آخرون إن ديمومة المنصب تجلب فوائد كثيرة، مثل الحياد والتحرر من الضغط السياسي. ولضمان استقلاليتهم المالية، يتقاضى قضاة المحكمة رواتب مرتفعة نسبياً. واعتباراً من عام 2021، يتقاضى القضاة راتباً سنوياً قدره 268 ألف دولار، ويتقاضى رئيس المحكمة 280 ألفاً. وتحظر المادة الثالثة من الدستور على الكونغرس، خفض رواتب القضاة. ورغم أن القانون يمنع القضاة من تلقي الهدايا ودعوات السفر باهظة الثمن، فإن تدقيقات أخيرة في العقدين الماضيين أظهرت أن جميع أعضاء المحكمة يقبلون هذه الهدايا. فقد تلقت القاضية سونيا سوتوماير 1.9 مليون دولار، من أحد الناشرين. وقام القاضي الراحل انتوني سكاليا وآخرون بعشرات الرحلات باهظة الثمن إلى «مواقع غريبة»، دفع ثمنها متبرعون من القطاع الخاص. كما تثير المناسبات الخاصة التي ترعاها مجموعات حزبية، ويحضرها القضاة مع أولئك الذين لديهم مصلحة، مخاوف بشأن التواصل معهم والتأثير في أحكامهم.