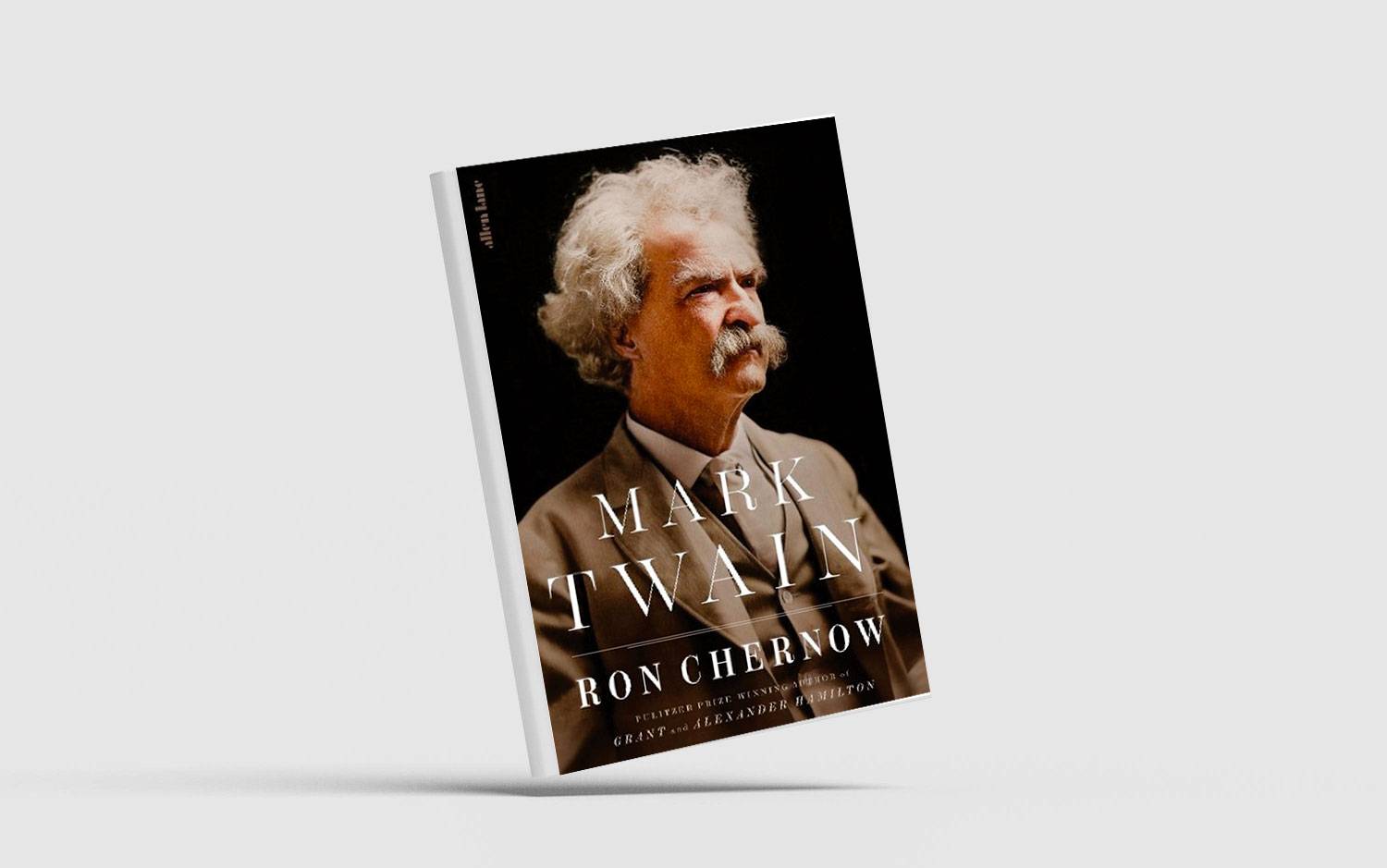يقارن البعض المفكر والناقد البريطاني ريموند ويليامز الذي ولد قبل مائة عام بمعاصره جون بيرغر، ويتأسفون نتيجة تلاشي تأثيره على الأجيال الجديدة، وهو الذي كان علماً على مرحلة بريطانية انقضت بين الحرب العالمية الثانية إلى ما قبل وصول مارغريت ثاتشر للسلطة، في الوقت الذي ما زال بيرغر مقروءاً وقيد التداول حتى اليوم.
ولكن تلك مقارنة غير عادلة البتة، إذ إن ويليامز رحل عن عالمنا قبل أكثر من ثلاثة عقود (1988)، فيما توفي بيرغر قبل سنوات قليلة فقط (2017). والأهم أن ويليامز عكس في مجمل أعماله تفكير جيل بريطاني كبر في مناخ الحرب الباردة ولم يكن قد شهد مرحلة انهيار الاتحاد السوفياتي ولا سقوط جدار برلين بعد. ومع أنه - بشكل عام - ميال لنقد التجربة السوفياتية، إلا أن نصوصه لا تُفهم سوى في إطارها التاريخي عندما كان وجود المعسكر الاشتراكي مَعلماً أساسيا في تكوين العالم بغض النظر عن المنطلق الآيديولوجي للمراقب تجاهه، بينما أمضى بيرغر ثلاثة عقود من العيش في ظل النظام النيوليبرالي الأحادي القطبية، وشوهدت كتب له تُتداول بين المتظاهرين في احتجاجات (احتلوا) التي اجتاحت مدناً عدة في الولايات المتحدة والغرب بداية من العام 2011 ولذلك فإن المقارنة لا تنعقد، والأولى هو البحث عن تأثير هذا الرجل الفائق على جيل كامل من المثقفين البريطانيين الذين نظروا إليه كمعلم، ونموذج لمصداقية نادرة تلاقت فيها المعرفة المعمقة، والالتزام السياسي بالممارسة العملية اليومية، وكمنظر مؤسس للدراسات الثقافية والنقد الثقافي، وأيقونة فكر جلت فوق الخلافات الآيديولوجية المحض، فلا ينكر إشعاعها أحد. وقد وصفه المنظر والناقد الثقافي المعروف ستيوارت هول بأنه «بلا شك أهم ناقد ومؤرخ ومنظر ثقافي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية».
ولد ويليامز قبل 100 عام (1921) لعائلة مزارعين في قرية بجنوب ويلز، تدعى باندي تقع قرب حدود الإقليم مع إنجلترا. والده كان ترك الزراعة والتحق بسكك الحديد كعامل إشارة، وانخرط بعمق في سياسات الطبقة العاملة لدرجة أنه أقيل لاحقاً من وظيفته لمشاركته في إضراب 1926 العام. ويبدو أن تلك الأجواء تركت انطباعا عميقاً على الابن بدلالة روايته الأولى «بلدة على الحدود - 1960» التي خطها بعد عقود طويلة من تركه باندي. وقد كتب ويليامز ذات مرة، أننا «نبدأ في التفكير من المكان الذي نعيش فيه»، ومن الواضح أن المجتمع الريفي المتماسك من الطبقة العاملة الذي نشأ في إطاره بقي كنقطة مرجعية دائمة في عمله، وعلى نحو ما مصدر تركيزه طوال حياته على قيم التضامن والعمل الجماعي، وربما أيضاً سر موقفه النقدي تجاه الثقافة الإنجليزية الرسمية التي واجهها في جامعة كامبريدج (1939) عندما أقبل للدراسة بمنحة حكومية للطلبة المتفوقين من الأقاليم. وهو في كتابه «السياسة والآداب» يروي «أن أحد المحاضرين بالجامعة قال إنه لا يمكننا الآن أن نفهم حقيقة معنى (الجار) في أعمال شكسبير لأننا نعيش في حضارة ميكانيكية فاسدة ليس للجيران فيها قيمة تذكر، فنهضت وأجبته، لا يا سيدي، أنا من ويلز، وأعرف جيداً ما تعنيه الجيرة».
لدى التحاقه بكامبريدج وجد ويليامز متنفساً طبيعياً في إطار الاتجاهات اليسارية التي كانت قوية هناك، لكنه استدعي للخدمة العسكرية مع نهاية سنته الجامعية الثانية (1941) وشارك في إنزال نورماندي بمراحل الحرب الأخيرة (1944) ومعارك (تحرير) بروكسل. وقد هالته تلك التجربة وكثفت مقته للعنف، فكان أن رفض استدعاءه للخدمة في كوريا بداية الخمسينات، وعاد لدراسته حيث كتب أوراقاً عن جورج إليوت وهنريك إبسن. وبعد تخرجه عام 1946 عمل مدرساً للكبار في جمعية العمال التعليمية، حيث كان يدرس مساء، ويكتب، بانتظام حديدي، في الفترة الصباحية. وباستثناء فترة وجيزة كأحد محرري مجلة «السياسة والآداب»، مارس ويليامز نقده الثقافي من خارج أسوار الأكاديمية طوال خمسينات القرن الماضي وكانت ذروتها كتبه المفصلية «الثقافة والمجتمع – 1958»، و«الثورة الطويلة – 1961». وقد تم تعيينه زميلاً في كامبريدج (1961)، واستمر بالتدريس هناك حتى تقاعده المبكر عام 1983.
وخلال سلسلة قراءات نقدية لعدد من المفكرين الإنجليز - من إدموند بيرك إلى توماس كارليل، ومن ماثيو أرنولد إلى تي إس إليوت - انتزع ويليامز تصورا أكثر شمولا للثقافة من ذلك التقليد الرجعي الغالب الذي يجعلها من انشغالات النخبة، وانتقد بشدة حصر منطق الإنتاج الثقافي بأقلية مهيمنة مانحاً مساحة تحت الشمس للمنتج الثقافي للطبقات المهمشة فيما يعرف الآن بالثقافة الشعبية بتمظهراتها الكثيرة: الأزياء والموسيقى والسينما، والتلفزيون والإذاعة وطرز العمارة والأغنيات وغيرها، ولتأخذ مكانتها الاستثنائية في المواجهة مع السلطات سياسية وثقافية واجتماعية.
شن ويليامز هجوماً ساحقاً على المفكرين الذين كانوا يوجهون سهام نقدهم إلى الحداثة بوصفها فتحت الباب أمام فوضى ثقافية من خلال التصنيع الرخيص والانتشار الشعبي، ويعتبرون نماذج الثقافة الرفيعة نوعاً من معقل أخير للقيم المتحضرة يتعرض للحصار. كانت تلك - عنده دائماً - نظرة قاصرة، فالحداثة جلبت منافع هائلة للبشرية كالكهرباء والطاقة البخارية والسينما، لكن تقاطعها مع النظام الرأسمالي هو ما تسبب في توظيف منجزاتها العبقرية تلك لغايات تعظيم الربح، وما يعنيه ذلك ضمناً من الانقسامات الطبقية وتفاوت الدخول التي أفسدت ذائقة الجماهير. ورفض أي تعامل فوقي يجعل من الثقافة نشاطاً منعزلاً للترفيه عن النخب، موسعاً المفهوم ليشمل كل «الجهود الضرورية التي نبذلها كل يوم لفهم بيئتنا - من خلال تفسيرها ووصفها – حتى نتمكن من العيش فيها بنجاح أكبر».
كان تمركز ويليامز جلياً في جهة اليسار وإن ظل بعيداً عن السياسة الحزبية بعد خيبة أمله من رمادية حزب العمال، لكنه لم يوفر أحداً من نقده الثقافي بما في ذلك تلك النظرة الميكانيكية للماركسية التي جعلت من الثقافة مجرد تابع ذليل لبنية الاقتصاد، واعتبرها بدلاً من ذلك بمثابة مجال أساس للصراع الطبقي يتم فيه التعبير عن هياكل السلطة والتنازع معها، وأصر على أن فكرة النظام الاجتماعي المستقبلي يجب أن تكون محددة بدقة شديدة، وتبدأ في أي بلد معين أو منطقة معينة مما هو موجود ماديا أو متاحٌ، ولا تستورد جاهزة ومكتملة من تجارب أمم أخرى، إذ لا توجد عنده قفزة سحرية من حاضر تسوده الفوضى الكاملة إلى بديل مثالي، بل عملية طويلة لا تنتهي أبدا من النضال – الديمقراطي - من أجل طرق أكثر عدلا ومساواة للعيش معاً.
طوال هذا الوقت، كتب ويليامز بغزارة في أعمال النظرية الثقافية والنقد والتحليل فصدرت له أكثر من 30 عملاً مطبوعاً، ونشر عدة روايات فضلاً عن مئات المقالات والمراجعات في الصحف والمجلات، وبرز كشخصية رئيسية في تيار اليسار الجديد الذي سعى إلى تقديم بديل اشتراكي أوروبي عن التجربة السوفياتية، وأصبح من موقعه في كامبردج أحد نجوم الأكاديمية الغربية الذين يشار إليهم بالبنان، رغم تناقضه الفكري مع تلك المؤسسة المفرطة النخبوية لا سيما بعدما خط نهجاً مميزاً في النقد الأدبي يعتمد على ما سماه بـ(المادية الثقافية) على النسق الذي طرحه المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي من ارتباط بنيوي بين هيمنة النخب والأدوات التي تشكل ثقافة المجتمعات.
وُجه إلى ويليامز الكثير من النقد المستحق لناحية تمركز فكره حول الحالة البريطانية حصراً وانغلاقه عن الفكر الأوروبي وحتى الإنتاجات الأدبية الأميركية. كما أنه وباستثناء جورج إليوت، بدا غير معني بالتجارب الأدبية النسوية، ووقع أسير حالة الفوبيا التي سادت أجواء اليسار البريطاني المهلهل من كل ما هو سوفياتي وبالتبعية لكلاسيكيات الماركسية اللينينية، الأمر الذي سمح لتلاميذه الأوسع أفقاً بالتفوق عليه، كما في حالة ستيوارت هول مثلاً الذي لا يُخفي انطلاقه من مكان ما بالقرب من ويليامز، ولكنه حلق بالدراسات الثقافية والتحليل السياسي المرتبط بها ونقد الإمبراطورية والرأسمالية كظاهرة ثقافية معولمة إلى مستوى آخر تماماً.
ومع ذلك، وفي ذكرى مائة عام على مولده، لا مناص من منحه مكانته المستحقة كمفكر ترك بصمة كبيرة على الجيل اللاحق من الدراسات الثقافية، وكصاحب تجربة شجاعة في تحدي المسلمات والأوضاع القائمة والانخراط الإيجابي في المحاولة النبيلة لبناء بديل عملي للعيش يتجاوز الرأسمالية خلال فترة السبعينات والثمانينات، ويشكل مجموعة أعماله – بما فيها رواياته الأدبية - ممراً لا يمكن تجاوزه لفهم ثقافة وأدب وتاريخ بريطانيا خلال مرحلة الحداثة.
مئوية ريموند ويليامز... رائد الدراسات الثقافية
عكس في مجمل أعماله تفكير جيل بريطاني كبر في مناخ الحرب الباردة

المفكر والناقد البريطاني ريموند ويليامز

مئوية ريموند ويليامز... رائد الدراسات الثقافية

المفكر والناقد البريطاني ريموند ويليامز
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة