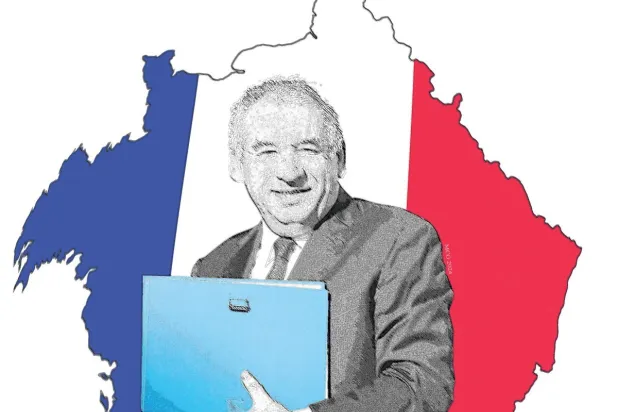بصرف النظر عن صفقة مبيعات الأسلحة الأخيرة لإسرائيل البالغة قيمتها 735 مليون دولار، فالولايات المتحدة تدعمها بمبلغ 3.8 مليار دولار كمساعدة أمنية سنوية، تطبيقا لـ«مذكرة التفاهم» التي وقعتها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2016 لمدة 10 سنوات، ودخلت حيز التنفيذ عام 2018، وتنقسم تلك المساعدة إلى مساهمة في تمويل عسكري بقيمة 3.3 مليار دولار و500 مليون دولار كمساعدة للدفاع الصاروخي سنوياً. ويمكن القول من دون أي مبالغة إن الولايات المتحدة لا تزال أكبر داعم ومموّل لإسرائيل منذ تأسيسها. وفي الآونة الأخيرة تكثفت تلك المساعدات، لأسباب سياسية واقتصادية ودينية وجيو - سياسية، بعضها متصل بالسياسات الأميركية المحلية، والبعض الآخر بالسياسات الخارجية، في ظل التحوّلات التي شهدتها السنوات الأخيرة منذ بداية عهد أوباما، مع تغيير واشنطن أولوياتها الاستراتيجية، ورغبتها في الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط، وتسليمها إلى وكلاء إقليميين، على الأقل.
غاب الحديث عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الولايات المتحدة، منذ أن توقفت مفاوضات السلام بين الطرفين، بعد آخر جولاتها التي عقدت في واشنطن خلال عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، تحت شعار «حل الدولتين». وباستثناء جولات الحروب المتقطعة خلال العقدين الأخيرين بينهما، كالحرب التي شنتها إسرائيل أيضاً على غزة عام 2014، بالكاد يُذكر الطرفان في وسائل الإعلام الأميركية، أو يحظيان بتغطية ومتابعة من الأميركيين.
وتكرّر سلوك الإدارات الأميركية المتعاقبة في التعامل مع الحروب التي خاضتها إسرائيل، كما هو حاصل اليوم مع الحرب المستمرة على غزة، حيث تتمدد «فترة السماح» الأميركية لآلة الحرب الإسرائيلية لتحقيق أهدافها، بعيداً عن الدخول في تفسير أسباب تلك الحرب، أو تعيين المشترَك أو المتعارض منها، مع المواجهات التي جرت بين فلسطينيي 48، في المدن والبلدات المحتلة داخل إسرائيل.
- الرأي العام الأميركي وإسرائيل
حتى الآن لا يمكن القول إن تغييراً حقيقياً قد حصل في مزاج الرأي العام الأميركي، من الموقف من إسرائيل. و«الاعتراضات» التي تتعالى من بعض التيارات السياسية - خصوصاً في الحزب الديمقراطي - على ما تفعله إسرائيل، والدعوات التي تطالب بإعادة النظر في المساعدات العسكرية التي تتلقاها من الولايات المتحدة، لطالما كانت موسمية ومرتبطة بمنسوب التوتر الأمني الذي يتكرر بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وبالتالي، فهي لم تتحول إلى حركة وازنة قادرة على تحويل تلك الاعتراضات الجزئية إلى حالة تخترق الطبقة السياسية الأميركية كلها، بجمهورييها وديمقراطييها، وحتى المستقلين فيها.
ولعله من نافلة القول أيضاً، إنه بعد أكثر من 10 سنوات... تفشّى «الخراب» في عدد من الدول العربية، وتآكل التضامن العربي نتيجة الحروب الأهلية المُغذّاة بمشاريع هيمنة إقليمية، وأمعنت آلة القتل الضخمة في حصد أرواح المدنيين من قوى محلية. وكل هذا أسهم في الحفاظ على مستوى عال من الانحياز الأميركي لإسرائيل.
يوم 22 أبريل (نيسان) الماضي، أعلن 331 نائباً من الجمهوريين والديمقراطيين (بشبه مناصفة) في مجلس النواب الأميركي - أي أكثر من ثلاثة أرباع أعضائه - أنهم يعارضون وضع أي شروط على المساعدات الأميركية إلى إسرائيل، من بينهم بعض الأعضاء التقدميين من الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي. وأوضح هؤلاء في رسالة إلى رئيسة لجنة المخصصات في المجلس النائبة الديمقراطية روزا ديلورو وكبيرة الجمهوريين في اللجنة النائبة كاي غراينجر، بأن «المساعدة الأمنية لإسرائيل هي في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة». وكان من بين «التقدميين» البارزين الموقعين على الرسالة، النائبان آندي ليفين من ولاية ميشيغان ورو خانا من ولاية كاليفورنيا. وتبرز أهمية الدعم الذي قدّمه «التقدميون» في أنه جاء في ظل دعوات من بعض رموز الجناح اليساري الذين وقعوا في وقت سابق على رسالة تدعو إلى التدقيق والإشراف على كيفية إنفاق إسرائيل مبلغ 3.8 مليار دولار الذي تتلقاه سنويا من الولايات المتحدة. وتزامنت تلك الرسالة مع دعوات مماثلة من السيناتور بيرني ساندرز والسيناتورة إليزابيث وارين، أبرز رموز هذا الجناح في مجلس الشيوخ، إلى تقييد تلك المساعدات كي لا يجري استخدامها ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. ويومذاك وجه ساندرز ووارين انتقادات صريحة ضد التوسع الاستيطاني، داعين الرئيس جو بايدن إلى اتخاذ إجراءات قوية لمساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين على التوصّل إلى «حل الدولتين».
هذا، ورغم أن عدداً من استطلاعات الرأي يشير إلى أن لدى ثلثي الديمقراطيين وجهة نظر إيجابية من إسرائيل، فإن ثلثيهم أيضا يؤيدون فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ثم إن غالبية الديمقراطيين يدعون الإدارة الأميركية إلى ممارسة ضغوط متساوية على الإسرائيليين والفلسطينيين. بيد أن شيوخ الحزب الديمقراطي، بمن فيهم زعيم الغالبية في مجلس النواب ستيني هوير وزعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، يدعمون المساعدات الأميركية لإسرائيل بحجة أن «لها الحق في الدفاع عن نفسها وعلى الولايات المتحدة تقديم الدعم».
وفي المقابل وجدت الاستطلاعات أن الأعضاء الجمهوريين مهتمون بمساعدة إسرائيل أكثر من سواهم. وهو ما يعكس التأثير السياسي الذي مارسته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، في ظل انحيازها التام لإسرائيل، مع أن الاستطلاع أظهر ارتفاعاً في نسبة المطالبين بموقف متوازن من إسرائيل والفلسطينيين، لا سيما من الفئات الشابة في الحزب الجمهوري.
- هاري ترومان... وإسرائيل
شهد مسلسل تجذّر العلاقات الأميركية بإسرائيل، الدولة التي أنشئت بقرارات لم تكن الولايات المتحدة طرفاً رئيساً فيها، محطات تاريخية ترافقت مع تحولات طرأت على ميزان القوى الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وبالأخص، مع تحوّل الولايات المتحدة إلى أبرز قوة عالمية.
في أكتوبر (تشرين الأول) 1948، أعلن الرئيس الأميركي هاري ترومان في خطاب، أنه «من مسؤوليتي أن أرى سياستنا في إسرائيل تنسجم مع سياستنا في جميع أنحاء العالم. إنني أرغب في المساعدة على بناء دولة ديمقراطية قوية ومزدهرة وحرة ومستقلة في فلسطين، تكون كبيرة بما يكفي وحرّة بما يكفي وقوية بما يكفي لجعل شعبها يدعم نفسه بنفسه». وفي ذلك العام وعلى أثر إعلان قيام دولة إسرائيل، وافق ترومان على تقديم مساعدات اقتصادية لدعمها على استيعاب المهاجرين، ووافق على قرض بقيمة 135 مليون دولار، كوسيلة «لتعزيز السلام».
ثم، في العام 1951 صوّت الكونغرس على مساعدة إسرائيل على تحمّل الأعباء الاقتصادية التي يفرضها تدفق اللاجئين اليهود من مخيمات النازحين في أوروبا ومن بعض الدول العربية. ويمكن القول إن إسرائيل تلقّت منذ الحرب العالمية الثانية نسبة مساعدات مباشرة من الولايات المتحدة، أكبر من المساعدات التي تلقتها أي دولة أخرى في العالم. ذلك أنه بين عامي 1949 و1973 تلقت إسرائيل من الولايات المتحدة ما متوسطه 122 مليون دولار سنويا، بإجمالي 3.1 مليار دولار، بينها قروض بقيمة مليار دولار لتمويل شراء معدات عسكرية بين عامي 1971 و1973، لكن منذ ذلك العام، تلقت إسرائيل أكثر من 120 مليار دولار من المساعدات، على خلفية موقف صدر عن الكونغرس الأميركي بعد «حرب 1973»، يقول إنه «ما لم تكن إسرائيل قوية، فإن الحرب في الشرق الأوسط ستغدو أعلى تكلفة على الولايات المتحدة، التي ستتكبّد نفقات مباشرة أكبر بكثير من دونها».
وحقاً، تألفت المساعدات الأميركية من حزم كبيرة أبرزها حزمة بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، حين تلقت 3 مليارات دولار تعويضا لها عن انسحابها من سيناء، و5 مليارات دولار لإعادة انتشار قواتها وقواعدها الجوية في صحراء النقب عام 1979. وجاءت الحزمة الثانية عام 1985 بعد أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تضخم بنسبة 445 في المائة، بقيمة 1.5 مليار دولار من المساعدات الطارئة، التي جرى صرفها على دفعتين، في عامي 1985 و1986 كجزء من برنامج الاستقرار الاقتصادي لإسرائيل. بعد ذلك، عام 1996 تحققت الموافقة على حزمة استثنائية لمساعدة إسرائيل في «محاربة الإرهاب»، حصلت بموجبها على 100 مليون دولار. وابتداءً من العام 1987 تلقت إسرائيل سنويا 1.2 مليار دولار على شكل منح مساعدات اقتصادية و1.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية. ثم عام 2005 تلقت إسرائيل 360 مليون دولار مساعدات اقتصادية و2.22 مليار دولار كمساعدات عسكرية، ما لبثت أن تصاعدت إلى 2.28 مليار دولار بعد الاستغناء عن جزء من المساعدة الاقتصادية وإضافتها إلى المساعدة العسكرية. ولا بد من الإشارة إلى أنه في العام 1998 جرى تصنيف إسرائيل على أنها «حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، ما سمح لها بتلقي معدات عسكرية يرغب الجيش الأميركي في الاستغناء عنها.
- إدارة أوباما أكبر داعم لإسرائيل
غير أن التحول الكبير الذي طرأ على طبيعة المساعدات الأميركية وقيمتها المقدّمة لإسرائيل، والتي تتطلب قراءة استراتيجية عن معناها، هي تلك التي أقرتها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، التي يتهمها البعض بشكل خاطئ على أنها معادية لإسرائيل. إذ وقّع الطرفان مذكرة تفاهم في نهاية عام 2016 مدتها 10 سنوات، توافق بموجبه الولايات المتحدة على منح إسرائيل 38 مليار دولار كمساعدات عسكرية تغطي السنوات المالية من 2019 حتى 2028. وشكلت إضافة هائلة بقيمة 8 مليارات دولار عن اتفاقية سابقة لمدة 10 سنوات أيضاً، انتهت عام 2018.
وتنقسم مساعدات المذكرة إلى فئتين، 33 مليار دولار من المنح العسكرية الأجنبية، و5 مليارات دولار إضافية للدفاع الصاروخي. ويعتقد على نطاق واسع أن هذه الزيادة كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقرار واشنطن إنهاء «حربها على الإرهاب»، والانسحاب من «رمال منطقة الشرق الأوسط»، والتخفيف من أعبائها عبر تعزيز وكلائها الإقليميين، على رأسهم إسرائيل، لتركيز اهتمامها ومواردها على مناطق التوتر والنفوذ الجديدة المندلعة مع الصين.
واللافت في هذا المجال أنه، منذ الإعلان عن هذه الصفقة قبل نحو 7 سنوات، جاءت الاعتراضات عليها خجولة، رغم الأصوات التي ترتفع بين الحين والآخر من معارضين يساريين، كما حصل خلال الشهر الماضي. ويعزى ذلك إلى نفوذ اللوبي الإسرائيلي والدعم الذي تحظى به من كل الإدارات الأميركية المتعاقبة، ديمقراطية أو جمهورية، ومن أكثرية أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب. وبينما كانت الولايات المتحدة تناقش حزمة المساعدات الخاصة بمواجهة جائحة «كوفيد - 19»، التي تسببت بأكبر أزمة اقتصادية منذ العام 2008، لم يناقش أحد المساعدة السنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل... باعتبارها من المحرّمات، وباعتبار أن دعمها كان ولا يزال، أولوية من الحزبين، وضرورة لتوفير عنصر استقرار استراتيجي في أجندة سياسة واشنطن الخارجية.
من جهة ثانية، لا تكتمل الصورة من دون التطرق إلى القواعد العسكرية الأميركية الموجودة في إسرائيل، فضلا عن القرار الاستراتيجي الذي اتخذته «القيادة الأميركية الوسطى» (السينتكوم) بضمها إلى منطقة عملياتها، بعدما كانت جزءا من القيادة الأميركية في أوروبا، ما يشير إلى الدور الاستراتيجي الذي ستلعبه لاحقا في المنطقة.
وفي حين تعَد إسرائيل من أهم الدول الشريكة في برنامج إنتاج الطائرة المقاتلة «إف 35»، وحصلت عليها بأعداد كبيرة منذ فترة طويلة، تحتفظ الولايات المتحدة بستة من مخزوناتها الاحتياطية في قاعدة «إيروينغ 7» في إسرائيل، وبنحو 300 مليون دولار من المعدات العسكرية في تلك المواقع. تلك المعدات تملكها الولايات المتحدة وتستخدمها القوات الأميركية في الشرق الأوسط، إلا أنه بإمكان إسرائيل استخدامها في أوقات الأزمات. كذلك تحتفظ الولايات المتحدة بمقاتلات وطائرات قاذفة، كما يعتقد أيضا أن إحدى القواعد تحتضن مستشفى بسعة 500 سرير لقوات المارينز والقوات الخاصة الأميركية «القبعات الخضر».
ووفق المعلق والصحافي الأميركي ويليام أركين، وضعت الولايات المتحدة ذخائر ومركبات ومعدات عسكرية ومستشفى في 6 مواقع على الأقل في إسرائيل، بينها مطار بن غوريون (اللد) ونيفاتيم وقاعدة عوفدا الجوية وهرتسليا، بعضها يتضمن مستودعات تحت الأرض وأخرى على شكل حظائر مفتوحة. كذلك يستضيف ميناء حيفا على البحر الأبيض المتوسط زيارات منتظمة لقطع البحرية الأميركية التابعة للأسطول السادس (مقره مدينة نابولي في إيطاليا). وللولايات المتحدة منشأة رادار في ديمونا بصحراء النقب في إسرائيل، بالقرب من مفاعل ديمونا النووي، حيث يوجد برجا رادار بارتفاع 120 متراً مصممان لتتبع الصواريخ الباليستية عبر الفضاء وتزويد شبكة الصواريخ المضادة لها، ببيانات الاستهداف اللازمة لاعتراضها. وبإمكان الرادار اكتشاف الصواريخ من مسافة 2400 كيلومتر، وتعد أبراجه الأطول في العالم.
ختاماً، يمثل برنامج التعاون الصاروخي بين الولايات المتحدة وإسرائيل أحد الجوانب الاستراتيجية بينهما، إذ تطوّر إسرائيل برنامج «أرو» المضاد للصواريخ الباليستية. ويزوّد الصاروخ الولايات المتحدة بالبحوث والخبرات اللازمة لتطوير أنظمة أسلحة إضافية، وتراوحت تكلفة تطويره بين 2.4 و3.6 مليار دولار، تتقاسمها الدولتان مناصفة.