في عملها الأخير «الراويات» (2014، دار التنوير)، الذي وصل هذا العام إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، تسبر السورية مها حسن أغوار السرد وعوالمه الخفية، بشقيه الكتابي والشفاهي. ويدور العمل حول مجموعة من الشخصيات، التي ليست بالضرورة مترابطة، ونسائية في أغلبها، يشغلها هم الروي، وتتملكها رغبة ملحّة بالتعبير عن المخيلة.
ابتداء من الإهداء.. «إلى النساء الحكواتيات في بقاع الأرض، اللاتي لم تساعدهن الحياة، على نشر رواياتهن على الملأ، فعشن ومتن في الظلمة»، وانتهاء بآخر جملة في العمل «عبر الكتابة، تحررت أعماقي، وخرجت إلى الضوء» (ص 190)، تحضر نبرة احتفالية، تكاد تكون ساذجة، حول أهمية الروي ودوره في خلق عوالم «يُكتب لها الخلود» (ص 8).
فالراوية الأولى تعيش كما تقول حياتَيْن، واحدة سطحية «نمطية» في عالم الواقع، وأخرى «غنية كثيفة» (ص 7)، تدور حول الكتابة وما يتخللها من شد وجذب مع شياطين السرد. «خُلقتُ لأروي» تقول الراوية، مستعيرة عبارة ماركيز بتصرّف، كتعبير عن مدى تعلّقها بهذا الفن. فهي «ليس لديها إلا متعة وتسلية الروي، لتمضية الحياة، وتمريرها بسلام، حتى النهاية» (ص 38). حتى عندما يسطو أحدهم على روايتها الأولى ويقوم بنشرها باسمه، لا تكترث أبدون، «وما الضرر، المهم أن شخوصي يملكون فرصة للخروج إلى العالم.. المهم أن تخرج الحكايات ليقرأ العالم.. المهم هو الرواية، لا الروائي» (ص 78، 79).
راما، آخر الراويات، تعيش في عالم موازٍ خاص بها، مليء بشخصيات وهمية لا وجود لها، لذلك حاولت أمها، التي خشيت عليها من الجنون، «زجر» مخيلتها بإرهاقها بشتى التمارين الجسدية وهي طفلة. فالطفلة التي وُلدت في الهند، ورثت عن جدتها «سحر القدرة على الحكي» (ص 181) وعلى عكس أقرانها الصغار، الذين يجدون في الاستماع إلى حكايات الجدات ممرا إلى النوم، راما تنتظر نهاية الحكاية لتفككها وتعيد بناءها بتفاصيل جديدة. عندما كبرت وصلت علاقتها مع زوجها إلى جدار مسدود، ذلك بعد أن اعترفت له بأن «اللحظات التي أشعر بها بنشوة تشبه الأورغازم، تتحقق فقط حين أروي» (ص 188).
هناك نقاط تشابه كثيرة لا يمكن تجاهلها بين الراويتين، أحدها هي الوصول إلى المتعة الجنسية عبر الروي. تقول أبدون: «ثمة طاقة جنسية تتولد بداخلي أثناء الكتابة» (ص 42).
لكن يخطئ من يظن أن هذا كل ما تنطوي عليه «الراويات»، أو أن شخصيات العمل النسائية هنّ «شهرزادات» يسرن على خطى معلمتهن الأولى التي استطاعت بعد «ألف ليلة وليلة» من الروي أن تنتصر على ذكورية الملك شهريار. «الراويات» لمها حسن أعمق من مجرد صرخة مدوية في وجه الثقافة الذكورية، أو مانيفيستو حماسي يدعو إلى ثورة نسوية. فأسفل السطح الاحتفالي «الثوري» الصقيل للعمل، هناك شبكة سردية معقدة من الحفر والمطبات تهدد بالانهيار.
تنطوي كل قصص الشخصيات على انقلاب مفاجئ في الحبكة، يناقض توقعات الراوية، كما يثير التساؤلات حول مصداقيتها ومدى إلمامها، أي الراوية، بالواقع الذي ترويه. فبينما ترى أبدون، على سبيل المثال، في ساباتو رجل الأحلام الذي قدم لها كل ما بوسعه لتكتب روايتها الأولى، يتبين للقارئ في نهاية قصتهما أنه استخدمها لتحقيق غايات نفعية بحتة.
كذلك الأمر بالنسبة لراما، التي بعد أن تعتقد أنها وجدت في الموسيقي الحالم أرافيند حيّزا لتتحرر روحها السجينة، تتلقى صفعة مدوّية لدى إدراكها، ولكن بعد فوات الأوان، أنه مجرد «أبله فاقد للمخيلة» (ص 189).
يقول الناقد والأكاديمي الأميركي جوناثان كولر: «روي القصص ينطوي على ادعاء سلطة معينة يقرّها المستمع». وكذلك هي علاقتنا كقراء مع راويات مها حسن الست، إذ أمام نبرة الشخصيات الاحتفالية حول دور السرد في تحطيم الثقافة الذكورية، لا نجد خيارا سوى أن نصدّق بظاهر ما يقلن، وبالتالي أن نعترف بسلطتهنّ على اعتبار أنهنّ الطرف المسيطر في عملية الحكي.
لكن وبعد الخذلانات، أو الصفعات، المتكررة للشخصيات/ الراويات، لا بد أن تساورنا الشكوك فيما إذا كنّ فعلا أهلاً للثقة التي منحناهن إياها في بداية العمل. لذلك يمكننا القول، إن الانعطافات المفاجئة داخل البنية الدرامية للعمل تحمل تساؤلات مبطنة حول مصداقية السرد، وفيما إذا كان الطرف السارد فعلا يستحق السلطة التي يمنحه إياها المستمع. بعكس «ألف ليلة وليلة» الذي يتمحور حول تمكّن شهرزاد من فن الروي، يسلّط عمل مها حسن الضوء على إخفاق الراويات في التحكم بخيوط السرد. فالعمل يدعي الشيء ويفعل نقيضه، إذ إن النبرة الحماسية للشخصيات توحي بثقتهنّ تجاه ما يروين، لكن الانقلاب الدرامي في النهاية يحيل الثقة إلى خذلان. راويات مها حسن يقدمن صورة مزيفة عن شهرزاد.
في أحد أكثر المشاهد ابتعادا عن أجواء العمل، تقوم أليس، المختصة في «دراسة الفلسفة وعلاقتها بالفن» (ص 156)، بزيارة القاهرة، بعد أن «مسّتها روح الفراعنة» (ص 158) القسم يطفح بإشارات حول نجاح تجربة الربيع العربي في مصر. تقول أليس، إنها «تثق بالمصريين، من أسقط مبارك، قادر على إسقاط الإخوان ولن يقبل ديكتاتورية جديدة» (ص 159، 160).
هذه وغيرها من العبارات، التي تبدو لنا الآن إما تهكمية أو ساذجة، يتم تمريرها بغاية الجديّة على لسان الراوية أليس، على الرغم من انقلاب الربيع العربي إلى خراب. حتى الآن، وبناء على ما كُتب عن «الراويات»، هناك نوع من الإجماع على عدم ضرورة هذا القسم، إذ إن الاعتقاد السائد يقول بإقحامه على بقية نص مها حسن. لكن في الواقع القسم بالغ الأهمية، إذ إنه يظهر بجلاء التباين بين الواقع والروي. فأليس، تقدّم للقارئ «روايتها» عن الربيع العربي، التي تتباين مع الواقع إلى حد كبير.
جميعنا شاهد عبر شاشات التلفزيون، وقرأ في الصحف والمجلات المختلفة عن الأحداث في مصر. بمعنى أن ما نعرفه عن الربيع المصري لا يرتقي إلى أكثر من «روايات» تعبر عن وجهة نظر أصحابها. الإنسان محاط بـ«الراويات» في كل مكان، في الصحف والكتب والتلفزيون و«يوتيوب»، ناهيك بوسائل التواصل الاجتماعي التي هي في نهاية الأمر منصة لأصوات/ روايات متعددة. لكن ترى هل كلها تعكس الواقع؟ «الروايات» لمها حسن تجيب بالنفي.
القارئ أيضا ينال نصيبه من الصفعات. فالبناء السردي لـ«الراويات» مربك في تشعبه، إذ يحتوي على أربع روايات في آن معا، «جلد الحية»، و«حور العين»، و«مقهى شهرزاد»، وأيضا «الحياة المزيّفة» لأبدون، جميعها تتداخل فيما يشبه دمية «الماتريوشكا» الروسية. كما أن تعدد وتداخل الأصوات الروائية يجعل القارئ لا يكفّ عن تكرار هذين السؤالين في رأسه: «من المتكلم؟» و«عماذا يتكلم؟»، يضاف إلى ذلك «تلذّذ» مها حسن، على ما يبدو، في ممارسة لعبة الأسماء الفضفاضة مع شخصياتها. فأبدون هي نفسها ميريام التي هي نفسها مها، وساباتو هو نفسه إرنستو، وكذلك فرانكو. أما ديبة فقد تصبح ظبية أو لويز، لا فرق، إذ «ليس لأسمائنا أهمية.. نحن كائنات افتراضية» (ص 38) كذلك الأمر بالنسبة للفضاء المكاني للعمل، فالمكان هو «تلك المدينة الكبيرة، التي تشبه القاهرة، أو نيويورك، أو طوكيو، أو باريس، أو لندن، أو بيروت» (ص 82).
«الراويات» لمها حسن عمل صِيْغَ بحرفية عالية من ناحية التكنيك والبناء، كما أن الاضطراب الظاهري للشكل يمنحه «لا نهائية» وغموض تلك الأعمال العظيمة مثل «موسم الهجرة إلى الشمال» للطيب صالح، و«عوليس» لجيمس جويس، التي لم تقدم إجابات بقدر ما أثارت تساؤلات.
شهرزادات مزيفات
«الراويات» لمها حسن دخلت القائمة الطويلة لجائزة بوكر العربية
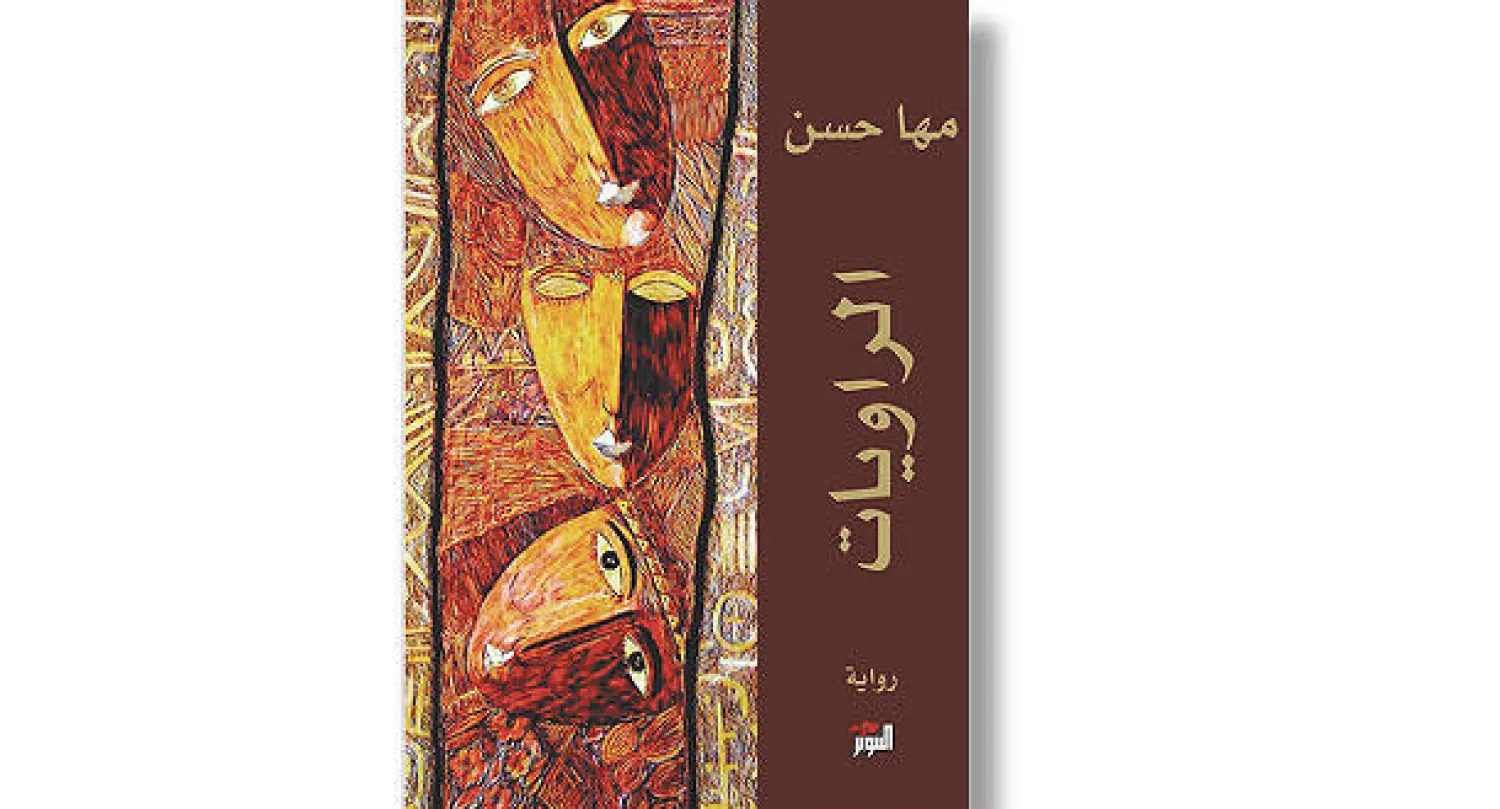
غلاف الرواية

شهرزادات مزيفات
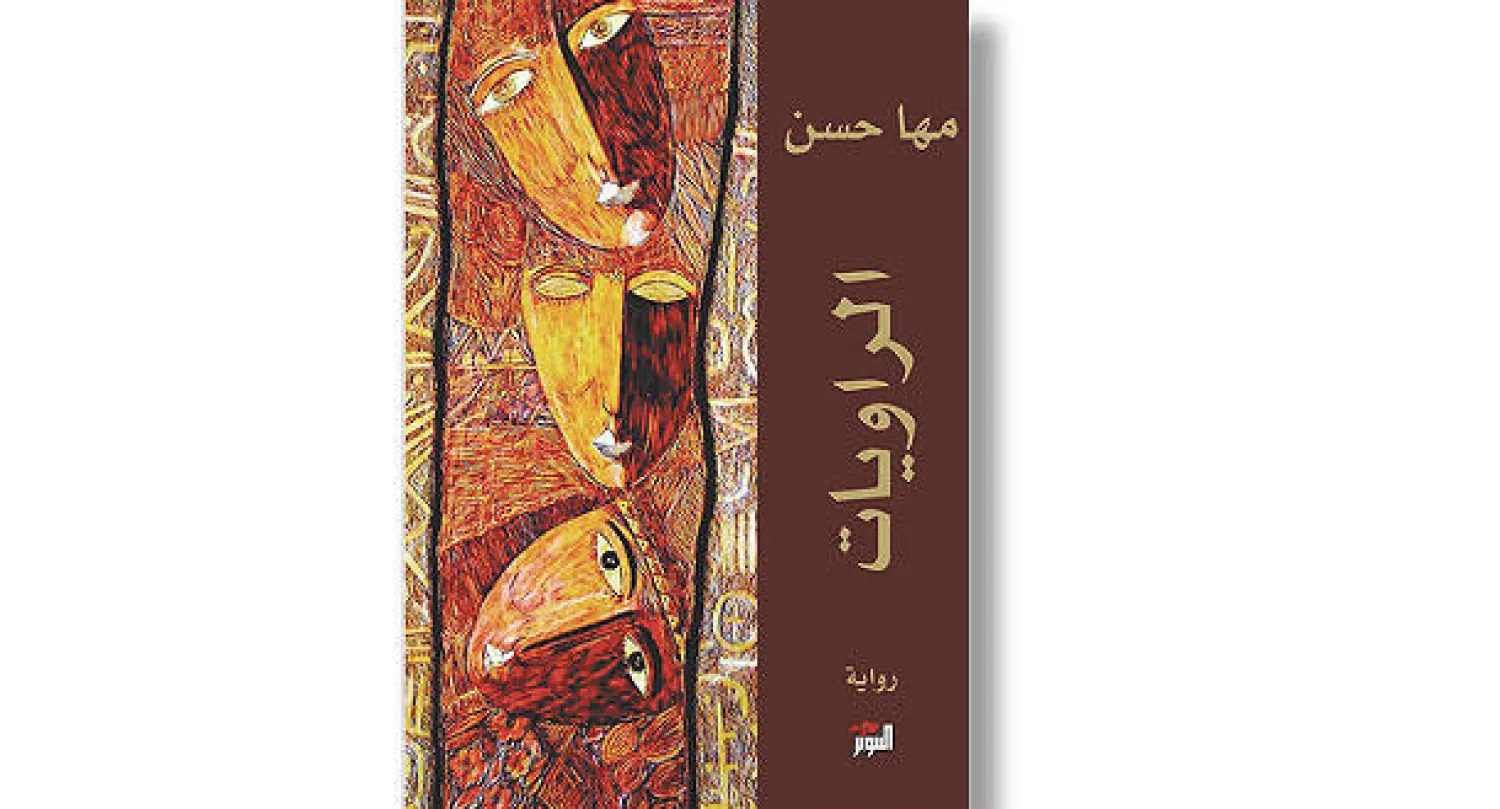
غلاف الرواية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة










