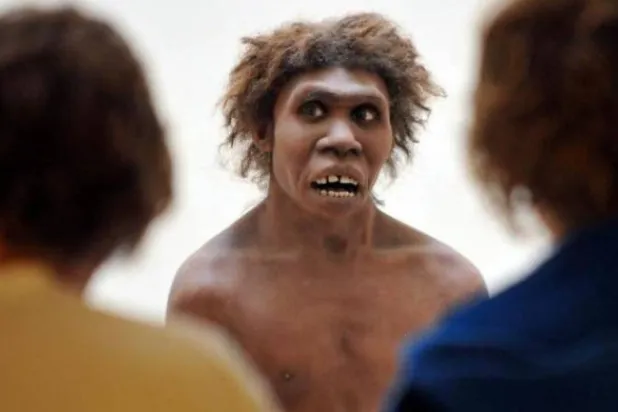قام علماء الأحافير بجامعة «كاليفورنيا ريفرسايد» في الثمانينات بزيارة جزيرة سيمور، وهي جزء من سلسلة جزر في شبه جزيرة أنتاركتيكا، وأحضروا معهم عدداً من الأحافير، بما في ذلك عظام القدم والفك الجزئي لطائرين من عصور ما قبل التاريخ، وفقاً لشبكة «سي إن إن».
ولعقود من الزمان، كانت الأحافير موجودة في متحف بجامعة «كاليفورنيا بيركلي»، حتى بدأ طالب دراسات عليا يُدعى بيتر كلوس التدقيق فيها عام 2015.
وفي دراسة نشرت يوم الاثنين بمجلة «ساينتفيك ريبورتس»، حدد كلوس الطيور بأنها مجموعة من الحيوانات المفترسة التي جابت المحيطات الجنوبية للأرض لمدة 60 مليون سنة على الأقل. وتُعرف بـ«الطيور ذات الأسنان العظمية» بسبب أسنانها الحادة ومناقيرها الطويلة، مما ساعدها على انتزاع الأسماك والحبار من المحيط.
وكانت الطيور ضخمة، ويصل طول أجنحتها إلى 21 قدماً (6.4 متر). وتشير الدراسة إلى أن المخلوقات المحددة التي تنتمي إليها الأحافير ربما كانت أكبرها جميعاً.
وباستخدام حجم وقياسات الأحافير، تمكن الباحثون من تقدير حجم بقية المخلوقات، وأن الطائر ذا عظم القدم «أكبر عينة معروفة لمجموعة كاملة من طيور (بيلاغورنيثيد) المنقرضة»، بينما كان من المحتمل أن يكون الطائر ذو عظم الفك «كبيراً؛ إن لم يكن أكبر من أكبر الهياكل العظمية المعروفة لمجموعة (الطيور ذات الأسنان العظمية)».
وقالت الدراسة: «هذه الأحافير في أنتاركتيكا لا تمثل على الأرجح أكبر الطيور في عصر الإيوسين فحسب؛ بل تمثل أيضاً أكبر الطيور التي عاشت على كوكبنا على الإطلاق».
ووجد كلوس وباحثون آخرون أن عظم القدم يعود إلى 50 مليون سنة، وأن عظم الفك يبلغ نحو 40 مليون سنة؛ وذلك يعدّ دليلاً على أن الطيور ظهرت في حقبة الحياة الحديثة، بعد أن ضرب كويكبٌ الأرض وقضى على جميع الديناصورات تقريباً.
وقال كلوس: «اكتشافنا الأحافير، مع تقديرنا أن جناحي الطائر يبلغ حجمهما من 5 إلى 6 أمتار (نحو 20 قدماً)، يُظهر أن الطيور تطورت إلى حجم هائل حقاً بسرعة نسبياً بعد انقراض الديناصورات، وحكمت المحيطات ملايين السنوات».
وأضافت المؤلفة المشاركة في الدراسة، آشلي بوست، من «متحف سان دييغو للتاريخ الطبيعي»: «الحجم الهائل والضخم لهذه الطيور المنقرضة لا مثيل له في موائل المحيط».
ومثل طيور القطرس؛ كانت طيور «بيلاغورنيثيد» تسافر على نطاق واسع حول العالم، ويمكن أن تطير لأسابيع في كل مرة فوق البحر. في ذلك الوقت، لم تكن المحيطات بعد تحت سيطرة الحيتان والفقمات؛ مما يعني فريسة سهلة للطيور العملاقة.
وقال المؤلف المشارك في الدراسة، توماس ستيدهام، من «الأكاديمية الصينية للعلوم»: «حجم طيور (بيلاغورنيثيد) الكبيرة يبلغ نحو ضعف حجم طيور القطرس، وكانت هذه الطيور ذات الأسنان العظمية من المفترسات الهائلة التي تطورت لتكون في قمة نظامها البيئي».
ورسمت الدراسة أيضاً صورة لما كان يمكن أن تبدو عليه القارة القطبية الجنوبية قبل 50 مليون سنة، حيث كان يمكن أن تكون أكثر دفئاً في ذلك الوقت، وموطناً للثدييات الأرضية مثل آكلات النمل.
وكانت جزيرة سيمور، وهي جزء من القارة القطبية الجنوبية الأقرب إلى طرف أميركا الجنوبية، موقعاً لكثير من المخلوقات الأخرى. ووجدت دراسة عن الأحافير التي اكتُشفت هناك في شهر أبريل (نيسان) الماضي أن نوعاً صغيراً من الضفادع عاش في المنطقة ذات مرة، وهو أول برمائي حديث يُكتشف في أنتاركتيكا.
وقال توماس مورز، كبير أمناء «المتحف السويدي للتاريخ الطبيعي»، في أبريل الماضي: «أعتقد أن أنتاركتيكا كانت مكاناً غنياً ومتنوعاً... لقد وجدنا حتى الآن نسبة مئوية صغيرة مما عاش هناك».
أحفورة بالقطب الجنوبي قد تعود لأكبر طائر حلّق في سمائنا على الإطلاق

جزء من الفك الذي اكتُشف بالقارة القطبية الجنوبية في الثمانينات ويعود إلى 40 مليون سنة (سي إن إن)

أحفورة بالقطب الجنوبي قد تعود لأكبر طائر حلّق في سمائنا على الإطلاق

جزء من الفك الذي اكتُشف بالقارة القطبية الجنوبية في الثمانينات ويعود إلى 40 مليون سنة (سي إن إن)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة