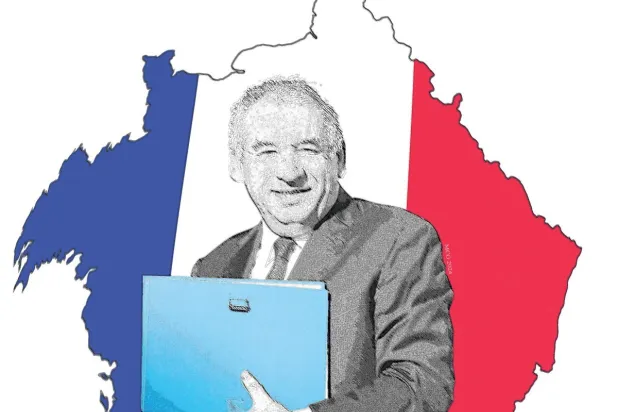تُجمع كل الدراسات والأبحاث على أن الدين يلعب دوراً كبيراً في السياسة الأميركية، الأمر الذي يضع الولايات المتحدة في المرتبة الأولى لناحية حضور الدين في الحياة السياسية، مقارنة مع أي دولة غنية أخرى في العالم.
ورغم أن التعديل الدستوري الأول يمنع تشكيل أي حكومة أميركية على أساس ديني، فإنه يضمن حرية ممارسة الدين. كذلك فإن الدين لا يزال يشكل عنصر الاستقطاب الرئيسي لدى الحزبين الكبيرين، في حين يعلن الأميركيون بلا تردد أنهم متدينون. وبحسب إحصاءات أخيرة، فقد أعلن 55 في المائة من الأميركيين أنهم «يصلّون» بانتظام، مقارنة بنحو 10 في المائة في فرنسا و6 في المائة في بريطانيا. كذلك يقول 87 في المائة إنهم يؤمنون بالله، و56 في المائة يقولون إنهم يؤمنون بالله «تماماً كما هو موصوف في الكتاب المقدّس».
تاريخياً، خلال القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20، استقطب الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة الأميركية أنصارهما على أسس عرقية ودينية. وعموماً، في الشمال كان معظم البروتستانت من الجمهوريين، في حين أن معظم الكاثوليك كانوا من الديمقراطيين. أما في الجنوب ومنذ ستينات القرن 19 إلى ثمانينات القرن الماضي، كان معظم البيض ديمقراطيين (بعد عام 1865) وكان معظم السود جمهوريين، قبل أن تتغير الحال في العقود الأربعة الأخيرة.
أيضاً، كثيراً ما يناقش السياسيون دينهم أثناء الحملات الانتخابية، فيما العديد من الكنائس والشخصيات الدينية نشطة سياسياً. ورغم ذلك كان توماس جيفرسون، الرئيس الثالث للولايات المتحدة، هو أول مَن شق الطريق للفوز بمنصب الرئاسة عبر أفكار مثيرة للجدل حول الدين، معلناً «لا دينيته»، بعدما تمكّن من تغيير العلاقة بين الفوز في الانتخابات على أساس الدين إلى إعلان تسامحه مع الحرية الدينية.
ولعل من بين جميع السياسيين الذين ترشحوا للرئاسة الأميركية خلال العقود الأخيرة، فإن بيرني ساندرز الأقل تديناً؛ فهو يعرّف نفسه على أنه يهودي علماني ويربط المعتقدات الدينية بالعدالة الاجتماعية، ولا يشارك في أي دين، ويدافع عن الفصل بين الكنيسة والدولة. لكن ظهور سياسات الهوية ونجاحها يشير إلى أن العرق أو الدين قد تكون لهما أهمية أكبر من العدالة الاقتصادية.
مع ذلك وبغية حفاظ الجمعيات الدينية والكنائس على وضعها كمؤسسات ومبرّات معفاة من الضرائب، فقد منعها الدستور الأميركي من اعتماد مرشح رئاسي رسمي. فالمسيحيون المتدينون موجودون في كل من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. لكن المسيحيين الإنجيليين المتشددين (أو «المولودين من جديد») يميلون إلى دعم الحزب الجمهوري، بينما يميل المسيحيون الأكثر ليبرالية والكاثوليك والعلمانيون إلى دعم الحزب الديمقراطي. ولقد وجد استطلاع أجراه مركز «بيو للأبحاث» عام 2019 أن 54 في المائة من البالغين يعتقدون أن الحزب الجمهوري «ودود» تجاه الدين، بينما قال 19 في المائة فقط من الشريحة المستطلعة الشيء نفسه عن الحزب الديمقراطي.
من ناحية ثانية، يعرّف غالبية الأميركيين أنفسهم بأنهم مسيحيون بنسبة 71 في المائة، بينما الأديان غير المسيحية (بما في ذلك الإسلام واليهودية والهندوسية وغيرها) تشكل مجتمِعةً نحو 6 في المائة من السكان البالغين. وأعلن 23 في المائة من السكان البالغين أن ليس لديهم انتماء ديني. ووفقاً لمسح الهوية الدينية لدى الأميركيين، يختلف المعتقد الديني بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، حيث يقول 59 في المائة من الأميركيين الذين يعيشون في الولايات الغربية إنهم يؤمنون بالله، لترتفع هذه النسبة إلى 86 في المائة في الجنوب.
إعادة تعريف الانتماء
عندما أسّست الولايات المتحدة، كانت تُسمّى بـ«الأمة البروتستانتية»، لكن «البروتستانتية» اكتسبت في الآونة الأخيرة تعريفاً أضيق. إذ بات يعني المتشددين أو البروتستانت «الإنجيليين» الذين يؤمنون بضرورة «الولادة من جديد»، ويؤكدون على أهمية الكرازة وعلى التعاليم البروتستانتية التقليدية حول سلطة الكتاب المقدس وتاريخيته. وفق هذا التعريف الضيق، يمكن القول إنهم ما عادوا يشكلون غالبية، بحسب مصادر متعددة. ووفق هذه المصادر، فإنهم يشكلون اليوم ما يقرب من ربع سكان الولايات المتحدة، وهم يأتون من مجموعات مأخوذة من خلفيات طائفية متنوعة، بما في ذلك الكنائس المعمدانية والنظامية (الميثودية) والإصلاحية وغير الطائفية.
«الإنجيلية» لعبت دوراً مهماً في تشكيل الدين والثقافة الأميركية، وشكلت «صحوتهم» الأولى الكبرى في القرن الـ18، بمثابة ظهور «الدين الإنجيلي» في أميركا الكولونيالية. ووحّدت هذه «الانجيلية» الأميركيين في جميع أنحاء المستعمرات 13 الأولى (التي أصبحت الولايات التي أسس اتحادها نواة الولايات المتحدة الـ50 حالياً) حول إيمان مشترك. ولاحقاً، أدت «الصحوة» الكبرى الثانية في القرن 19 إلى ما أطلق عليه المؤرخ مارتن مارتي «الإمبراطورية الإنجيلية»، وهي الفترة التي سيطر فيها «الإنجيليون» على المؤسسات الثقافية الأميركية، بما في ذلك المدارس والجامعات.
كان «الإنجيليون» في شمال الولايات المتحدة من دعاة الإصلاح بقوة، وشاركوا في حركة الاعتدال، ودعموا إلغاء الرق (العبودية)، بالإضافة إلى العمل من أجل إصلاح التعليم والعدالة الجنائية. في حين انفصل «إنجيليو» الجنوب عن نظرائهم الشماليين بشأن قضية الرق، وأسسوا طوائف جديدة لم تطالب بإلغائه. ويجمع المحللون على أن العامل الرئيسي الذي يقف وراء الدعوة لإلغاء الرق، تعود أسبابه إلى عوامل اقتصادية بحتة. ففي أواخر أربعينات القرن 19 كان للهجرة الكثيفة والتدفق المفاجئ وغير المسبوق للمهاجرين الألمان والآيرلنديين على الولايات المتحدة، أبلغ الأثر على الانخفاض السريع والحاد في أجور اليد العاملة، الأمر الذي هدّد بخفض عدد «الرجال الأحرار البيض» لمصلحة العبيد، وذلك لدى إقدام الأثرياء البيض بزيادة عدد العبيد لاستثمار الأرض. وبسبب هذا الخوف من أن الرق سيدمر الآفاق الاقتصادية للعائلات العاملة البيضاء، نما وتوسع حزب لم يعمر طويلاً كان يسمى «لا نعلم شيئاً»، أو «نو نوثينغ»، لكنه شكل الأرضية لتعزيز قوة الحزب الجمهوري الذي دعم ترشح أبراهام لينكولن وقاد الحرب لإلغاء الرق.
مشهد ديني متغير
حضور الدين في الخطاب السياسي الأميركي تزايد بعد «تسييسه»، لا سيما بين «الإنجيليين» البيض منذ سبعينات القرن الماضي، وسلّط هذا التسييس الضوء على الانقسام العنصري الموجود في الولايات المتحدة. وبحسب «المعهد العام لأبحاث الدين» وهي منظمة غير ربحية وغير حزبية، «لا توجد اليوم جماعة دينية أكثر ارتباطاً بالحزب الجمهوري من البروتستانت الإنجيليين البيض». ومع ذلك، فإن تسمية «إنجيلية» قضية معقدة؛ فهي حركة عابرة للطوائف في الغالب داخل المسيحية البروتستانتية على أساس مجموعة من المعتقدات الأساسية الشخصية: الكتاب المقدس هو مركز الإيمان، والتكفير عن الخطايا بصلب المسيح، والاهتداء الشخصي والخلاص، والمشاركة في الإنجيل الذي منه أخذت هذه الحركة اسمها.
لكن ليس كل «الإنجيليين» اليوم هم من البيض والمحافظين. بل هناك نسبة صغيرة من «الإنجيليين» غير البيض (نحو 25 في المائة) بالإضافة إلى بعض «الإنجيليين» البيض التقدميين (نحو 15 في المائة) يميلون إلى التصويت للديمقراطيين. ومع ذلك، تظهر الإحصائيات تآكلاً بطيئاً في عدد الأميركيين الذين يُعرّفون بأنهم بروتستانت «إنجيليون» منذ تسعينات القرن الماضي، وخاصة لدى الأجيال الشابة. أيضاً، انخفض عدد الكاثوليك ببطء، في حين انهار عدد البروتستانت التاريخيين.
بعض الأكاديميين يناقشون أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الأميركيين الذين لا ينتمون إلى أي دين، وهؤلاء باتوا يساوون عدد «الإنجيليين» إن لم يكونوا أكثر عدداً. لكن باحثين آخرين، مثل لوريك هينيتون، يقولون إنه لا يوجد شيء مشترك سوى أنهم لا يريدون أن يُحسبوا على أنهم ينتمون إلى مجموعة دينية أو لتقاليد راسخة. وأظهر استطلاع أجراه مركز «بيو» عام 2014 أن الملحدين و«اللاأدريين» Agnostics آخذون في الازدياد، لكنهم ما زالوا يمثلون أقل من ثلث اللامنتمين، مما لا يثير الدهشة أن بيرني ساندرز هو المفضل عندهم.
من ناحية أخرى، تظهر بعض الدراسات أن الأجيال الشابة لا تنتسب بشكل متزايد إلى دين أو كنيسة، لكنهم أيضاً من أقل الأجيال إقبالاً على التصويت، ما يقلل من تأثيرهم على الانتخابات. بل حتى لو تزايدت نسبة تصويتهم، كما جرى في الانتخابات النصفية عام 2018، فإن النظام الانتخابي والتقسيم السياسي لأميركا يضخّم قوة الناخبين البيض والريفيين والمسيحيين المحافظين، عبر تقسيمات إدارية للمقاطعات تمكن الأقلية في الولايات القليلة السكان من التحكّم بنتائج الانتخابات. ومن ثم، يُرجّح أن يستمر الدين في لعب دور رئيسي في الانتخابات الأميركية لسنوات مقبلة، وأن ستستمر «الآلة القومية المسيحية» في دفع دونالد ترمب لجعل الهوية الدينية عنصراً أساسياً في حملته، على حد قول الباحثة كاثرين ستيوارت، وفي المقابل، يسمح لمنافسه جو بايدن باستخدام «تسامحه الديني» لاستقطاب القاعدة المؤمنة.
مرحلة رونالد ريغان
خلال العقود الأخيرة أصبح التديّن أكثر وضوحاً في البيت الأبيض. لقد كان رؤساء الولايات المتحدة يتذرّعون بالإيمان والله منذ أن أعرب جورج واشنطن عن «توسلاته الحارة لهذا القدير الذي يحكم الكون» في خطابه عام 1789. غير أن استخدام اللغة الدينية وحتى الإشارات الصريحة إلى الله قد ازدادت في الخطاب الرئاسي منذ الثمانينات. ويرى باحثون أن عبارة «بارك الله في أميركا»، وهي العبارة الأكثر وضوحاً التي تربط بين الله والوطن، تزايدت بشكل كبير، وباتت متوقعة في جميع الخطابات الرئيسية، بينما كانت شبه غائبة قبل رونالد ريغان. وبحسب دراسة حديثة أجراها الباحث سيري هيوز، يبدو أن هذا الاتجاه أكثر وضوحاً مع دونالد ترمب... الذي رغم ادعائه الانتماء إلى الطائفة البروتستانتية المشيخية، هناك أدلة كثيرة تشير إلى أنه أقل الرؤساء التزاماً دينياً في العصر الحديث. وفي هذا السياق، فإنه يستدعي الدين أكثر من غيره، في استراتيجية استخدمها بشكل ناجح عام 2016؛ فقد صوّت 81 في المائة من «الإنجيليين» البيض لصالح ترمب، ووعد بالدفاع عنهم في الحروب الثقافية، لا سيما في مواضيع الإجهاض وحقوق مجتمع المثليين والصلاة المدرسية.
وبخلاف ترمب، حدد جميع رؤساء العصر الحديث أنهم «مسيحيون بروتستانت»، باستثناء جون كينيدي (الرئيس الكاثوليكي الوحيد) الذي ظهر أن «كاثوليكيته» كانت قضية حملته الانتخابية. من ناحية أخرى، لم ينل أي شخص يهودي ترشيحاً رئاسياً من أي حزب كبير (فقط حصل جوزيف ليبرمان على ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس في عام 2000)، في حين لم يخلُ من جدل انتماء ميت رومني المرشح الجمهوري في عام 2008 إلى طائفة المورمون.
في أي حال، ولئن كان لا يزال هناك تشكيك في أهمية الدين والدور الذي يلعبه في السياسة الأميركية، فإن تركيبة الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، تعطي صورة واضحة عن هذا الدور. ومع أن الكونغرس الحالي الـ116 يُعتبر الأكثر تنوّعاً على المستوى الديني، فإنه يظل مسيحياً بأغلبية ساحقة قياساً حتى لعدد سكان الولايات المتحدة؛ فهناك 88 في المائة من أعضائه من المسيحيين، مقابل 71 في المائة من السكان الأميركيين البالغين. وهناك مشرّع واحد منتخب فقط في مجلس الشيوخ: السيناتورة كيرستن سينيما (ديمقراطية من ولاية أريزونا)، تعلن أنها لا دينية، في حين لا يوجد أي مشرّع يصف نفسه بالملحد. وحتى النائبة اليسارية النيويوركية إلكساندريا أوكاسيو كورتيز دائماً ما تذكّر بإيمانها الكاثوليكي وتقتبس تعابير من الإنجيل وتنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
المتدينون أنشط اقتراعاً
وإذا كان من الصعب معرفة اتجاهات التصويت لدى المتدينين الأصوليين، خصوصاً من «الإنجيليين»، وهو ما لعب دوراً كبيراً في فشل استطلاعات الرأي التي توقعت فوز هيلاري كلينتون على ترمب عام 2016، فإنهم «يميلون إلى الانخراط في النشاط السياسي بمعدلات أعلى من متوسط الأميركيين».
كذلك، رغم أن الاعتقاد السائد بأن الناخبين المتدينين يصوتون دائماً للجمهوريين، فهذا لا يصح دائماً. فالتصويت لمصلحة هذا الحزب أو ذاك يعتمد بشكل ملحوظ على الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وبالنسبة للأشخاص المتدينين ذوي الدخل المنخفض، لا يوجد تقريباً أي ارتباط بين معتقداتهم الدينية وقرارهم في التصويت. إذ حقق جورج بوش الأبن (الطائفة النظامية) فوزا ضئيلاً جداً على منافسه جون كيري، حين لم يلعب الاستشهاد «بالقيم الأخلاقية» دوراً كبيراً في حض القاعدة الانتخابية المتدينة على التصويت بكثافة لبوش. ونسب فوزه مباشرة إلى الجماعات الأصولية المسيحية الذين أطلق عليهم تسمية «المحافظون الجدد»، وليس للمتدينين عموماً. من جهة أخرى، أشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب» عام 2019. إلى أن 60 في المائة من الأميركيين على استعداد للتصويت لرئيس ملحد. في حين أن أبحاثاً كثيرة تظهر أن الأميركيين ينظرون للمرشحين الذين يُعتبرون متدينين بأنهم جديرون أكثر بالثقة.
الواقعان السياسيان لليهود... والمسلمين
> يشكل تعداد اليهود في الولايات المتحدة ما يصل إلى 2.1 في المائة من السكان. ولقد سجل هذا التعداد انخفاضاً كبيراً من أكثر من 3 في المائة في الخمسينات، ويرجع السبب أساساً إلى انخفاض معدل المواليد نسبياً بين اليهود الأميركيين وارتفاع معدلات الزواج المختلط من غير اليهود.
مع هذا، ما زال اليهود يلعبون دوراً مؤثراً في الحياة السياسية الأميركية لأسباب عدة متشعبة، يتداخل فيها العامل الآيديولوجي مع السياسي والاقتصادي. وبينما كان المهاجرون اليهود الأوائل من ألمانيا يميلون إلى أن يكونوا محافظين سياسياً، كانت موجة يهود أوروبا الشرقية التي بدأت في أوائل ثمانينيات القرن 19 أكثر ليبرالية أو يسارية بشكل عام، وأصبحت الغالبية السياسية. لقد جاء العديد من هؤلاء إلى أميركا من ذوي الخبرة في الحركات الاشتراكية والفوضوية والشيوعية بالإضافة إلى حزب العمال، المنبثق من أوروبا الشرقية. وصعد العديد من اليهود إلى مناصب قيادية في الحركة العمالية الأميركية في أوائل القرن العشرين وساعدوا في تأسيس نقابات لعبت دوراً رئيسياً في سياسة اليسار ثم بعد عام 1936، في سياسات الحزب الديمقراطي.
بعد تلك الفترة كانت الغالبية العظمى من اليهود في الولايات المتحدة متحالفة مع الحزب الديمقراطي. وقبيل نهاية القرن 20 وبداية القرن 21. أطلق الجمهوريون مبادرات بدأت تؤتي ثمارها لجذب اليهود الأميركيين بعيداً عن الحزب الديمقراطي. ولعل العلاقة الخاصة التي باتت تربط ترمب بإسرائيل وسلسلة القرارات السياسية المهمة التي اتخذها سواء في ملف السلام أو في قضية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقله السفارة الأميركية إليها واعترافه بحقها في ضم أراضي الجولان السورية المحتلة، شكلت كلها علامات فارقة، كان بالإمكان رؤية تأثيرها في الخطابات التي ألقيت في الاجتماعات السنوية للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية «أيباك».
ماذا عن المسلمين؟
أما عن المسلمين، ففي عام 2006. أصبح كيث إليسون أول مسلم ينتخب في مجلس النواب الأميركي، كممثل عن الدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا، وأصبح لاحقاً رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي. وعند إعادة تصوير أدائه اليمين استخدم نسخة من القرآن كان يملكها الرئيس توماس جيفرسون.
بعدها، أدت انتخابات مجلس النواب عام 2018 إلى دخول نائبتين مسلمتين مجلس النواب هما إلهان عمر (من أصل صومالي) ورشيدة طليب (من أصل فلسطيني). ولكن حتى الساعة لا يمكن الحديث عن دور كبير يلعبه المسلمون في الحياة السياسية الأميركية، خاصة، أنهم يشكلون أقلية لا تزيد نسبتها على 2 في المائة، سوادهم الأعظم من المهاجرين وأطفال المهاجرين. من ناحية ثانية، معظم منظماتهم التي تشكلت في العقود الأخيرة، وهي لا تزال تسعى إلى الموازنة بين لعب دور سياسي من ناحية، ورفع صفة الإرهاب عنهم من ناحية ثانية. وراهناً توجد عدة منظمات إسلامية أميركية متعددة التوجهات، بعضها يوصف بالمعتدل وبعضها الآخر يتهم بالتشدد والارتباط بقوى سياسية في العالم الإسلامي.