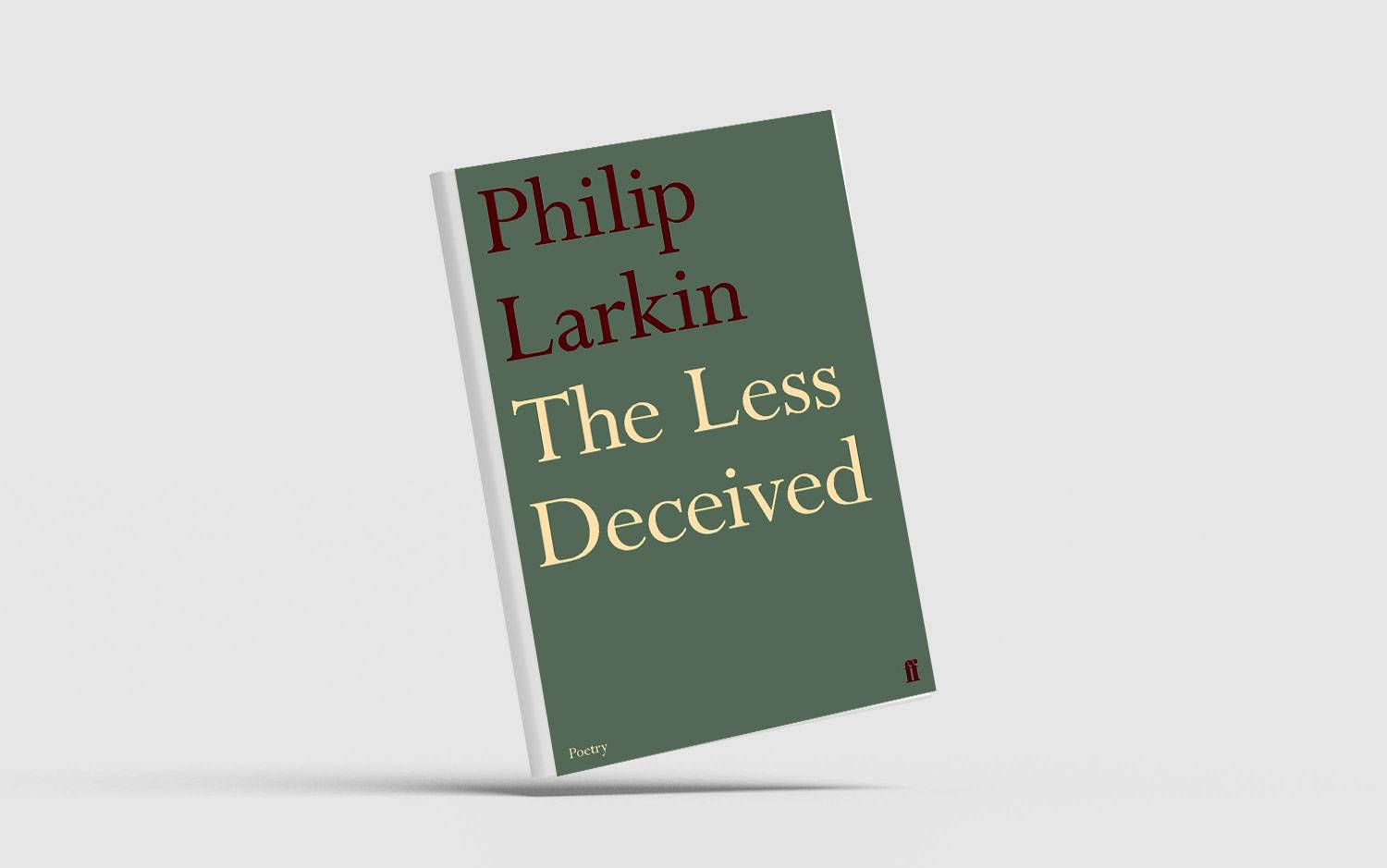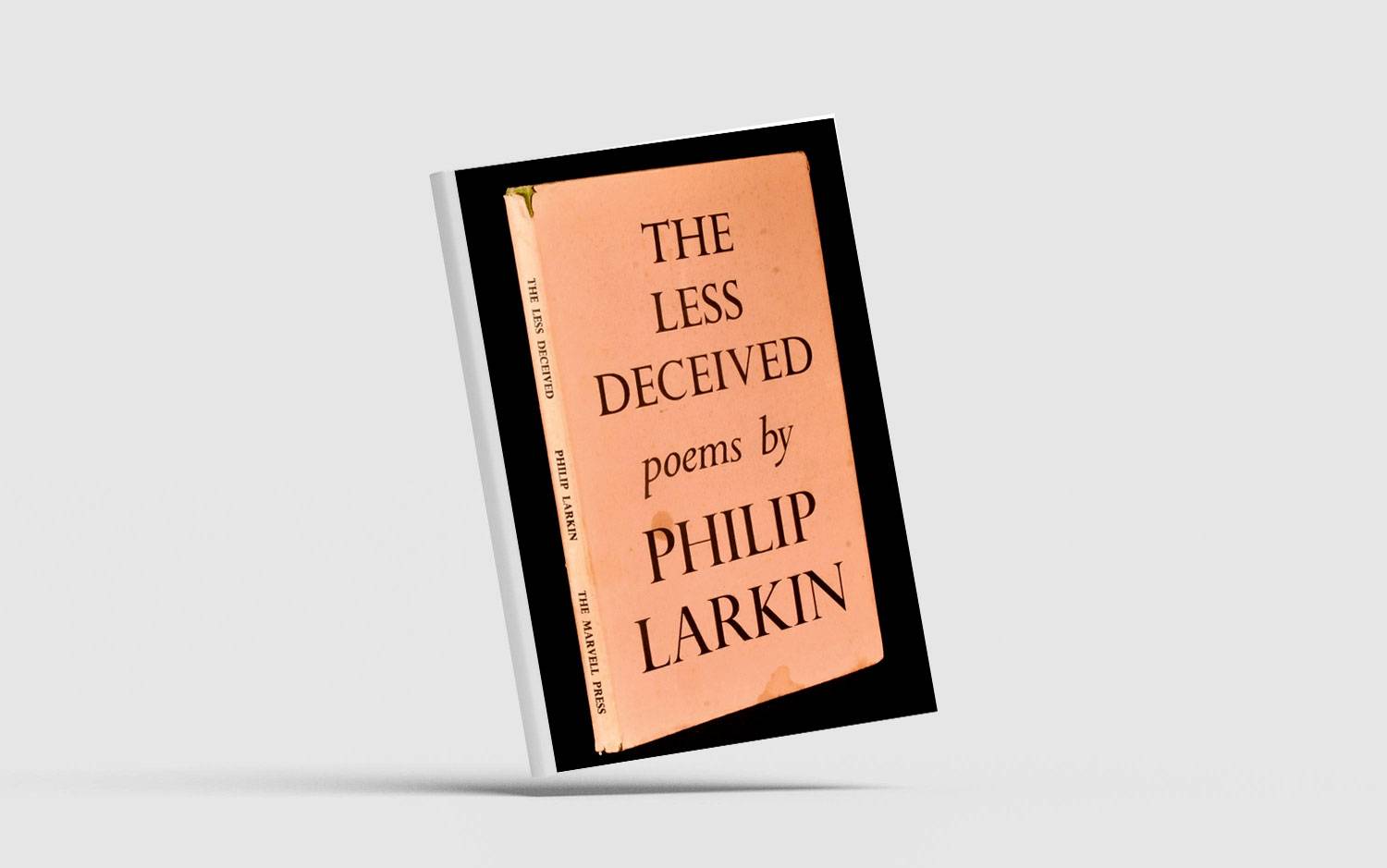البحث عن غزة في الرواية يقود صاحبه إلى متاهة، وقليل من الإجابات، بعضها واضح ومحدد ودقيق، وبعضها الآخر يشبه بيانات الفصائل الفلسطينية ويتمثل خطابها. فغزة المحاصرة منذ أكثر من 7 سنوات، تبدو مغلقة على أدبائها. لم يساعدهم نشر أعمالهم محليا على اجتياز الحدود. وسعوا، في زمن الاحتلال الإسرائيلي المباشر، إلى «تهريب» بعض إنتاجهم، من القصة القصيرة غالبا، إلى الخارج سعيا وراء نشره أو توزيعه. لكنه لم يصل إلى الخارج المتاخم لغزة، أو البعيد عنها وراء البحار. وفي هذا المجال، يشير الدكتور عادل الأسطة، أستاذ الأدب الحديث والنقد في جامعة النجاح الوطنية، وهو متابع دؤوب لما يصدر من أعمال روائية في فلسطين وخارجها، إلى صعوبة متابعة الأدب الصادر في قطاع غزة، وبخاصة الرواية، منذ انقطاع الاتصال بين القطاع والضفة الغربية، في السنوات الـ14 الأخيرة؟
غير أن انتشار الرواية «الغزاوية» لم يتحقق، حتى في زمن الانفجار التكنولوجي واتساع شبكات التواصل الاجتماعي. إذ تباطأت الرواية المكتوبة في غزة، وعنها، في اللحاق بروايات كتبها فلسطينيون آخرون في الضفة الغربية، وفي الأردن، وفي الشتات أيضا، نافست الرواية العربية على غير مستوى. لم تصل الرواية «الغزاوية» إلى الناشر في الخارج، ولم يتقدم منها الناشر خطوة واحدة، مع أن «إيميلاً» واحدًا يحمل ملفًّا، قادر على اختراق الحدود وتجاوز الحصار.
وباستثناء 3 روايات كانت غزة مسرح أحداثها، أو جانبا من مسرحها، لم تتوفر في الخارج، روايات عن غزة. والروايات الـ3، كتب اثنتين منها فلسطينيا الأصل، والثالثة إنجليزي، وهي: «Out of It» أو «خارجها»، أي غزة، لسلمى دباغ، الفلسطينية الأصل، المولودة في اسكوتلندا، وصدرت بالإنجليزية عن دار «بلومزبري، في ديسمبر (كانون الأول) 2011. و«السيدة من تل أبيب» لكاتب هذه السطور، وهي الرواية الفلسطينية الوحيدة عن غزة، المترجمة من العربية إلى الإنجليزية. و«Grave in Gaza»، أو «قبر في غزة»، للبريطاني مات بينون ريس، الذي فاجأ الفلسطينيين قبل أن يفاجئ الغرب بثلاث روايات «فلسطينية بوليسية، تدور أحداث اثنتين منها في الضفة الغربية، وواحدة في غزة».
فأي شوط قطعه الروائيون الفلسطينيين المقيمون في غزة في الكتابة عنها؟ وماذا كتبوا؟ وما سمات ما كتبوه؟ ولماذا بقيت كتاباتهم بعيدة كل هذه المسافة عن القراء في الضفة والبلاد العربية والعالم؟
* القصة القصيرة أولا
في يوليو (تموز) الماضي، صدر عن دار «كوما برس»، بالإنجليزية، كتاب «ذي بوك أُف غازا»، وضم 10 قصص قصيرة مترجمة، لكتاب من غزة من أجيال مختلفة. بعدها، زار لندن الروائي والقاص عاطف أبو سيف، الذي حرّر الكتاب. في مقابلة خاصة معه أجرتها {كوما برس}, تحدّث أبو سيف عن تطور الأشكال الأدبية في كتابات غزة خلال القرن الماضي. وأجاب عن بعض ما طرح هنا من أسئلة. ومما قاله أنقله بتصرف: إن الكتّاب ومنذ مطلع سبعينات القرن الماضي كتبوا القصة القصيرة، «فالرواية كبيرة وتهريبها إلى الخارج (في ظروف الاحتلال) صعب». أما الروايات التي كتبت في السبعينات والثمانينات فلم تكن تزيد على 70 صفحة، وحتى 55 أحيانا. بمعنى آخر، هي «قصص قصيرة» طويلة. ولم تكن سمات شخصياتها واضحة، بل غالبا متشابهة ومكررة. «شخصيات لا تمثل ذاتها أو تعبر عنها، بل تمثل أفكارا». أما الروايات، فهي روايات ذاكرة، تحاول استعادة الماضي بإعادة إحياء ما جرى تدميره خلال النكبة. أي استحضار المكان الذي غاب منذ نكبة 1948. فسعى أحمد عمر شاهين مثلا، إلى استعادة صورة يافا. وجعل جبرا إبراهيم جبرا من السفينة مكانا. وذهب غسان كنفاني إلى حيفا في «عائد إلى حيفا». يقول أبو سيف: الرواية تحتاج إلى استقرار، ومجتمع مستقر، وعلاقات اجتماعية واضحة. وقد تحقق شيء من هذا بعد عام 1995 حين تشكلت سلطة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حقّقت بعض الاستقرار. فظهرت سمات أوضح لشخصيات روائية، وظهر المكان الذي غاب في أعمال ما قبل هذا التاريخ.
* شعارات سياسية
أما الدكتور عادل الأسطة، فقال لـ«الشرق الأوسط»: لم تصدر في غزة، في القرن العشرين، روايات كثيرة. وما صدر منها تحت الاحتلال وفي ظل السلطة الفلسطينية، ظل ضعيفا إلى حد ما. والذين كتبوا روايات كانوا حقا من كتاب القصة القصيرة، أولهم وأبرزهم كان غريب عسقلاني، وعبد الله تايه، ومحمد أيوب. ونادرا ما تجاوز أي من رواياتهم الـ140 صفحة. وقد كتب هؤلاء عن معاناة الناس تحت الاحتلال، كما في رواية غريب عسقلاني «الطوق»، وهي من أولى الروايات، وكما في رواية محمد أيوب «الكف تلاطم المخرز» التي حضر فيها الشعار السياسي أكثر من الجانب الفني. ورأي الأسطة أن الرواية تحت الاحتلال، والأدب بشكل عام، ظلا ضعيفين، وظلت الرواية أقرب إلى القصة الطويلة منها إلى الرواية. ومع انقطاع الاتصال بين الضفة وغزة، في السنوات الـ14 الأخيرة، أصبحت متابعة الأدب الصادر هناك، بخاصة الرواية، أمرا صعبا. لقد تمكنا من قراءة «السيدة من تل أبيب»، وهي عن غزة، قبل أن نتمكن من قراءة روايات لروائيين جدد، مثل خضر محجز، وعاطف أبو سيف. ورواياتهم لم تحقق الانتشار الذي حققته «السيدة من تل أبيب» التي بقيت الأكثر حضورا وتمثيلا لصورة غزة في الرواية. ويضيف: «أعتقد أن مأساة غزة كبيرة جدا، وقد لامست الروايات الصادرة هناك الجرح ومعاناة الناس. لكن الجرح كبير وعميق بحيث يحتاج إلى عشرات الروايات لتعبر عنه. ونظرا لأن الرواية ليست كالشعر، وتحتاج إلى فترة طويلة لتمثل الحدث، فإن الأيام المقبلة قد تأتي لنا بروايات أخرى».
وذكّر الدكتور عادل بثلاثية السبعاوي، التي قال إنها «لم تصور معاناة غزة في اللحظة الراهنة، إذ عاد (الكاتب) إلى فترات زمنية سابقة ليكتب عنها، وبقيت رواياته ضعيفة إلى حد ما، ولم ترق إلى جرح المدينة».
* مضامين نضالية
ويميل الروائي عبد الله تايه، إلى تأكيد «الدور النضالي» للرواية «التي وثّقت متغيرات المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة وتحولاته في مراحله النضالية المختلفة، من خلال إبداعات كتابها. فكانت الذاكرة وحفظها من أهم وسائل التصدي للمحتل، فالرواية تتحمل كل التفاصيل، وتعتبر (...) من المصادر الهامة والصادقة والصادمة، لكل راغب في دراسة تحولات المجتمع في غزة». ويقول تايه إن جيل السبعينات من الكتاب اعتمد على التثقيف الذاتي، ورصد ما يدور من تحولات في القطاع. ويلتقي مع الأسطة وأبو سيف في تأكيد أسبقية القصة القصيرة، عند الجميع، على الرواية التي تحولوا إلى كتابتها لاحقا، «نظرا لاتساع فضائها وإمكاناتها في استيعاب ما يودون التعبير عنه». وقد كانت مخيمات قطاع غزة وأحياء المدينة الفقيرة، المكان الجغرافي لروايات تلك الفترة، و«مادتها التي سجلت المتغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصورت المقاومة وألوانها، والنماذج الإنسانية وتنوعاتها، بفقرها وبؤسها في أزقة المخيمات، حيث المتطلعين إلى الحرية، بكل تشابك علاقاتهم وصراعهم مع المحتل ومع الحياة نفسها».
ويشير تايه إلى الروائيين الطليعيين، فيذكر شخصه وروايته «الذين يبحثون عن الشمس» 1979، كأول رواية صدرت بعد الاحتلال، و«العربة والليل» 1982، و«التين الشوكي ينضج قريبا» 1983، و«وجوه في الماء الساخن» 1996، و«قمر في بيت دراس» 2001. ثم الروائي غريب عسقلاني وروايته «الطوق» 1979، و«زمن الانتباه» 1983، و«زمن دحموس الأغبر» 1996، التي أتت على النماذج الإنسانية السلبية في التنظيمات الثورية والدينية، ورواية «نجمة النواتي» 1996 التي تحدثت عن الحالة السياسية في غزة ومخيماتها في الستينات وانعكاسها على الشرائح الاجتماعية، خصوصا البرجوازية المثقفة، ورواية «جفاف الحلق» 1998، عن تهجير أهل المجدل عسقلان إلى غزة، ورواية «عودة منصور اللداوي» 2003، وتبحث في التطورات الوجدانية والسياسية للمقاومة المسلحة من بداياتها حتى قيام السلطة، ورواية «ليالي الأشهر القمرية» 2005، وتحكي عن العودة المنقوصة لبطلها الذي لم تعده اتفاقيات أوسلو إلا للمخيم الذي خرج منه. تلا ذلك بعض الكتاب الذين قدموا نماذج في هذا السياق منهم، حسب تايه، محمد أيوب في روايته «الأحزان تأتي في حزيران»، وعلي عودة في رواية «بكاء العزيزة»، ومحمد نصار في رواية «سوق الدير».
* من قلب المعاناة
ويرى الباحث والناقد ناهض زقوت أن إنتاج الرواية في قطاع غزة تأخر بسبب الظروف السياسية التي مر بها القطاع، «فقد كان القطاع هو الحاضنة الأكبر لجموع اللاجئين الفلسطينيين عام 1948، وهؤلاء هم الذين أنتجوا الرواية في نهاية السبعينات بعد أن استقرت أوضاعهم المعيشية، وهذا ما تحتاج إليه الرواية لكي تنمو وتنتعش وتعبر عن الواقع».
ويتفق زقوت مع تايه وآخرين في أن «واقع الاحتلال وممارساته العدوانية والعنصرية يكاد يكون من أكثر القضايا التي ألح الروائيون على تناولها في قطاع غزة، بالإضافة إلى النكبة وتداعياتها وواقع اللاجئين وأحوالهم في المخيمات، والعمليات النضالية، والأوضاع الاجتماعية والمعيشية». ويري أن الروائي في قطاع غزة «استطاع أن يخلق لغته ووسائل للتعبير تحمل بصمته أو رؤيته الفردية (...) فهو لم يكتب الرواية من الخارج تصويرا أو تعبيرا أو تخيلا، إنما كتب من الداخل من قلب المعاناة ومن العيش على أرض الواقع أو من خلال الاكتواء بنارها».
ويؤكد زقوت على أن ما يزيد عن مائة رواية لنحو 50 كاتبا كتبت في غزة في الفترة من عام 1975 حتى عام 2003، إلا أنه ونتيجة لافتقار غزة إلى دور النشر فقد كان أغلب هذه الروايات يطبع في القدس، وما طبع في غزة كان قليلا، وطُبع على نفقة مؤلّفه.
ويضيف زقوت أن كتّاب غزة تناولوا واقع السلطة الوطنية وما أفرزته من إيجابيات وسلبيات، ويقول إنهم «كانوا سباقين في تناول هذا الواقع بعدد لا يستهان به من الروايات، حيث صدر في فترة من 1996 وحتى 2005 نحو 55 رواية لـ26 روائيا.