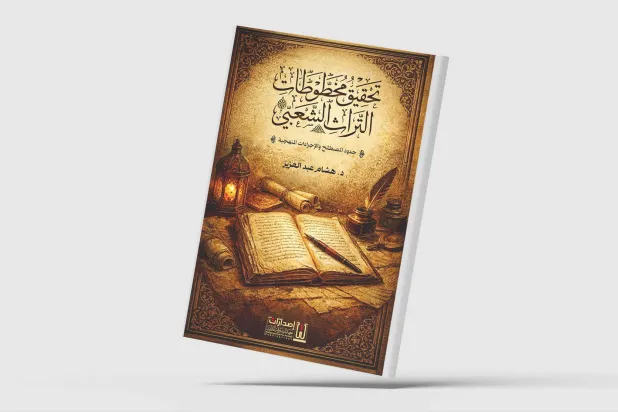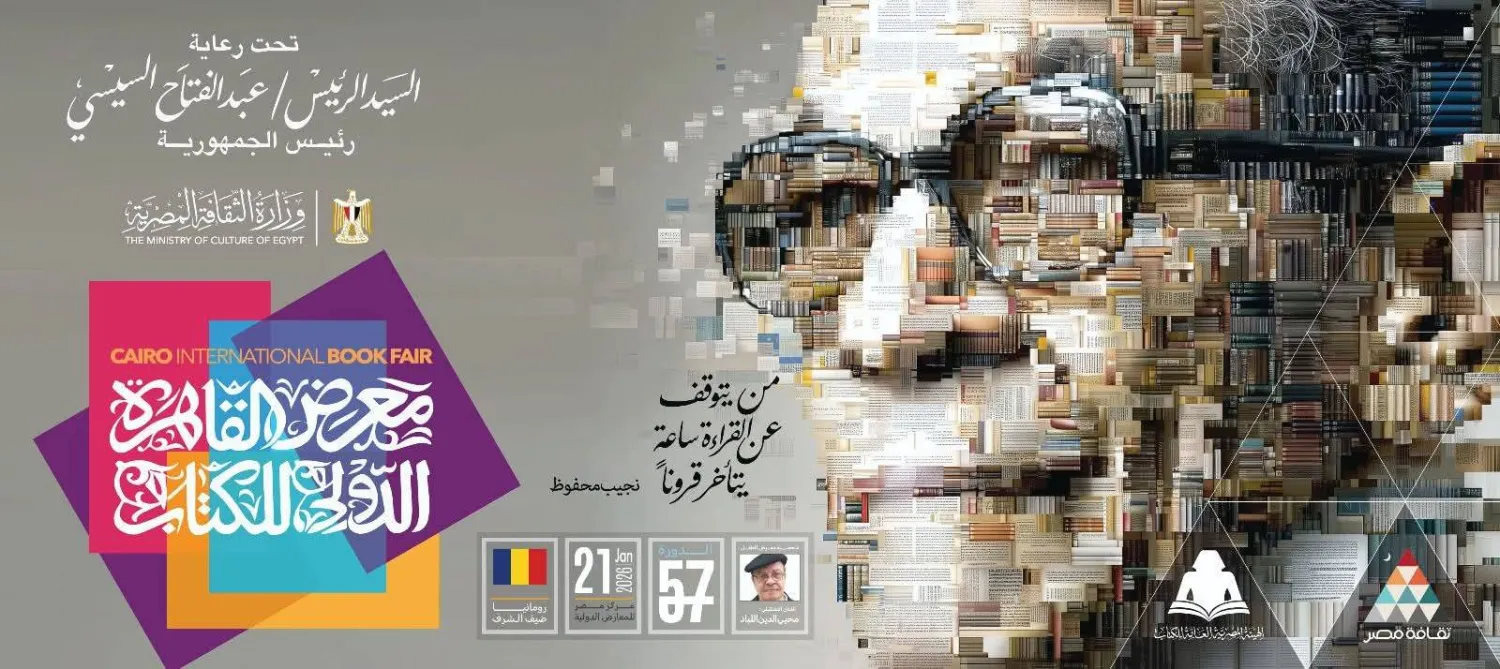قد لا يكون الزمن مثالياً للكتابة عن قصة حب بين شاب طموح وأستاذة رقيقة وجميلة؛ لكنها في عمر أمه.
أغرم بها وهو على مقاعد الدراسة الثانوية. كانت أستاذته في فن المسرح في مدينة أميان الواقعة شمال باريس. هي أستاذة لغات قديمة وأدب ومسرح. متحدرة من عائلة من البورجوازية الريفية المتوسطة. متزوجة ولها ابن وبنتان. وهو تلميذ نحيل القامة، متوسطها، متفوق في الدراسة وشغوف بالمطالعة. واسع «الحشرية»، راغب في الغَرف مما هو متاح، ولكن أيضاً مما هو غير متاح. والده طبيب معروف وأمه ممرضة. انتمى صدفة إلى نادي المسرح في ثانوية المدينة التي تحتضن إحدى أجمل كاتدرائيات فرنسا وأوروبا. هو يتمتع بإحساس مرهف. عينان زرقاوان وجسم نحيل متوسط القامة. ولأنه يحب المسرح ويرغب في التمثيل، فقد توطدت علاقته بأستاذته.
هي رأته متفرداً، وهو رآها متميزة. أقنعها بأن تشاركه في إخراج مسرحية أعادا معاً كتابتها في منزلها، مساء كل يوم جمعة. ألهبت مشاعره وحفزته للاعتراف بولعه بها. بينهما نمت علاقة فريدة.
حاجز السن الذي عنوانه 24 سنة فاصلة بينهما طوَّعاه معاً. أرادها أن تترك زوجها وتلتحق به. الأمر لم يكن رائجاً في بيئة بورجوازية محافظة. أرادها له وحده، وألح عليها لكي تترك زوجها، فكان له ما أراد.
في 20 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2007، تزوج إيمانويل ماكرون بريجيت ترونيو، مطلقة أندريه لويس أوزيير، والد أولادها الثلاثة. هو في مقتبل العمر ولامس الثلاثين. وهي امرأة ناضجة في الـ54 من عمرها. الزواج حصل في مقر بلدية مدينة «لو توكيه»، وهي منتجع صيفي بورجوازي يطل على بحر المانش؛ حيث تملك بريجيت منزلاً ورثته عن والدها، وقد أصبح اليوم «محجة» للزوار، بمن فيهم الإنجليز الذين تضج بهم المدينة كل نهاية أسبوع وخلال الفرص الكبرى.
كُتب الكثير عن إيمانويل وبريجيت ماكرون؛ خصوصاً منذ أن دخلا معاً إلى قصر الإليزيه يوم 17 مايو (أيار) من عام 2017، بعد انتخابه رئيساً للجمهورية وهو لم يبلغ الأربعين من عمره، بحيث بات أصغر رئيس فرنسي منذ تأسيس الجمهورية الخامسة في خمسينات القرن الماضي.
لكن الكتاب الصادر حديثاً تحت عنوان: «السيدة الرئيسة»، لمؤلفتيه الصحافيتين أفا جمشيدي وناتالي شوك، جاء مختلفاً، إذ نجحتا في الدخول إلى قلب هذه العلاقة الاستثنائية. وينضح الكتاب، في كل صفحة من صفحاته، بإعجاب المؤلفتين بشخصية هذه المرأة التي كان قدرها أن تكون معلمة وزوجة وأُماً، وليس أكثر من ذلك. ولكن تلميذها الموهوب، ليس فقط في الدراسة أكان في المرحلة الثانوية أو لاحقاً؛ حيث انتمى إلى معهد العلوم السياسية في باريس، ثم إلى معهد الإدارة العالي الذي يخرج كبار كوادر ونخب البلاد. أدخلها سريعاً إلى دائرة الضوء خلال مشواره المهني: موظفاً رفيعاً في دائرة التفتيش المالي، ثم مصرفياً في أحد أعرق المصارف (بنك روتشيلد في باريس)، ومن هناك التحاقه بالمرشح الرئاسي الاشتراكي فرنسوا هولاند الذي وعده بأن يكون «الشخص الثالث» في الإليزيه في حال انتخابه، وهو ما حصل. ومن مستشار اقتصادي للرئيس، أصبح ماكرون وزيراً للاقتصاد في صيف عام 2014 وحتى صيف عام 2016؛ حيث أطلق حركته السياسية «فرنسا إلى الأمام». وبعد أقل من عام، أصبح رئيساً للجمهورية في انتخابات فريدة من نوعها.
هكذا، بسحر ساحر، أصبحت هذه السيدة الشقراء، نحيلة القامة، في سن الـ64 عقيلة رئيس الجمهورية التي تُفتح أمامها الأبواب، ولا يُرد لها طلب. تدور على عواصم العالم مع زوجها وتستقبل كباره. آمرة ناهية. قبلة الصحافة الشعبية، وصورها تغزو المجلات مصقولة الورق، ويتسابق الإعلاميون والإعلاميات ليحظوا بجملة منها أو بمقابلة.
تتبارى كبار بيوتات الأزياء لإقناعها بارتداء أجمل ما تحيكه معاملها. هي صورة فرنسا في الخارج. دخلت العمل الإنساني. بدَّلت وجددت في قصر الإليزيه، ولم تتردد في أن تطلب استبدال أطباق المائدة الرئاسية حتى تليق بالمطبخ الفرنسي الشهير؛ لكن الكلفة جاءت في زمن عصر النفقات منتفخة؛ إذ وصلت إلى نصف مليون يورو، ما عزز قول القائلين بأن ماكرون «رئيس الأغنياء». وذهب بعضهم إلى تسميتها «ماري أنطوانيت»، زوجة ملك فرنسا لويس السادس عشر التي ردت على من يقول لها إن الفرنسيين يفتقدون الخبز ولا يجدون ما يأكلونه، بقولها: «ليأكلوا البسكويت». وقد انتهت الملكة والملك على المقصلة التي كانت منصوبة في ساحة الكونكورد الحالية في باريس، على بعد رمية حجر من قصر الإليزيه.
لكن هل هذه هي حقيقة بريجيت؟ والسؤال الأهم الذي يمثل الإشكالية التي يدور حولها الكتاب، يمكن اختصارها بهذا السؤال: من صنع من؟ هل استمرت بلعب دور الأستاذة وهو التلميذ؟ أم أن التلميذ تحرر من الوصية؟ هل يستفيد من صورتها أم أنها فقط هي التي تستفيد من موقعه؟
تنقل المؤلفتان عن مصدر مقرب من الثنائي قوله: «إيمانويل يدين بكل شيء لـبريجيت. لقد أصبح رئيساً بفضلها. لقد (أنسنت) صورته، ووفرت له الدخول إلى منازل الفرنسيين وقلوبهم». ويضيف آخر: «إنها المرأة الوحيدة التي ساعدت زوجها وساهمت في انتخابه. هي تمثل العالم الجديد والحداثة، بينما هو أصبح كهلاً في سن العشرين. إنها ضمانته العاطفية وهو الضمانة العقلانية».
ويسهب الكتاب في سرد الأحداث التي تبين كم أن الرئيس الشاب حرص على أن يسمع رأي زوجته في كل ما يقوم به. فعندما اقترح عليه الرئيس السابق فرنسوا هولاند أن يصبح وزيراً طلب منه وقتاً ليستشير زوجته. وعندما أراد خوض مغامرته الرئاسية كانت مستشارته، وهي التي شجعته على ذلك وأخذت بيده. وخلال الحملة الرئاسية كانت دائمة الحضور.
كانت تراجع معه خطاباته، ولا تتردد عن انتقاده إن رأت أنه أطال أو بقي غامضاً. كانت تدربه على إيجاد المستوى الصوتي الملائم، ولطالما عبرت له عن تحفظها على ما قاله أو الطريقة التي استخدمها لإيصال رسالته. كانت تنتقد نسق عمله الذي لا يتوقف عندما كان وزيراً ثم مرشحاً، ولاحقاً رئيساً.
ويروي الكتاب أن مستشاري ماكرون كانوا يشعرون بالسعادة عندما ترافق الرئيس في رحلاته الرسمية إلى الخارج؛ لأنهم كانوا يتيقنون أنه لن يفرض عليهم العمل طوال فترة الرحلة مهما طالت، وإلى أي ساعة تواصلت. إذ إن بريجيت كانت تقترب من الرئيس لتقول له: «كفى تعذيباً لهؤلاء المساكين. اتركهم يرتاحون قليلاً». وليس سراً أن ماكرون مصاب بهوس التواصل مع الوزراء والمستشارين ليلاً نهاراً، وفي ساعات متأخرة جداً من الليل. والويل الويل للوزير أو المستشار الذي يحضر اجتماعاً ولا يكون متمكناً من ملفه بالكامل.
مع تواتر الصفحات، يتبدى بوضوح حرص بريجيت على أن تكون دوماً قريبة من إيمانويل إلى درجة أنها تلح دوماً على مستشاريه ومساعديه بأن يوفروا لهما بعض الوقت بين المواعيد الرسمية ليتلاقيا على انفراد. ثم إنها حريصة على مراقبة نوعية الطعام الذي يتناوله، وهي مثلاً تفرض على العاملين في المطبخ الرئاسي أن يحضروا يومياً عشرة أنواع من الخضراوات والفاكهة.
زوجته فتحت له الأبواب والنوافذ على الثقافة والمثقفين وأهل الفن، وقررت أنه يتعين دعوة فرقة موسيقية أو مسرحية أو مغنٍّ على الأقل مرة في الشهر، في إطار «أمسيات الإليزيه» حتى يعود المقر الرئاسي «صديقاً» للفن والثقافة. وليس سراً أن بريجيت ماكرون، كونها كانت تدرس فن التمثيل، لها علاقات واسعة مع شرائح عديدة في قطاع الفن؛ خصوصاً المسرح. وقبل يومين فقط من فرض الحجر في المنازل، في إطار مكافحة وباء «كورونا»، شوهد الرئيس وزوجته في أحد مسارح وسط العاصمة، لحضور الحفلة الافتتاحية لمخرج صديق لـبريجيت ماكرون.
وتروي المؤلفتان أن بريجيت فرضت على زوجها قضاء عطلة نهاية الأسبوع خارج قصر الإليزيه. ولحسن الحظ، فإن الرئاسة تشغل مقراً ملاصقاً لقصر فرساي، يسمى «لانتيرن» وهو يبعد حوالي نصف ساعة من قلب باريس بالسيارة. وهذا المقر الذي تحيط به أسوار عالية يعد مرتعاً مثالياً. فهو يقع في قلب غابة، ويتميز داخله بالأناقة والحداثة والتجهيزات اللازمة، بما في ذلك ملعب لكرة المضرب (تنس) ومسبح. وكان المقر سابقاً تابعاً لرئاسة الحكومة؛ إلا أن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي «وضع» اليد عليه، وأصبح بالتالي في عهدة رئيس الجمهورية.
وفي هذا المقر، كان الرئيس الأسبق فرنسوا ميتران يخفي ابنته غير الشرعية مازارين بينجو عن الأعين، وإليه «هربت» فاليري تريفيلر، رفيقة درب فرنسوا هولاند، بعد أن اكتشفت «خيانته» لها مع الممثلة جولي غاييه. وتقول المؤلفتان إن بريجيت ماكرون «وقعت في حب المكان» وتحرص على الوجود فيه كلما سنحت لها ولزوجها الفرصة. كذلك، فإن زوجة الرئيس أحبت المقر الصيفي الموضوع بتصرف الإليزيه، وهو «حصن بريغونسون» المطل على مياه المتوسط. إلا أن رغبة الزوجي الرئاسي تزويد الحصن بمسبح، أثارت لغطاً في فرنسا، وأعادت إلى الأذهان صورة الرئيس الباذخ الذي كان ينفق ما لا يقل عن عشرين ألف يورو لغرض الماكياج.
حقيقة الأمر أن الفرنسيين دهشوا عندما خرجت بريجيت ماكرون إلى دائرة الضوء. كانوا يعتبرون أنها امرأة بورجوازية محافظة إلى حد ما، رغم أنها بدت «ثورية» عندما استجابت لنداء قلبها وتركت زوجها لتعيش رفقة إيمانويل ماكرون. وتفيض المؤلفتان في سرد تفاصيل تبين كم أنها كانت «خجولة». وإحدى ثوابت الكتاب الرئيسية أن هناك امرأتين في واحدة: ما قبل وما بعد قصر الإليزيه.
تتمتع فرنسا بنظام مركزي هو الأشد من بين كافة البلدان الأوروبية. وقلب هذه المركزية النابض هو قصر الإليزيه الملتحف بدستور الجمهورية الخامسة، الذي فصله الجنرال ديغول في ستينات القرن الماضي على مقاسه. وكثيرون يعتبرون أن رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات تفوق صلاحيات الملك إبان الملكية. والنتيجة أن عقيلة الرئيس يمكن أن تمارس نوعاً من السلطة الخفية عبر زوجها. ورغم أن بريجيت ماكرون دأبت على أن تبقى بعيدة عن مثل هذه الظنون، فإن الواقع شيء آخر.
ويروي الكتاب أنها هي من اكتشفت جان ميشال بلانكيه، وزير التربية الحالي، وأحد أبرز أفراد الحكومة. هي تستقبل الوزراء، ولها معجبون في صفوفهم.
إلى جانب بلانكيه، وزيرة العمل موريل بينيكو، ووزيرة حقوق المرأة مارلين شيابا. وعن هذه الأخيرة، يروي الكتاب أن ماكرون كان يفكر بإحداث تعديل حكومي وكان متردداً. ولأن الوزيرة شيابا قريبة جداً منها، فقد سارعت لإبلاغ زوجها أنه «يستطيع أن يفعل ما شاء ما دامت محظيتها تبقى في الحكومة». ويأتي الكتاب على شهادة وزير راغب في البقاء مجهولاً، إذ يقول إنه «إذا أراد أحد الوزراء أن يمرر تعديلاً على نص مشروع قانون، فإن الحديث إلى بريجيت يكون بالغ الفائدة، كونها تستطيع التأثير على الرئيس والالتفاف على المستشارين».
هي دعمت الوزير المستقيل ريشار فران، أحد الأوائل الذين التحقوا بـماكرون من بين نواب الحزب الاشتراكي، بسبب فضيحة عقارية لحقت به، وقالت له يوماً وهي تحاول التخفيف عنه: «ريشار، يمكن أن تكون رئيساً عظيماً للبرلمان» وريشار اليوم رئيس للبرلمان. ويسرد عنها الكتاب أنها تردد على أسماع الوزراء: «إذا كنت قادرة على المساعدة، فلا تتأخروا في إخطاري».
تقول عنها المؤلفتان: «إنها تتمتع بحدس سياسي كما أنها بالغة الحساسية»؛ لا بل إنهما يصفانها بأنها «الدماغ الأيمن للرئيس» وأنه «يستشيرها في كل شيء بعد أن يغلق باب الجناح الخاص بهما» في قصر الإليزيه. ويكشف الكتاب أنها دائمة الحضور خلال عشاءات أركان الأكثرية الذين يدعون إلى قصر الإليزيه، الأمر الذي لا يظهر في مفكرة الرئاسة الرسمية. وقد فهم الوزراء والحالمون بالحقائب الوزارية هذا الأمر. لذا هم يسعون للتقرب منها، ما يذكر بـ«حاشيات الملوك».
ولم تتردد بعض أصوات المحتجين في إطار حركة «السترات الصفراء» في تسميتها «بريجيت أنطوانيت» تذكيراً بزوجة الملك لويس السادس عشر. بريجيت تشكل البوصلة بالنسبة للرئيس وفق الكتاب، مكَّنته من إبقاء علاقات جيدة مع الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي، ومع كثيرين، ومنهم المتموضع في أقصى اليمين، مثل فيليب دوفيليه، رئيس «الحركة من أجل فرنسا».
وبالنسبة للمؤلفتين، فإن بريجيت ماكرون، رغم حسها السياسي؛ لا بل دهائها، فإنها ارتكبت عديداً من الأخطاء التي سيقت ضد زوجها وضد سياساته. هذه هي بريجيت ماكرون: امرأة ذات شخصية معقدة، ولكنها استثنائية، أكان ذلك في حياتها الشخصية أم «السياسية». ومن لا يعرف تفاصيل حياتها لا يدرك العوائق التي كان عليها اجتيازها لتصل إلى ما وصلت إليه. ولكنها في المحصلة كانت فاعلة بالأحداث بقدر ما كانت متأثرة بها، إن لم يكن أكثر من ذلك.