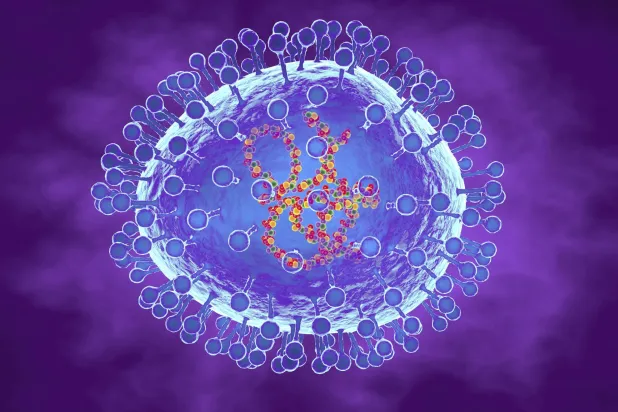وإذا كان في كثير من الأحياء المصرية قد تراجع حضور هذا البراح الجميل والمتنفس البسيط للأسر خلال السنوات السابقة بسبب ضيق المسافات بين المباني التي سرقت الخصوصية والإحساس باتساع المكان فإن الشرفة تعود الآن لتجذب من جديد الكثيرين بسبب الملل من الانعزال داخل المنزل حتى في الأحياء المزدحمة.
للشرفة في التراث الاجتماعي المصري قيمة كبيرة تتجاوز تصميمها الهندسي وأهميتها المعمارية فلطالما كانت حاضرة بقوة في حياة المصريين كإطلالة على العالم الخارجي، وملتقى لأفراد الأسرة والأصدقاء والجيران، وبعد تراجع دورها لهثاً وراء التفاصيل اليومية بدأ البعض يعود مرة أخرى إلى هذا البراح الذي بات يمثل متنفساً للكثيرين الذين يحاولون استعادة الهوايات القديمة على غرار قراءة الكتب ولعب الطاولة والشطرنج وممارسة التريكو أو غزل النسيج اليدوي، والتي كانت متعذراً القيام بها في الروتين الوظيفي واليومي قبل ظهور «كورونا».
في شرفتها بحي المعادي الراقي بالقاهرة، تجلس السيدة أمينة محسن، معلمة بإحدى المدارس الدولية، تنسج الخيوط وتحولها إلى قماش. فيما يعرف بـ«التريكو» حيث يوجد بجوارها صندوقان أحدهما يضم الخيوط والإبر، والآخر يحتوي على أحدث مجموعة من الدمى والحقائب والملابس التي صنعتها يدوياً في مرحلة الحجر المنزلي، تقول لـ«الشرق الأوسط»: «عدت إلى هوايتي الأثيرة التي تعلمتها من جدتي في منزلنا الريفي بمحافظة الشرقية (دلتا مصر)، وفي مدرستي الفرنسية أتقنتها لكن انشغلت عنها فيما بعد بأسرتي وبعملي كمعلمة، إلى أن اضطرتنا جائحة كورونا إلى البقاء بالمنزل، وأصبح لدي متسع من الوقت، فأصبحت أستمتع بغزل التريكو بالبلكونة مع الاستماع للموسيقى الهادئة».
الشرفة بالنسبة لها مكان ملهم ومصدر للهدوء النفسي تجتر به الذكريات، تقول: «الآن أصبحت البلكونة في منزلي من أكثر الأماكن اتساعاً، عادت كما عرفتها في منزل العائلة ترحب بالجميع، وتتسع لتشمل مختلف النشاطات اليومية»، وترى أن الجيل الجديد قد حرمته الحياة العصرية ومواقع «السوشيال ميديا» من هذه اللحظات الاستثنائية التي عاشتها هي وأبناء جيلها، لكنها الآن تحاول جذب أبنائها إلى الشرفة».
وبعد قرار الحكومة المصرية أخيراً بمد حظر التنقل حتى يوم 23 أبريل (نيسان) الجاري، من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً، واستمرار غلق المدارس والجامعات وتعليق حركة الطيران، مع إغلاق النوادي الاجتماعية والمسارح ودور السينما والمقاهي خلال تلك المدة، فإن عدداً كبيراً من المصريين سيضطرون للبقاء فترات طوية في شرفاتهم.
وإذا كان في كثير من الأحياء المصرية قد تراجع حضور هذا البراح الجميل والمتنفس البسيط للأسر خلال السنوات السابقة بسبب ضيق المسافات بين المباني التي سرقت الخصوصية والإحساس باتساع المكان فإن الشرفة تعود الآن لتجذب من جديد الكثيرين بسبب الملل من الانعزال داخل المنزل حتى في الأحياء المزدحمة، فوفق وائل حامد، موظف في هيئة النقل العام بالقاهرة، فإن الشرفات أصبحت الوسيلة المثلى حالياً للاتصال بالمحيط الخارجي.
وبسبب عزلة «كورونا» يقضي وائل أوقاتاً طويلة بشرفة منزله بمنطقة فيصل بالجيزة، لمتابعة الحركة المحدودة بالشارع صباحاً بجانب الاستمتاع بالشمس والهواء.
وظهر الاهتمام ببناء الشرفات في مصر منذ قرون، حيث بدأ تصميمها أولاً في المباني العسكرية والحصون الإسلامية، ثم تطور استخدامها لاحقاً في البيوت مع إضافة الزخارف والكرانيش بها لتضفي شكلاً جميلاً للمنازل. وتتزين عشرات المباني الإسلامية الأثرية بالقاهرة الفاطمية (وسط القاهرة) بشرفات تراثية بديعة، بالإضافة إلى شرفات عمارات القاهرة الخديوية المميزة.
ولاستعادة التقارب بين أفراد الأسرة والبحث عن متنفس حقيقي لمواجهة أجواء العزلة، أعاد شريف جاد، مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، تصميم بلكونة منزله بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة (غرب القاهرة) وتزويدها بقطع ديكور بسيطة وأنيقة مثل مجموعة من المقاعد و«البوف العربي» والإكسسوارات وطاولة صغيرة وسجادة خضراء ليجعل منها براحاً منزلياً.
ولم يكتف جاد بتحويل شرفته من مساحة خالية من الأنفاس والأثاث إلى براح للتأمل والقراءة والجلسات العائلية الدافئة لكنه وجه الدعوة بشكل غير تقليدي للآخرين ليحذوا حذوه حين التقط مجموعة من الصور الفوتوغرافية له مع الأسرة، لا سيما ابنه عمر الذي يشاركه لعب الطاولة والشطرنج لأوقات طويلة من اليوم داخلها، ونشرها على صفحته الشخصية على «فيسبوك».
ويرى جاد أن إعادة توظيف مساحة لم تكن مستغلة في شقته تعد من أهم مكتسبات عزلة «كورونا» بالنسبة له، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان أهم ما يميز الشرفات في عصور سابقة هو تصميمها المعماري الرائع والمتنوع فهي تعود من جديد أو نعود نحن إليها في إطار مواجهتنا لعزلة (كورونا)».
استعادة الهوايات القديمة بشرفات منازل القاهرة بعد العزلة
قراءة الكتب ولعب الطاولة والشطرنج وأعمال التريكو أبرزها

شريف جاد مع ابنه ولعبة الطاولة في شرفة المنزل

استعادة الهوايات القديمة بشرفات منازل القاهرة بعد العزلة

شريف جاد مع ابنه ولعبة الطاولة في شرفة المنزل
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة