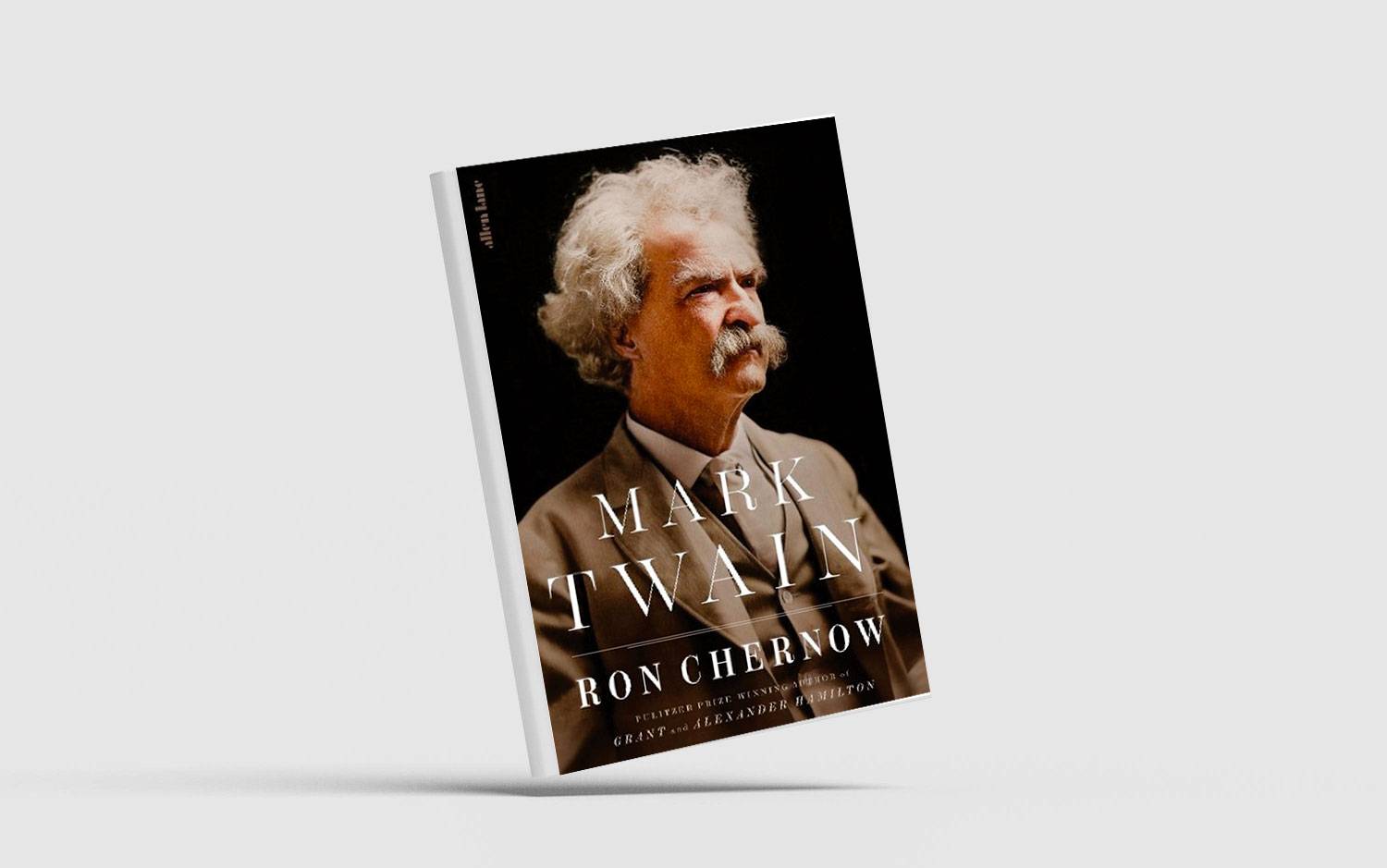«الرواية هي كتابُ الحياة المشرق» بهذه العبارة المشعّة يختزل أحد أقطاب الحداثة الروائية «دي. إتش. لورنس» قيمة الرواية ومكانتها الاعتبارية في حياة الأفراد والأمم، وقد جاءت عبارته تلك في سياق مقالة تأريخية له «تعدُّ اليوم واحدة من أهم الأدبيات التأسيسية لفن الرواية» عنوانها «لماذا تُحسبُ الرواية شأناً مهماً؟».
ليس لورنس وحده هو من كتب في أهمية الفن الروائي؛ بل إن معظم روائيي وروائيات عصر الحداثة وما بعد الحداثة وحتى حقبة الرواية المعاصرة ورواية القرن الحادي والعشرين ساهموا في تدعيم نظرية الرواية وكشفوا عن رؤاهم بشأن الفن الروائي، وإذا ما شئتُ إيراد أمثلة فسأكتفي بالأمثلة القياسية التالية: «فن الرواية» للروائي ميلان كونديرا، «تأمّلات في السرد الروائي» للكاتب والروائي أمبرتو إيكو، «فن الرواية» للكاتب والروائي كولن ويلسون. ذهب بعض الروائيين إلى كتابة مطوّلات روائية صارت بمثابة كتب منهجية تدرّسُ في الجامعات، وأميل في هذا الشأن للإشارة إلى الكتاب المهم الذي كتبته الروائية والأستاذة الجامعية جين سمايلي (Jane Smiley) بعنوان «13 طريقة في النظر إلى الرواية»، ذلك الكتاب الذي أراه عظيم الأهمية للروائي المبتدئ والمتمرّس في حرفته الروائية لسببيْن: الأول، لكون الكتاب مكتوباً من وجهة نظر روائية خبرت العملية الروائية وحيثياتها الدقيقة، وبالتالي لم يأتِ ما كتبته بدفعٍ من المتطلبات الأكاديمية واشتراطاتها الضيقة، أما السبب الثاني فهو أنّ الكتاب يضمّ في فصله الأخير قراءة الكاتبة لمائة رواية ورواية «101 رواية»، «ونلاحظ قصدية الكاتبة في الإحالة إلى ألف ليلة وليلة وأجوائها السحرية!!»، والكاتبة إذ تقدّمُ هذه القراءة فهي تعلن للقارئ معتمدها الأدبي (Literary Canon) الخاص بها والذي تراه خليقاً بتشكيل الذائقة الروائية المميزة لكلّ من يعتزم الانغمار الكامل في مخاضة الكتابة الروائية العسيرة.
الكتابة الروائية فنٌّ يتّسمُ بالغواية، وهي قادرة على الإمساك بعقل القارئ وروحه بطريقة -ربما- تعجز عنها الأنماط السردية الأخرى، وتلك حقيقة كُتِب بشأنها الكثير من الشروحات والمسوّغات التي تتفق جميعها على أنّ الرواية تمتلك مقدرة متفرّدة في قول أي شيء وكلّ شيء؛ الأمر الذي جعلها ممارسة مهنية وإنسانية ذات طبيعة معولمة تتعالى على محدّدات الزمان والمكان والبيئة والجغرافيات البشرية. تناولتُ في مقدّمة كتابي المترجم «تطوّر الرواية الحديثة» الأسباب التي أراها مسوّغة لامتلاك الرواية هذه الفتنة المغوية التي تدفع الجميع لتجريب الكتابة الروائية في طورٍ واحد -على الأقلّ- من أطوار حياتهم.
تروي الكتب التي تتناول التأريخ الروائي أنّ الرواية كانت تُخاطِبُ النساء حصراً في بواكيرها الأولى، وكان مطلوباً من الرواية أن تملأ ذلك الفراغ العاطفي لديهن بكتابات تغلب عليها الرومانسية الفيّاضة التي وصفها الدكتور جونسون بأنها «مفسدة للعقل الجميل وحسّ المحاكمة الأخلاقية المسؤولة». لستُ في حاجة إلى القول إن تلك كانت عهوداً شهدت بواكير الكتابة الروائية المثبتة تأريخياً في القرن الثامن عشر؛ أما في وقتنا الحاضر فقد شهد الفن الروائي اعترافاً راسخاً بكونه الفاعلية الإنسانية الأكثر رواجاً وتأثيراً من سواه حتى بات كلّ فردٍ في هذا العالم -حتى لو كان عالماً وأكاديمياً متخصّصاً في أحد الفروع المعرفية الصلبة- يتوق لكتابة روايته، ولو شئت إيراد مثال معاصر فسأذكر الرواية المنشورة حديثاً بعنوان «موت الشمس – Sunfall» للفيزيائي الأشهر «جِم الخليلي». لا يمكن للمرء أن يغفل هنا ملاحظة أنّ الرياضياتيين والفيزيائيين هم أكثر شغفاً في الفن الروائي بالمقارنة مع سواهم من العلماء، وربما تشير هذه الحقيقة إلى أنّ الرواية فاعلية فكرية تتناغم مع آلية تخليق الأفكار في الفروع المعرفية خارج نطاق الفاعلية السردية المتداولة.
لستُ هنا مهجوسة بتقديم المسوّغات التي تُعلي شأن الكتابة الروائية، أو تقديم وصفة -كما وصفات الطبخ- للرواية الجيدة؛ بل أسعى لمخاطبة كلّ من يستأنسُ في نفسه شغفاً في الولوج لغابة السرد الروائي -من الشباب والشابات بخاصة- وسأسجّلُ بعض الأفكار التي أراها مفيدة في هذا الشأن:
الرواية الأولى تتصادى مع وقائع من سيرتك الذاتية
كلّ من جرّب كتابة روايته الأولى سيجد نفسه مدفوعاً بقوة قهرية لتوظيف وقائع من سيرته الذاتية، والسبب وراء ذلك واضح: إنه أشبه ما يكون بآلية دفاعية لا تنفكّ تضغط على المرء للتشبث بملاذ آمن يكمنُ في سيرته الذاتية. هذه آلية طبيعية ناجمة عن الخشية من ولوج عالم الأفكار والوقوع في مطبّات منطقية أو نهايات مستغلقة أو عوالم هيكلية فكرية غير مقنعة أو ساذجة. لا ضير بالطبع من تناول المرء لسيرته الذاتية وبخاصة في روايته الأولى؛ لكنما يتوجب أن تنطوي هذا السيرة على ما يستحقُّ التحوّل من واقعة حياتية عادية إلى تجربة إنسانية نتشاركُها مع الآخرين، والمعيارُ الأوحد لتقدير هذه الأهمية هو الفرد ذاته ومروءة أخلاقياته وتقديره الشخصي المرتكن إلى منظومة يفترضُ أن تتّسم بقدر معقول من النزاهة.
غواية المُعتمد الأدبي
أغلبنا تلبّستنا غواية المعتمد الأدبي في بواكيرنا الأدبية: أن نرتكن لمعتمدٍ أدبي اتفق عليه أحد كبار النقّاد «هارولد بلوم، جورج شتاينر، فرانك كيرمود... إلخ» ونمضي في قراءة الأعمال الروائية المسطورة فيه تباعاً حتى نأتي عليها كلها. القراءة فعلٌ محمود في كلّ الأحوال، والنتائج المترتبة عليها رائعة ومفيدة؛ لكنما الاختلاف يكمن في طبيعة المعتمد الأدبي الذي نعتمده؛ فهو ناتجٌ كيفي يتفق مع سيكولوجيا الفرد وذائقته القرائية وعمره البيولوجي وخبرته الحياتية، وما مِن معتمد أدبي يتفق عليه اثنان باستثناء المعتمدات الأدبية التي ترسّخت بفعل المواضعات النقدية. كلّ منّا يخلق معتمده الأدبي الخاص به بفعل القراءة الروائية المتصلة والمتنوّعة وغير المقتصرة على أسماء روائية بعينها دون سواها.
أهمية القراءة الواسعة والمتنوّعة في الحقول المعرفية المستجدة
لا أقصدُ هنا القراءة الواسعة في الحقول المعرفية المعروفة: الفلسفة والسيكولوجيا وتأريخ الأفكار؛ بل أقصدُ -بالتحديد- القراءات في الميادين المعرفية المشتبكة التي نشأت مع الثورة المعلوماتية الرابعة -تلك الثورة التي باتت تطرق أبواب العالم، وباتت تتمظهرُ في مفردة الأنسنة الانتقالية (Transhumanism) وسائر موضوعات الثقافة الثالثة. كان القطار -على سبيل المثال- أحد الأمثلة كثيرة الشيوع في الروايات الحداثية لكونه التجسيد الشاخص للحداثة العلمية والتقنية، وفي السياق ذاته ينبغي لمفردات عصر الثورة الرابعة أن تكون جزءاً من أي مشروع روائي جاذب يسعى لنيل الاعتراف والمقبولية في حدودها الدنيا الممكنة.
وهمُ الاندفاع وراء الأخدوعات السائدة
تشيعُ بين آونة وأخرى موضة كتابية معيّنة تلقى دعماً من جانبٍ ما، ثمّ تتغوّلُ تلك الموضة لتستحيل نمطاً يسعى الجميع لاعتماده تقليداً روائياً سائداً. من الطبيعي أن يميل الشباب لتقليد تلك الموضات الكتابية طمعاً في جائزة أو حظوة؛ غير أنّ مقتلة الكاتب الروائي تكمن في اعتماده نمطاً كتابياً مصطنعاً لا يتناغم مع ميله الطبيعي وشغفه.
أودّ هنا الإشارة إلى ظاهرة «الفصاحة الجديدة» كمثال؛ فقد شاع هذا النمط الكتابي باعتباره محاولة جريئة للتوغّل في القيعان المجتمعية السحيقة الحافلة بالعوالم الديستوبية المسكوت عنها، وقد تمادى بعض كتّابنا الشباب -بل حتى بعض الروائيين المخضرمين كذلك- في هذه الفصاحة الجديدة التي صارت ميداناً لتجريب كلّ القباحات اللغوية الفجة والمبتدعات الروائية المصطنعة.
الكتابة الأصيلة المتناغمة مع خبرة الفرد وممكناته اللغوية لهي أفضلُ وأبقى من كتابة مصطنعة يتوسّلُ بها الفرد وسائل وأساليب مفروضة بطريقة قسرية ومُخادِعة.
أهمية إتقان لغة ثانية
قد يقرأ أحد الشباب مئات وألوفاً من الأعمال الروائية وغير الروائية المكتوبة باللغة العربية؛ لكن ما من وسيلة تعويضية للنقص الكامن في معرفتنا بالآخر وعوالمه وتجاربه سوى قراءة أعماله بلغتها الأصلية. الإنجليزية بالطبع هي اللغة العالمية الأكثر رواجاً وتأثيراً من سواها؛ وعليه لو أراد أي منّا ترسيخ فرادته الروائية ورصانته المعرفية العامة فليس من بديل عن إتقان الإنجليزية في المقام الأول، ولو استطاع لمعرفة لغة أخرى –إلى جانب الإنجليزية- سبيلاً فسيكون أمراً عظيم الفائدة والأهمية.
هاجسُ التجنيس الروائي
لا يوجد في العالم كاتبٌ روائي يخاطبُ نفسه قبل الشروع في عمل روائي جديد: هذا عمل سأكتبه بموجب مقاسات رواية ما بعد الحداثة، أو رواية القرن الحادي والعشرين. إنّه يكتبُ بموجب ذائقته الشخصية ومواصفات الكتابة التي تستطيع استيعاب ما يبتغي تمريره من أفكار وخبرات. تمثل رواية القرن الحادي والعشرين مصداقاً للمدى الواسع الذي يمكن أن تبلغه الحدود القصوى في الكتابة الروائية؛ فقد ارتدّت الكتابة الروائية إلى نمطٍ من السرديات الكلاسيكية -التي سادت في بواكير الرواية- مع تطعيمها بأنماط سردية تناغم المقدرة المفترضة للرواية في تناول كل شيء وأي شيء، ولو تفحّصنا واحدة من روايات كاتب معاصر (إيان ما كيوان، على سبيل المثال) لشهدنا توليفة من الكتابة الفنتازية والوثائقية وسرديات التخييل التأريخي ورواية الخيال العلمي والمستقبليات المحكومة بالذكاء الصناعي.
التعجل الروائي مصيدة ومثلبة كبرى
يستلزم العمل الروائي المصنوع بطريقة تستحقّ جهد القراءة ثلاث سنوات -في المعدّل- من البحث والمتابعة والكتابة، وهذا ما نشهده في الروايات المبدعة لكبار الكتّاب العالميين. إنّ إصدار رواية «أو ما يشبه الرواية» كلّ ستة أشهرٍ أو سنة، وبصرف النظر عن المسوغات الدافعة له، لهو فعلٌ يشي بكتابة متعجّلة تفتقر إلى البحث الرصين والتنقيب في الوقائع والتواريخ والحيثيات الدقيقة فضلاً عن كونه إشارة غير محمودة لكاتب يكتبُ كلّ ما يعنّ له من أفكار لحظية متوهماً أن هذا الفعل هو رواية. الرواية صناعة دقيقة وصبورة تعتمد خريطة تضاريس فكرية مسبقة ومحدّدة المعالم -يمكن إعادة ترتيبها كلّ حين؛ إنما ليس ممكناً العمل من دونها أو حتى التخلي عنها- وسنكون غشماء كثيراً لو صدّقنا الأكذوبة التي تقول «إن الرواية هي من تقودك ولستَ أنت من يقودُها».
- كاتبة وروائية ومترجمة عراقية تقيم في الأردن