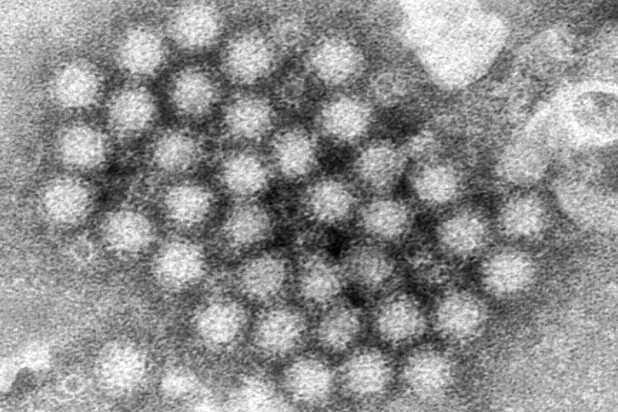بقدرات دبلوماسية تأكدت بفعل الممارسة، وسمات شخصية تتوزع بين الهدوء والحنكة، ودوافع بعضها ذو طابع شخصي وأخلاقي، يقود اليوم الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، منذ عام 2017، جهود العالم بأسره في معركة التغلب على فيروس «كوفيد 19» (فيروس الكورونا المستجد) الفيروسي الذي يقض مضاجع العالم.
والواقع أنه عند ظهور أي وباء عالمي تتطلع الأنظار إلى منظمة الصحة العالمية، التي تعتبر في مثل هذه الأزمات المصدر الأول للمعلومات، التي يجب أن تتحلى بالدقة العلمية، دون أن يخلو الأمر من بعض الدبلوماسية في إدارة الأزمة دون تهويل أو تهوين. ومع اندلاع أزمة الوباء الفيروسي الجديد، انطلاقاً من الصين، برز اسم أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام للمنظمة، الذي يدير المعركة بخبرات جمعت بين العالم والدبلوماسي، كما يشكل الواجهة الإعلامية والتوجيهية المسؤولة في مكاشفة جادة ورصينة، لا تهوّن ولا تهوّل.
الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أكاديمي وخبير صحة عامة إثيوبي الجنسية إريتري المولد، بنى سمعته في مجال الصحة العامة كعالم في «الملاريا»، قبل أن يصبح وزيراً للصحة في إثيوبيا عام 2005، ثم يتولّى منصب وزير الخارجية عام 2012. وبعدها انتخب مديراً عاماً لمنظمة الصحة العالمية يوم 1 يوليو (تموز) عام 2017، ليغدو أول أفريقي يشغل هذا المنصب في تاريخ المنظمة البالغ عمرها 69 سنة.
تيدروس الذي تولى مهام منصبه بعد فترة وجيزة من انتهاء تفشّي فيروس «إيبولا» في غرب أفريقيا، وكان قد جادل كثيرون من النقاد يومذاك بأنه كان من الممكن التقليل من خطره لو كانت جهود منظمة الصحة العالمية أكثر فاعلية لاحتواء العدوى في بداياتها. وحالياً، بعد سنتين، لا تبدو مهمة تيدروس أسهل بكثير، إذ عاد «الإيبولا» مرة أخرى للظهور في الكونغو. وهو يواجه الآن مهمة أخرى تبدو أصعب من سابقتها، وهي «كوفيد 19» أي فيروس «كورونا» المستجد.
مع هذا، تعاملت منظمة الصحة العالمية مع الوباء الجديد، تحت رئاسة تيدروس، بشكل مختلف عن تعاملها مع «إيبولا» عند تفشيه في غرب أفريقيا عام 2005. وحسب رسائل إلكترونية مسرّبة، نشرتها محطة «فرانس 24» يوم 7 فبراير (شباط) الحالي، انتظرت المنظمة شهرين لإعلان حالة الطوارئ في غرب أفريقيا مع وباء «إيبولا»، مراعاة لتلك الدول التي قد تنظر لمثل هذا الإجراء على أنه يشكل تهديداً لاقتصادها، لكنها في الحالة الصينية أعلنت حالة الطوارئ سريعاً. إذ أعلنتها في 31 يناير (كانون الثاني) من العام الحالي بعد نحو شهر من ظهوره، رغم التعهدات الصينية باتخاذها ما يلزم للسيطرة عليه.
- أداء غير مسبوق
لقد أدار تيدروس الأزمة بدبلوماسية بدت واضحة في تصريحاته التي استبقت تساؤلات مريبة قد تثار حول تحول موقف المنظمة من النأي بنفسها عن الأزمة، تاركة الأمر للصين إلى إعلان حالة الطوارئ. إذ وصف فيروس «كورونا» المستجد في المؤتمر الصحافي، الذي أعلن خلاله حالة الطوارئ، بأنه «فيروس ينتشر بشكل غير مسبوق»، بالتالي وجه بـ«رد غير مسبوق». وتابع «إن السبب الرئيس لإعلان الطوارئ ليس ما يحدث في الصين، وإنما ما يحدث في دول أخرى، ومبعث القلق هو انتقال الفيروس إلى دول ذات أنظمة صحية ضعيفة».
ومن ثم أرسل بعدها رسالة طمأنة إلى الصين، قائلاً خلال خطابه أمام الجلسة الـ146 لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في يوم 3 من فبراير الحالي، إنه «لا مبرّر» للإجراءات غير الضرورية في حركة السفر والتجارة الدولية خلال أزمة تفشي الوباء.
لقد اكتسب تيدروس هذه الحنكة الدبلوماسية في إداراته للأزمات من خبرات جمعها إبان عمله في إثيوبيا، وخلال السنوات الثلاث التي أمضاها حتى الآن في رئاسة المنظمة، حيث واجه الكثير من الانتقادات. وهو أثناء حملته ليصبح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عام 2017، اتهمه معارضوه بالتغطية على ثلاث حالات لاندلاع «الكوليرا» في إثيوبيا، إبان توليه مسؤولية وزارة الصحة. كذلك وصفت أطراف من المعارضة الإثيوبية ترشيحه للمنصب بأنها محاولة من الحكومة الإثيوبية لتبييض وجهها عالمياً، بسبب التجاوزات التي حدثت في ملف حقوق الإنسان.
تيدروس احتل أيضاً عناوين الصحف عندما اختار زعيم زيمبابوي روبرت موغابي، سفيراً للنوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية عام 2017، وهو قرار تراجع عنه في نهاية المطاف، قائلاً في بيان أصدره في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، «خلال الأيام الأخيرة فكّرت في قرار تعيين الرئيس روبرت موغابي سفيراً للنوايا الحسنة لدى منظمة الصحة العالمية (للأمراض غير المُعدية) في أفريقيا، وقررت إلغاءه حرصاً على مصلحة الوكالة الأممية بعد الجدل الذي أثاره هذا القرار».
وفي هذا السياق، اعترف تيدروس في مقابلة مع مجلة «تايم» في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أنه لا يلتفت كثيراً إلى الانتقادات، بل يظل هادئًا بشكل دائم في مواجهتها، كما أنه يصب طاقته في العمل، بينما يكتشف لاحقاً أنه ربما كان ينبغي عليه أن يأخذ بعضها على محمل الجد.
- دوافع شخصية
ومن المفردات التي دائماً ما تتردد على لسان تيدروس، حتى في الأزمة الأخيرة، هو الخوف من انتقال الوباء إلى الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة، وهو ما ينسجم مع اهتماماته قبل أن يصبح مديراً عاماً للمنظمة، التي قد يرجعها البعض إلى انتمائه لأحد البلدان الأفريقية النامية. هذا الأمر لا ينكره الرجل، إضافة إلى وجود دافع شخصي وراء ذلك. إذ شغل تيدروس قبل انتخابه مديراً عاماً للمنظمة منصب وزير خارجية إثيوبيا في الفترة الواقعة بين عامي 2012 و2016، ونجح في إطار أدائه لهذا الدور في قيادة الجهود الرامية إلى التفاوض على خطة عمل أديس أبابا، التي التزم فيها 193 بلداً بتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تهدف إلى تحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال المقبلة.
المدير العام يقول في حواره مع مجلة «تايم» الأميركية، إنه كان مدفوعاً في هذه الاهتمامات بوفاة شقيقه الأصغر، الذي كان يبلغ 3 أو 4 سنوات فقط، بسبب ما يشتبه الآن أنه حصبة. ويضيف: «أنا لا أقبل ذلك حتى الآن... كنت قادراً على الشعور بالفرق بين الدول الفقيرة والغنية، عندما أمضيت في سن الثالثة والعشرين أربعة أشهر أدرس في الدنمارك بعد تخرّجي من جامعة أسمرة الإريترية حاصلاً على درجة علمية في علم الأحياء. هناك شاهدت رعاية صحية شاملة أثناء الدراسة، وتكثف الشعور عندما تعرفت على النظام الصحي الوطني في بريطانيا أثناء إقامتي هناك للحصول على درجة الماجستير في علم المناعة للأمراض المعدية في لندن في أوائل التسعينات من القرن الماضي». ويتابع تيدروس الكلام عن تجربته: «لقد كافحت من أجل تقليص الفوارق بين عالم يمكن أن يموت فيه الأولاد مثل أخي، بينما يزدهر الأطفال الآخرون في بلدان تتمتع بفرص أفضل للحصول على الرعاية».
وحقاً، في كلمته أمام منظمة الصحة العالمية بعد تقلّده المنصب، عكس الرجل هذا التوجّه، فقال إن رؤيته كمدير جديد للمنظمة الصحة تتمثل في وجود «عالم يمكن لجميع سكانه أن يعيشوا حياة صحية ومثمرة بغض النظر عن هويتهم أو أماكن وجودهم». قبل أن يعد أعضاء وفود الدول الأعضاء في الجمعية العامة للمنظمة بأن يستيقظ كل يوم «عاقداً العزم على إحداث فرق».
- جوانب شخصية من حياته
على عكس كثير من الناس الذين يحبون الاستيقاظ من النوم، ولديهم دوافع إيجابية، يقول تيدروس في حواره مع المجلة الأميركية، «ما يوقظني في الصباح هو المشكلة التي يجب معالجتها... لذلك أنا أواصل». وليس هذا فحسب، بل إنه يسعى إلى رؤية المشاكل على أرض الواقع، ولذا اعترف خلال الحوار نفسه بأنه يحب السفر إلى المناطق الريفية، قائلاً «أحب أن أرى أناساً حقيقيين... أحب أن أرى المشكلة، التي لا يمكن رؤيتها هنا في مدينة جنيف، حيث مقر المنظمة». وعن حياته الأسرية، قال «عندما أحصل على لحظة خالية نادرة، فإنني أمضي بعض الوقت مع زوجتي وأولادي الخمسة في جنيف، أو أقرأ كتب القيادة والإدارة».
أما عن هواياته، فهو يمارس رياضة المشي صباحاً، مرتدياً قميصاً أزرق اللون وسروالاً رياضياً ومنتعلاً أحذية رياضية. وهو على الرغم من توليه مهمات صعبة في ملفي الصحة والشؤون الخارجية، فهو يحتفظ بروح مرحة، تدفعه كثيراً إلى التحليق بعيداً عن هموم الصحة والسياسة لتلقيه في أحضان الدعابة.
- جوائز ومهام صعبة
أما موقع منظمة الصحة العالمية، فيشير إلى أن تيدروس نشر طوال حياته المهنية العديد من المقالات في المجلات العلمية البارزة، وحصل على جوائز وشهادات اعتراف بأعماله من جميع أنحاء العالم. كذلك فإنه حصل على العديد من الجوائز، منها وسام صربي عام 2016، ومُنِح في عام 2011 جائزة جيمي وروزالين كارتر للشؤون الإنسانية تقديراً لإسهاماته في مجال الصحة العمومية.
فضلاً عن ذلك، سمي واحداً من 50 شخصًا سيغيرون العالم في عام 2012 من قبل مجلة «وايرد» الأميركية، التي كتبت أنه استخدم تقنيات مبتكرة لإنقاذ حياة ملايين الإثيوبيين، وبدلاً من بناء مستشفيات باهظة الثمن، دشن برامج لتدريب 35000 عامل صحي، كما أصبح بإمكان النساء في عهده الوصول إلى برامج تنظيم الأسرة، وأصبح بمقدورهن الآن التخطيط لتوقيت أطفالهن والمباعدة بين الولادات. وتلقى الأطفال في عهده لقاحات منقذة للحياة وعلاج الأمراض القاتلة مثل الالتهاب الرئوي و«الملاريا» والإسهال. وخلال خمس سنوات، خفّض عمله من معدل وفيات الأطفال الإثيوبيين دون سن الخامسة بنسبة 28 في المائة.
كذلك صنّفته مجلة «نيو أفريكان» البريطانية، واحداً من أكثر 100 أفريقي نفوذاً لعام 2015 في فئة السياسة والخدمة العامة، ووصفته المجلة بأنه «القائد»، واعتبرت أنه وضع الناس في صميم سياساته، سواء وزيراً للصحة أو وزيراً للخارجية، كما ساهم كلاعب أساسي في التدخلات الإقليمية والوساطة الاستراتيجية لإثيوبيا في السودان والصومال.
وللعلم، كانت مصر على موعد معه على طاولة مباحثات «سد النهضة» أثناء توليه مسؤولية الخارجية الإثيوبية، وربما كانت مواقفه المرنة إلى حد ما، هي التي دفعت مصر إلى إعلان تأييدها المبكّر له عند ترشحه للمنصب.
ويبقى القول إن المدير العام من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابعه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حوالي مليون و16 ألف متابع، بينما يتابعه عبر «تويتر» حوالي نصف مليون متابع.
- بطاقة هوية: تيدروس أدهانوم غيبرييسوس
> ولد في مدينة أسمرة يوم 3 مارس (آذار) 1965.
> ينتمي إلى شعب التيغراي، وكان عضواً في جبهة تحرير شعب التيغراي والجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبي.
> درس علم الأحياء (البيولوجيا) في جامعة أسمرة وحاز فيها البكالوريوس في العلوم. ثم حصل على الماجستير في الأمراض المعدية والسارية من معهد الصحة وطب المناطق المدارية بجامعة لندن في بريطانيا، ثم حصل على الدكتوراه في الصحة العامة من جامعة نوتينغهام في بريطانيا.
> تولى منصب وزير الصحة بين 2005 و2012، بعد توليه مسؤوليات إدارية صحية.
> تولى منصب وزير الخارجية بين 2012 و2016.
> تولى منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية منذ 2017.