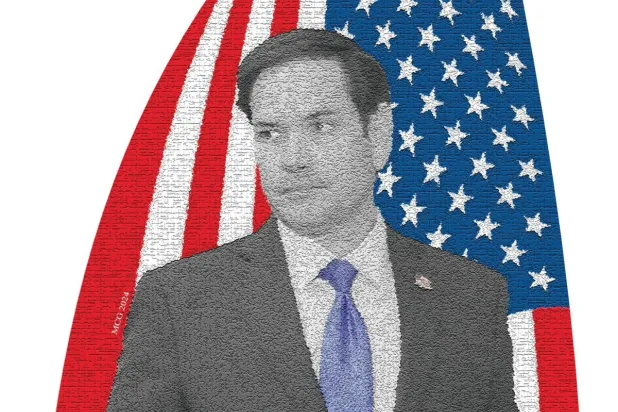على مدار العقود الأربعة الماضية، أي منذ تأسيس آية الله الخميني الجمهورية الإسلامية في إيران، لم يكن يمر عام من دون أن تشهد البلاد مظاهرة أو مسيرة أو احتجاجاً لدى بعض شرائح المجتمع الإيراني. وتوثق قائمة من إعداد الباحث الإيراني باري صحابي، اندلاع ما لا يقل عن 800 حالة احتجاج ضمت أكثر من 1000 مواطن منذ عام 1979. ولقد اشتملت القائمة على العديد من الشرائح والطبقات الاجتماعية التي تضم المزارعين، وعمال النقل، وعمال المناجم، والمعلمين، والجماعات العرقية، والناشطات في قضايا حقوق المرأة، والمعارضة الدينية، والمواطنين الذين فقدوا مدخراتهم، أو غيرهم ممن تعرضوا لعمليات الاحتيال الاقتصادي التي غالباً ما تشارك فيها عناصر مؤيدة للنظام الحاكم.
هناك تساؤل مطروح للنقاش في الدوائر السياسية في طهران، مع استمرار الاضطرابات الشعبية في إيران: ما الذي يحدث بالفعل هناك؟
على الرغم من أن الاحتجاجات ليست من الظواهر نادرة الحدوث في إيران الخمينية، فإن الموجة الراهنة منها سببت هزّات صادمة وعنيفة لدى النخبة الإيرانية الحاكمة أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الـ40 الماضية، ولكن لماذا؟
لا تبدو الاحتجاجات الراهنة في حجم شيوع أو انتشار الانتفاضة التي عمت أرجاء إيران في شتاء عام 2017 - 2018 الماضيين، ومن المؤكد أنها ليست ذات دوافع سياسية على غرار «الحركة الخضراء» التي شهدتها البلاد قبل 10 سنوات. إلا أن وزارة الداخلية الإيرانية تقرّ بأن الانتفاضة الحالية شملت 110 مدن وبلدات من أصل 1080 تحمل تصنيف المدن والبلدات في إيران، بمعنى أنها في الأماكن التي يتجاوز عدد سكانها 10 آلاف مواطن أو أكثر.
حتى الآن، لم يصدر حصر رسمي بشأن أعداد الوفيات في الانتفاضات الأخيرة. وكانت السلطات الإيرانية، في بداية الأمر، قد أشارت إلى سقوط نحو 30 قتيلاً في المظاهرات، غير أنها تراجعت بعد ذلك، وقالت إنه من غير المسموح الإعلان عن أي أرقام على المستوى المحلي. مع هذا، تقدر منظمة العفو الدولية عدد القتلى في المظاهرات الإيرانية خلال الأسبوع الأول منها بأكثر من 100 قتيل. وتقول مصادر موثوقة إن لديها قائمة بأسماء 57 مواطناً إيرانياً لقوا حتفهم في 14 بلدة، فضلاً عن تقارير إخبارية أخرى تفيد بمقتل 80 مواطناً آخرين، ولكن من المستحيل الآن التأكد من وفاتهم. بعبارة أخرى، حتى مع افتراض أكبر عدد ممكن من الوفيات، فإن الانتفاضة الحالية لم تكن دموية على غرار الحالات السابقة من الانتفاضات الإيرانية الأخرى.
هزّة سياسية وأرقام
في الانتفاضات الأخرى، بلغت حالات الوفيات أكثر من 1000 قتيل، مع أرقام للمعتقلين في انتفاضة عام 2017 - 2018 تجاوزت 10 آلاف مواطن جرى احتجازهم لفترات زمنية متفاوتة.
مع ذلك، يبدو أن النظام الإيراني الحاكم يعاني من زلزلة شديدة الآن أكثر من أي وقت مضى. إذ ظهرت، للمرة الأولى على الإطلاق، انقسامات واضحة في الرواية الرسمية للأحداث الراهنة. فإحدى الروايات الرسمية، التي روّج لها الفصيل الموالي للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، تفيد بأن الأمر برمته ليس إلا مؤامرة أجنبية خبيثة تشمل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وإسرائيل وبلداناً عربية مختلفة. وهناك رواية أخرى صادرة عن وسائل الإعلام، التي لا تزال تحت سيطرة الفصيل الموالي للرئيس حسن روحاني، تقول بأن المظالم الشعبية الإيرانية لها ما يبررها على اعتبار أنها واحدة من بين أسباب الانتفاضة، وتحاول تمييز «المحتجّين الحقيقيين» عن المتظاهرين من «أصحاب النوايا الخبيثة».
كذلك، أعربت النخبة الإيرانية الحاكمة عن مخاوفها الواضحة من خلال لعبة «لست أنا الفاعل»، فيما يتعلق بقرار مضاعفة أسعار الوقود ثلاث مرات دفعة واحدة، ما أدى إلى اندلاع المظاهرات العارمة في البلاد. وافتتح الرئيس روحاني اللعبة بالزعم أن القرار قد اتخذ من جانب لجنة حكومية ثلاثية برئاسته، وعضوية رئيس هيئة القضاء آية الله إبراهيم رئيسي، وعضوية رئيس البرلمان علي أردشير لاريجاني. ومع ذلك، نفى رئيسي ولاريجاني تلك الأنباء، زاعمين أنهما أُبلغا فقط بالقرار الرئاسي المنفرد بشأن رفع أسعار الوقود، وأن مبدأ الفصل بين السلطات لا يسمح للجهاز القضائي، ولا للجهاز التشريعي، بالتدخل في المسائل ذات الصلة بالسلطة التنفيذية في الدولة.
ولمواصلة تبادل إلقاء الاتهامات واللوم، قامت الحاشية المُلاصقة للرجال الثلاثة بتعميم رواية أخرى تفيد بأن القرار الحكومي الأخير نال استحسان المرشد الأعلى علي خامنئي. وأثار ذلك التصريح ردود فعل غاضبة من جانب حاشية خامنئي التي زعمت أن المرشد الأعلى لم يشارك على نحو مباشر في اتخاذ القرار الحكومي الأخير. وفي وقت لاحق، زعم خامنئي بنفسه أنه لم يكن لديه علم مسبق بذلك القرار، وأنه لا يملك الخبرة الكافية في مثل تلك الأمور الاقتصادية، بيد أنه لم يعترض على القرار حين صدروه.
انتشار الخوف
هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها كبار صناع القرارات السياسية في طهران النأي بأنفسهم تماماً عن أي خطوة لا تحظى بالشعبية في إيران، وهذه إشارة واضحة إلى خشيتهم من عواقب الأمور كما حدث.
ونظراً لأن الخوف يملك المقدرة على التوالد والتكاثر، فإنه سرعان ما انتشر إلى قطاعات أخرى من النظام. إذ أصدر أربعة، من آيات الله التسع الذين يشكلون «مجلس العلماء» الموالي للنظام في مدينة قُم، بياناً شجبوا فيه بقوة القرار الحكومي بزيادة أسعار الوقود، ودعوا الحكومة إلى إعادة النظر في القرار الأخير. وهذه أيضاً هي المرة الأولى التي يعارض فيها آية الله صافي كلبايكاني (غولبايغاني) وآية الله علوي كركاني (جرجاني) وآية الله جوادي آملي وآية الله مكارم شيرازي، علانية، أحد القرارات الحكومية الصادرة عن السلطة مما كان المرشد الأعلى قد أقره بنفسه لاحقاً.
هذا، وصار من الواضح للعيان ذلك الانقسام الذي يشوب رجال الدين الرسميين الموالين للنظام الحاكم في إيران، الذين يقدر عددهم بنحو 6 آلاف من آيات الله والملالي من مختلف الدرجات والمستويات في عموم إيران، لا سيما مع انضمام بعض أئمة صلوات الجمعة إلى المظاهرات في البلدان والمدن الصغيرة، منها شهريار القريبة من العاصمة طهران، وسيرجان في الجنوب الشرقي من البلاد، داعين إلى إلغاء القرار الحكومي الأخير.
كذلك أشاعت التقارير الإخبارية المتنوعة قدراً من المخاوف بين صفوف الحكام في طهران، لا سيما تلك التي تفيد بأن قوات الأمن الإيرانية انضمت إلى صفوف المحتجّين، وسمحت لهم بكل بساطة بالسيطرة على المباني التابعة للحكومة في بعض المدن والبلدات، منها بوشهر وزنجان وجهروم. وفي بوشهر وماهشهر، في محافظة خوزستان (عربستان)، دخل الموظفون الحكوميون في إضراب غير رسمي عن العمل، وأعلنوا عن انضمامهم لصفوف المتظاهرين. وسرت مشاعر الخوف أيضاً بين أروقة البرلمان الإسلامي الإيراني عندما قدّم خمسة من أعضاء المجلس على الأقل استقالاتهم من مناصبهم تأييداً لمواقف المحتجين. وفي خطوة رمزية أخرى، دعا بعض أعضاء المجلس إلى عزل رئيس البرلمان لمشاركته المزعومة في اتخاذ قرار رفع أسعار الوقود، بصفة منفردة، من دون مشورة البرلمان.
من جهة ثانية، ساهمت الحكومة الإيرانية في بث مشاعر الخوف والذعر من خلال إلغاء كل مباريات كرة القدم، ومنع الحفلات الموسيقية، وقطع الاتصال بشبكة الإنترنت، وإجبار «المجاهدين» الأجانب الموجودين في طهران حالياً - لحضور مؤتمر «الوحدة الإسلامية» - على سرعة مغادرة البلاد. وكانت هناك جماعة من «الجهاديين» الأتراك، تحت قيادة المدعو محمد قره ملاّ، قد نُقلوا بالحافلات إلى المطار أثناء توجههم لزيارة قبر الإمام الخميني قرب طهران. كذلك أدى الإعلان عن حظر كل رحلات السفر إلى العراق إلى زيادة الخوف من اهتزاز نظام طهران بسبب الانتفاضات التي اندلعت في الداخل الإيراني وفي العراق. وسادت حالة من الارتباك داخل أروقة النظام الإيراني أثناء بحثه المستمر عن الأعذار والمبرّرات التي أدت إلى اتخاذ القرار المفاجئ بزيادة أسعار الوقود.
روحاني وأعذار السلطة
كان العذر الأول، الذي صدر عن الرئيس حسن روحاني، يتمثل في أن الحكومة في حاجة ماسة إلى توفير الموارد المالية الإضافية لتأمين حزمة المساعدات لـ60 مليون مواطن، أي ما يشكل نسبة 70 في المائة تقريباً من تعداد السكان، ممن يعيشون تحت خط الفقر في إيران. ومن شأن الإيرادات الإضافية المنشودة أن تمكن الحكومة من سداد مبلغ 110 دولارات في العام لـ18 مليون عائلة من العائلات الإيرانية الفقيرة. وكان المبرّر الشائع أن الذين يعارضون قرار رفع أسعار الوقود يمثلون نسبة 30 في المائة من الطبقة الوسطى المعتدلة مالياً في البلاد. وجاء في تصريح لروحاني قوله «نعلم من هم نسبة الثلاثين في المائة، كما نعلم أنهم يعيشون حياة طيبة ولا يهتمون بشؤون الآخرين».
إلا أن بعض الشخصيات النافذة في النظام الإيراني عارضت مزاعم الرئيس. ففي اجتماع المجلس الأعلى للثورة الثقافية الإسلامية، فوجئ روحاني بهجوم من طرف حسن رحيمبور أزغدي، العالم الديني الإيراني، وأحد منظّري الثورة الإسلامية والمقرّبين من خامنئي، اتهمه فيه «بمحاولة تقسيم الأمة على أساس الدخل الفردي». ووفقاً للتقارير الواردة عن بعض الحاضرين في الاجتماع، فإن أزغدي قال إن المهم في البلاد ليس ما يكسبه المواطن من دخل شهري أو سنوي، بل مدى التزامه بالإسلام الصحيح. وانتهى الاجتماع بفوضى عارمة، قرّر روحاني على أثرها المغادرة بعد نوبة غضب واضحة.
وفي اليوم التالي، تقدّم علي ربيعي، المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية، بتفسير جديد قال فيه إن قرار مضاعفة أسعار الوقود إنما اتخذ لتلبية الالتزامات الإيرانية بموجب «اتفاقيات باريس» بشأن التغيرات المناخية. وقال ربيعي في تصريحه، «نحن في حاجة ماسة إلى إنقاذ الكوكب. ومن أجل ذلك علينا خفض الاستهلاك العام من الوقود، لا سيما البنزين، من 110 لترات إلى أقل من 90 لتراً أو أدنى». وسرعان ما تحرك خامنئي، الذي زعم أنه وجّه الأوامر إلى الحكومة بخفض استهلاك البنزين إلى نحو 65 مليون لتر، لتأييد مزاعم ربيعي بصورة غير مباشرة، إذ قال: «لسنا في حاجة إلى إهدار الكثير من موارد الوقود والطاقة».
ارتباك حكومي كبير
في إشارة أخرى على الارتباك الواضح، حذرت وزارة الاقتصاد الإسلامي الإيرانية من مخاطر التضخم المفرط الناجم عن ارتفاع أسعار الوقود. ومع معدلات التضخم التي تحوم حول 40 في المائة خلال العام الحالي، من شأن الارتفاع في أسعار الوقود أن يزيد من تفاقم وتعقيد الأوضاع. ومع ذلك، عارض بنك إيران المركزي تلك المزاعم قائلاً إن ارتفاع الأسعار من شأنه الإسهام بنسبة لا تتجاوز 3.5 إلى 4 في المائة من معدل التضخم. وفي إشارة أخرى إلى الارتباك الحكومي في إيران، أعلن رضا أردكانيان وزير المياه والطاقة الإيراني، أن قرار رفع أسعار الكهرباء والمياه قد تأجل لمدة عام كامل لمنع معدلات التضخم من مواصلة الارتفاع.
في أي حال، يبدو أن النخبة الإيرانية الحاكمة عاجزة عن تحديد تشخيص معين لاندلاع الاحتجاجات الجماهيرية الكبيرة. فهي تجهل ببساطة ماهية التهديدات التي تتعامل معها.
أيضاً، اتسمت ردود فعل النظام بالتناقض الصارخ. وجرى في بعض الحالات الاستعانة بالقوة الأمنية المفرطة من دون الحاجة الماسة إليها. فعلى سبيل المثال في شهريار قرب طهران، وصلت قوة أمنية مكونة من ألفي ضابط وجندي إلى البلدة، وبلغت حالة من الهستيريا في التعامل مع الأوضاع، الأمر الذي أسفر عن اشتباكات خطيرة كان من الممكن تفاديها بكل سهولة. وفي أماكن أخرى مثل مدينة شيراز، عاصمة إقليم فارس، تخيّرت قوات الأمن ألا تمارس القوة المفرطة، وكانت «القوات الخاصة» التي أرسلت من طهران قد وصلت في وقت متأخر، وتعيّن عليها الاشتباك لاستعادة السيطرة على المباني الحكومية التي استولت عليها جموع المتظاهرين.
من ناحية ثانية، اتسمت الاحتجاجات الشعبية، التي جرى تنظيمها وترتيبها بصورة جزئية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بقدر معتبر من الابتكار. ففي بداية الأمر، جرى التركيز على المدن والبلدات الصغيرة والمتوسطة. وذلك لأن النظام الإيراني يعتمد سياسة أمنية تدور حول الافتراض بأن طهران هي الأهم إلى جانب عدد من المدن الرئيسية الأخرى، وخصص لأجل ذلك ما يقدر بنحو 600 ألف من أفراد الخدمة الأمنية من الرجال والنساء هناك. وفرض الاضطرابات في أكثر من 100 بلدة ومدينة صغيرة، وفي الحالة الراهنة يمكن القول بأكثر من 300 بلدة دفعة واحدة، يجعل من العسير على النظام الحاكم فرض الأمن والحفاظ على السيطرة على الصعيد الوطني بأسره. والأسوأ من ذلك، أن تكتيكات المعارضة الحالية تهدف إلى إجبار النظام الحاكم على تخفيف الدفاع عن العاصمة طهران والمراكز الإقليمية الرئيسية الأخرى ما يجعلها معرّضة لموجة ثانية من الاحتجاجات الشعبية.
ونظراً لأن السياسات الإيرانية كانت تتمحور على الدوام حول طهران، على الأقل منذ بدايات القرن العشرين، فلن يمكن لأي نظام حاكم في طهران البقاء من دون بسط السيطرة الكاملة على العاصمة. وحالياً ستحتاج العاصمة الإيرانية، التي يزيد تعداد سكانها على 15 مليون نسمة، إلى قوة تأمين أمنية تضم ما لا يقل عن 100 ألف جندي للحؤول دون السيطرة عليها من قوة المعارضة جيدة التنظيم، وإن كانت أصغر عدداً من ذلك بكثير. وعندما يكون النظام متمتعاً بقاعدة قوية من الدعم الشعبي، يمكنه الاعتماد على جزء من السكان في مساعدة قوات الأمن الحكومية في مواجهة مجموعات المعارضة. أما الآن، بسبب الصعوبات الاقتصادية المتزايدة والفساد الرسمي المتفشي في مختلف المجالات، لا يستطيع النظام الإيراني الاتكال على مثل هذا السيناريو.
لقد احتاج النظام الإيراني لستة أيام كاملة من بدء الاحتجاجات الجارية لمحاولة تنفيذ أحد أساليب السيطرة القديمة: أي تنظيم المسيرات الشعبية المؤيدة له. ورغم مناشدة روحاني «أبناء الثورة الإسلامية» الخروج والمسير، وإظهار بأسهم وقوتهم، فإنه، حتى يوم الأربعاء الماضي، لم يستطع إلا الإشادة بثلاث مدن إيرانية، هي تبريز وزنجان وشهركُرد، لتنظيمها مسيرات شعبية مؤيدة للنظام. بل حتى هنا، أفادت بعض المصادر المطلعة في مدينة تبريز، ذات المليون نسمة تقريباً، أن عدد المشاركين في المسيرة المؤيدة للحكومة بالقرب من السوق المركزية لم يتجاوز 500 من المشاركين. ووفقاً للتقارير الإخبارية، التي لم تتمكن من تأكيد خطط المسيرات الشعبية في العاصمة طهران، بصورة مستقلة، ألغيت المسيرات المماثلة في مشهد وأصفهان (ثاني وثالث أكبر مدن إيران) خشية أن تتحول إلى معارضة النظام والاحتجاج عليه. أما اختيار مدينة زنجان لتنظيم مسيرة مؤيدة للحكومة، فكان مثيراً للاهتمام من زاوية أن المدينة نفسها كانت قد شهدت قبل أربعة أيام انضمام قوات الأمن المحلية إلى المتظاهرين المحتجين ضد النظام.
أخيراً، في حين أن وزارة الداخلية ومؤسسة الرئاسة الإيرانيتين قد بثتا مزاعم تفيد بأن الاحتجاجات عفوية وعشوائية وغير منظمة إلى حد كبير، وتفتقر إلى القيادة الواضحة، فإن «الأمن الإسلامي»، الخاضع لسيطرة «الحرس الثوري الإيراني»، يزعم أن الاحتجاجات الحالية جرى التخطيط لها بعناية خارج البلاد، وهي تحت قيادة سبعة من الرجال تم تحديد هوياتهم، وإلقاء القبض عليهم في طهران. كذلك تزعم مصادر «الأمن الإسلامي» أن كل أعضاء مجموعة «المخرّبين السبعة» يحملون جوازات سفر ألمانية وأفغانية وتركية.
اتهامات النظام شملت أسرة الشاه ومناصريها
> اتهم المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، بنفسه، أسرة الشاه الراحل محمد رضا بهلوي، بالتعاون مع منظمة «مجاهدي خلق»، الناشطة في المنفى، في التحريض على الانتفاض ضد النظام الخميني القائم.
غير أن الأمير رضا بهلوي، ولي عهد الشاه الإيراني الأسبق، أعلن في رسالة بعث بها بعد خمسة أيام من اندلاع الانتفاضة الحالية، أنه يؤيد الاحتجاجات ضد النظام الإيراني، لكنه لم يزعم المطالبة بقيادة تلك الاحتجاجات. وللعلم، شهدت بعض المدن الإيرانية، مثل بوشهر (المطلة على الخليج) وساري (عاصمة مازندران بشمال البلاد على بحر قزوين)، هتافات وشعارات مؤيدة لأسرة بهلوي، ووصفت الملك رضا بهلوي، مؤسس الأسرة الحاكمة، بـ«الرجل العظيم».
أيضاً، ظهرت شعارات من شاكلة «أين أنت يا رضا بهلوي؟» على بعض الجدران في العاصمة طهران. أما بالنسبة إلى منظمة «مجاهدي خلق»، فإن الأساليب المستخدمة في مسيرات بعض الأماكن، كمسيرات مدينة أصفهان، على سبيل المثال، لم تتغير بصمتها منذ سبعينيات القرن الماضي. وعلى الرغم من ذلك، مما تجمع لناشطين جيّدي الاطلاع من أدلة وتقارير وإفادات، يبدو أن الانتفاضة الشعبية الحالية خلفها قادة محليون قادرون ومستنيرون، وتتمتع بزخم شعبي هائل في كل مكان اندلعت فيه تقريباً، غير أنها لا تزال تفتقر إلى القيادة الوطنية الشاملة والموحّدة.
بعبارة أخرى، هناك موجة عارمة من الاستياء والسخط الشعبي الواضح في إيران، ما يمكن أن يزلزل أركان النظام الحالي، ويعصف باستقراره الواهي، أو حتى يطيح به تماماً، لكنه ما زال مركباً بلا قائد واحد.