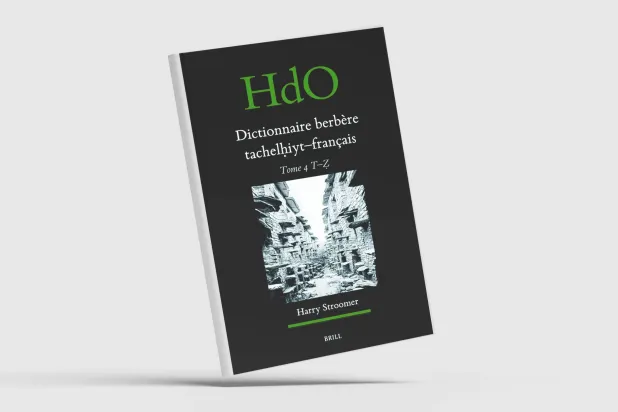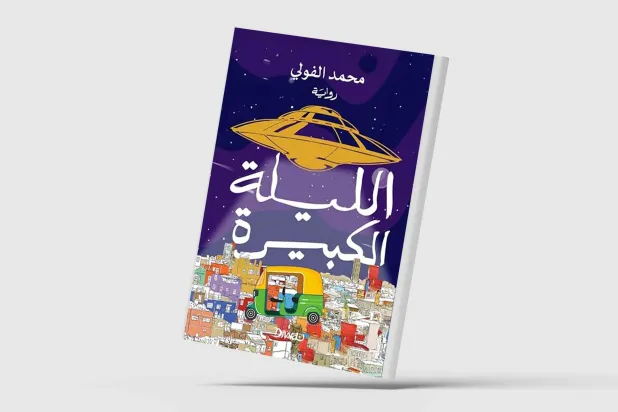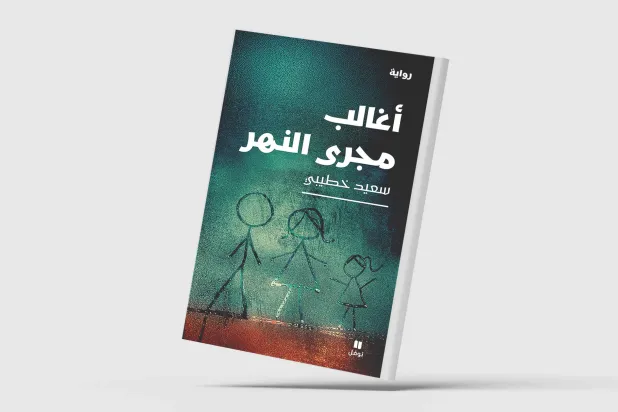إنّ المهتمّ بالثعالبي ومصنّفاته سيتوقّف مليّاً عند باحثين ارتبطا به في الحقل الأكاديمي، وهما د. رمزي بعلبكي ود. بلال الأرفه لي، اللذين حقّقا سابقاً كتابين للثعالبيّ: كتاب زاد سفر الملوك: في السفر ومدحه وذمّه ومحاسن الأخلاق فيه، وكتاب مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب وبدائع الأوصاف وغرائب التشبيهات، فضلاً عن دراسة للدكتور الأرفه لي حول الكتاب الأشهر للثعالبي «يتيمة الدهر» نشرت بالإنجليزية.
إنّ عناية هذين الباحثين بأبي منصور الثعالبي ليست محطّ غرابة، فهو الأديب الناقد المتذوّق للأدب كثير التصنيف فيه. وهو في كتبه ينقل عن مصادر أدبيّة من القرنين الثالث والرابع، لكنّه يرتكز أكثر على ما سمعه من روايات في أثناء ترحاله الكثير، مما يجعل مصنّفاته خزانة أدبيّة أمينة لنتاج عصره وما سبقه. ولا تقتصر أهمّيتها على مضمونها الأدبي، شعراً كان أم نثراً، فالثعالبي معروف بتجديده المنهجيّ، وهو في تبويبه للمادّة وترتيبها يثير لدى الدارسين عدداً من التساؤلات. ويقدّم معرفة بطبقات المجتمع وتراتبيّتها، أو بجغرافية البلاد الإسلاميّة وتقسيمها.
وإنّ كتاب الثعالبي المعنون «خاصّ الخاصّ» قد حُقّق ونشر مراراً، لكنّه ليس الكتاب محطّ حديثنا. فالأخير هو «خاصّ الخاصّ في الأمثال»، ولم يغفل المحقّقان عن الإشارة إلى مواطن التشابه بين الكتابين في موضعها. ويندرج كتابنا ضمن كتب المختارات الأدبيّة، وقد جعله الثعالبي في الأمثال التي كان مولعاً بها، إذ ليس هذا الكتاب مصنّفه الوحيد فيها. ويكشف التحقيق عن أوجه تكرار مادّته في غير مؤلّفٍ له، وهو الذي عدّه المحقّقان دلالة على براعته في التأليف وإعادة التأليف وتقديم مؤلّفاته هدايا.
ويقع الكتاب في ثلاثة أقسامٍ مبوّبة حسب الموضوعات، ويختار الثعالبي لكلّ قسمٍ طريقة خاصّة في عرض المادّة، مبتعداً بذلك عن النسق المعجمي الذي عُرفت به كتب الأمثال. وقد جعل القسم الأوّل فيما يُتمثّل به من ألفاظ القرآن، ويستغرق هذا القسم نصف الكتاب تقريباً. ويبدأ الكاتب كلّ بابٍ من أبوابه السبعين بآية أو أكثر، ثمّ يدرج تحتها ما جاء في معانيها من الخبر وأمثال العرب والعجم وكلام الخاصّة والعامّة. وهو في هذه التوليفة يجمع بين الأمثال القديمة التي أبقى عليها الإسلام - مغيّراً في دلالتها أحياناً - والأمثال النبويّة، والأمثال المولّدة أو المحدثة بعد نزول القرآن.
ويحافظ القسم الثاني على هذا التنوّع في مصادر المادّة، ويجمع فيه الثعالبي أمثال طبقات الناس وذوي المراتب المتباينة والصناعات المختلفة. ويعتمد التدرّج الطبقي، بدءاً بالأمثال السلطانيّة والملوكيّة، انتقالاً إلى الأمثال المعنيّة بالوزراء والكتّاب والبلغاء، وانتهاءً بأمثال النساء فالصبيان فالعبيد. وهذه ليست المرّة الأولى التي يتخطّى فيها الثعالبي نظرة الأديب المتمكّن واسع الاطّلاع إلى نظرة الناقد الاجتماعيّ، فيمنح القارئ تصوّراً لمكانة كلّ طبقة في السلّم الاجتماعي آنذاك، وموقعها بالمقارنة مع غيرها من الطبقات.
أمّا القسم الثالث - وهو الأقصر - فيجمع فيه مختارات من الأمثال التي جاءت على أفعل من كذا، ولم يتضمّنها كتاب أبي عبد الله حمزة بن الحسن الأصبهانيّ. ويقع في ثلاثة أبواب: الأوّل أمثال منسوبة إلى أربابها، والثاني غرر من رجز الشعراء، أمّا الثالث ففيه يدلي الثعالبي بدلوه، غير مكتفٍ بالجمع والترتيب، منتقلاً إلى الابتداع والتأليف. فيخصّصه لما جمعه بنفسه واخترعه وابتدعه، واللافت أنّ بعض العناوين في هذا الباب يشابه عناوين سبقت في القسمين الأوّل أو الثاني، ولكن يبدو أنّ المؤلّف أراد بإفرادها أن تحظى بعناية القارئ وملاحظته.
لقد تحمّل المحقّقان - في جميع ما سبق - عناء ردّ كلّ مثلٍ إلى مصدره العربي أو الفارسيّ، ومواطن وروده في مظانّ الكتب. وألحقا بالكتاب فهارس بالآيات، والأحاديث، وأبيات الشعر، وأشطار الأبيات، والأعلام والأماكن، الأمر الذي يجعل البحث فيه والإفادة منه أيسر وأعظم. وإنّ المطّلع اليوم على ما يُنشر من مخطوطات، يدرك بشكلٍ بدهي أنّ للتحقيق درجات، ولعلّ دأب المحقّقين كان بلوغ أعلاها.
وأخيراً، فإنّ الأمثال بما تشتمل عليه من معاني الحكمة، وإيجاز اللفظ وشيوعه، تعكس ملامح المجتمع الذي أنتجها أو تداولها، وتغري الباحثين من مجالاتٍ عدّة بدراستها. وإنّ كتاب «خاصّ الخاصّ في الأمثال» إضافة جديدة إلى هذا الحقل، من شأنها أن تستقطب إلى جانب أهل الاختصاص الهواة من قرّاء الأدب.
- طالبة دكتوراه
- الجامعة الأميركية في بيروت
«خاصّ الخاصّ في الأمثال»... معاني حكمة وملامح مجتمع
باحثان لبنانيان يعودان إلى الثعالبي

«خاصّ الخاصّ في الأمثال»... معاني حكمة وملامح مجتمع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة