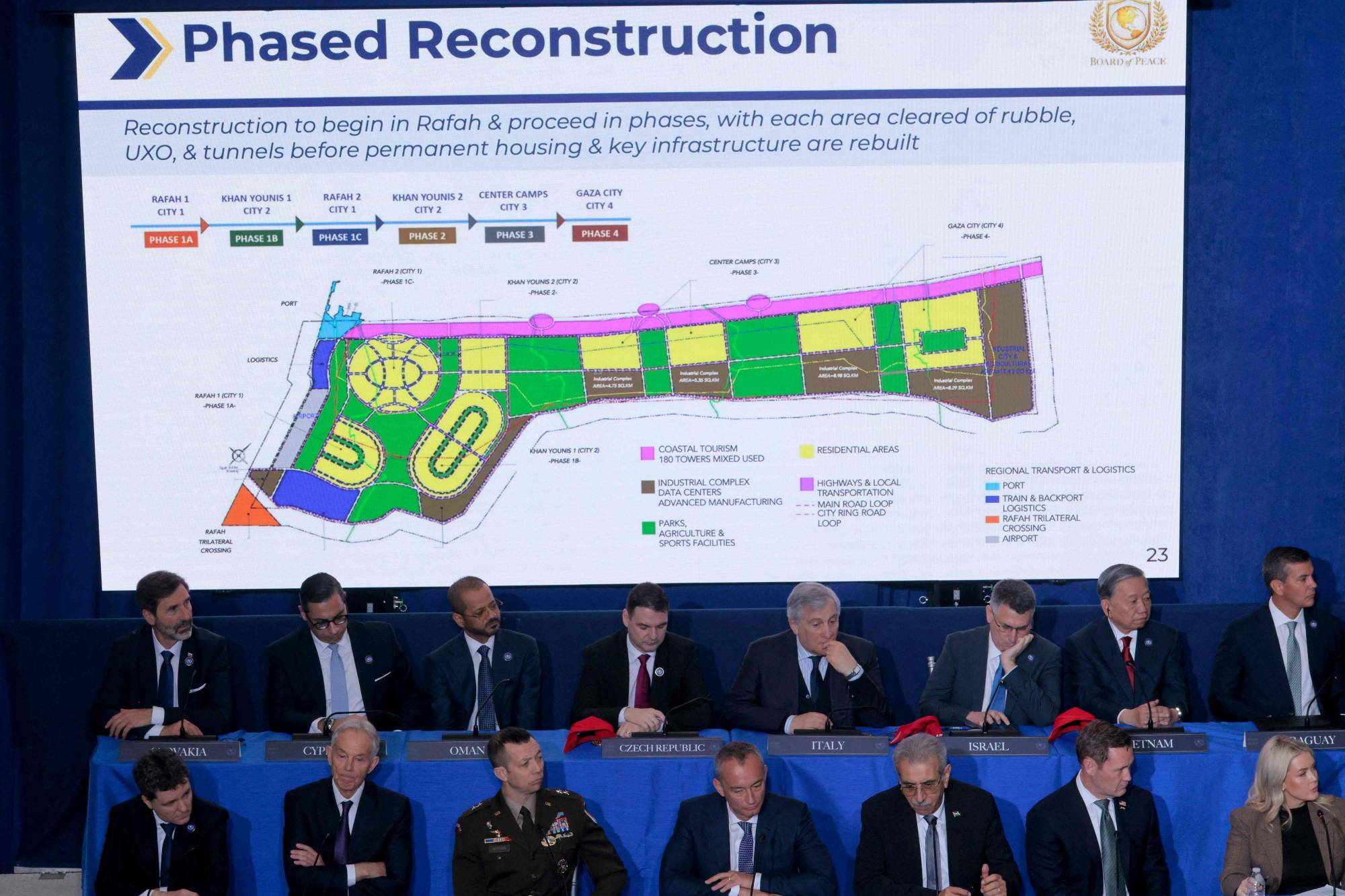غرق العراق في حلقة جديدة من عدم الاستقرار قد تكون أخطر ما يواجهه، بعد عامين بالكاد من إعلان النصر على تنظيم «داعش» في حرب تركت نحو ثلث البلاد وسط ركام الأنقاض وشردت عشرات الآلاف.
ولفتت وكالة «أسوشييتدبرس» الأميركية في تقرير، أمس، عن الأزمة التي تعكسها المظاهرات الأخيرة إلى «الرد القاسي» لقوات الأمن العراقية التي قتلت أكثر من 100 شخص بالرصاص الحي خلال أقل من أسبوع، رداً على مظاهرات «شبان مطالبين بالوظائف والكهرباء والمياه النظيفة ومكافحة الفساد».
وقالت الوكالة إنه «ما زال من غير الواضح لماذا اختارت الحكومة مثل هذا الرد القاسي على بضع مئات من المتظاهرين العزل الذين تجمعوا للمرة الأولى الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم احتجاج». لكنها أشارت إلى أن الرد العنيف على الاحتجاجات «دفع بالعراق نحو مسار خطير قد يكون من الصعب التراجع عنه».
ومع استمرار الاحتجاجات العفوية - مع عدم وجود قيادة سياسية واضحة - في الاشتباك مع قوات الأمن في المدن والبلدات، بدت الحكومة منقوصة الشرعية وفشلت في تقديم حلول للمشاكل الراسخة، مما أثار المخاوف من أن دولة عربية أخرى ستسقط في أزمة مفتوحة من دون أفق.
وكتب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «مجموعة أورآسيا» أيهم كامل أن «استخدام القوة إلى جانب التنازلات الشكلية سيعمل على تخفيف الضغط مؤقتاً، لكنه لن ينهي الأزمة». وقال: «يمكن احتواء دورة الاحتجاجات هذه، لكن النظام السياسي سيواصل فقدان شرعيته».
ولا يختلف المحتجون في مطالبهم بتحسين الخدمات ووضع حدٍ للفساد، عن أولئك الذين قاموا بأعمال شغب في مدينة البصرة الجنوبية بسبب انقطاع التيار الكهربائي المزمن وتلوث المياه الصيف الماضي. أو في عام 2016. عندما قام المتظاهرون الغاضبون بتسلق الجدران في المنطقة الخضراء شديدة التأمين في بغداد واقتحام البرلمان العراقي، وهتفوا: «لصوص».
لكن على عكس ما حدث في عام 2016 عندما قاد الاحتجاجات رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، لم يشترك أي حزب سياسي في احتجاجات اليوم. معظم المتظاهرين من الشباب في العشرينات. ليست لديهم خطة أو قائمة واضحة بالمطالب، وليس لديهم متحدث ينطق باسمهم. وبعضهم من المراهقين أو خريجي الجامعات الجدد غير القادرين على العثور على وظائف في بلد يعاني من الفساد ويملك بعض أكبر احتياطيات النفط في العالم.
هذا الحراك ليست له ملامح واضحة أو حلول سريعة. يقول المتظاهرون إنهم سئموا من الطبقة السياسية الكاملة لما بعد عام 2003 واستفادتها من الرشاوى والمحسوبية والفساد بينما يشرب العراقيون المياه الملوثة ويتحملون بطالة هائلة. والأكثر لفتاً للنظر أن الاحتجاجات هي في الغالب مظاهرات شيعية ضد حكومة يقودها الشيعة.
وعد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمعالجة مطالب المحتجين. لكن الرجل البالغ من العمر 77 عاماً بدأ فترة ولايته العام الماضي في مواجهة مجموعة من التحديات المتراكمة، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة والفساد على نطاق واسع والخدمات العامة المتداعية وضعف الأمن، وقد أخبر المتظاهرين أنه «لا يوجد حل سحري» لذلك كله.
اندلعت الأزمة مطلع الشهر الحالي بعد أن نظم المتظاهرون عبر دعوة على وسائل التواصل الاجتماعي، مظاهرة طالبوا فيها بحقوقهم. وقوبلت بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص. اندلعت المظاهرات جزئياً بسبب الغضب من الإقالة المفاجئة لقائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي الذي قاد معارك ضد مقاتلي «داعش»، وكان ينظر إليه إلى حد كبير على أنه جنرال غير فاسد ومحترم. لكن المتظاهرين حملوا قائمة طويلة من المظالم.
وتأتي الاحتجاجات في لحظة حرجة بالنسبة إلى العراق الذي وقع في خضم التوترات المتصاعدة بين حليفيه الولايات المتحدة وإيران. ومما زاد من حدة التوتر، توعد إيران باستهداف القوات الأميركية المتمركزة في العراق، بعد غارات غامضة استهدفت قواعد عسكرية وذخائر في العراق تابعة لميليشيات «الحشد الشعبي» التي تدعمها طهران.
وعندما بدأت الاحتجاجات، انتشرت بسرعة من بغداد إلى معاقل الشيعة في الجنوب، بما في ذلك البصرة. وفرضت الحكومة حظر تجول على مدار الساعة، وأوقفت الإنترنت لبضعة أيام، في محاولة يائسة لإخماد الاحتجاجات.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الأحد الماضي، إن 104 أشخاص على الأقل قتلوا وجُرح أكثر من 6 آلاف في الاضطرابات. وأشار إلى أن ثمانية من أفراد قوات الأمن كانوا بين القتلى وأن 51 من المباني العامة وثمانية مقار للأحزاب السياسية قد أحرقت من قبل المتظاهرين.
ويبدو أن الحملة الأمنية الضخمة نجحت في تقليص عدد المتظاهرين في الوقت الحالي، رغم استمرار الاشتباكات المتقطعة بين المتظاهرين وقوات الأمن على نطاق أصغر، بما في ذلك تبادل لإطلاق الرصاص استمر لساعات ليلة الاثنين قرب حي مدينة الصدر المضطرب في بغداد.
لكن بين العراقيين والمراقبين، هناك إجماع على أن حاجزاً قد تم كسره وأنه مع مقتل الكثير من المتظاهرين، فمن المرجح أن تعود حركة الاحتجاج، وأن تصبح أكثر تنظيماً في المرة المقبلة، كلما كان ذلك ممكناً. وفي بلد مليء بالأسلحة، هناك مخاوف من أن يؤدي العنف ببعض المتظاهرين إلى تسليح أنفسهم، على غرار ما حدث في سوريا. وهناك قلق أيضاً من دخول بعض الميليشيات المتشددة الموالية لإيران المعركة واستغلال الفوضى.
ودعا زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الذي تحظى ذراعه السياسية بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، الحكومة إلى الاستقالة بسبب العدد الكبير من القتلى. كما علق مشاركة كتلته في الحكومة حتى يتم التوصل إلى «برنامج إصلاحي». وإذا انضم الصدر إلى حركة الاحتجاج، فسيعطيها المزيد من الزخم وربما يؤدي إلى مزيد من العنف.
وتنقل «أسوشييتدبرس» عن مدوّن عراقي قوله إن «الحكومة ربما نجحت في وضع حد للوضع في الوقت الحالي... لكن سيكون مثل جمر جاهز للاشتعال في أي وقت ومكان. وعندما يحدث ذلك، سيحرق الجميع».
احتجاجات العراق... أزمة مفتوحة من دون أفق
https://aawsat.com/home/article/1939121/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%81%D9%82



احتجاجات العراق... أزمة مفتوحة من دون أفق
مخاوف من اتخاذها منحى مسلحاً واستغلالها من الميليشيات الموالية لإيران

عادل عبد المهدي - الصدر

احتجاجات العراق... أزمة مفتوحة من دون أفق

عادل عبد المهدي - الصدر
مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة