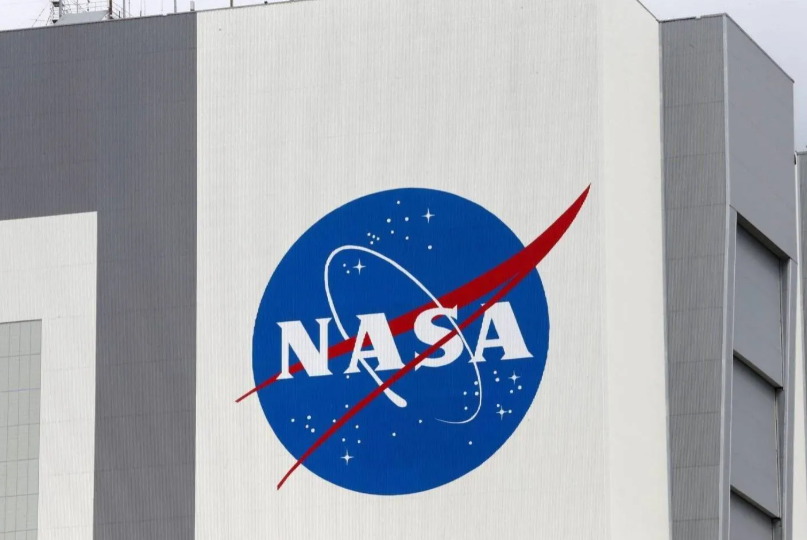من الخطأ بمكان أن نعتقد، نحن الذين غادرنا قرانا النائية وأماكن عيشنا في مطالع الصبا، أن في مستطاعنا العودة إليها بالبساطة التي نظن؛ ذلك أن أرض الطفولة هي حالة من أحوال الأمومة، أو هي أم ثانية لا يتسنى لنا أن نُفطم عن صدرها مرتين. ولعل هذه الفكرة على وجه التحديد هي التي دارت في خلد الشاعر الراحل محمد العبد الله حين هتف قبل نصف قرن، من على منبر كلية التربية في الجامعة اللبنانية، وباسم كل ذلك الجيل القادم من الأرياف الفقيرة بحثاً عن موطئ ملائم للأحلام: «الدم الزراعي ينزف عشباً أخيراً | الدم الزراعي مات». والحقيقة أن ذلك الدم لم يمت تماماً، ولكنه بدأ ينحل كالحبر داخل الروح، أو يتحول بقوة الحنين إلى مادة لصناعة الكلمات. هكذا يبدو الانفصال عن مسقط الرأس، على قسوته، وكأنه الشرط الأهم لإخراجه من صورته الواقعية المألوفة، وتحويله إلى يوتوبيا أرضية، أو إلى كوكبة من الفراديس التي تلمع على طريق الفقدان. ولو كان لنا أن نظل هناك، حيث العالم صغير ضيق مغلق على نفسه، لغرقنا في دوامة الملل والمراوحة والثرثرة اليومية، ولَبَطُل السحر الذي يضرمه الغياب كالنار تحت حطب الحنين والشغف، ولغرقت الأماكن التي نشتاقها عن بُعد في مألوفيتها الرتيبة وخوائها السقيم.
على أن الأمور لا تبقى على حالها في مراحل العمر المختلفة. ففي موازاة القوة الطاردة التي تدفعنا في عقود العمر الأولى إلى شق عصا الترحال، طمعاً بالمغامرة والاكتشاف وتحقيق الذات، ثمة قوة أخرى جاذبة تشدنا إلى الخلف في سني الكهولة والنضج، وتزين لنا العودة إلى النقطة التي انطلقنا منها، حيث الحياة كروية، كالأرض تماماً، وحيث مراتع الشيخوخة ليست سوى محاولة رمزية متأخرة لاستعادة حدائق الصبا، وحيث من الخشب إياه تُصنع الأسرة والنعوش. وإذ يدركنا التعب، ونفقد القدرة على المغامرة ومقارعة المستحيل، وينسحب من تحت أرواحنا بساط الأوهام، لا يعود لنا ساعتئذ سوى الانكفاء نحو مسقط الرأس، لنبني في مرحلة ما بعد التقاعد بيوتاً لتزجية الأيام، وننشئ حدائق وارفة نحاول من خلالها استعادة ما خسرناه من رياض الماضي وحدائقه المفقودة. لكن ما يفوتنا دائماً هو أن ما كان يفصلنا عن القرى التي غادرناها لم تكن الجغرافيا وحدها، لكي نستعيد المكان بمجرد عودتنا إليه، بل تلك الفجوة الزمنية الطويلة التي تفصل بين ما كناه يافعين، وما أصبحنا عليه كهولاً ومسنين. ذلك أن البشر الذين خلفناهم هناك إلى مصائرهم، بمن فيهم الأهل وذوو القربى، تولوا ترتيب حيواتهم وحاجاتهم، وحتى عواطفهم، في ضوء غيابنا الأبدي، بعد أن يئسوا من عودتنا، ووضعونا خارج مرمى الحياة الفعلية، ليقتصر حضورنا على الحنين واستدرار المشاعر واستدعاء الذكريات. وليس البشر وحدهم هم الذين أجروا «هندسات» عاطفية وسلوكية طارئة على حيواتهم في غيابنا، بل الطبيعة أيضاً فعلت ذلك. فالورود التي وخز شوكها أجسادنا في الطفولة كفت منذ زمن بعيد عن انتظارنا لكي تتفتح. ولم يعد الشجر في حاجتنا ليثمر، ولا الريح لتهب، ولا النجوم لتتلألأ، ولا الطيور لتحلق عالياً، ولا الينابيع لتسيل. وفضلاً عن أننا تغيرنا كثيراً، وبتنا ظلالاً باهتة لما كناه في الماضي، فإن الأشياء (كما الكائنات) التي ألفناها فيما مضى لم تعد هي نفسها الآن. وهو عين ما قصده أبو تمام، حين قال وهو يختبر تجربة مشابهة: «لا أنت أنت ولا الديارُ ديارُ».
وفي روايته «الجهل»، القصيرة شبه الوثائقية، يعرض ميلان كونديرا للمصائر المأساوية للمهاجرين التشيك الذين عادوا إلى بلادهم بعد تفكك الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية في العقد الأخير من القرن الماضي، والذين كان معظمهم قد نزح إلى فرنسا وبلدان أوروبا الغربية، هرباً من وطأة النظام الشمولي الذي حكم تشيكيا بقبضة من حديد لعقود عدة. وإذ يتابع صاحب كتاب «الضحك والنسيان» بنفسه معاناة العائدين، ويتحدث إلى بعضهم عن كثب، يكتشف أنهم عوملوا من قبل المجتمعات التي انفصلوا عنها بجفاء ولامبالاة، إن لم نقل بعدائية وتوجس. فمن جهة أولى، لم يلتفت أحد إلى الأسباب القاهرة التي دفعتهم إلى الهجرة، بل نُظر إليهم بوصفهم المتخاذلين والأنانيين الذين بحثوا عن طوق للنجاة بأنفسهم، هرباً من سفينة الوطن الغارقة. ومن جهة ثانية، كانت الحياة الفعلية تدور من دونهم، وخارج معرفتهم، في نظر أهلهم وأصدقائهم القدامى. لذلك، فإن ما اختبروه بعيداً عن التراب الأم لم يكن سوى ضرب من ضروب الجهل والفصام الروحي الذي لا سبيل إلى إصلاحه. هكذا، كان على بعضهم أن ينغلقوا على أنفسهم كالشرانق، وحيدين منفصلين عن كل ما حولهم، مكتفين بأن يجدوا على أرض وطنهم مكاناً لمواراة جثامينهم متى أزف الوقت، فيما اختار البعض الآخر العودة إلى المنفى الذي عصمهم، شباباً، من الفاقة والتشرد، ولن يبخل عليهم، عجائز وشيباً، بالرعاية اللازمة.
«ما مضى لن يعود»، يقول إدغار ألان بو، على لسان الغراب، في قصيدته التي تحمل الاسم ذاته. هذا ما يتكشف لنا جلياً، نحن الذين عولنا على متكأ وملاذ أخيريْن لأجسادنا المتهالكة، وأرواحنا التي قصمتها الهزائم وخيبات الأمل. فالعالم الذي نعود إليه، ذاهلين شبه عميان، ليس هو العالم القديم الطافح بالبراءة وهناءة العيش، الذي أطبقنا عليه أجفاننا، نحن أهل الغفلة ورعاة السهو، منذ عشرات الأعوام. أما الحياة التي نتوق إلى استعادتها فتتفتح ورودها عميقاً في الأسفل، حيث لا سبيل إلى بلوغها إلا بالموت.
11:9 دقيقه
أماكن تتعذر استعادتها إلا بالموت
https://aawsat.com/home/article/1937021/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA



أماكن تتعذر استعادتها إلا بالموت
قوة جاذبة تشدنا إلى الخلف في سني الكهولة والنضج

لوحة «العودة» للرسام الأميركي فيليب غوستون

أماكن تتعذر استعادتها إلا بالموت

لوحة «العودة» للرسام الأميركي فيليب غوستون
مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة