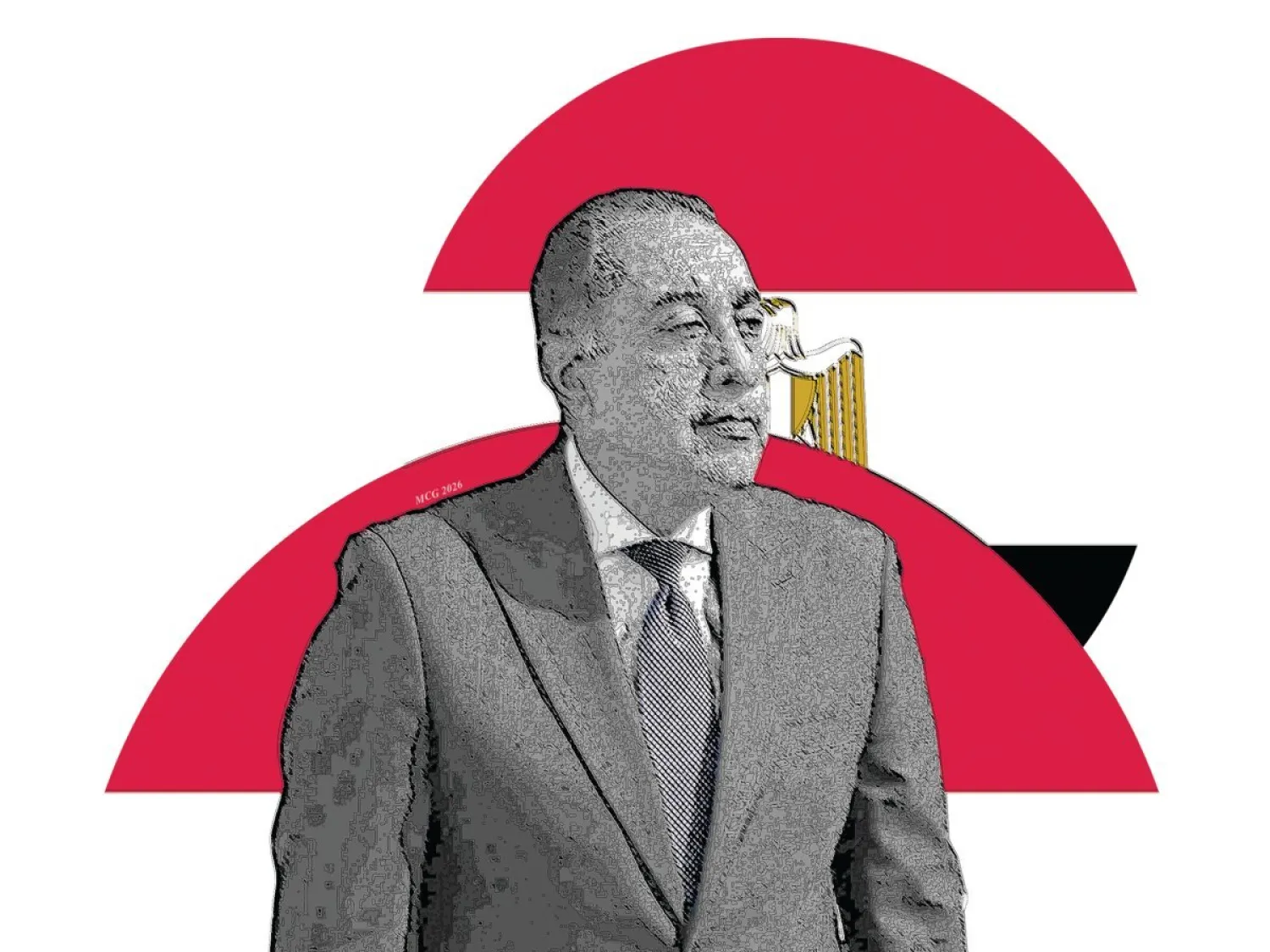لم تسجّل نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور في مصر طوال عقود كثيرة مضت حالة رفض. وعلى ذلك فإنه لا يوجد مجال للشك في أن عملية التصويت التي تنطلق اليوم (السبت) داخل البلاد، وبدأت أمس للمقيمين بالخارج، ستنتهي إلى إقرار التعديلات. وبالتالي، ستجد مصر نفسها أمام مشهد سياسي مُغاير وممتد الأثر بحد أدنى حتى عام 2030. ومع أن التعديلات لم تأت بجديد على مستوى تأكيد موازين القوى القائمة بالفعل؛ فإنها تعضد بسند من الدستور ممارسة سلطات ومؤسسات لصلاحيات ومهام وأدوار لم تكن في عهدتها، وإن أقدمت، سابقاً، على تنفيذ بعضها بموجب «تفويض شعبي» أو «تعديل تشريعي».
وللدلالة على اتساع نطاق التعديلات بما يرسم المرحلة الحالية من عمر البلاد بصورة مختلفة، فإن جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكذلك مؤسّسة القوات المسلحة، جميعها نالت نصيباً من التغيير، سواءً تعلّق ذلك بطريقة الإدارة، أو وصف الدور، أو سنوات الولاية.
مبكراً جداً، وتحديداً، منذ مطلع العام الحالي تقريباً، اتجهت أنظار المتابعين داخل مصر وخارجها إلى الشقّ المتعلق بالمدة الرئاسية في تعديلات مواد الدستور. إذ إن المقترح الذي ظهر إعلامياً وفي ساحات القضاء في البداية، وتنقل بين مراحل مختلفة، كان يشير إلى تعديلات تسمح ببقاء الرئيس في السلطة حتى عام 2034، وهكذا ظهرت النسخة الأولية في البرلمان أيضاً بموجب مقترح من ائتلاف الغالبية «دعم مصر»، لكن المادة محل التعديل لم تخرج من البرلمان على سيرتها الأولى.
ويمكن القول إن ثمة ارتباكاً خيّم على مسار المناقشة بشأن المادة «241 مكرّر»، فلقد أجازها البرلمان بشكل مبدئي بما يسمح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بشكل استثنائي، أن يترشح لفترتين رئاسيتين مقبلتين. واعتبر مقدّمو التعديلات أن ذلك لا يتناقض مع القيد المفروض في مادة أخرى «226» بما يحظر تعديل المواد المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية.
وبالنظر إلى أن السيسي تمكّن في يونيو (حزيران) الماضي، من الوصول إلى سدة الحكم للفترة الثانية التي كانت ستنتهي في عام 2022، كان المقترح مبدئياً أن يترشّح الرئيس لفترتين، كل منها 6 سنوات بما يسمح له بالبقاء في منصبه حتى عام 2034.
انتقلت المادة إذن مع غيرها من مقترحات التعديلات إلى عهدة لجنة الصياغة التابعة للجنة «الشؤون التشريعية والدستورية»، وهي التي استضافت بدورها جلسات تحت اسم «الحوار المجتمعي»، بحضور مؤسسات وهيئات وأحزاب غلب عليها الطابع المؤيد للتعديلات. وقرب نهاية المدة القانونية للانتهاء من الصياغة، ظهر فجأة مقترح بدا «غريباً» في رأي خبراء قانونيين، يتلخص في منح الرئيس الحالي فترة إضافية لمدّته الرئاسية التي انتخب عليها سابقاً وانتهت عام 2018، والأخرى السارية. بمعنى آخر أن يجري تطبيق زيادة الفترة الرئاسية بأثر رجعي، إذ بعدما كان السيسي قد انتخب على أساس فترة رئاسية مدتها 4 سنوات، فيستفيد بموجب هذا المقترح بزيادتها إلى 6 سنوات وفق تعديل الدستور الذي سيُستفتى الشعب عليه.
الصياغة الجديدة
وبين قبول وتأييد، في مواجهة تشكيك وطعن في مدى القانونية، خرجت الصياغة الجديدة. وبها جمع البرلمان بين الأمرين، وطبّق بأثر رجعي مدة الزيادة لسنوات حكم الرئيس للفترة القائمة التي ستنتهي - وفق الصيغة الجديدة - عام 2024. وسيُسمح له، أيضاً بشكل استثنائي، بالترشح لفترة ثالثة، وعلى أساس 6 سنوات للفترة. وهكذا، انتهت الصيغة إلى إمكانية بقاء الرئيس في السلطة حتى عام 2030.
لقد جاءت الصيغة التي أقرّها البرلمان على النحو التالي: «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية». وربما لا تبدو مسألة 4 سنوات كفارق بين المقترحين مسألة كبيرة، خصوصاً، بالنظر إلى الفكرة الأولى. بل قد يعدها البعض كَبحاً لفكرة الاستمرار الطويل في السلطة التي طالما عانت منها مصر سابقاً، أو تأثيراً من المعارضة في الموالاة. لكن ما صاحبها من إعلان رئيس مجلس النواب علي عبد العال، في خضمّ حسم مناقشة صياغة المواد المقترحة، من أن الدستور القائم يحتاج إلى تعديل كامل وإعادة صياغة شاملة - قدّر أنها ستكون بعد «خمس إلى عشر سنوات» - جاء كإشارة بالغة الدلالة إلى مستقبل الدستور القائم، وبالتالي، احتمال إدخال تعديل جديد على ما يجري الاستفتاء عليه حاليا.
وفي الحقيقة، تبدو إشارات رئيس البرلمان عن الحاجة لدستور جديد، متوافقة مع ما قاله الرئيس المصري في سبتمبر (أيلول) 2015، من أن الدستور المصري «كُتب بنيات حسنة، والدول لا تُحكم بحسن النيات فقط».
أدوار ومهام
يدرك مراقبو المشهد المصري طبيعة وحجم الدور الذي تمثله مؤسسة القوات المسلحة في البلاد، وانعكس ذلك في السنوات التسع الأخيرة على نحو لافت، بتحرّكين بالغي الدلالة في خضم تجاذبات واحتجاجات وتغيرات سياسية: إذ تدخّل الجيش في أحداث «ثورة 25 يناير (كانون الثاني)»، وساهم على وقع اعتصام المتظاهرين، في تنحّي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن السلطة. ثم عاد مرة أخرى في أحداث «ثورة يونيو» وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم، بعد مظاهرات حاشدة، ودعا القائد العام للجيش (حينها) عبد الفتاح السيسي إلى «تفويض شعبي» من المواطنين لمواجهة جماعة «الإخوان».
وتسجل البيانات الرسمية للقوات المسلحة المصرية، في أجواء «الثورتين»، تعابير «الالتزام بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه»، كمسوّغ للتفاعل مع «25 يناير». ثم الإشارة إلى أن «القوات المسلحة المصرية، كطرف رئيسي في معادلة المستقبل وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في حماية أمن وسلامة هذا الوطن (...)، يكون لزاماً عليها استناداً لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية واحتراماً لمطالب شعب مصر العظيم أن تعلن عن خريطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية»، بحسب بيان ما بعد مظاهرات (30 يونيو).
وهكذا، تأتي التعديلات الدستورية الجديدة لتنصّ على الأدوار والمهام التي سبق أن لعبتها وتولتها القوات المسلحة. إذ تشير «المادة 200» من الدستور، الذي تحققت الموافقة عليه عام 2014 إلى أن «القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات (...)». لكن التعديلات التي أدخلت تقول إن «القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، (وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد)، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات (...)».
كلمة «المدنية»
لقد أثارت كلمة «المدنية» في التعديلات حفيظة نواب حزب «النور»، ذي التوجهات الإسلامية، في بداية المناقشات استناداً إلى تمسكهم بتفسير أن مصر «دولة إسلامية»، كذلك واجهت معارضة من قوى مدنية رأت في الأمر «تدخّلاً في السياسة». إلا أن رئيس البرلمان علي عبد العال، قال للنواب إن «التعديلات المقترحة على هذه المادة، كاشفة لدور القوات المسلحة، وليست منشئة للقوات المسلحة، فهي دائماً وأبداً تختص بمهمتين: حماية الدولة وتأمين حدودها، وحماية شرعيتها الدستورية».
في المقابل، تَحذف التعديلات في صيغتها النهائية كلمة واحدة من المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إذ تقول المادة القائمة إنه «لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثِّل اعتداءً (مباشرا) على المنشآت العسكرية، أو معسكرات القوات المسلحة، أو ما في حكمها»، غير أن الصيغة التي يجري التصويت عليها حذفت كلمة «مباشرا» من المادة.
أما منصب وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، فسيكون من شأن التعديلات تثبيت اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيينه بشكل دائم. وبعدما كانت صيغة «المادة 234» من الدستور تشير إلى أن «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين ابتداء من تاريخ العمل بالدستور (2014)»، يأتي التعديل لينص على أن يكون «تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، دون تحديد للمدة.
ما يتعلّق بالقضاء
أيضاً، وفق التعديلات، تُغيّر «المادة 193» طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، إذ تشير في صورتها الحالية إلى أن «اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون بناءً على قرار الجمعية العمومية لها، ويصدر الرئيس قراراً بتعيينهم». لكن التعديل الجديد يمنح «رئيس الدولة سلطة اختيار رئيس الدستورية من بين أقدم 5 نواب، كما يعيّن نائب رئيس المحكمة».
وفي الشأن القضائي نفسه تأتي إضافة فقرة لـ«المادة 189» التي تحدّد طريقة اختيار النائب العام، وتُلزم في صورتها الحالية أن «يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى (...) ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية». غير أن التعديل يشير إلى أن «يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى».
وثمة تعديل آخر يرتبط بالسلطة القضائية، جاء في مقترح تعديل «المادة 190» التي تنصّ على أن «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختصّ دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية (...) ومراجعة وصياغة مشاريع القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية». وجاء التعديل ليضيف عبارة «التي تُحال إليه»، الأمر الذي من شأنه السماح لمجلس الدولة بمراجعة مشاريع القوانين التي ينظرها البرلمان، في حال قرر الأخير إحالتها، وإنهاء الإلزام الذي تنص عليه المادة الحالية بإحالة كل القوانين لمراجعتها وصياغتها.
أما تعديل «المادة 189»، فيُنشأ بموجبها «مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية» برئاسة رئيس الجمهورية. وتنص كذلك على أن «يُعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيّهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
«استقلال» القضاء
أما بالنسبة لطريقة إصدار القرار في المجلس فإنها تكون «بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس». وأثناء مناقشة هذه المادة دبّ خلاف بشأن إنابة رئيس الدولة لوزير العدل في رئاسة «المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية»، ونشب جدال بين عبد العال، ومعدّي صياغة التعديلات، إذ نوّه عبد العال بعدم جواز ترؤس مسؤول تنفيذي (وزير العدل) مجلساً يضم ممثلي الهيئات القضائية، واعتبر أن ذلك «يمسّ استقلال القضاء».
وانتهى الخلاف بشأن تلك المسألة بالوصول إلى صيغة تسمح لرئيس الجمهورية، في حالة غيابه، بأن يفوّض من يراه «من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية».
السلطة التشريعية
وبموافقة من مجلس النواب، على نصوص التعديلات، أقرّ البرلمان بنفسه تقليص عدد مقاعده. وبينما يسجل عدد أعضاء البرلمان الحالي 596 نائباً، تأتي التعديلات ليُشكَّل «مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصَّص للمرأة ما لا يقل عن رُبع إجمالي عدد المقاعد».
ومن دون صلاحيات تشريعية، جاءت التعديلات لتعيد مجلس الشيوخ إلى الحياة السياسية المصرية، وهو الذي كان سابقاً يحمل اسم «مجلس الشورى». ولقد حدّدت «المادة 248» اختصاصات المجلس المتمثلة في «دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقوّمات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته».
وبموجب التعديلات «تكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السِّرّي المباشر، ويعيِّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي»، ويشكل «الشيوخ» «من عددٍ من الأعضاء يحدّدهم القانون على ألا يقلّ عن (180) عضواً».
وفي مادة أخرى، هي «المادة 249»، تُلزِم التعديلات بأن يؤخَذ برأي مجلس الشيوخ في «الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية».
ويشترط في مَن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يُعيَّن فيه أن «يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية».
وفيما يتعلق بالدور الرقابي، فإن «رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غيرُ مسؤولين أمام مجلس الشيوخ»، بسحب التعديلات كذلك.