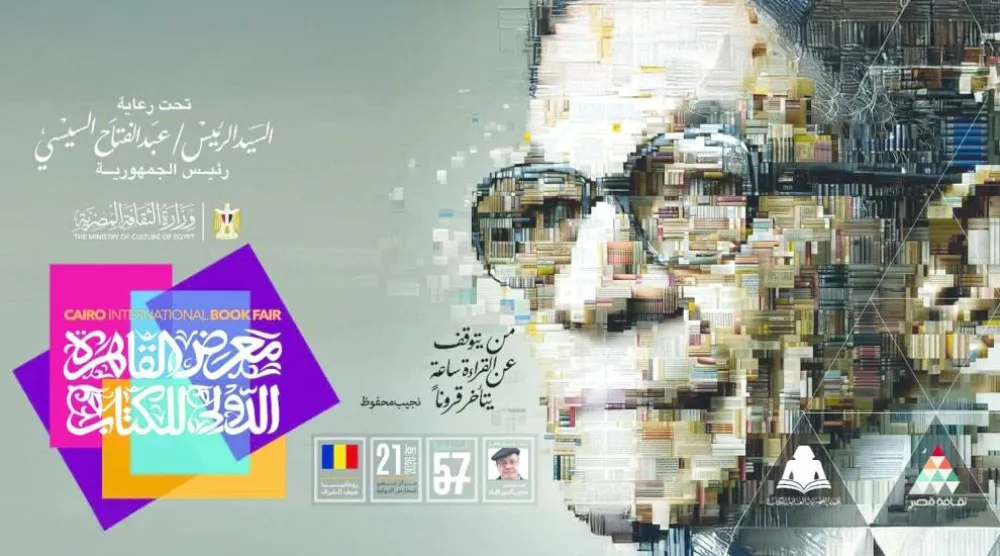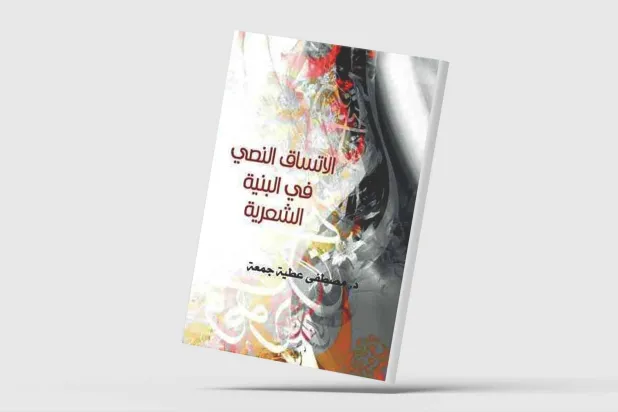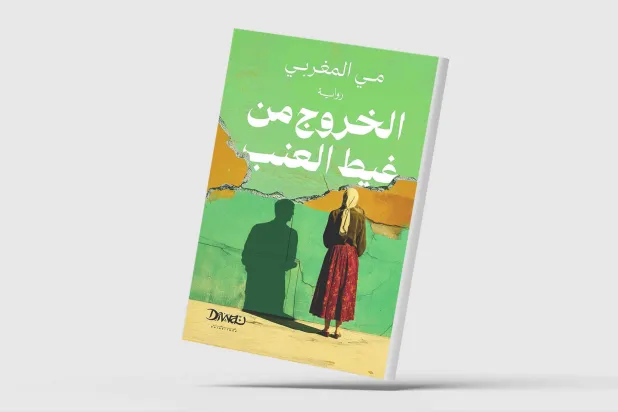للدكتور أحمد المطيلي صدر أخيراً كتاب «علم النفس المدرسي - معالم نظرية ومنهجية وتطبيقية»، الذي جمع فيه بين خبرتي المنظر والمعالج الميداني. وهو أول كتاب في بابه عن علم النفس المدرسي في المكتبة المغربية. ويأتي في سياق سياسة الإصلاح التي تنتهجها وزارة التعليم في البلد والدعوة لتطوير الخدمات النفسية والتربوية والاجتماعية المقدمة للطفل والمدرس والأسرة جميعاً. هنا حوار مع المؤلف حول الإصدار الجديد، والأسباب التي أدت إلى ضعف تدريس علم النفس المدرسي، والمشكلات التي تلم بالمتعلم، مثل عسر القراءة وعسر الإملاء وعسر الكتابة وعسر الحساب...
> هل ثمة اختلاف بين علم النفس المدرسي وعلم النفس التربوي؟ أم أن المسألة تتعلق بصياغات مختلفة للموضوع ذاته؟
- حقاً هناك تداخل بين مجالات علم النفس التربوي وعلم النفس المدرسي مع فارق دقيق؛ هو أن علم النفس التربوي يهتم أساساً بسيرورة التعلم ورفع كفاية المتعلم والمعلم، كما يسعى إلى تحسين البرامج الدراسية والمناهج التعليمية المتبعة وطرق مختلف وسائل التقييم. فهو من أهم الروافد التي يمتح منها علم النفس المدرسي بجانب روافد أخرى. أما النفساني المدرسي فيستعين في عمله بنظرة أشمل تراعي مختلف الجوانب المتصلة بالنمو الوجداني والانفعالي والمكونات الشعورية واللاشعورية والصلات الأسرية والاجتماعية التي تتحدد بها شخصية الطفل وتحدد مختلف الأنماط السلوكية التي يأتيها الطفل داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها. وعنده أن سيرورة التعلم لا تقتصر على العوامل المعرفية فقط وإنما تتصل اتصالاً شديداً بمختلف مجريات الحياة الوجدانية والانفعالية والأسرية أيما اتصال، وهي لذلك تستوجب اهتماماً قد لا يقل أهمية عن العوامل المعرفية. وتبعاً لذلك يتولى النفساني المدرسي الكشف عن مختلف الاضطرابات التي تلم بالمتعلم، مثل مشكل اضطرابات الانتباه والكلام والتخلف الذهني ومختلف أنماط سوء التوافق النفسي والمدرسي. ثم إن المسألة مسألة تأهيل كذلك، فقد نجد من المختصين في مجال علم النفس التربوي من لم يحصل على تأهيل مهني كافٍ يمكنه من استثمار معارفه النظرية استثماراً تطبيقياً يؤهله لمقابلة الطفل والأسرة وتطبيق مختلف الروائز لقياس الذكاء ومختلف مناحي الشخصية. ومع ذلك أقول بضرورة التعاون بين المختصين في هذين المجالين، كلما أمكن ذلك خدمة لكل من الطفل والأسرة والمدرس.
> هل يمكن لعلم النفس المدرسي أن يقوم بمهمته منفرداً؟ أم أنه في حاجة إلى دعم وتكامل مع بقية الفروع العلمية الأخرى؟
- علم النفس المدرسي علم تطبيقي قائم الذات، لأنه يتشكل من موضوع ومنهج ويستهدي بأسس وتصورات نظرية معلومة. غير أنه ليس علماً منقطع الصلة عن بقية الفروع الأخرى وما ينبغي. فالفروع النفسية الأخرى بمثابة روافد يستقي منها مفاهيمه ونظرياته وطرائقه المنهجية. وقد ذكرت منها القياس النفسي وعلم النفس المرضي وعلم النفس العيادي وعلم نفس النمو وعلم النفس التربيائي وعلم النفس الاجتماعي والتحليل النسقي وعلم النفس المعرفي. فعلم النفس يستعين بهذه الفروع جميعاً وفق نظرة تكاملية دعوت إليها في آخر الكتاب تفادياً للنظرة الجزئية التي تسلط الضوء على جانب محدد وتترك بقية الجوانب الأخرى في الخفاء.
> أشرت في تقديم كتابك إلى بعض العوامل التي تفسر قلة تدريس علم النفس المدرسي في المؤسسات الجامعية... هل يمكن أن توضح لنا الأمر بشكل أكثر تفصيلاً؟
- بالفعل لقد أثرت هذه المسألة في بداية كتابي لما رأيته من غياب لهذه المادة في برامج التدريس الجامعي في عدد من الدول العربية التي قدر لي الاطلاع على برامجها في مختلف أسلاك التعليم العالي.
فأنا أفترض أن مرد هذا الغياب عدم الاهتمام بهذا الفرع من فروع علم النفس التطبيقي، بدليل أن الخدمات التي يقوم بها النفساني المدرسي كالفحص النفسي، والتتبع النفسي للتلاميذ غير مستوفاة في المؤسسات الحكومية. ومن أجل ذلك يلزم مأسسة هذه الوظيفة بتعيين النفسانيين المدرسيين على غرار ما تفعله عدد من الدول التي أدركت الفائدة المتوخاة من المهام المذكورة خدمة للتلميذ وللأسرة وللمجتمع جميعاً. مع أن كثيراً من الأصوات قد ارتفع في الآونة الأخيرة للمطالبة بإصلاح التعليم وتجويده والوقاية من الأخطار المتربصة بالتلميذ كالمصاعب الدراسية واضطرابات التعلم وما تفضي إليه من سوء التوافق النفسي والعنف والتعثر والفشل والهدر المدرسي وما شابه. فعلم النفس يستجيب لداعي الإصلاح الذي ينشده القائمون على شؤون التعليم ويهفو إليه الداعون للنهوض به وتجويده.
> يلاحظ أنك تستعمل بعض المصطلحات غير المتداولة في كتابك من قبيل «علمياء» بديلاً عن نظرية المعرفة أو استخدام كلمة «تربيائية» بديلاً عن تربوية وكذلك كلمة «مأسسة»...
- أشكرك على انتباهك إلى مشكل المصطلح هذا. حقاً لقد لجأت إلى استخدام بعض المصطلحات غير المعهودة بين عموم القراء، بل وعند بعض المختصين أنفسهم. فقد استخدمت لفظ «علمياء» بديلاً لما يصطلح عليه بمبحث المعرفة أو الأبستمولوجيا، واستعملت لفظ «التربياء» للدلالة على علم التربية أو البيداغوجيا. وكلا اللفظين صيغ على وزن فعلياء التي تستخدم للدلالة على مباحث معينة مثل مبحث السيمياء.
وأما لفظا الفيزياء والكيمياء فهما مصطلحان مستحدثان للدلالة على مبحثين قديمين. وما شجعني على هذا المنحى الاصطلاحي أني لاقيت استحساناً من المشاركين في الدورات التدريبية التي أشرفت على تنشيطها، فكان عدد من الأساتذة يستحسنون أن تصاغ مصطلحات عربية خالصة ويستثقلون بديلاتها ذات الأصل الإغريقي. على أن البعض الآخر كان يساير الألفاظ الشائعة ولا يجد غضاضة في استعمالها لشيوعها. وقد اجتهدت كذلك في ابتداع مصطلح «الاستمهاء» للدلالة على قدرة الفرد على أن يضع نفسه مكان الغير ليحس بما يعتمل في نفسه من أحاسيس ومشاعر وشواغل فيتمكن من مد يد المساعدة إليه. وما عدا ذلك، فقد حرصت على استخدام المصطلحات النفسية الشائعة ما دامت تفي بأغراض البيان والتفاهم وتستجيب لمقتضيات الفصاحة والدقة والسلاسة والشيوع. ولم أتوانَ عن تذييل الكتاب بثبت المصطلحات المستعملة ومقابلاتها بالفرنسية والإنجليزية تيسيراً على القارئ المتخصص.
وليت المختصين في علم النفس وفي بقية المجالات العلمية يحذون هذا الحذو اجتناباً لكثير من مظاهر الفوضى الاصطلاحية المستشرية في كثير من الكتابات العربية الحديثة تأليفاً وترجمة.
> ما أهم المشكلات التربوية والنفسية التي تناولتها في كتابك والأسباب التي أفضت إليها؟
- لقد أفردت فصلاً خاصاً لتناول عدد من المشكلات الدراسية والنفسية التي تلم بالمتعلم.
وفي مقدمة المشكلات الدراسية نجد اضطرابات التعلم مثل عسر القراءة وعسر الإملاء وعسر الكتابة وعسر الحساب. وهذه من أهم الاضطرابات التي تضر بالمتعلم وتتسبب له في مشكلات لا حصر لها، وقد تفضي به رأساً إلى التعثر الدراسي بل الفشل والانقطاع، علماً أنها اضطرابات تصيب أطفالاً لا تقل معدلات ذكائهم عن المتوسط، بل قد نجد منهم ذوي درجة عالية من النباهة والذكاء. ونحن نعرف أن عدداً من المشاهير في الشرق والغرب عانوا من بعض هذه الاضطرابات، ولولا العين الساهرة لبعض المدرسين وحرص الآباء لكان مصيرهم الشارع. وقد قدر لي في آخر مؤتمر وطني شاركت فيه بالرباط أن صادفت طبيباً مغربياً متخصصاً ورئيساً لإحدى الجمعيات الطبية المتخصصة أسَرّ لي في حديث خاص معه أنه يعاني من عسر القراءة، وقد استطاع رغم كل المصاعب التي لاقاها أثناء دراسته في المغرب وفي فرنسا لاحقاً أن يغالب بكل ما أوتي من قوة تبعات هذا الاضطراب وأن ينجح في دراسته ويصل إلى ما وصل إليه. وثمة مشكلات نفسية كثيرة ذكرت منها مشكلة اضطراب الانتباه والكلام والتخلف الذهني ومشكل التفوق والعنف والهروب من المدرسة والغش في الامتحانات والرهاب المدرسي. ولم يفتني أن أثير مسألة الاضطرابات العضوية التي يعاني منها المتعلم كمشكل الإعاقة بأنواعها الحاسية والحركية والذهنية وما تستوجبه من اهتمام وعناية خاصة. وتقتضي هذه المشكلات على اختلافها كشفاً وفحصاً وتشخيصاً وتتبعاً.
> ماذا عن طرق العلاج وإمكانات الأخصائي النفسي في التدخل؟ وما العقبات التي تقف أمامه وكيف يمكن في نظرك التغلب عليها؟
- بعد عملية الكشف والفحص والتشخيص تأتي عملية التتبع والإرشاد والعلاج، والأفضل منها جميعاً عملية الوقاية.
إذ إن عدداً لا يستهان به من المشكلات التي تلم بالطفل المتعلم في مختلف مراحل التعليم قد يكون مردها إلى الروابط الأسرية والأساليب التربوية المتبعة في المعاملة أو التدريس. ومن شأن الاستشارة النفسية التي يحرص عليها النفساني المدرسي بمعية والدَي الطفل أو أحد أعضاء هيئة التدريس أن تمكنه من الوقوف على حيثيات الاضطرابات التي تظهر على الطفل ونمط الاستجابة التي يسلكها في البيت أو في الفصل الدراسي، فتكون وسيلة لتغيير عدد من التمثلات وتوضيح عدد من المسببات واستشراف طرق أخرى أقل كلفة وأيسر تنفيذاً وأجدى نفعاً. أما عن العلاج النفسي فالقاعدة المتبعة أن المشكلات التي تتصل اتصالاً مباشراً بالمؤسسة التعليمية؛ إن من حيث نمط التعامل أو المناخ المدرسي السائد والعلاقات القائمة بين الطفل وأقرانه مثلاً، تعالج في المؤسسة نفسها. فمن شأن بعض التعديلات التي بوسع المدرس أو أعضاء الهيئة الإدارية إجراؤها داخل الفصل أو في الفضاء العام للمؤسسة التعليمية أن تبدد الاضطراب الذي يلم بالطفل ولو بمقدار. وأما الاضطرابات النفسية التي تمس شخصية الطفل أو التي تتصل بالقصور أو الخلل في ملكاته الذهنية والمعرفية والأداتية فيحبذ علاجها في المراكز المتخصصة.
> كيف تفسر الإهمال الجسيم الذي تتعرض له وظيفة الأخصائي النفسي في المدارس والمؤسسات التعليمية إلى درجة أن من يقوم بهذه الوظيفة في بعض الأحيان لا صلة له من قريب أو بعيد بهذه الوظيفة المفيدة لصحة ومستقبل التلاميذ والطلاب؟
- تلك إحدى النتائج المترتبة عن الغفلة عن مهنة النفساني المدرسي، ذلك أن عدداً من المهام التي يضطلع بها النفساني المدرسي بحكم تخصصه توكل إلى أشخاص آخرين غير مؤهلين للقيام بها، وتهمل البقية الباقية منها كالفحص النفسي بواسطة الروائز المستخدمة في تقييم مستوى ذكاء المتعلمين وكفاياتهم وشخصياتهم ومعارفهم الدراسية، وتتبع حالات التلاميذ الذين يلم بهم عدد من الاضطرابات النفسية والمشكلات الدراسية فتعيق مسيرتهم التعليمية وتحول بينهم وبين الانشراح النفسي والتوافق الدراسي.
ونحن نعلم أن الفحص المبكر الذي يتولى النفساني القيام به في مستهل كل عام دراسي أو كلما دعا داعٍ إليه مثل التنبيه الصادر من أحد المدرسين أو أولياء التلاميذ أو عند إعلان النتائج الدراسية في نهاية كل دورة دراسية، كل ذلك كفيل بالكشف عن حالات التلاميذ التي تستدعي تتبعاً خاصاً أو رعاية نفسية أو تربوية أو طبية داخل المؤسسة التعليمية نفسها أو في المصالح المتخصصة في الوقت المناسب. ولعل أحد أسباب الهدر المدرسي الذي يستنزف كل سنة أعداداً هائلة من المتعلمين في مختلف مراحل التعليم إنما يعزى إلى انعدام المواكبة النفسية للتلاميذ وعدم محاصرة المصاعب الدراسية واضطرابات التعلم التي يقاسي منها المتعلمون في صمت وتتضرر منها الأسر وتؤخر مسيرة المجتمع بأسره.
د. أحمد المطيلي: كيف نبني الذات العربية إن اضطربت نفسية طالب العلم؟
كتاب مغربي عن ضعف تدريس علم النفس المدرسي ومشكلات المتعلمين


د. أحمد المطيلي: كيف نبني الذات العربية إن اضطربت نفسية طالب العلم؟

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة