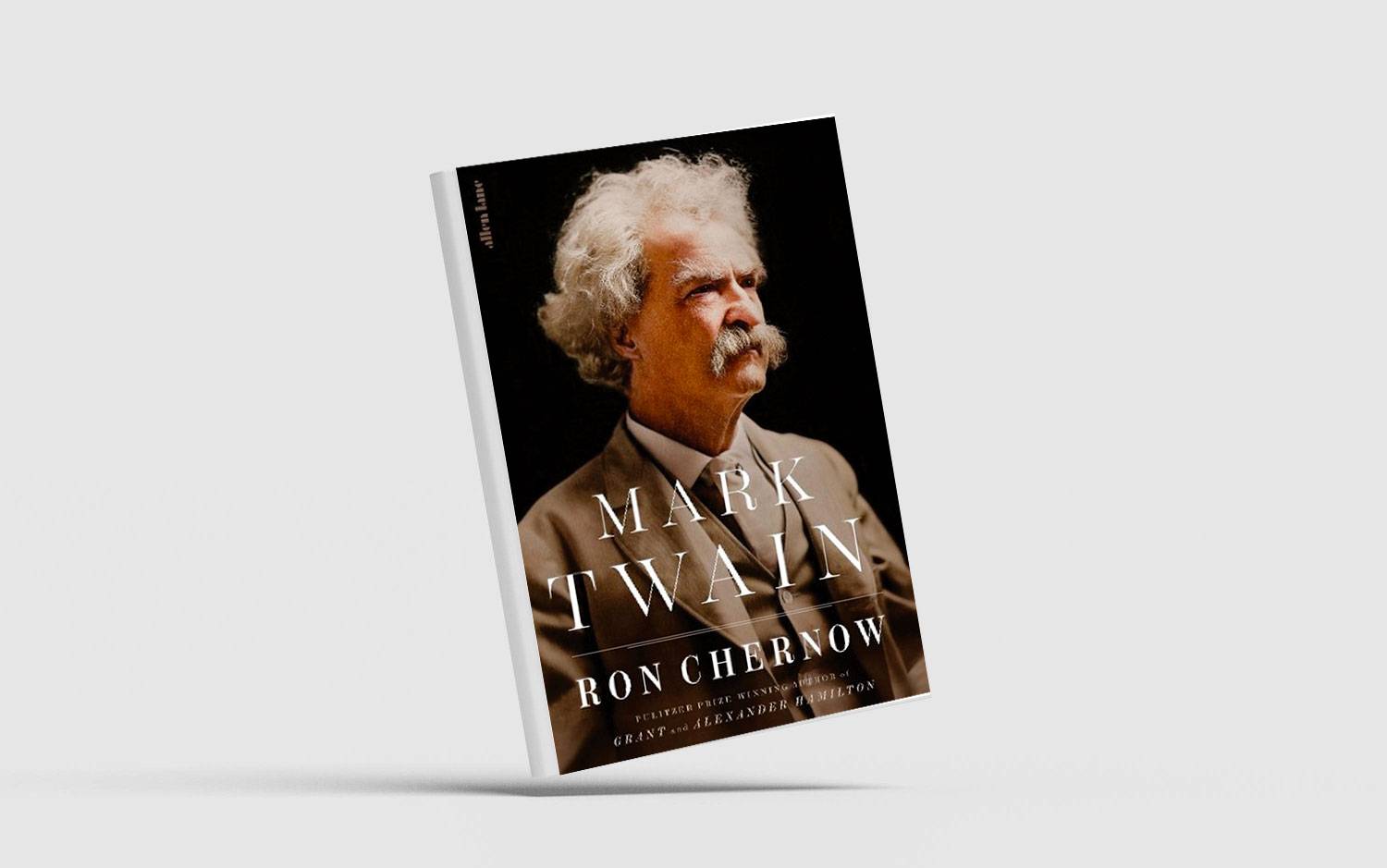إذا كان الزمن هو الناقد الأهم والعامل الحاسم في الحكم على نتاج الشعراء والمبدعين، فإن المرء لا يجافي الحقيقة بشيء إذا اعتبر أن أمل دنقل هو أحد الشعراء القلائل الذين نجحوا في امتحان الزمن، وتمكنت نصوصهم من الرسوخ بثبات في ذاكرة القراء والمتابعين على المستويين المصري والعربي. ففي حين كان النسيان جاهزاً لتلقف العشرات من مجايلي الشاعر، فإن العشرات من نصوص أمل دنقل، الذي رحل في مثل هذه الأيام قبل ثلاثة عقود ونصف العقد، لا تزال نابضة بالحياة وقادرة على الإفلات من أسر اللحظة العابرة لمعاينة عراك الإنسان، العربي بوجه خاص، مع نفسه من جهة، ومع محيطه وسلطاته القامعة وقدره المأساوي من جهة أخرى. على أن قدرة دنقل على مقارعة النسيان لم تتوفر بفعل موهبته العالية وحدها، بل بفعل عوامل عدة، من بينها إخلاصه التام لهذه الموهبة، وتعهده لها بالكدح والاطلاع، وصدقه النادر في علاقته بنفسه وبالآخرين، إضافة إلى اندفاعته الضارية باتجاه الحياة، ورفضه الحاسم لعقد الصفقات المادية والأخلاقية مع سلطة الأمر الواقع، أو للتنازل عن كل ما يتعلق بالحرية والعدالة وكرامة الإنسان.
لم تكن شخصية أمل دنقل من جهة ثانية لتتسم بالمرونة واللين وتدوير الزوايا، ولا كان صاحبها قابلاً للانصياع للأعراف والتقاليد السائدة، بل ظل طيلة حياته مخلصاً لنزاهته وصدقه وصوته الداخلي. ورغم أنه انخرط بكليته في عوالم القاهرة وطقوسها المدينية وصراعات مجتمعها الثقافي، فإن ميله الجارف إلى الصعلكة والتسكع وارتياد الحانات والمقاهي لم يستطع أن يقتلعه من جذوره الصعيدية التي أصَّلت في داخله قيم الفروسية والشهامة والكرم والحدب على الآخرين. على أن صاحب «تعليق على ما حدث» لم يكن ليقيم في الوسط من أي شيء، ولا ليقبل بأنصاف الصفات والحلول، بل يوثر الذهاب إلى تخوم الأضداد، حيث يلتقي النزق مع الخجل الريفي، واللسان السليط مع القلب المنفطر، والعدائية الفظة مع البكاء المكتوم والدموع الخرساء. ولعل أفضل بورتريه عاكس لظاهر أمل وباطنه هو ذلك الذي قدمته حبيبته ورفيقة سنيّه الأخيرة عبلة الرويني في كتاب «الجنوبي»، حيث تشير إلى تناقضاته السلوكية بالقول: «استعراضي يتيه بنفسه في كبرياء لافت للأنظار. بسيط بساطة طبيعية يخجل معها إذا أطريته وأطريت شعره... صخري شديد الصلابة لا يخشى شيئاً ولا يعرف الخوف أبداً، لكن من السهل إيلام قلبه». أما إشارة الرويني إلى انفعالية زوجها وميله إلى المشاحنات الحادة والعراك الجسدي، فقد عاينتها بشكل مباشر أثناء سهرة جامعة أقامها أحد الكتاب في بيروت بمناسبة انعقاد «ملتقى الشقيف الشعري» في أوائل الثمانينات، حيث تعارك أمل مع أحد شعراء العراق المعروفين بعد أن عمد هذا الأخير إلى اتهام المصريين بالمساومة، والتفريط بحقوق الفلسطينيين. فأمل الذي لم يستسغ آنذاك تجاهل البعض للتضحيات الجسيمة التي قدمها آلاف المصريين على مذبح القضايا العربية المختلفة لم يستطع أن يدافع عن كبريائه الجريح بغير ذلك النوع من العنف اللفظي والجسدي.
لم يبتعد أمل دنقل عن الموضوعات الوطنية والقومية التي تناولها العديد من أترابه الذين عُرفوا اصطلاحاً بجيل الستينات، والذين وجدوا أنفسهم ممزقين بحكم الظروف العربية الصعبة بين الذهاب بمغامرة الحداثة حتى تخومها الرؤيوية والجمالية، وبين اعتبار الشعر أداة فعالة من أدوات التغيير السياسي والاجتماعي. ولعل هذا الارتباك بين المفهومين قد عكسته بشكل جلي مجلة «الآداب» البيروتية، كما دار «الآداب»، اللتان احتفتا في الآن ذاته بفكرة اللا منتمي عند كولن ولسون وبمبدأ الأدب الملتزم عند جان بول سارتر. ومع أن دنقل قد انحاز بشكل واضح إلى فكرة الالتزام في الأدب وإلى تقليص المسافة التي تفصل الشعر عن جمهوره، إلا أنه حرص كل الحرص على ألا يتم ذلك على حساب القيمة الإبداعية والجمالية للنص. وإذا كان عمله الأول «مقتل القمر» لا يختلف عن النصوص السائدة في زمنه، رغم ما فيه من إرهاصات تعبيرية وصورية واعدة، فقد أخلد الشاعر إلى الصمت سنوات عدة ليخرج بعدها بمجموعته المتميزة «البكاء بين يدي زرقاء اليمامة» التي بدت بعض نصوصها إرهاصاً واضحاً بهزيمة يونيو (حزيران)، وبفقدان الجدوى من أي تغيير في ظل مازوشية الأمة الجمعية والاستسلام التلقائي لأنظمة القهر والاستبداد. وهو ما تعكسه بوضوح قصيدة «كلمات سبارتاكوس الأخيرة» التي يخاطب فيها الشاعر «قيصر الصقيع» قائلاً: «يا قيصر العظيم: قد أخطأتُ / إني أعترفْ / دعني على مشنقتي ألثم يدكْ / ها أنذا أقبّل الحبل الذي في عنقي يلتفْ فهو يداكَ / وهْو مجدك الذي يجبرنا أن نعبدكْ... يا إخوتي الذين يعبرون في الميدان بانحناءْ / لا تحلموا بعالم سعيدْ / فخلف كل قيصرٍ يموت قيصرٌ جديد». وبعد وقوع الهزيمة بأيام معدودة يكتب أمل في القصيدة التي جعلها عنواناً لمجموعته «أيتها العرافة المقدسة / ماذا تفيد الكلمات البائسة؟ قلتِ لهم ما قلت عن قوافل الغبارْ / فاتهموا عينيك يا زرقاء بالبوارْ / وحين فوجئوا بحد السيف / قايضوا بنا / والتمسوا النجاة والفرارْ».
ثمة نبرة من المرارة وخيبة الأمل تطل من وراء كل قصيدة كتبها أمل دنقل بعد الهزيمة. ففي مجموعته اللاحقة «تعليق على ما حدث»، يتنقل الشاعر في أزقة مدينته الكبرى، فلا يسمع سوى نشيج البشر التائهين فوق أزقة الفقر والخنوع والإذلال، حيث الماء يسقط دماً في الصنابير، والنيل يبحث عن أوراقه الثبوتية لكي يُسمح له بالجريان، والشاعر المنكفئ إلى داخل نفسه يتوق إلى الصراخ ضد ما يحدث فيصاب بالرعب مخافة أن يحمل الصدى نداءه إلى «الهوائيات فوق أسطح البيوت». أما «العهد الآتي»، فتشكل من حيث التكثيف الدلالي والنضج المعرفي وتوظيف التراث الإنساني واحدة من أفضل مجموعات الشاعر وأكثرها تمثيلاً لمهاراته وتحولاته المتسارعة. فالشاعر إذ يستعير من النص الديني بعض رموزه ومفاتيحه اللغوية والأسلوبية يبدو وكأنه يعيد على طريقته كتابة هذا النص من منظور التاريخ الفعلي، لا من منظور المثاليات المجردة. وهو تبعاً لذلك يقدم لقرائه إصحاحات ومتواليات حوارية تجسد رؤيته إلى واقع البشر وحقيقتهم الصادمة: «قلت: فليكن العدل في الأرض / عينٌ بعينٍ وسنٌّ بسنْ / قلت: هل يأكل الذئب ذئباً أو الشاة شاة / ولا تضع السيف في عنق اثنين: طفلٍ وشيخ مسنْ / ورأيت ابن آدم يردي ابن آدم / يشعل في المدن النار / يغرس خنجره في بطون الحوامل / يلقي أصابع أطفاله علفاً للخيول / يقص الشفاه وروداً تزيّن مائدة النصر... وهي تئنْ». ولم يفت الشاعر بالمقابل الإفادة من المرويات والسير الشعبية المتغلغلة في وجدان العرب من محيطهم إلى خليجهم، بغية الحث على مواجهة الظلم والانتصار للحقوق المغتصبة والدم المراق. وهو ما عكسته قصيدته الملحمية «أقوال جديدة عن حرب البسوس» التي أثبت فيها الشاعر مرة أخرى أن ما يحدد قيمة العمل الفني ليس موضوعه بل قدرة صاحبه على رفده بطاقة المغايَرة، والتأويل، وشحنات التوهج الإبداعي. وما زلت أذكر حتى الآن تلك اللحظات المؤثرة التي صعد فيها أمل دنقل، متكئاً بسبب المرض على عصاه، إلى منبر الشعر في الذكرى الخمسين لغياب شوقي وحافظ، حتى إذا شرع بالقراءة وعاين بالملموس حب جمهوره له استعاد حيويته المعروفة، وهو يردد بلسان كليب مخاطباً أخاه المهلهل قبل أن يلفظ أنفاسه: «لا تصالحْ ولو منحوك الذهبْ / أتُرى حين أفقأ عينيك / ثم أثبّت جوهرتين مكانهما هل تَرى؟ هي أشياء لا تُشترى... إنها الحرب ُقد تُثقل القلب لكن خلفك عار العربْ لا تصالح ولا تتوخّ الهربْ».
في عمله الأخير «أوراق الغرفة رقم 8» الذي كتبت معظم نصوصه في المستشفى، تبلغ تجربة أمل ذروة شفافيتها ونقائها التعبيري والروحي. ليس ثمة من مكان هنا للغة الصاخبة والغضب من تردي الواقع، بل تصفية حساب مع الحياة، واستعداد للعبور إلى الضفة الأخرى. والكتابة هنا تشتغل على خط الدمج بين مصير الكائن الفرد وبين المآلات المماثلة للأشياء والكائنات، كما في قصائد «الخيول» و«الطيور» و«الزهور» التي تهدى إلى المرضى، وتحمل «اسم قاتلها في بطاقة». وإذا كان ثمة شبه واضح بين تجربتي المرض لدى بدر شاكر السياب وأمل دنقل، إضافة إلى شبه آخر في الشكل والملامح، فإن الثاني مدفوعاً بأنفة وكبرياء نادرين لا يحول معاناته إلى فرصة للنواح والتفجع وطلب الاستغاثة، بل إلى أسئلة ممضة عن مغزى وجودنا العابر على الأرض. وحتى في قصيدته «ضدّ من» لا يكتفي بالإشارة إلى ما يعتمل في داخله من حرقة النفس ووهن الجسد، بل يشير إلى المفارقة الملغزة بين بياض أماكن الموت وسواد التعبير عن حضوره «لون الأسرة / أربطة الشاش والقطن / قرص المنوّم / أنبوبة المصل / كوب اللبنْ / كلّ هذا البياض يذكّرني بالكفنْ / فلماذا إذا متّ يأتي المعزّون متّشحين بشارات لون الحدادْ / هل لأن السوادْ هو لون النجاة من الموت / لون التميمة ضدّ الزمنْ / ضدّ مَنْ؟ ومتى القلب في الخفقان اطمأنْ؟».
لا بد أخيراً من طرح السؤال الذي طالما طرحه المختصون والنقاد على أنفسهم: هل حالت السياسة والالتزام بقضايا الوطن والأمة دون ذهاب أمل دنقل بعيداً في مغامرة الكتابة؟ وإذا كنت أجيب من زاويتي الشخصية بالنفي فليس من باب المجاملة، والشاعر لم يعد بيننا اليوم، بل لأن موهبة أمل المتوقدة وانصهاره الوجداني بموضوعاته وقراءته العميقة للتاريخ قد أسهمت جميعها في النأي بتجربته عن التقريرية والمباشرة والشعارات الطنانة، وأتاحت لشعره أن يوائم بين الحفر المعرفي والرؤيوي من جهة، وبين براعة التأليف الماكر والقدرة على الإدهاش من جهة أخرى. كما أن هجوم أمل الضاري على الحياة والتحامه بورودها وأشواكها، أبعد شعره عن الافتعال والتجريد الذهني، ووفر له مروحة واسعة من المرئيات والتفاصيل والحواريات السردية التي ترسم للبشر المتعبين ملامحهم وهواجسهم وتلاحق مصائرهم إلى محطاتها الأخيرة. إنه شعر حواس وروائح ومذاقات وأخلاط وغرائز ورغبات طازجة وشقاوات وآلام، بقدر ما هو شعر ارتطام شبقي بالعالم وكائناته وأشيائه. إضافة إلى كل ذلك ثمة قدرة لافتة على التجريب والمغامرة الشكلية التي تجعله يضع نصين متوازيين على صفحة واحدة، أو يستثمر على إيقاعات البحور وجوازاتها وشطورها بما يعصم النص من الرتابة والتنميط الأسلوبي. وهو يلح على استخدام الرجز لأن هذا البحر يتيح أكثر من سواه التعبير عن خلجات النفس وتوتراتها، بعيداً عن التطريب والإنشاء العاطفي الصرف. كما يُظهر الشاعر براعة استثنائية في اجتراح التناظرات الدقيقة بين الجمل واختيار القوافي الساكنة ذات الرنين الصوتي المتناغم. أما المعيار الأهم للحكم على شاعرية أمل دنقل فيتمثل في تجاوزها بنجاح لامتحان الزمن، بحيث يمكن لنا أن نقرأها مرات ومرات دون أن يفارقنا الشعور الغامر بمتعة القراءة أو لذة الاكتشاف.
أمل دنقل... التمرد على السائد والمغامرة الجمالية
بعد 35 سنة على غيابه

أمل دنقل

أمل دنقل... التمرد على السائد والمغامرة الجمالية

أمل دنقل
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة