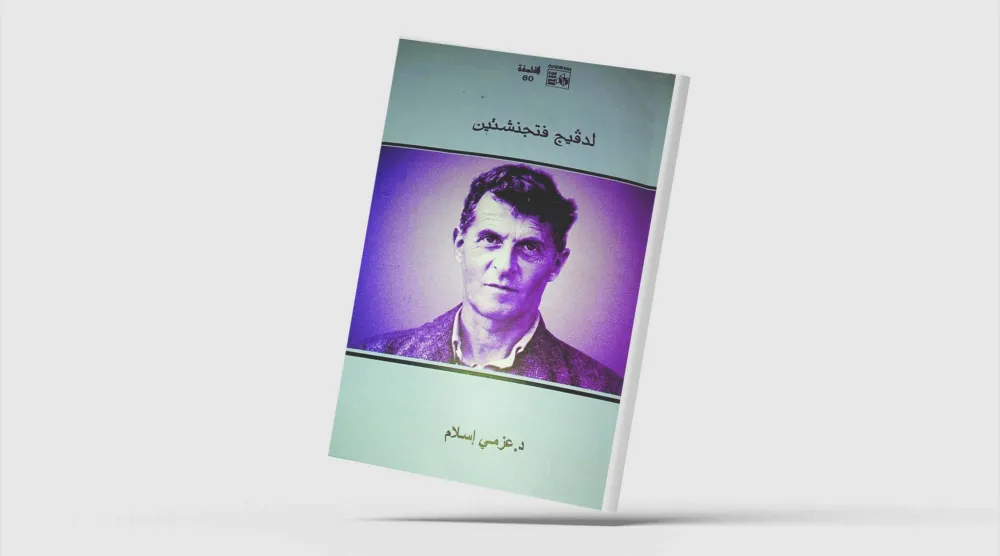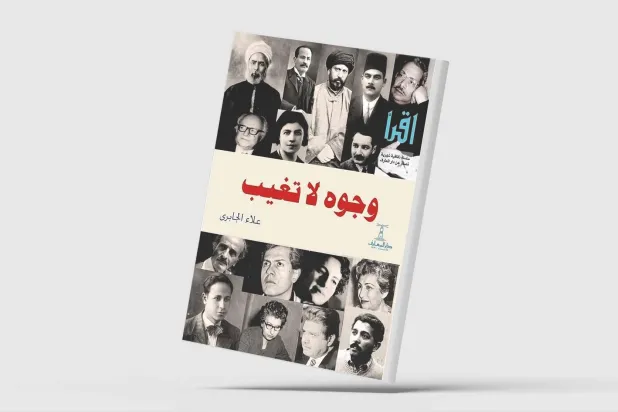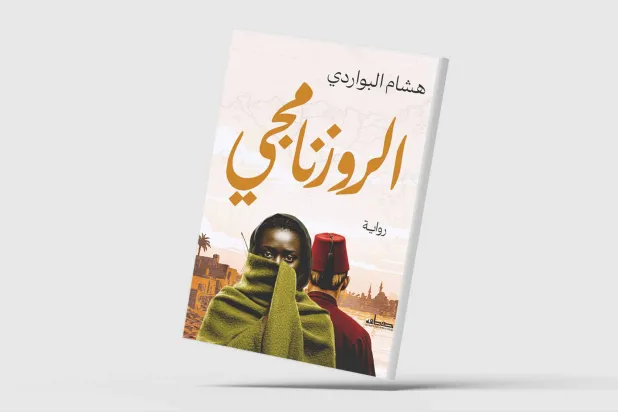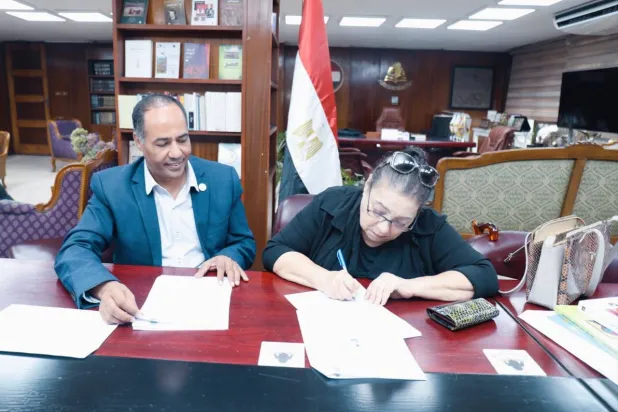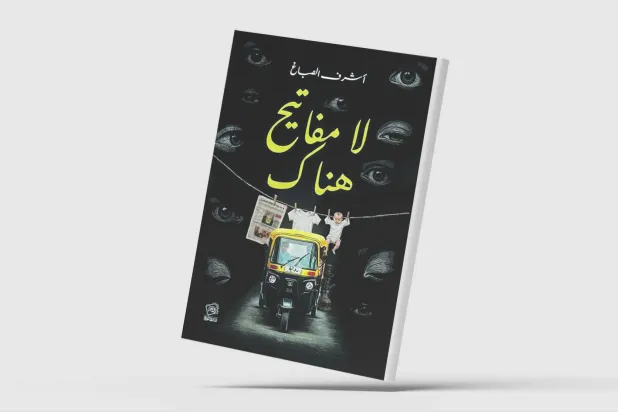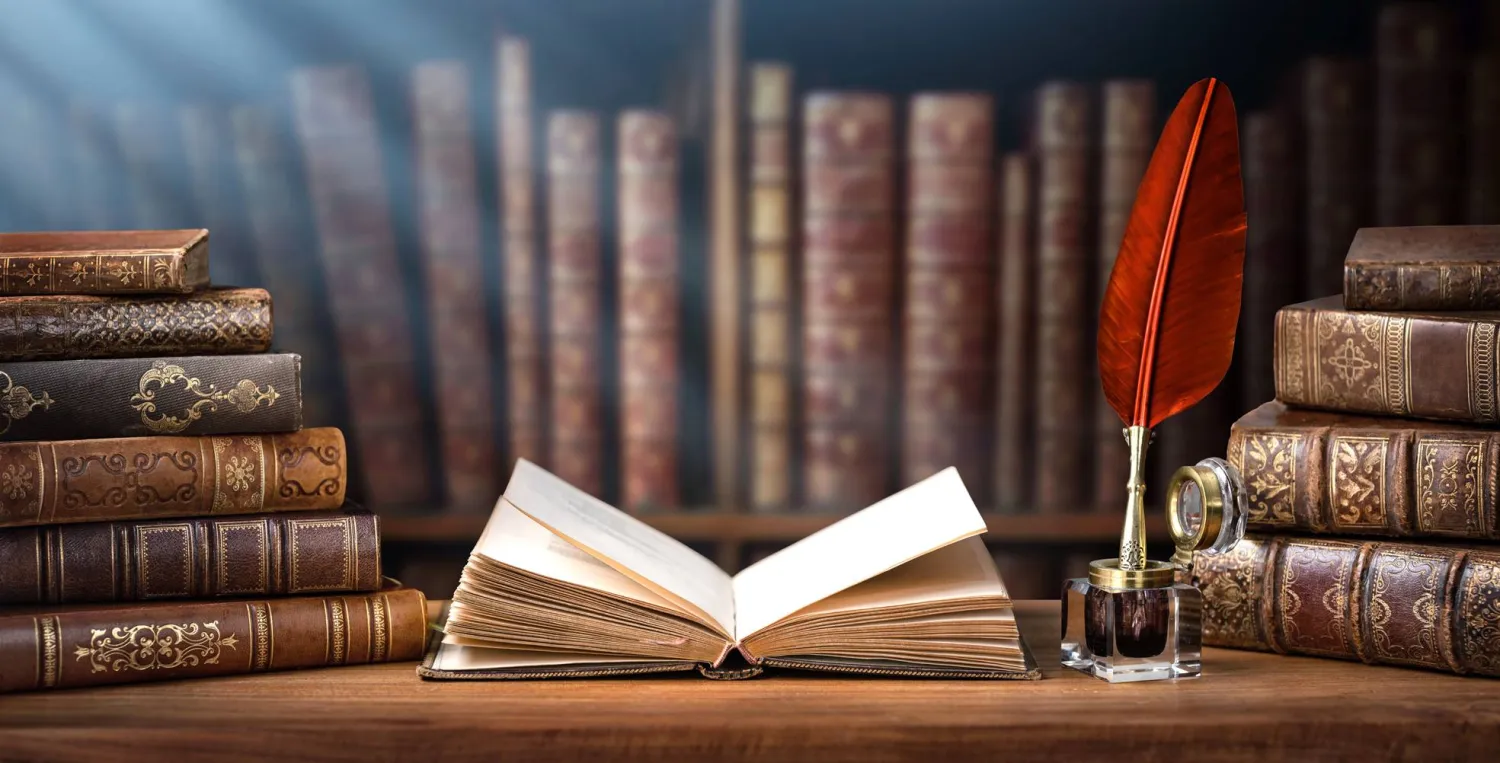تلج الروائية والكاتبة السعودية أميمة الخميس عالماً مختلفاً للكتابة الروائية، بعيداً عن نهجها الذي غالباً ما يتخذ منحى اجتماعياً على نسق أعمالها الروائية السابقة: «الوارفة» و«زيارة سجى» و«البحريات»، كما في عملها الجديد «مسرى الغرانيق في مدن العقيق»، الصادرة عن «دار الساقي» في 559 صفحة. وتتركز الرواية حول شخصية مزيد الحنفي النجدي، برحلاته المبتدئة باليمامة، المتنقلة ما بين بغداد والقدس والقاهرة وحتى الأندلس، في سعي نحو تطبيق وصايا سبع اكتشفها أثناء رحلاته. لأول وهلة، يظهر الجهد المبذول في البحث والسرد من منطلق تاريخي لتتمحور الحكاية بشكلٍ أو بآخر في اليمامة حيث حكمها بنو الأخيبر واستبدوا فيها.
هذا العمل، وإن كان مختلفاً، فإنه امتداد لأعمال أميمة الخميس السابقة بنمطٍ مختلف، إذ إنها جميعاً تتمركز على المنطقة الوسطى في الجزيرة العربية، كما أن الكاتبة تخرج فيه عن الساردة الأنثوية باختيار شخصية ذكورية لسرد الحكاية.
يبرز حضور اليمامة في بداية الرواية، إلا أن ملامح نجد تنتقل إلى المدن الأخرى عبر شخصية مزيد الذي يناقض الصورة النمطية لأعرابي قادم من اليمامة، والانطباع عنه باعتباره «الصحراوي الجلف» أو «الجاهل»، ليثبت عكس ذلك بعمله كبائع للكتب، وبعمق ثقافته وافتتانه بالكتب والفلاسفة والمفكرين وإجادته إلقاء الشعر.
يعكس هذا العمل الروائي أيضاً مبلغ التنوع الثقافي والديني في العالم الإسلامي في عام 402هـ، وامتداداً إلى عام 405هـ، وإن كانت تلك التعددية تتعرض للتقهقر فيما بعد عبر إلغاء الآخر وشيطنة أي معتقد يخالف ما يعتنقه المرء، إلى الحدّ الذي وصف فيه الفلاسفة بالهرطقة والإلحاد وظهور جماعات سرية مثل جماعة السراة.
تبدأ رحلة مزيد من خلال انتقاله إلى بغداد بصخبها وتنوع تركيبتها الثقافية، التي تسبب له صدمة اجتماعية وحضارية، عانى منها وانعكست على نفسيته، فبات يوصف نفسه «بالصحراوي الذي لا يستسيغ السمك ويتقزز من رائحته النفاذة رغم محاولات الآخرين إقناعه بلذة طعمه»، كما أن تجربته في «دار الندوة» تركت تأثيراً سلبياً بالغاً عليه بهيبتها كمركز فكري، وإن كانت مليئة بالمتملقين والنرجسيين ممن عاملوه بعدائية كدخيل. من هنا، تبدأ مرحلة أزمته الداخلية وتساؤلاته المتشككة مثل: «ماذا فعلت بنفسك يا مزيد؟ ماذا غرسك بينهم؟»، أو «هل أنا عفّ نزيه أم أنني لم أصل ساحة وغي الشياطين بعد؟»، و«لا يوجد لدينا حق خالص، ولا باطل خالص»، تقلب مزيد بين المدن كرحّالة استكشافي جعله يصل إلى قناعة بضرورة مروره بمرحلة تطهر بلا دنس وخطايا نتيجة انفتاحه على العالم الخارجي إذ «سلخت عني مزيد اليمامة، وجعلتني صحيفة بيضاء يخط القدر فوق ضلوعي وصاياه السبع»، ولكن هذه الوصايا السبع تبدو غير مقنعة، بل عبارة عن مواعظ تختفي بين طيات الرواية، وقد كان من الممكن توظيفها بشكلٍ أكبر إذ هي غير مرتبطة بمتن العمل الروائي مثل الوصية الثالثة: «العالم هو نار ونور، اشرب من أكواب المعرفة دون أن تلسعك نيرانها، فهي غايتك العظمى وفيها نجاتك».
وعموماً يمكن القول، إن المدن هي بطل رئيسي في الرواية، إلى جانب شخصية مزيد، بدءاً بجزء من العنوان «مدن العقيق»، واستكمالاً في السرد حيث تفوق سطوة المدن وتأثيراتها على الحوارات وتركيبة الشخصيات التي رافقت مزيداً في رحلاته حول المدن، إذ تذوب كل شخصية وتختفي حال انتقاله إلى مدينة جديدة.
وينطبق ذلك أيضاً على العلاقات العاطفية السريعة المتآكلة التي مرّ بها مزيد، إذ تظهر فجأة وتنتهي بعجالة فلا يتبقى منها إلا هواجسه ووقوفه على الأطلال. ونلاحظ على الرواية أيضاً، تكلفاً في استخدام اللغة في أجزاء منها، فهناك جمل مركّبة كثيرة أدّت إلى نوع من الثقل في القراءة، وقد يكون ذلك ناتجاً عن السعي لعكس الحقبة الزمانية للرواية، عام 402 للهجرة.
وتسببت هذه الجمل المركبة بالتشتت لا سيما أن هناك توصيفات ليس لها علاقة بحبكة الرواية مثل: «أسدل فوقهما ستائر بيضاء منعشة، وفي طياتها شيء يشبه الفرح»، و«خلّفنا هدير البحر خلفنا ورائحة مطر وغيوم تتجمع فوق رؤوسنا».
لكن تظل الرواية بشكلٍ عام جريئة بفكرتها وأسلوبها الذي خرجت فيه الروائية أميمة من بوتقة الأعمال الاجتماعية إلى التجريب الذي يستلهم المدن ويتطرق إلى حقبة زمنية وتاريخية سابقة، على نسق «موت صغير» و«قواعد العشق الأربعون»، التي توحي بشكلٍ أو بآخر بعهد جديد للروايات التي تتنقل في بلدان مختلفة من خلال الأسفار والرحلات، عاكسة ثقافات مختلفة في الوقت نفسه.
14:11 دقيقه
«مسرى الغرانيق» لأميمة الخميس... ذوبان الشخصيات واستنطاق المدن
https://aawsat.com/home/article/1252061/%C2%AB%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%82%C2%BB-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%B0%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86



«مسرى الغرانيق» لأميمة الخميس... ذوبان الشخصيات واستنطاق المدن

- الرياض: نداء أبوعلي
- الرياض: نداء أبوعلي

«مسرى الغرانيق» لأميمة الخميس... ذوبان الشخصيات واستنطاق المدن

مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة