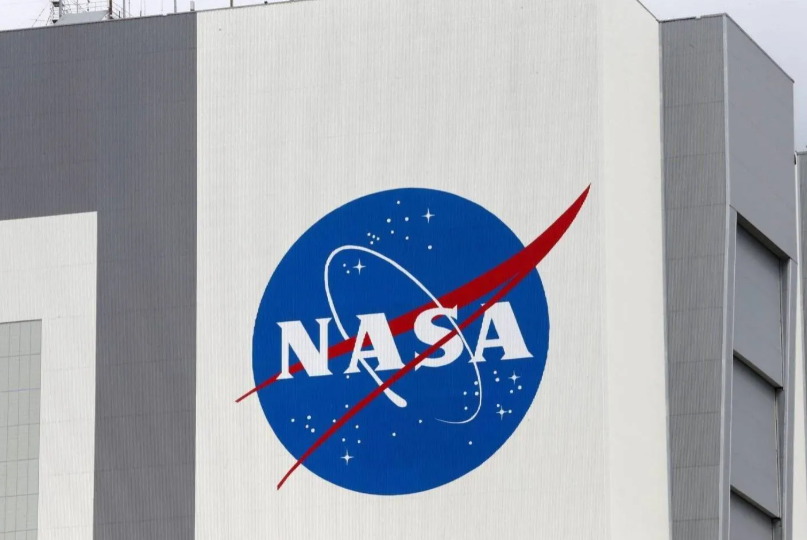لطالما أثارت الجوائز المختلفة التي تمنح للكتاب والمبدعين لغطاً واسعاً وغير محدود في الأوساط الثقافية والنقدية والإعلامية. فلا تكاد هيئة من الهيئات المعنية بهذا الشأن تعلن أسماء الفائزين بهذا الفرع الأدبي أو ذاك حتى تتصاعد موجات متتالية من ردود الأفعال المنقسمة بين الابتهاج والاحتجاج، وبين التأييد والتشكيك. وهذه الردود لا تنحصر في أهلية الأشخاص الممنوحين وأحقيتهم في بعض الأحيان، بل تتعدى ذلك إلى التنديد بالفكرة نفسها واعتبارها نوعاً من الرشى التي تهدف إلى تدجين الكتاب وإعادتهم إلى حظائر السلطة وبيت طاعتها. وإذا كانت مثل هذه الشكوك لا تجد في بلدان الغرب وأقطاره المتقدمة مسوغاً كافياً لها، فإن الأمر يختلف كل الاختلاف في العالم العربي وبلدان العالم الثالث حيث تخضع كثير من الجوائز، وبخاصة الرسمية منها، لاعتبارات خارجة عن أهلية الأسماء والأعمال المرشحة ومتصلة بالأثمان السياسية والأخلاقية التي لا يتورع البعض عن دفعها من أجل غنائمه الموعودة. ومع ذلك فإن من الإجحاف أن نضع الجوائز الرسمية في سلة واحدة، إذ ينبغي التفريق جيداً بين الجوائز التي وظفها بعض الحكام لتلميع صورتهم وتزيين بلاطاتهم بصغار الكتبة والمداحين، وبين تلك التي تلتزم بالحد المعقول من معايير النزاهة والموضوعية، وتتخذ طابعاً تقديرياً للرواد والمكرسين وتشجيعياً بالنسبة للشبان من ذوي المواهب الواعدة.
وأعتقد أنهم نادرون أولئك الشعراء والكتّاب الذين لا يطمحون إلى نيل جوائز أدبية مرموقة يحققون من خلالها اعترافاً بمكانتهم ومنجزهم الإبداعي، فضلاً عن المكافأة المالية التي ترد عنهم غائلة الفقر والعوز، وبخاصة في زمني الكهولة والشيخوخة. ومع ذلك فإذا كان طموح الكاتب لنيل مثل هذه الجوائز مبرَّراً ومشروعاً ولا غبار عليه، فإن من غير المبرر بالطبع أن يتحول هذا الطموح إلى وسواس يومي أو هاجس مرَضي يقع البعض تحت وطأته مدى العمر. وما هو غير مبرر أيضاً أن يعمد البعض، وفي العالم العربي على وجه الخصوص، إلى إعداد كتب ومؤلفات خاصة تراعي الشروط والمواصفات المطلوبة لنيل هذه الجائزة أو تلك، وهو ما تؤكده حالات وشواهد عدة في السنوات القليلة الفائتة. فالإنجازات الحقيقية لا يمكن أن تتحقق وفق تصميمات مسبقة أو غايات مادية بحتة، بل هي حفر في تربة النفس بحثاً عما يعصم الكاتب من الوقوع في شرك اليأس وبراثن العدم، وهي منازلة ضارية مع الكلمات فوق ساحة مأهولة بالوحشة والخوف. وهي تبعاً لذلك تتطلب إطفاء الأنوار تماماً والإخلاد إلى عتمة الداخل، بعيداً عن إغواء التصفيق وجاذبية المنابر وشبق المكافآت المادية ومراكز النفوذ السياسية والآيديولوجية. وإذا كان لهذه الجهة أو تلك أن تكافئ الكاتب على إضافاته الإبداعية فيجب أن يتم ذلك دون شروط أو تنازلات أو مساومات من أي نوع.
لكن الحقيقة التي لا ينبغي إغفالها هي أن الجوائز على أنواعها وتفاوت قيمتها وصدقيتها لا تشكل معياراً حقيقياً ووحيداً للحكم على المبدعين وتحديد قاماتهم وأحجامهم الفعلية، ولا يمكن بالتالي أن نربط بشكل حاسم بين قيمة الكاتب وبين ما يناله من جوائز وأوسمة وتكريمات. فالحقيقة الأدبية نسبية ومخاتلة وحمالة أوجه، وليس ثمة من معايير نهائية لتحديد مقاساتها والعثور عليها. ومهما بلغت ثقافة الأشخاص المنوطين بالتحكيم فإن آراءهم على وجاهتها لا تختزل آراء القراء ووجهات نظرهم في نتاج الشعراء والكتاب المرشحين لنيل هذه الجائزة أو تلك.
كما أن بعض الجوائز الأدبية قد أنشئت في الأصل لدواعٍ آيديولوجية، وقُدمت على صورة «إكراميات» ومكافآت لمن يتم التثبت من ولائهم الشخصي، أو ولاء دولهم وأحزابهم، للدولة المانحة. وهو ما بدا جلياً خلال الحقبة السوفياتية، حيث كانت جائزتا اللوتس ولينين تمنحان في الأعم الغالب لأسباب عقائدية وسياسية غير متصلة بالإبداع، ولأسماء متواضعة النتاج وشحيحة المواهب.
سيكون من الإجحاف بالطبع أن نخلط بين الجوائز الكبرى ذات التاريخ العريق مثل نوبل وغونكور وبوكر وبوليتزر وبين تلك التي تنتشر كالفطر في دول العالم المختلفة، وتبدو أقرب إلى الفولكلور والمسابقات المدرسية منها إلى أي شيء آخر. ومع ذلك فإن جائزةً من وزن نوبل نفسها لم تنج من تهم الانحياز الآيديولوجي والتعصب للثقافة الغربية وتهميش ثقافات معينة أو تغييبها، فضلاً عن المساومات الشخصية بين أعضاء أكاديميتها التي بلغت حدود الفضائح في بعض الأحيان. ورغم كونها الأهم والأقدم بين مثيلاتها فإن علامات استفهام كثيرة حول بعض من مُنحوها دون جدارة واستحقاق، أو الذين طوتهم بعد نيلها بقليل غياهب النسيان، حيث قلة في العالم تتذكر أسماء مثل برودوم وشبتلر وبونين وغيرهم. في حين أن بعض الذين لم يمنحوها خلخلوا بعنف معاجم لغاتهم وخلقوا من بنات أخيلتهم نماذج للعيش عصية على النسيان، من مثل الروسي ليو تولستوي صاحب «الحرب والسلم» و «أنّا كارنينا»، والفرنسي مرسيل بروست صاحب «البحث عن الزمن الضائع»، والآيرلندي جيمس جويس صاحب «عوليس» و«صورة الفنان في شبابه»، واليوناني نيكيس كازانتازاكيس صاحب «زوربا اليوناني»، والأرجنتيني خورخي بورخيس والفرنسي أراغون، والإنجليزية فيرجينيا وولف، وكثيرين غيرهم.
ولا يمكن للمرء أن ينسى أولئك الذين «تعالوا» على الجائزة التي يحلم بها معظم كتاب العالم، من مثل جان بول سارتر الذي اعتذر عن قبولها بدعوى رفضه لكل أشكال المؤسسات، وجورج برناردشو الذي شبهها بطوق الأمان الذي يُرمى لمن بلغوا في الأصل بر الأمان، والذي صرح على طريقته في السخرية «إنني أغفر لنوبل أنه صنع الديناميت، ولكنني لا أغفر له إنشاءه لهذه الجائزة}.
لا يختلف وضع الجوائز العربية التي تتزايد باطراد في الآونة الأخيرة عما هو الحال في الإطار العالمي. فبصرف النظر عن كثير من الأسماء الهامة التي نالتها، سيعثر البعض بين حين وآخر على من لا يرون فيه من حيث الأهمية الأدبية مستحقاً للظفر بجائزة كبرى من وزن جائزة زايد للكتاب وجائزة الملك فيصل وجائزة كتارا وجائزة السلطان قابوس وجائزة سلطان بن علي العويس والبوكر بنسختها العربية، أو غيرها من الجوائز المماثلة. وما يزيد من حساسية الموقف أو حدة المنافسة بين المبدعين هو المكافأة المالية العالية التي تمنح للفائزين، والتي توازي على هذا الصعيد ما تمنحه أرفع الجوائز العالمية وأكثرها عراقة. ولن يعدم أي منا العثور على ثغرات وعيوب تطال هذه الجائزة أو تلك في غير وجه من الوجوه، كأن تفضي بعض التسويات بين المحكمين، أو بين هؤلاء وبين مانحي الجائزة ومجالس أمنائها، بمراعاة الاعتبارات الكيانية والقطرية في اختيار الفائزين، أو أن يحظى بالفوز من يعتبرهم البعض أسماء من الدرجة الثانية على حساب مبدعين أكثر أهمية منهم. أو أن تطغى الرواية على الشعر بصورة كاسحة في بعض الحالات. على أن كل تلك الهنات لا ينبغي أن تطال المبدأ بحد ذاته، حيث يحتاج الكتاب الذين سخروا حياتهم برمتها من أجل رفع منسوب الحرية والفرح والجمال على هذا الكوكب البائس لمن يشد على أيديهم وينتبه لمغامرتهم الإبداعية الشاقة، في ظل انهيار القيم واستتباب الغرائز وانصراف الناس عن القراءة. أما القول بأن الجوائز، وبخاصة الكبرى بينها، قد تودي بالحائزين عليها إلى درك الزهو والانتشاء بالنفس والكف عن التطور فهو لا ينسحب إلا على الكتاب الزائفين والنرجسيين الذين نضبت مواهبهم في الأصل، فيما لا نُعدم على الجانب الآخر من يشيحون بوجوههم سريعاً عن الحدث لينقبوا في أعماق ذواتهم عن الكنوز الأثمن التي لا سبيل إلى نفادها.
الوجوه الملتبسة للجوائز الأدبية
لا تشكل معياراً للحكم على المبدعين وتحديد أحجامهم الفعلية وقاماتهم

تولستوي

الوجوه الملتبسة للجوائز الأدبية

تولستوي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة