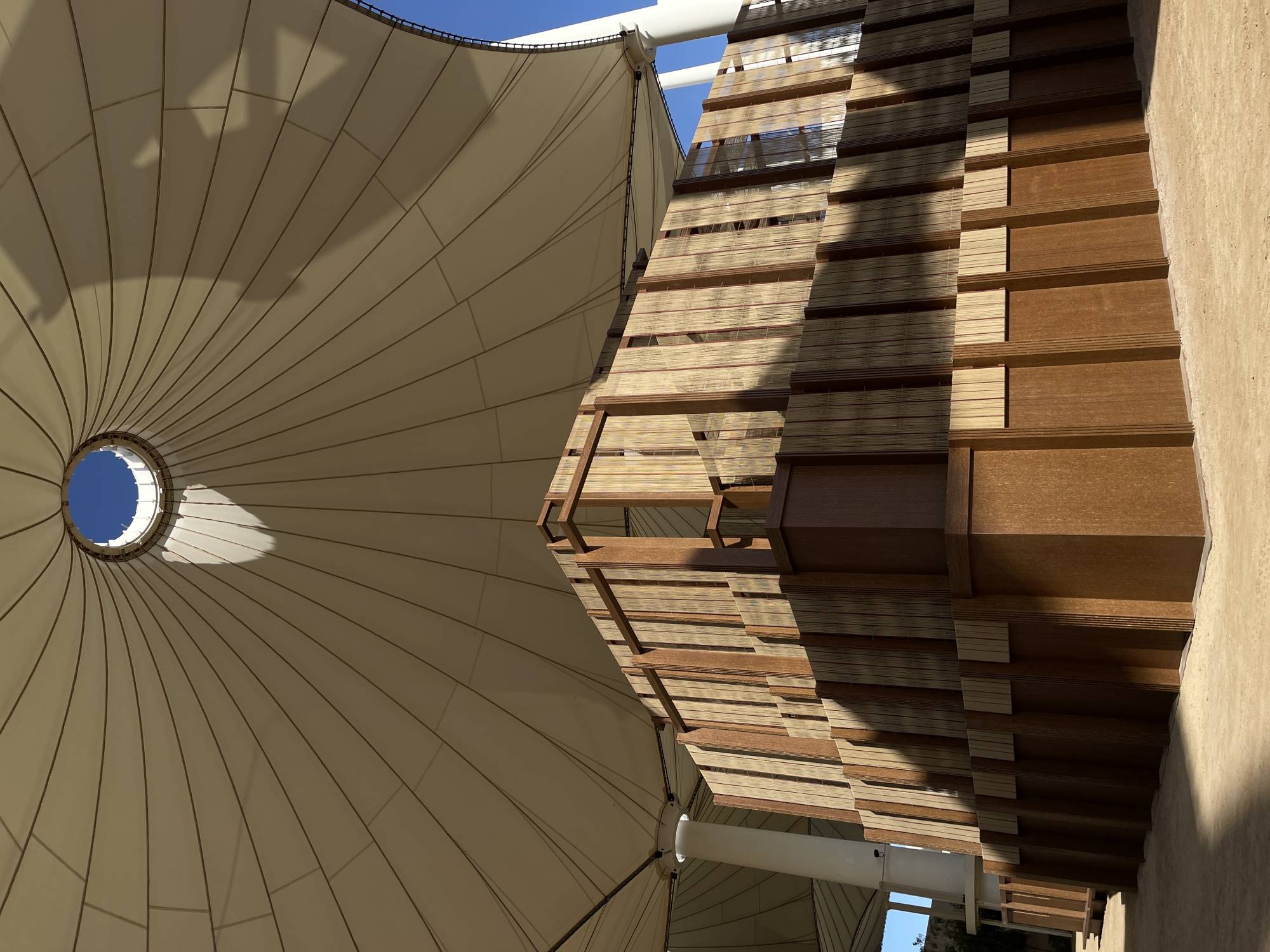صدرت عن «بيت الكتاب السومري» ببغداد رواية «حُب في ظلال طاووس مَلَك» للقاص والروائي العراقي حمّودي عبد محسن، وهي روايته الخامسة بعد «الدفّان والغجريّة»، «المِزمار»، «حكاية من النجف»، «امرأة الحُلُم»، ويبدو أنه استمرأ تقنية الرواية التاريخية الحديثة التي لا يستنسخ كاتبُها أحداث التاريخ حرفياً وإنما يلتقط اللمسات الوجدانية المسكوت عنها أو التي غفلها المؤرخون أو تفادوها عمْداً. وبما أنّ الرواية كجنس أدبي حديث لا يتقبل الوقائع التاريخية القارّة فعلى الروائي المبدع أن يطوّعها، ويستدعي روحها، ويستنطق زمانها ومكانها النائيين، وأكثر من ذلك، أن يستجلب عبقها المخبأ بين طيّات السنين. وهذا ما فعله حمّودي في روايته الأخيرة التي حرّرها من سطوة التاريخ وألبسها حُلّة أدبيّة، مُطرِّزاً إياها ببعض القصص والحكايات الأسطورية التي تمزج الخيال بالواقع في محاولة جادة لترويضه واستساغة شطحاته الفنتازية بُغية إبقاء القارئ في الفضاء الروائي الآمن الذي تتماهى فيه الشخصيات بالأحداث وتُصبح جزءاً من نسيج الثيمة الروائية التي اشتغل عليها الكاتب منذ جملته الاستهلالية حتى خاتمة نصه الروائي.
لم يشأ حمّودي أن يكتب عن المجزرة الأخيرة التي ارتكبها الدواعش بحق الإيزيديين، وسبي نسائهم، وبيعهنَّ في سوق الرقيق الأبيض لأن الرواية تتحدث عن مجازر وإبادات جماعية عديدة وقعت على مرّ التاريخ وكانت آخرها مجزرة سنجار التي تحمل الرقم 73.
لم يقع الروائي أسيراً لهذه المجازر الوحشية خشية من السقوط في الجانب التقريري، فالرواية لا تؤرخ للأحداث، بل تكشف التاريخ، وتعرّيه، وتعيد صياغته من جديد على وفق الرؤية الإنسانية التي تتوهج في ذهن كاتبها الموضوعي والمُحايد في آنٍ معاً. وحتى الثيمة الرئيسة ذهبت أبعد من حدود المجازر الدموية لتركِّز على الإنسان الإيزيدي البسيط، وخصاله النبيلة التي تشبه خصال العاشق ميرزا، بطل الرواية الذي لم يفارقنا إلاّ في الصفحات الأخيرة من هذا السِفر الأدبي المؤثر الذي يلامس وجدان القارئ ويهزّ مشاعره الإنسانية الرقيقة.
تشكِّل قصة الحُب البريء، والطاهر بين ميرزا وهنار العمود الفقري لهذه الرواية، وقد أقسَمَ هذا العاشق الولهان مع نفسه بأنه سيظل يحبها، ويخلص لها حتى الموت، لكن القدر كان يقف لهما بالمرصاد إذ لسعتها نحلة ذهبية وماتت تاركة إيّاه يتخبط في محنته التي لن يتجاوزها بسهولة.
لم يكتفِ الكاتب بهذه الثيمة التي سينبثّ لهيبها في تضاعيف الرواية كلها، بل قفز منها إلى دائرة أوسع حينما تساءل مستفهماً: «أليس الإيزيدي في السومرية هو الإنسان السوي المستقيم، والروح الخيّرة غير الملوثة الذي يسير في الطريق الصحيح؟» (ص59). ونظراً لخبرة جده العميقة في الحياة فإنه ينصحه بالذهاب إلى معبد «لالش» والاعتكاف هناك عسى أن يصل بتأمله إلى قنديل العرش.. وبعد مرحلة طويلة من التعبّد ومُجاهدة النفس يصل ميرزا إلى مرتبة «الفقير» وهو أعلى مستوى يبلغه الكاهن الإيزيدي لكنه ما إن يعود إلى المقبرة ويحتضن قبر حبيبته هنار حتى يفارق الحياة بينما تغطي طيور السنونو سماء المقبرة قبل أن تتلاشى في المدى البعيد.
تعتمد الرواية على تعددية الأصوات فالجد كنجي يروي لحفيده ميرزا قصصاً مُعبِّرة لكنها لا تخلو من جوانب أسطورية ورمزية، وهو يروي هذه القصص إلى حبيبته هنار وهكذا دواليك حتى يتكشف لنا التاريخ بأوجهه المختلفة التي لم تسلم من الحذف، والإضافة، والطمس، والتحريف. سعى حمّودي إلى خلقِ نسقٍ موازٍ للقصة العاطفية التي يقوم عليها النص الروائي مُقدماً فيه عدداً كبيراً من القصص والحكايات التي لا نعرف حجم التغييرات التي أحدثها فيها لكن من المؤكد جداً أنه طوّعها وجعلها تنقاد بسهولة ويُسُر في أنساق الحبكة الروائية التي تُدين رموز الشر والجريمة سواء أكانوا حيوانات أم بشراً متوحشين مثل الدبّة، الذئب الأسود، كسرى، فريق باشا، الأمير الأعور، بدر الدين لؤلؤ وما إلى ذلك من شخصيات شرّيرة تحركت على مدار النص الروائي وتفاعلت بقوة مع حبكته التي تريد القول بلسان فصيح «لا أحد يُهلِك الشمس» (128). وكلنا يعرف سلفاً أهمية الشمس في الديانة الإيزيدية.
تبدو هذه الرواية وكأنها «قصة إطارية» بطلاها ميرزا وهنار لكنها تضم بين دفتيها عدداً كبيراً من القصص والحكايات مثل الغزالة البيضاء التي تظهر مرة واحدة كل مائة عام وتنثر المسك من سُرّتها، والمُستبصِر الذي يحطم الثلج ويلج في إحدى معاصر الزيتون كي يتخلص من حماة، وشجرة الزيتون التي جلبها الشيخ عادي من بعلبك إلى لالش، والشقائق التي ظهرت بعد قتل النعمان بن المنذر تحت أقدام فيلة كسرى، والقيصر الروماني الذي أحبّ الباشق الذي يصطاد الأرانب والغزلان، والحيّة التي أنقذت السفينة من الغرق، والأمير ئال الذي خطف الوردة الحمراء من شَعر الأميرة طاووس فمات في سجنه حتى نصل إلى خروج روح ميرزا من سجن الجسد وصعودها إلى السحابة الوردية التي جمعت الروحين النقيين الغارقين في المحبة الأبدية.
تتمثل الخبرة الفنية للروائي حمّودي عبد محسن في لي عُنُق هذه الرواية التي تشظّت خارج المساحة السردية المُخصصة لها ويبدو أنه انتبه في خاتمة الأمر لهذا التشظي فقرر إنهاء الرواية بحدثين مهمين استقاهما من مخطوطتي «الأمير الأعور» و«بدر الدين لؤلؤ» حيث ذهب الأول بقدميه إلى حتفه بعد أن قتل قرابة مائة ألف إيزيدي، فيما ذاق الثاني مرارة الذل والهوان على يد هولاكو الذي أوغل هو الآخر في دماء الإيزيديين قبل أن يواجه مصيره المحتوم غير مأسوف عليه من قِبل المواطنين الموصليين الذين سامَهم سوء العذاب.
تمّ العثور على هاتين المخطوطتين في صندوق سيدة إيزيدية جليلة خبأته في باطن أرضية غرفتها بوصفها حافظة للأسرار، وحامية للتراث الإيزيدي وحينما رأت الدواعش يدمِّرون كل شيء حتى قبري ميرزا وهنار قررت إنقاذ المخطوطتين اللتين تمّ استنساخهما إلى أعداد كبيرة وإرسالها إلى أبناء الأمة الإيزيدية التي تشردت في المنافي والأمصار.
على الرغم من الثيمة الجيدة، والحبكة القوية للرواية، فإن هناك إطناباً واضحاً في سرد الأحداث، وبناء الشخصيات الرئيسة التي خلع عليها الروائي كل الأوصاف الإيجابية التي لا يمكن أن تجتمع في كائن بشري واحد حتى وإن كان سوياً، وَرِعاً، دمث الأخلاق، فثمة غرائز كثيرة تحرّك الإنسان وتجعله عرضة لارتكاب الأخطاء والذنوب الصغيرة. وكنا نتمنى على الكاتب أن يقدّم لنا الشخصيات الإيزيدية كأناس مثل باقي البشر والطوائف التي تعيش حياتها اليومية، وتنغمس في الملذات الدنيوية شأنها شأن المِلل والنحل الأخرى التي نعرفها عن كثب.
مِثل عدد غير قليل من الأدباء المُكرّسين في الوسط الثقافي العربي يرتكب حمودي عبد محسن أخطاءً لغوية ونحوية لا يمكن غضّ الطرف عنها مثل همزة الوصل والقطع، والعدد والمعدود، والجموع، وعدم التفريق بين حرفي الضاد والظاء، والخطل في استعمال بعض الأفعال مثل (حدقت النظر) بدلاً من (دققت النظر) أو (متنكباً فرسه) عوضاً عن (ممتطياً فرسه) و(تسلخ الحيّة جلدها) بدلاً من (تنزع أو تنضو الحيّة جلدها) وأمثلة أخرى تضيق بها مساحة هذا المقال.
استنطاق تاريخ الإيزيديين وتطويعه
رواية «حُب في ظلال طاووس مَلَك» تركز على الإنسان البسيط

تم العثور على مخطوطتين في صندوق سيدة إيزيدية خبأته في باطن أرضية غرفتها بوصفها حافظة للأسرار، وحامية للتراث الإيزيدي حينما رأت الدواعش يدمِّرون كل شيء

استنطاق تاريخ الإيزيديين وتطويعه

تم العثور على مخطوطتين في صندوق سيدة إيزيدية خبأته في باطن أرضية غرفتها بوصفها حافظة للأسرار، وحامية للتراث الإيزيدي حينما رأت الدواعش يدمِّرون كل شيء
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة