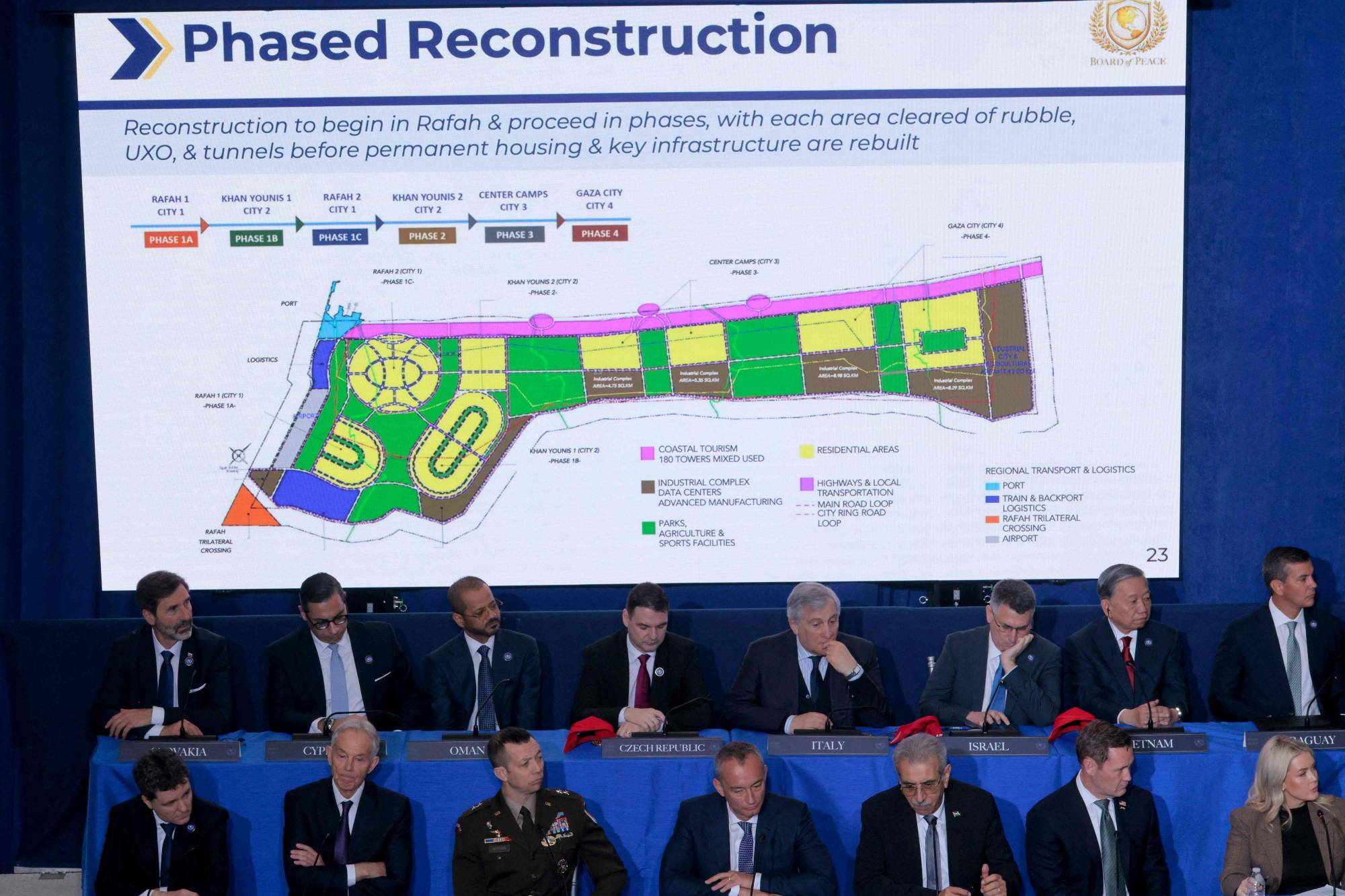المعركة انتهت - على الأقل في الوقت الراهن - وجرى تطهير آخر معاقل تنظيم «داعش» على أيدي قوات سورية وعراقية بدأت تدخل إلى قرى على جانبي نهر الفرات للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. وقد انتهت هذه الحملة المحددة في خضم الحرب الطويلة ضد المسلحين المتطرفين، لكن الحرب الأوسع مستمرة.
بيد أن التساؤل هنا: كيف سيتطور هذا الصراع على امتداد الشهور والسنوات؟ في الواقع، سيعتمد هذا الأمر على مجموعة من العوامل: رد فعل فلول «داعش» والحركة الأوسع التي خرج التنظيم من رحمها، والقرارات التي تتخذها مجموعات ودول متورطة في الحروب المتنوعة المشتعلة عبر أرجاء العالم الإسلامي، وبطبيعة الحال الإطار العالمي الأوسع الذي تدور فيه هذه الصراعات. وتعد تلك حرباً معقدة، أشبه بالحروب العالمية الكبرى التي دارت في القرن الـ20، وتضمنت صراعات عدة، أصغر من الحرب الكبرى التي غالباً ما يجري رسم صورتها.
ويكمن التساؤل الأول هنا: ماذا سيحدث للمسلحين أنفسهم؟ لقد ولّى الكيان الذي أطلق عليه «الخلافة» المزعومة وأعلن عنه من داخل مسجد عمره 950 عاماً في الموصل في خطاب أطلقه زعيم «داعش» إبراهيم عواد (46 عاماً) أستاذ الشريعة السابق الذي أصبح معروفاً باسم أبو بكر البغدادي. الحقيقة أن سقوط هذا الكيان المزعوم بدا دوماً أمراً محتملاً، ومن المحتمل كذلك أن يلقى البغدادي حتفه في غضون فترة قصيرة نسبياً. والجدير بالذكر أن أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، ظل حياً على مدار عقد بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، لكن كانت أمامه باكستان للاختباء بها. واقعياً، ليس أمام زعيم «داعش» سوى غرب العراق للاختباء به.
الواضح أن العامل الوحيد الذي لم يجعل هزيمة التنظيم أمراً حتمياً منذ اللحظة الأولى حالة الفوضى والعنف التي عانتها سوريا جراء الحرب الأهلية هناك، وهو ما سمح للتنظيم بتوسيع رقعة نفوذه في المقام الأول. ومع حسم الصراع هناك لصالح نظام الأسد، بفضل الدعم الإيراني والروسي، ننتقل الآن نحو مرحلة جديدة يتركز النضال فيها حول ممارسة النفوذ على تسوية ما بعد الحرب، وليس القضاء على عدو مشترك. المؤكد أن هذا الوضع سيخلق ديناميكيات خاصة به، وصراعات أيضاً. فالواضح أن مساعي البغدادي لبناء قوة عظمى عانت أوجه قصور جوهرية عدة أسفرت عن إخفاقها في نهاية الأمر. ومن المهم التعرف على نقاط الضعف تلك؛ لأنها تكشف الكثير عن تطور حركة التطرف خلال الشهور والسنوات المقبلة.
أولاً: كان الكيان الذي أعلنه «داعش» (أي «الخلافة» المزعومة) في حاجة إلى المضي في حالة مستمرة من الغزو كي ينجح، ذلك أن النصر يضفي عليه شرعية، وكذلك يجلب مجندين جدداً لتعويض الخسائر في صفوف المقاتلين. كما أن السيطرة على مزيد من الأراضي تعني مزيداً من الموارد، وشراء الأسلحة والذخائر، وكنوزاً أثرية يمكن بيعها، ومزيداً من السكان لفرض ضرائب عليهم، وأصحاب أعمال لابتزازهم، وممتلكات لنهبها، وآبار بترول لاستغلالها.
إلا أن التوسع إلى ما لا نهاية لم يكن خياراً واقعياً، ذلك أن ثمة قيوداً طبيعية أمام المساحات التي يمكن لـ«داعش» بسط نفوذه عليها. مثلاً، ثبتت استحالة توسيع رقعة نفوذ التنظيم لما وراء المعاقل التي يهيمن عليها السنّة. كما أن «داعش» لم يكن ليجرؤ على خرق حدود دول قوية مثل تركيا أو إسرائيل أو الأردن. كما أن عناصره من السنّة المزودين بأسلحة خفيفة لم يكونوا لينجحوا أبداً في شق طريقهم عبر وسط وجنوب العراق، حيث السيطرة للشيعة، أو لبنان.
اليوم، عاد «داعش» إلى الصورة نفسها التي كان عليها منذ عقد تقريباً: جماعة عنيدة ومتمردة محنكة بمجال أعمال العنف الإرهابية الوحشية، تنطلق من اعتبارات طائفية متطرفة.
ومن أجل الاحتفاظ بالصورة والمكانة كلتيهما اللتين تمتع بهما «داعش» في السنوات الأخيرة، فإنه سيتعين عليه الاعتماد على جماعات تابعة له. لكن يبدو هذا الأمر غير مؤكد، ففي الوقت الذي قد تظل بعض الجماعات على ولائها للتنظيم المركزي، مثل «ولاية سيناء»، من المحتمل أن تقدم أخرى على الانفصال. ومن بين الجماعات الأكثر احتمالاً للانفصال «بوكو حرام» في غرب أفريقيا التي لطالما اتسمت صلاتها بـ«داعش» بالهشاشة.
ثانياً: تسبب تطرف «داعش» في إثارة سخط مجتمعات تقع تحت نفوذه، ورغم تلقي التنظيم تحذيرات من الإخفاقات التاريخية التي منيت بها جماعات في الجزائر مطلع ومنتصف تسعينات القرن الماضي، فإنه مضى قدماً في أجندته المتطرفة التي لا تعرف حدوداً.
وكانت النتيجة أن زعامات عشائرية سنيّة وعناصر نافذة أخرى داخل العراق وسوريا سبق وأن قبلت سلطة التنظيم؛ الأمر الذي بدا ميزة كبرى بالنسبة إلى الأخير، بفضل ما يوفره من أمن نسبي ونمط مبتذل من العدالة وحماية في مواجهة الشيعة وقمع النظام، انقلبت ضد الحكام الجدد. وتكشف سرعة انهيار الكيان الجديد الذي بناه التنظيم مدى السطحية التي اتسم بها الولاء تجاهه.
ويعني ذلك أنه خلال الفترة المقبلة، فإن تنظيم «القاعدة» بقيادة أيمن الظواهري يتمتع اليوم بميزة أكبر تمكّنه من الفوز في التنافس العالمي على زعامة الحركة الأصولية المتطرفة. ومع أن تنظيم «القاعدة» خفت نجمه كثيراً أمام «داعش» في السنوات الأخيرة، فإنه يحظى اليوم بميزة كبرى. يسعى كلا التنظيمين إلى بناء كيان جديد، لكن الرؤية الاستراتيجية لـ«القاعدة» أطول أمداً: فقط عندما تتوفر على الأرض الظروف اللازمة، سيصبح من الممكن تنفيذ المشروع. وخلال السنوات الأخيرة، استفاد تنظيم القاعدة من محاولة بناء إجماع في صفوف المجتمعات المتنوعة التي توجد بينها؛ وذلك لإدراكه أن التحرك بسرعة كبيرة في وقت قصير للغاية سيثير رد فعل عكسياً. واللافت، أنه عندما يصبح الانسحاب التكتيكي ضرورياً - حتى من مكان بالغ الأهمية مثل ميناء المكلا في اليمن - يبدو أتباع التنظيم على استعداد للتنازل عن الأراضي التي يسيطرون عليها. ويبدو «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» في وضع جيّد يؤهله لأن يكون القوة المتشددة المهيمنة في منطقة الساحل.
داخل سوريا، عملت الجماعة التابعة لـ«القاعدة» المعروفة باسم «جبهة النصرة»، والتي بدّلت اسمها اليوم إلى «جبهة فتح الشام»، بجد لبناء قاعدة دعم لها في أوساط العشائر والسكان. ورغم أنها قد تتعرض للسحق خلال الهجمات التالية من جانب قوات النظام أو قوى أخرى، فإنها أظهرت فاعلية الاستراتيجية التي ينتهجها تنظيم القاعدة.
ثالثاً: شن «داعش» هجمات ضد قوى غربية وإقليمية، وكان ذلك قراراً واعياً يضرب بجذوره في آيديولوجية هذه الحركة المتشددة ورؤيتها العالمية، ولم يأت انطلاقاً من الرغبة في الدفاع عن النفس، مثلما لمح البعض. انطلقت أول مجموعة أرسلها «داعش» إلى أوروبا مطلع عام 2014، قبل أن يشرع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في توجيه ضربات جوية لمعاقل التنظيم. ويخبرنا التاريخ أنه من الصعب إحراز نصر قاطع ضد المتطرفين والمتمردين دون إقرار تسوية سياسية وتوفر ظروف اجتماعية واقتصادية تقضي على العوامل المحفزة وراء الآيديولوجيات المتطرفة.
ومع هذا، فإن المنظمات المسلحة التي يستهدفها الغرب وحلفاؤه داخل العالم الإسلامي عادة ما يجري إجبارها على الأقل على التخلي عن مكاسب من حيث الأراضي التي تسيطر عليها، وبخاصة المراكز الحضرية. ويعني ذلك أنه بوسعنا توقع إقدام «داعش» على شن مزيد من الهجمات ضد الغرب والقوى الإقليمية في المستقبل، وأن يثير ذلك ردود أفعال تؤدي إلى مزيد من التآكل في قدرات التنظيم الإرهابي، وإن كان ذلك سيأتي على حساب كثير من الدماء.
بالنسبة إلى المنطقة الأوسع بوجه عام، ثمة عوامل عدة تيسّر الحياة أمام المتطرفين. الملاحظ أن ثمة صراعاً وحالة من غياب الاستقرار قائمة على امتداد القوس الواسع الممتد من ساحل شمال أفريقيا حتى جنوب غربي آسيا. من بين الأخطاء الشائعة أن يجري اتخاذ قرار بأنه فقط لأن هناك بعض المشكلات في جزء ما، تصبح الدولة برمتها مفتقرة إلى الاستقرار. قد تكون دولة، مثل ليبيا، مفتقرة بالفعل إلى الاستقرار، لكن ليس باكستان، مثلاً.
في الوقت ذاته، فإن ثمة صراعات منخفضة الحدة دائرة في سيناء مثلاً، والكثير من الصراعات مرتفعة الحدة مثلما الحال في اليمن، مما يخلق فرصاً أمام المتشددين يمكن استغلالها. ولا يزال الوضع داخل سوريا فوضوياً، بينما يظل العراق ممزقاً.
ومن شأن تدمير كيان «داعش» تفكك التحالف المناوئ لهذا التنظيم وعودة ظهور الانقسامات والتنافسات التي تفتح بدورها مجالاً أمام عودة العناصر المسلحة المتشددة إلى النشاط. وبالتأكيد، يمكن أن تتفاقم المشكلة جراء بعض السياسات الأميركية التي قد يستغلها متشددون، مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل دون استيعاب حقيقة عواقب مثل هذا الإجراء.
وحتى في حال توقف أعمال القتال نهائياً داخل سوريا وتوفر الأموال الضخمة اللازمة لعملية إعادة الإعمار والمضي قدماً في طريق السلام، فإن أعداداً ضخمة من الشباب العاطل عن العمل والغاضب قد توفر مورداً هائلاً أمام أي تنظيم متطرف يسعى إلى اجتذاب مجندين. كما أن أي جهود للتخفيف من تأثير رجال الدين والآيديولوجيات المتطرفة لن تؤتي ثماراً قبل عقود.
الملاحظ أن أربع موجات كبرى من الحركات المسلحة انطلقت على امتداد الأعوام الـ50 الماضية، ظلت أول موجتين - أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات من القرن الماضي، ثم مطلع التسعينات - مقتصرتين بدرجة كبيرة على العالم المسلم. أما الثالثة والرابعة - من منتصف التسعينات وحتى عام 2010، ثم منذ تلك الفترة حتى اليوم - فقد شهدتا وقوع أعمال عنف كبرى في دول تنتمي غالبية سكانها إلى المسلمين، مع وقوع سلسلة من الهجمات اللافتة للأنظار في الغرب. وبذلك، تحولت هذه التنظيمات إلى مشكلة عالمية.
واتبعت الموجات الأربع جميعها مساراً متشابهاً: فترة من النمو البطيء غير الملحوظ، ثم وقوع حدث ضخم يلفت الأنظار نحو التهديد الجديد، ومرحلة من النضال الدموي، ثم انتصار جزئي على المسلحين. وقد دام كل منها ما بين 10 أعوام و15 عاماً.
ثمة مشكلتان هنا: الأولى: تحمل كل موجة بذور الموجة التالية: تأجيج الاستقطاب وزعزعة استقرار الدول ونشر آيديولوجيات العنف المتطرف على رقعة أوسع. الأخرى: نميل إلى التركيز على المرحلة الأخيرة من تهديد ما آخذ في الانحسار، بدلاً من الآخر المتنامي. وينبغي أن نضع هذا نصب أعيننا اليوم، ونحن نتابع عودة «داعش» لدوره الأصلي كتنظيم إرهابي، وليس حركة تمرد مكتملة الأركان.
صراعات ما بعد «داعش»
ليس أمام البغدادي سوى غرب العراق للاختباء


صراعات ما بعد «داعش»

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة