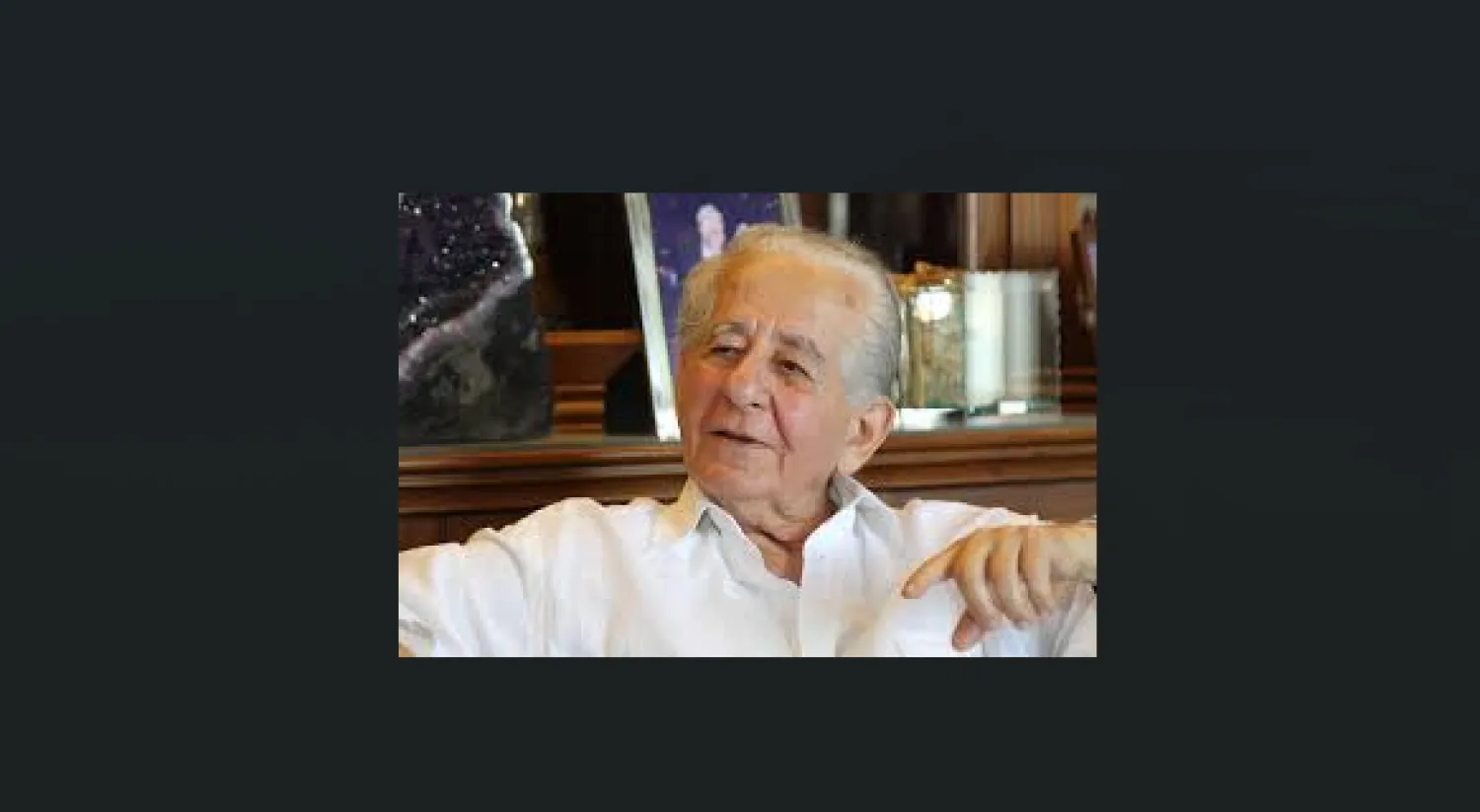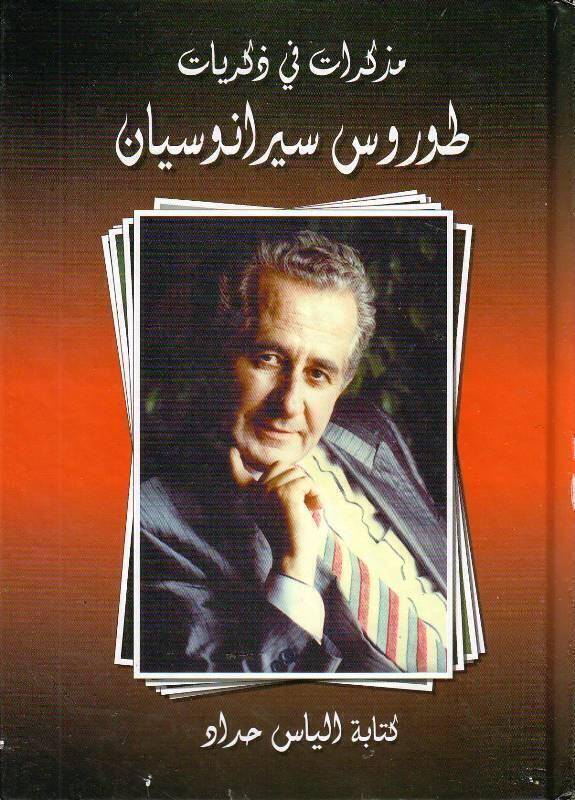يُشبه عنوان الفيلم القصير للكاتبة والمخرجة اللبنانية ماري لويز إيليا، «الموت ومخاوف أخرى»، أحوالنا. إننا في اللهب، ووهجُه حارق. موتنا ومخاوفنا في سباق مع النجاة، فتغلبه في معظم جولاته. وإنْ تفتتح الشابة الثلاثينية شريطها بإعلان الخوف من المرتفعات، سرعان ما تتوسّع المخاوف لتشمل العلاقة بحياة تُفاقم موتها. تقول لـ«الشرق الأوسط» إنّ أوطاننا تربّي في أبنائها القلق وتواجههم بأشكال النهايات. الوداع على المطارات، الانسلاخ عن المدينة، مقتل الأمل؛ منها.

في السماء غيمٌ ومشهد بحر وانعكاس أمواج، ومن نافذة الطائرة تبدو المدن مسكونة بالدفء. لكنَّ الجمال معرَّض لسيطرة المشهد العنفي، حين تنهمر من المرتفعات أدوات القتل الإنساني. الفيلم شخصي، بوصفه تجارب صوَّرتها صاحبته بكاميرا هاتفها، يتحوّل جماعياً بمجرّد سيطرة الشعور المشترك بترقُّب الأسوأ.
بدأت التصوير قبل سنوات، وظلَّت تُرجئ صناعة مادة فيلمية مما تصوِّره: «حين أفرغتُ اللقطات وجمعتُها على هذا الشكل، استراحت أعماقي. شعرتُ أنني أؤكد ما جرى بإخراجه من داخلي ليتشاركه الآخرون». كانت تبحث عن إجابات تتعلّق بمستقبلها الإنساني في بلد يمارس هدر العُمر. بحثتْ ولم تجد. لذا صوَّرت. لكنَّ تلك الاستراحة تراءت مؤقتة. تبخَّر مفعولها بتفاقُم الحدث الضاغط؛ واليوم، بعد مدّة على طرح الفيلم القصير، تشعُر مجدداً بفَتْك السؤال وتيه الجواب.

خذلان الجغرافيا المُشتعلة علّة عصّية على الشفاء. الزمن يُعمّق هذا الصنف من الجرح. تقول ماري لويز إيليا: «نكبُر مع الخوف، فلا يعُد يقتصر على المرتفعات أو لحظات إقلاع الطائرة وتأرجحها قبل المسار الثابت. كنتُ في فرنسا قبل شهرين، وحدَثَ سماعي ضَرْب مدفع للإشارة إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً بإحدى القرى. إنه تقليد، والسكان يتعاملون معه بلا رد فعل. أما أنا، فأصابني الهلع. أتى الجواب مصحوباً بالاستغراب من هشاشتي، حين تساءلتُ عما يجري. بالنسبة إلى فرنسيي القرية، المشهد عادي. في ذاكرتي، هو مسار أحداث».
لا تدري أكان التفكير في النهايات مردُّه النشأة في أوطان مأزومة تقامر بمصائر أبنائها. تقول في الشريط المعروض عبر منصّة «أفلامنا»: «أخاف من الموت، لكنني لا أشاء العيش الأبدي. أفكّر برحيلي دائماً. لا أريد مشاعر الألم، كما أرجو ألا تكون نهايتي مفاجئة». حديث الموت وفجاجته في العنوان، تُقابلهما استحالة فصل النفس عن أشكال فنائها. يستوقفها الربط بين الموت والواقع، فتُعلّق: «اليوم، يصعب أكثر تصديق النجاة. سَلْخ النفس لا ينفع أمام غزارة تساقُط الضحايا. كان المشهد من بعيد، عنوانه غزة. البعض استطاع التنحّي عن أهواله. كيف نفعل الآن، وناره تهبّ من حولنا؟ كبرتُ وفكرة الموت تطاردني، فأراها في أفكاري وأيامي. اليوم تلتصق بي، كأنّ كل يوم هو موتنا المؤجّل حتى إشعار آخر».

لأننا أبناء الاحتراق، نستكثر بهجاتنا. فالفيلم يتحوّل جماعياً بتبنّي حالة اللبناني المُدرِك أنّ خلف الفرح غصّة. هواجس صاحبته هي هواجس مُشاهده. وحين تقول: «بِعتَل هَم انبسط»، فذلك لحتمية تسلُّل الأحزان من حيث لا ندري. السؤال المُتعب: «أي ثمن سنسدّده حين نفرح؟». المفارقة أن الجواب مُلقى في الهبوب أو مُصادَر أسوةً بأعمارنا.
طرحُها سؤالاً آخر، هو: «لِمَ يسهُل على بعضنا قتل بعض؟»، تحيله أيضاً إلى اللاجواب: «كأننا نُسيَّر بالشرّ المُطلق فيتعذّر ضبط القتل. لا شيء يُبرر المقتلة من دون أن أجد تفسيراً لها». تكثُر الأشياء العاجزة عن تبريرها، كأنْ تودِّع صداقات وتُرغَم على بناء أخرى، «من الصفر»، في كل مرة تمتلئ المطارات بالمغادرين، ويحدُث الانسلاخ الجماعي الهستيري، دلالةً على ذروة التأزُّم واستحالة الاستمرار وسط التشظّي.
الخياران شاقّان؛ اليُتم والبناء على أنقاض ما تهدّم. بالنسبة إليها، «صعبة عزلة الإنسان ولا تُحتَمل»، لذا تبني. كلما صغُرت الدائرة، توسِّع ما أمكن توسيعه: أصدقاء جدد، وثقة جديدة، ودفء للاحتيال على البرودة. تقول: «الامتلاء يلي كل فراغ. في الفراغات، يفنى البشر. لذا نحاول الامتلاء فنواجه الوحشة».

اكتشافها بيروت حدَثَ في وقت متقدِّم، فالشابة نشأت في مكان آخر. ولمّا توطَّدت العلاقة، بعد الإقامة في شوارعها الصاخبة، ترافق الشعور بالحبّ مع احتدام الصراع: «أودّ حمايتها، ولكن هل نحن محميّون؟ الانتماء لبيروت محفوف بالأخطار».
ولأنّ الصور ترسخ، تشاء لذاكرتها تفادي أقساها. لبعض الوقت، حيَّدت ماري لويز إيليا نفسها عن ويلات غزة، لتجنُّب امتلاء الذاكرة بالمجازر. ولما راحت تتجوَّل في لبنان، تعذَّر هذا الفصل. «نتآكل بالذنب إن حاولنا التلهّي عن فداحة الموت المجاور. اليوم هو في ديارنا ويعبث بنا».