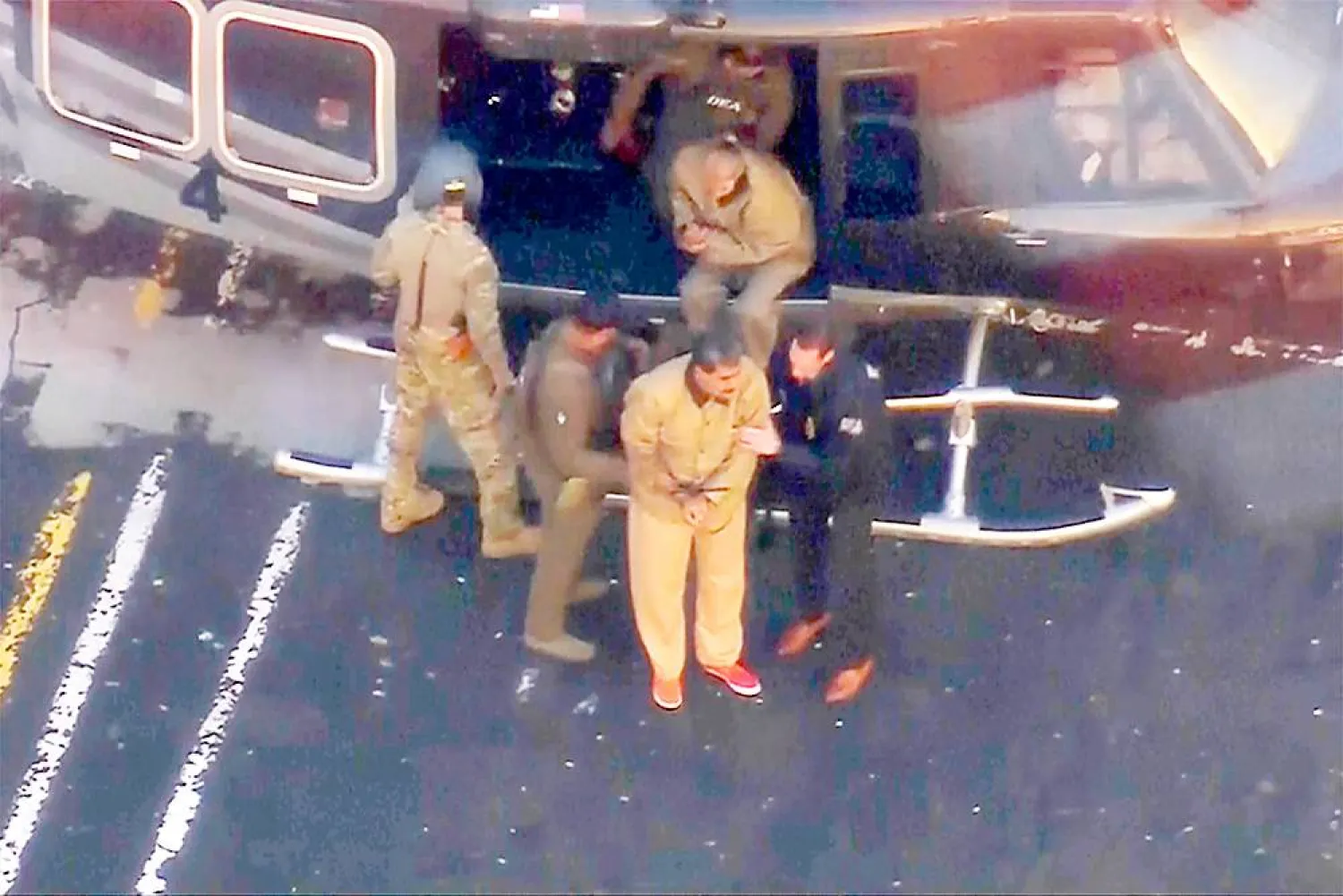مع تزايد الكلام عن اتجاه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للاعتراف بـ«دولة فلسطينية»، بدا أن حراكاً دبلوماسياً تساهم فيه دول عدة، على رأسها بريطانيا، في طريقه للتحول إلى دينامية مختلفة تسهم بتغيير أولويات «اتفاق أوسلو»، الذي كان يحيل هذا الاعتراف إلى نهاية العملية التفاوضية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ومع استمرار المفاوضات لإطلاق الرهائن بين إسرائيل و«حماس» والتوصل إلى هدنة مديدة، تزايد الأمل بقرب الإعلان عن وقف إطلاق النار، بما ينهي الحرب في غزة. وفي الوقت عينه، عدّت الضربات غير المسبوقة بشدتها، التي وجهتها الولايات المتحدة إلى ميليشيات طهران، تغيراً مهماً في سياسات واشنطن تجاه القيادة الإيرانية، ما قد يؤشر إلى أن السماح لها بمواصلة التنصل من مسؤوليتها عن «التخريب» الذي تمارسه عبر ميليشياتها في المنطقة، في طريقه ليصبح أكثر كلفة وصعوبة عليها. فهل اقترب الإعلان عن وقف لإطلاق النار في غزة، بما يمهد لخطوة الاعتراف بـ«دولة فلسطينية»، على الرغم من كل الأسئلة حول تفاصيلها، من الحدود مروراً بالشكل، وصولاً إلى السلطة التي ستحكمها، ومَن سيعيد بناء قطاع غزة الذي بات «منطقة غير قابلة للحياة»، وفق الأمم المتحدة؟

نشرت صحيفة الـ«نيويورك تايمز» الأميركية مقالة للصحافي توماس فريدمان عن «استراتيجية جديدة» من 3 مسارات، سماها كاتبها «عقيدة بايدن»، لمعالجة الحرب المتعددة الجبهات التي تشمل غزة وإيران وإسرائيل والمنطقة.
على المسار الأول، سيكون اتخاذ موقف قوي وحازم تجاه إيران، بما في ذلك الانتقام العسكري القوي من وكلائها وعملائها في المنطقة، رداً على الهجمات التي تُشَن على القوات الأميركية.
وعلى المسار الثاني ستكون هناك مبادرة دبلوماسية أميركية غير مسبوقة للترويج لـ«دولة فلسطينية الآن» تكون منزوعة السلاح، إذ يتشاور مسؤولو إدارة بايدن مع خبراء داخل الحكومة الأميركية وخارجها، حول الأشكال المختلفة التي قد يتخذها هذا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وعلى المسار الثالث، بناء تحالف أمني أميركي إقليمي موسّع إلى حد كبير، إذا تبنّت الحكومة الإسرائيلية عملية دبلوماسية تؤدي إلى دولة فلسطينية بقيادة سلطة فلسطينية متغيرة. ويرى فريدمان أنه إذا تمكّنت الإدارة من جمع تطبيق هذه المسارات الثلاثة معاً، وهو أمر ضخم، فإن «عقيدة بايدن» يمكن أن تصبح أكبر إعادة تنظيم استراتيجي في المنطقة منذ «معاهدة كامب ديفيد» عام 1979.
من جهة ثانية، حسب تقرير لموقع «أكسيوس»، طلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من مساعديه «طرح خيارات بشأن إمكانية اعتراف أميركي ودولي بدولة فلسطينية منزوعة السلاح»، ما يفتح الباب أمام إعادة المضي في التطبيع بين إسرائيل والدول العربية. وهذا ما أوضحه، الثلاثاء الماضي، جون كيربي، الناطق باسم مجلس الأمن القومي، عندما ادعى أن إدارة بايدن «تلقت رداً إيجابياً يفيد باستعداد السعودية وإسرائيل لمواصلة المناقشات الخاصة بتطبيع العلاقات بينهما». وعدّ ذلك استجابة لاستعداد واشنطن للاعتراف بدولة فلسطينية، قد يكون بحثه الوزير بلينكن خلال جولته الخامسة إلى المنطقة.
ويشير الموقع، إلى «وجود ثلاثة خيارات ممكنة أمام واشنطن؛ هي: الاعتراف بدولة فلسطين بشكل ثنائي، أو الإحجام عن عرقلة تصويت مجلس الأمن على قبول فلسطين عضواً دائماً في الأمم المتحدة، أو تشجيع دول أخرى على الاعتراف بفلسطين».
التطبيع مقابل «الدولة الفلسطينية»
غير أن المملكة العربية السعودية شدّدت الأربعاء الماضي، على أن أي تطبيع مع إسرائيل مشروط بالاعتراف بدولة فلسطين، سواءً من قبل واشنطن أو تل أبيب. وأبلغت الرياض موقفها للإدارة الأميركية، وجوهره أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتحقق الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وليس الاعتراف بدولة «حكم ذاتي». وهو ما عُدّ رداً أيضاً على رفض إيران القبول بـ«حل الدولتين»، ما يضعها في حالة مساواة مع رفض إسرائيل الاعتراف بهذا الحل، رغم اختلاف أهدافهما.
ريتشارد غولدبيرغ، كبير الباحثين في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» في واشنطن، المحسوبة على الجمهوريين والقريبة من إسرائيل، يرى أن التطبيع السعودي الإسرائيلي «لا يزال يحمل القدرة على إحداث تغيير جذري في الأساسيات في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي». وأردف خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» قائلاً: «لقد علمتنا اتفاقيات إبراهيم أن السلام العربي الإسرائيلي أمرٌ لا مفر منه. أما بالنسبة للفلسطينيين، فإن السلطة الفلسطينية تجاوزت حد الانهيار. وستكون ثمة حاجة إلى حملة ضغط هادئة، ولكن قوية، من جانب الدول العربية لفرض إصلاحات كبيرة في رام الله، (في إشارة إلى السلطة الفلسطينية) كي يتبلور طريق قابل للتطبيق لتحقيق السلام الإسرائيلي الفلسطيني»!
غير أن التحليلات أعلاه، عن «إعادة التفكير» الجارية في واشنطن، تشير من جهة إلى تغير في تعاملها مع تهديدات طهران ومساعيها لإخراج القوات الأميركية من المنطقة... والتصدي لترهيب الحلفاء عبر وكلائها، ومن جهة أخرى إلى الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للقبول بحل الدولتين وبناء سلطة فلسطينية برعاية عربية وإقليمية.
«التغير الأميركي»... هل هو حقيقي؟
مع هذا، يعتقد البعض أنه لا يوجد تغيير حقيقي في «الستاتس كو» (الوضع الراهن) القائم، سواءً بالنسبة إلى إيران أو إلى أهداف الحرب في غزة والعملية السياسية التي يجري الترويج لها.
وهنا يقول غولدبيرغ: «نحن نشهد السياسة نفسها فيما يتعلق بالدور الإيراني... فما يجري هو تكثيف للهجمات على الميليشيات العربية ولكن بلا أي ضغط على إيران. بل على العكس من ذلك، فإننا نشهد مواصلة واشنطن تخفيف العقوبات عن طهران، وتأكيدات متكرّرة من إدارة بايدن أن إيران ليست هدفاً». ومن ثم، يرى الباحث الأميركي «وجود سياسة واضحة تتمثل في الإحجام عن أي شيء من شأنه إثارة أزمة نووية محتملة... حتى لو أدت هذه السياسة إلى زيادة الإرهاب في المنطقة».
وحقاً، يكرّر المسؤولون الأميركيون، وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن، التأكيد على «أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع إيران»، رداً على الهجمات المميتة الأخيرة التي استهدفت القوات الأميركية في الأردن. إلا أن حجم الضربات الأخيرة واستمرارها وشدّتها، فضلاً عن مداها، الذي شمل العراق وسوريا واليمن، رأى فيها العديد من المراقبين رسالة واضحة تنم عن «يأس» إدارة بايدن من إمكانية إقناع طهران بتغيير سلوكها، رغم نَسْبها إلى «أسباب انتخابية»، يسعى من خلالها بايدن إلى تحسين صورته «المنحازة» إلى إسرائيل، و«تهاونه» مع سلوك طهران وطموحاتها.
«السعودية تشترط دولة فلسطينية مستقلة، للتطبيع مع إسرائيل»
حذر إيران... وارتباك ساحاتها
في المقابل، فإن رد فعل طهران «الحذر» على هذا «التغير» الأميركي عكس تخوفاً حقيقياً، لا يمكن تجاهله، من إمكانية تعرّضها لهجوم مباشر عالي التكلفة بالنسبة لها. وظهر ذلك من خلال سحبها مستشاريها من كل من العراق وسوريا، وتشديدها على «استقلالية» ميليشياتها.
كذلك مع استبعاد طهران من المفاوضات الجارية، سواءً حول تبادل الرهائن بين إسرائيل و«حماس»، أو مستقبل الأراضي الفلسطينية، رأى متابعون أن دورها بات «تخريب» التسويات، في ظل خسارتها «ورقة» قطاع غزة، والفلسطينيين عموماً، على أمل الحصول على تنازلات من واشنطن.
ولكن، بالتوازي مع حرص إدارة بايدن على تحاشي توسيع الصراع في المنطقة، تواصل السلطات الإيرانية توتير الجبهات في مواجهة استبعادها بوصفها طرفاً لم تعترف واشنطن بأي دور له في المرحلة المقبلة. وهي لا تزال تمتنع عن تقديم أي «صفقة»، سواءً عبر رفع العقوبات عنها، أو حسم مصير ملفها النووي، أو الاعتراف بنفوذها في المنطقة، أو إشراكها في أي ترتيبات دولية وإقليمية بعد انتهاء الحرب في غزة.
كل هذا عمّق، بحسب عدد من المتابعين، ارتباك «الساحات» التي تسيطر عليها طهران، من العراق إلى سوريا واليمن، مروراً بلبنان. وكشفت الهجمات الأميركية المستمرة في العراق، ليس فقط عن «أزمة» بين مكوّناته السياسية والطائفية والمناطقية على خلفية المطالبة بانسحاب القوات الأميركية، بل أيضاً عن مخاوف طهران، من عجزها عن إدارته إذا حصل هذا الانسحاب.
وفضلاً عن أن المطالبة بانسحاب القوات الأميركية، تُعدّ خيار حكومة تسيطر عليها الفصائل الموالية لإيران لا خيار جميع المكوّنات العراقية، فهي تُعد أيضاً اختباراً لطهران التي يجب أن تحسم ما إذا كانت قادرة على ملء الفراغ بكل جوانبه وتعقيداته... وجاهزة له.
وللعلم، واشنطن كانت قد أوضحت أن انسحابها لن يكون «بلا ثمن»، مع ما يعنيه هذا من ضغط سيقع على الحكومة العراقية لتبرير ازدواجية التشكيلات العسكرية فيه، فضلاً عن الضغط الاقتصادي والمالي الذي بدأته مبكراً واشنطن عبر فرضها عقوبات وحصاراً مالياً على عدة بنوك عراقية، مُتهمة بتبييض الأموال لمصلحة إيران ومساعدتها في التهرّب من العقوبات.
أما عن سوريا، فإنها بدأت تشهد حراكاً جدياً في أجهزتها الأمنية وسط تكاثر الكلام عن «تململ» في صفوفها من السيطرة الإيرانية. ولقد نظر متابعون إلى المواجهات والاعتقالات التي نفذتها تلك الأجهزة لميليشيات مدعومة من إيران بعدّها تغييراً في «نظرة» دمشق لمستقبل علاقتها بطهران، وبخاصة بعدما ظهر حجم الانكشاف الأمني... جراء الهجمات الإسرائيلية المتتالية، وعمليات الاغتيال التي طالت «مستشارين» إيرانيين كباراً. بل، وترافق هذا مع كلام عن اعتراضات روسية متنامية على دور ميليشيات إيران في سوريا، وتأثيرها على دور موسكو المستقبلي في هذا البلد، بعدما لمست استقواء طهران بمأزقها في حربها المستمرة في أوكرانيا.

تغيير الموقف من الحوثيين هو الأكبر
إلا أن التغيير الأكبر قد يكون الموقف الأميركي من ميليشيا الحوثيين في اليمن، حيث سيسري قرار إعادة تصنيفهم «منظمة إرهابية»، يوم 16 من الشهر الحالي. ومع تحميل الحوثيين وإيران المسؤولية عن «عسكرة البحر الأحمر»، وفق تصريحات تيم ليندركينغ، المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، لـ«الشرق الأوسط»، يخاطر الحوثيون بتدمير قدراتهم العسكرية، ما قد يضعف، ليس فقط قدرة طهران على استخدامهم، بل وقدرة هذه الميليشيات نفسها على إمساكها بالمناطق التي تسيطر عليها، والإطاحة بالعملية السياسية لوضع حد للحرب في اليمن. فحسب ليندركينغ «إيران تشكل تهديداً كبيراً»، واصفاً إمداد الحوثيين بالمال والسلاح لمهاجمة السفن بأنه «ملائم للغاية لأجندة إيران» التي تتصرف من أجل «زعزعة الاستقرار»، وسلوكها ليس «سلوك عضو في المجتمع الدولي».
هذا، ومع تصاعد الأضرار من الهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر «نصرة لغزة»، توسعت لائحة المتضررين أيضاً، وعلى رأسهم الصين. ومع أن بكين لا تزال تحاول الاستفادة من تلك الضربات للنيل من هيبة الولايات المتحدة في المنطقة، فإن «حرب غزة» وتداعياتها، كشفت عن عجز دولي غير مسبوق في التأثير على مجريات الأحداث في الشرق الأوسط، من الصين إلى روسيا ودول «البريكس»، وغيرها من الداعين لبناء نظام دولي جديد.
وسواءً كان ذلك نتيجة للحرب الأوكرانية، أو لأزمات الصين البنيوية المتصاعدة - من إفلاس شركة إيفرغرين العقارية العملاقة... إلى تراجع نموها الاقتصادي وعجزها عن الحصول على التقنيات المتقدمة من الولايات المتحدة - يبدو أن الميل لوقف «التخريب» الإيراني في البحر الأحمر، هو الذي قد يفرض على طهران إعادة حساباتها.
الخطة القطرية ــ المصرية ــ الأميركية... «المتعثرة»
مع «تعثر» الخطة التي قدمها الوسطاء القطريون والمصريون والأميركيون، جدّدت إسرائيل، بلسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، إصرارها على مواصلة حربها ضد «حماس» حتى «تحقيق النصر». وجاء هذا بعدما نشرت وسائل إعلام عدة رد «حماس» الذي اقترحت فيه وقفاً لإطلاق النار من 3 مراحل، كل مرحلة مدتها 45 يوماً على مدى 135 يوماً، وتتضمن تبادلاً للرهائن الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين.المرحلة الأولى تقترح «تبادل السجناء الفلسطينيين والإفراج عن بعض الرهائن الإسرائيليين من غير العسكريين، وتسليم المساعدات الإنسانية، والسماح بإعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللجوء وخروج القوات البرية الإسرائيلية من المناطق السكنية».وتقترح المرحلة الثانية «إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين مقابل عدد معين من السجناء الفلسطينيين، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة».وفي المرحلة الثالثة تطالب «حماس» بإعادة إعمار غزة و«ضمان» الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتبادل الرفات والجثث.إسرائيل -عبر نتنياهو- عدّت شروط «حماس» انسحاب القوات الإسرائيلية نصراً لمحاولات طهران تخريب أي اتفاق لا تشارك فيه، وقد ركز نتنياهو على أن الجيش الإسرائيلي لن يعود من قطاع غزة «حتى تحقيق النصر»، وأنه أمره بمباشرة عملية عسكرية في رفح. غير أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال مخالفاً، إنه لا يزال هناك «مكان لاتفاق» بين إسرائيل وحركة «حماس». وأردف: «نعتقد أن ذلك يُفسح مكاناً للتوصل إلى اتفاق، ونحن نعمل على ذلك من دون كلل حتى التوصل إليه... على الرغم من وجود أمور من الواضح أنها غير مقبولة في رد (حماس)».من جانب آخر، رغم تحذير بلينكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته من «أفعال تؤجج التوترات»، وأن الأولوية في مدينة رفح هي للمدنيين، لوحظ أنه لم يدعُ إلى وقف تنفيذ العملية فيها. بل كل ما قاله: «إن أي عملية عسكرية تنفّذها إسرائيل يجب أن تأخذ المدنيين في الاعتبار، أولاً وقبل كل شيء!»، مما يشير إلى أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار لا يزال بعيد المنال.وهنا، يحذّر غولدبيرغ من الخلط بين التزام إسرائيل بإعادة الرهائن... وقرار إنهاء أي شكل من أشكال سيطرة «حماس» على قطاع غزة. ويضيف أنه «مع استمرار سيطرة (حماس) على رفح وأجزاء من خان يونس، وإفلات يحيى السنوار من القتل أو الأسر، فإن الأهداف العسكرية الإسرائيلية لم تتحقق بعد». لكنه مع هذا يعتقد أن واشنطن ستضغط من أجل إنهاء الحرب، رغم صعوبة موافقة إسرائيل على ذلك.
تدنّي السقف السياسي الفلسطيني
غيث العمري، الباحث بمعهد واشنطن للشرق الأدنى، يعد أن الكلام عن الاعتراف بدولة فلسطينية، وبناء سلطة فلسطينية ذات صدقية وشرعية، تستطيع «في يوم من الأيام» أن تحكم غزة والضفة الغربية بشكل فعّال، «لا يزال مجرد فكرة لم تتبلور بوصف ذلك اقتراحا رسميا، وتواجه الكثير من التحديات». وتابع العمري في حديث سابق مع «الشرق الأوسط»، أن «السلطة الفلسطينية ضعيفة للغاية وفقدت مصداقيتها، بحيث لا يمكنها أن تلعب أي دور في غزة في الوقت الحالي. وبناءً على ذلك، يُعوّل على الدور الدولي لإعادة تأهيلها. ولهذا السبب تحدث الوزير بلينكن عن السلطة الفلسطينية المعاد تنشيطها».غير أن مراقبين يرون أن تدّني السقف السياسي الفلسطيني، الذي يواصل انخفاضه، منذ توقيع «اتفاق أوسلو»، قد يحدّ من شروط نشوء «الدولة الفلسطينية الموعودة» وحدودها وحيثيتها. وحقاً، يعكس هذا «التدني» أيضاً مدى التلاعب الأميركي المترافق الآن مع ما عُد تواطؤاً من قبل واشنطن على تقويض دور الأمم المتحدة. ويأتي هذا التواطؤ ليس فقط انتقاماً من قرار «محكمة العدل الدولية» بعد حكمها بوجود شبهة إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في غزة، بل وتقويض وكالة «الأونروا»، التي يتجاوز دورها تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، عبر إبقاء حق العودة للاجئين الموزّعين في دول الجوار حياً، الأمر الذي تسعى إسرائيل إلى إنهائه.