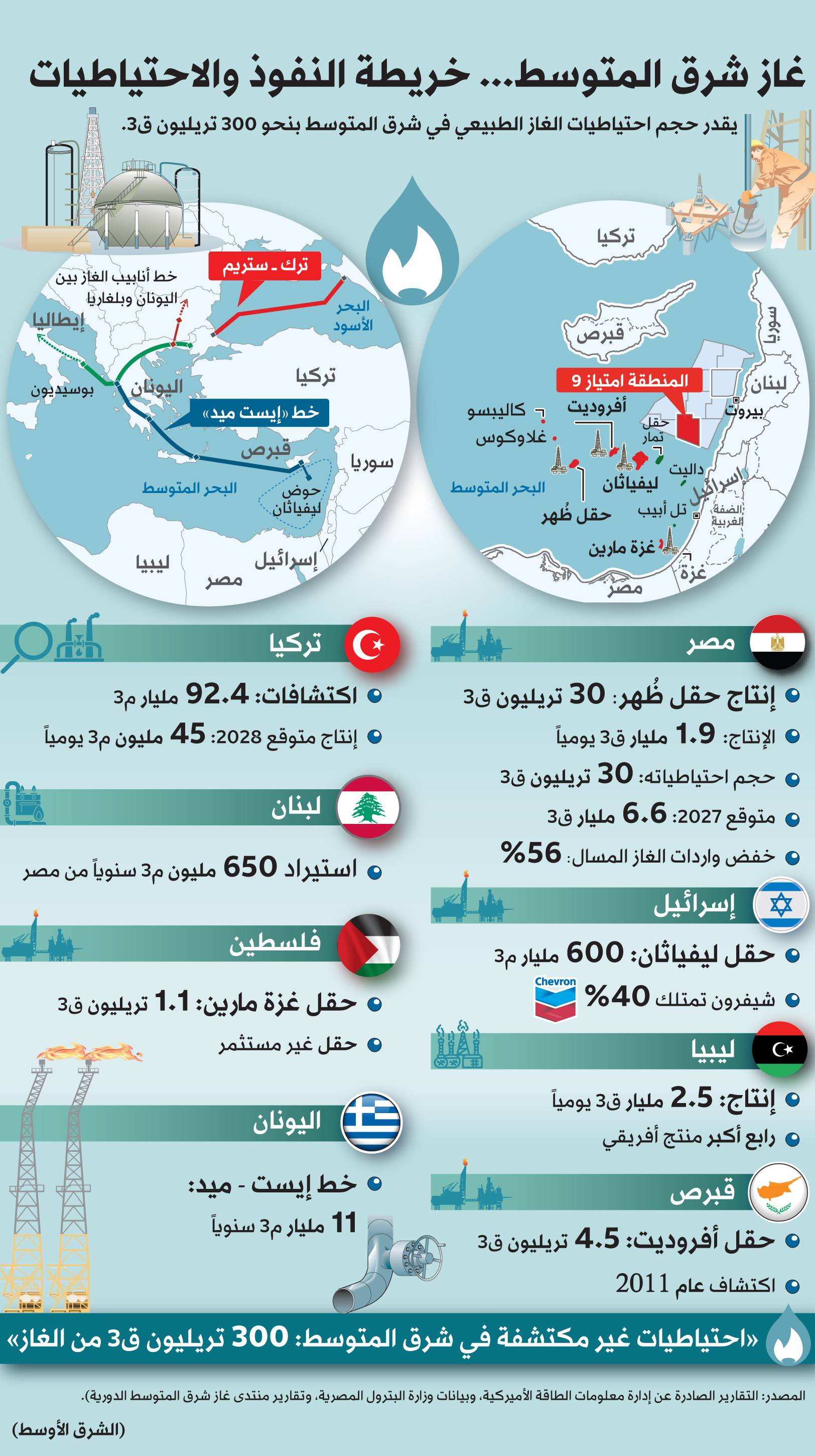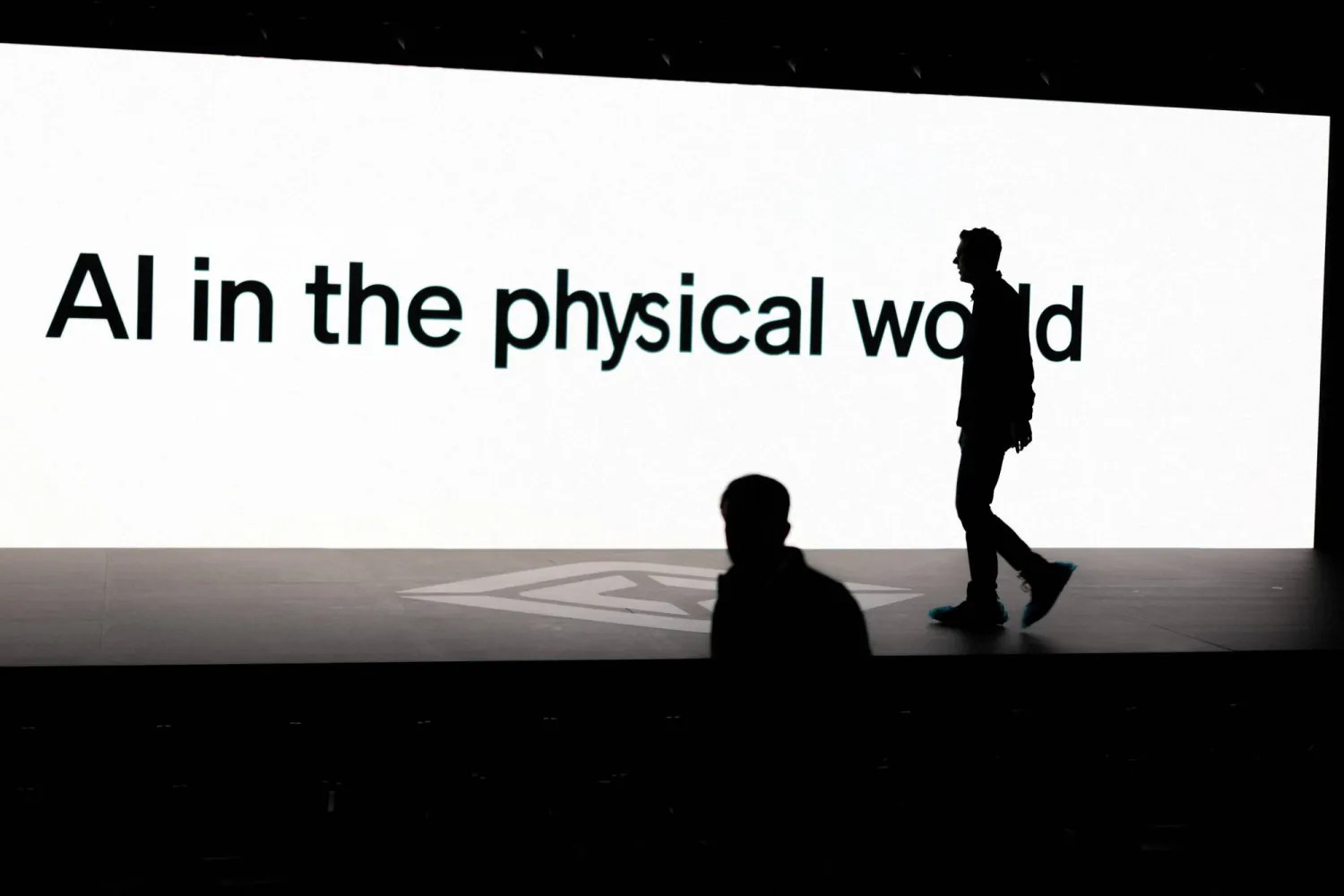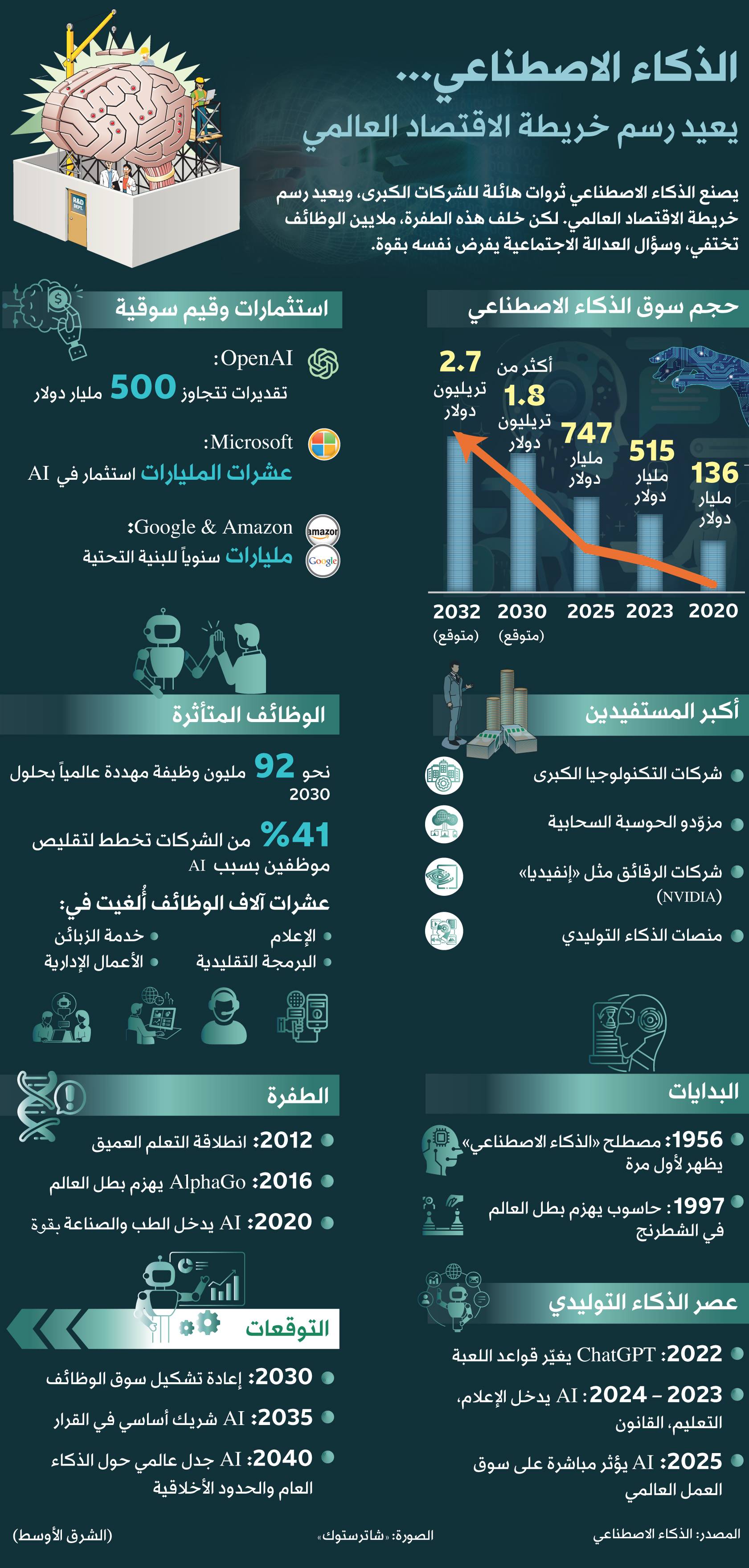وصلت عزة ح. (35 عاماً)، إلى السويد قبل 11 عاماً، عن طريق لمّ الشمل مع زوجها، وقامت باستثمار كثير من الوقت في تعلم اللغة السويدية، ومعادلة شهادتها الجامعية ودراسة مجموعة إضافية من المساقات التي تؤهلها للدخول إلى سوق العمل مجدداً ممرضةً، معتبرةً أن ما حصل معها في السويد «عبارة عن حلم، لم يكن ليتحقق في أي مكان آخر في العالم».
وتقول عزة: «السويد بلد الفرص، لمن يعرف كيف يستثمرها. فما توفره الدولة هُنا، لا يمكن مقارنته بأي بلد ثانٍ، وهذا سبب انتقالنا إلى السويد».
لكن، ورغم ذلك، تخطط عزة اليوم لـ«هجرة ثانية» إلى المملكة العربية السعودية حيث وُلِدت وترعرعت لعائلة سورية. وفي حديثها مع «الشرق الأوسط» تستذكر كيف بدأت تفكر بذلك، فتقول: «في البداية كنا منهمكين في بناء حياة جديدة، لكن مع الوقت افتقدنا الروابط الاجتماعية. العلاقة بين المواطنين والقادمين الجدد كارثية خصوصاً بالنسبة لشخص مثلي. هنا نعيش حياة باهتة فلا نلقى تفاعلاً اجتماعياً، أو قبولاً. القيم والأعراف الفردية المطلقة تهيمن على المجتمع السويدي، وبالنسبة لنا كمهاجرين، الفردية القصوى ليست بديهية، نحن أكثر ارتباطاً بالجماعة، وغالباً ما يرتبط الناس بالعائلة أو العشيرة أو المنطقة بأشكال مختلفة من التسلسل الهرمي الاجتماعي».
تروي عزة بشيء من الإحباط كيف أنها حتى الآن لا تملك «رقم هاتف شخص سويدي واحد بعد كل هذه المدة»، وتسأل: «هل يُعقل ذلك؟! لم أختبر معنى أن أتحدث مع مواطن حول أمور الحياة العادية».
تغير مفهوم الاندماج
في الماضي، شهدت السويد موجات من المهاجرين، وعملت على دمجهم وكانت هناك رغبة مجتمعية في مساعدة المهاجرين على الاندماج، وقد اختبر العراقيون الذين وفدوا بعد 2003 تلك الحالة إلى حد بعيد. وفي عملية الاندماج تلك، غالباً ما يتخلى الفرد عن الخصال المجتمعية والثقافية التي يحملها ويتكيف مع أعراف المجتمع المضيف وتقاليده.
لكن اليوم تحول التركيز إلى ترسيخ مفهوم التنوع الثقافي والمجتمع المتعدد، بهدف ألا يضطر أي شخص للتخلي عن هويته الخاصة مقابل فرص اقتصادية واجتماعية وسياسية متساوية في المجتمع المضيف. فكان لذلك أثر سلبي أيضاً لكونه يحصر الوافدين في دوائر مغلقة. وبحسب عزة، يصبح المهاجر «محاصَراً»، لأن المواطن السويدي «لا يرى ضرورة للاندماج أو التواصل على المستوى الفردي، ويترك المهمة للدولة والبرامج الممولة، التي في الغالب تكون نتائجها مخيبة».

وفي الوقت نفسه تُعتبر سياسة الاندماج موضوعاً ساخناً في وسائل الإعلام، والغرف السياسية، خصوصاً مع تصاعد اليمين المتطرف ووصول أحزابه إلى السلطة في عدد من البلدان الأوروبية، وليس فقط في السويد. وتقول عزة: «يتم تحميلنا مسؤولية العزلة التي نعيشها هنا، والبطالة، والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والثقافية والصحية الناجمة عن فشل إدماجنا، فتحولنا بدورنا إلى قضية سياسية توصل أحزاب اليمين إلى السلطة».
أمام هذا كله، ترى عزة أنها لم تعد مضطرة للتحمل أكثر، وتقول: «نعيش الحاضر ونحاول التغلب على العزلة والاكتئاب بممارسة اليوغا، أو المشي مسافات طويلة في الغابة، أو الجري في الصالات المغلقة، أو الذهاب إلى حفلات موسيقية رديئة في الغالب، ونوثق هذه اللحظات على وسائل التواصل الاجتماعي، لإيهام أنفسنا بأننا بخير وللحصول على جرعة من الأمل».
وليست عزة حالة منفردة في السويد، فـ«الهجرة المعاكسة» باتت ظاهرة، خصوصاً في أوساط الوافدين واللاجئين. وأظهرت أرقام هيئة الإحصاء الوطني السويدية أن عدد المهاجرين الذين غادروا البلاد في عام 2022 بلغ 50 ألفاً و592 شخصاً، شكل المولودون في السويد من أبوين سويديَيْن نسبة 37 في المائة منهم لأسباب متنوعة.
ومع نهاية عام 2023، تم تسجيل أكثر من 66 ألف شخص مهاجراً من السويد (أي أنه غادر لأكثر من عام وشطب من سجلات المقيمين)، وهذه أرقام مقلقة ترافقت مع انخفاض عدد الولادات إلى معدلات غير مسبوقة أيضاً أدت إلى تراجع النمو السكاني ليصبح الأدنى منذ عام 2001.
نحن وهم... و«السوسيال»
المهندس عامر بارودي، الذي انتقل للعيش في بلد خليجي قبل عامين، يروي تجربته في الهجرة من السويد، بعدما قضى فيها مع عائلته 8 سنوات. ويرى أن الانتقال كان أكثر ملاءمة له ولعائلته من جميع النواحي بالإضافة إلى الأمان الاجتماعي وإمكانية تربية الأطفال بحسب القيم والعادات والتقاليد العربية.
ويشير بارودي إلى أن أحد الأمور الحاسمة التي دفعته إلى اتخاذ قرار الهجرة المعاكسة صعود اليمين المتطرف في السويد، ومشاركته في وضع سياسات الهجرة، والتضييق المتزايد على المهاجرين، من خلال مشاريع قوانين وأحكام تجعل من الصعب عليهم الاندماج. ويقول: «الخطاب العنصري متصاعد على المستويين الرسمي والمجتمعي حتى وصل إلى بيئة العمل الرسمية، مع مؤشرات كثيرة للعنصرية المؤسساتية».
ويتابع بارودي قوله: «خطاب الكراهية يبدأ من قمة السلطة السياسية، حيث يصنف المهاجرون مواطنين من الدرجة الثانية، ويسهل الطعن في وطنيتهم وولائهم للسويد، واتهامهم بأنهم غير مستعدين للدفاع عنها في حالة الحرب، بالإضافة إلى الحديث المتكرر عن سحب الجنسيات الممنوحة لهم، وفرض مناطق أمنية يسمح فيها للشرطة بتفتيشهم وأطفالهم في أي مكان عام، من دون وجود شبهة جريمة».
وفي بعض المناطق، يجوز للشرطة تفتيش الأشخاص والمركبات بحثاً عن أسلحة أو ممنوعات فيما لا يسمح لها عادة بالتفتيش بلا إذن، وما لم يكن هناك «سبب موجب للافتراض» بأن مخالفة ما أو جريمة قد ارتُكِبت بالفعل.
وفي سياق التجاذبات بين المهاجرين وممثلي المؤسسات الرسمية، يشير بارودي إلى مسألة مهمة، هي دور جهاز الرعاية الاجتماعية (السوسيال) والصورة السلبية عنه التي ترافقت مع تصاعد حملات معادية على وسائل التواصل الاجتماعي مقابل غياب تام لأي خطاب رسمي هادئ يوضح دوره ويفسر أداءه. وقد عمَّت مؤخراً حالة من الرعب بين أوساط المهاجرين مما سمي «خطف الأطفال» (المسلمين بشكل خاص) أدَّت إلى اتخاذ قرار جماعي بمغادرة البلاد أو البحث عن بدائل.

وكانت هذه المؤسسة تشكلت، مطلع التسعينات، بصلاحيات واسعة تتخطى أحياناً قرارات المحكمة الإدارية بحيث يسمح لها بسحب الأطفال من عائلاتهم إذا ما تعرضوا لسوء معاملة، أو إذا تبين أن بيئة أسرهم غير ملائمة للأطفال واليافعين لأسباب تتراوح بين العنف الأسري أو إدمان المخدرات أو غير ذلك مما يعرِّض الأطفال لمخاطر جسدية ونفسية. وكانت السنوات الخمس الماضية شهدت «ذروة» في سحب أطفال من عائلاتهم، غالبيتهم من أصول مهاجرة، وإيداعهم إما في دور رعاية للدولة أو لدى أسر مضيفة. وتعتبر المؤسسة في المقابل أنها لا تسعى إلى «استهداف» المهاجرين بشكل خاص أو طريقة ممنهجة، وإنما الأمر نسبة وتناسب، وبالتالي فإن الأعداد قد تبدو أعلى بين فئات أكثر من فئات أخرى.
وكان لافتاً طريقة إدارة الأزمة التي نشأت حول دور «السوسيال»، والتجاوزات الكثيرة التي سُجّلت في عمل موظفيه، ثم التكتم وغياب الشفافية في الرد المتأخر من الجهات المسؤولة، وتصوير الأمر فقط على أنه حملة تستهدف أمن السويد؛ ما أدَّى إلى تعميق الهوة بين مكونات مختلف المجتمع السويدي. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه وسائل إعلام محلية أن 200 طفل من أصل 240 سُحِبوا من عائلاتهم في عام 2022 وحده انخرطوا في أعمال إجرامية، ليتبين إنهم يتعرضون للتجنيد داخل دور الرعاية نفسها. فهؤلاء الأطفال المهمشون والمحرومون يجدون أنفسهم مستهدَفين من قبل عصابات الجريمة المنظمة التي تستغل ظروفهم. وتترجم هذه الظاهرة بوضوح في زيادة عدد العصابات وجرائم العنف وإطلاق النار في الضواحي التي يقطنها المهاجرون؛ ما يعود ويكرس الصورة النمطية عنهم، ويرفع الخطاب الشعبوي ضدهم. وبسبب فقدان الثقة واعتماد لغة «هم ونحن»، تمتنع الأسر المهاجرة عن المشاركة بفعالية في جهود الدولة لوقف تجنيد الأطفال، فيدور الجميع في حلقة مفرغة.
وفي النهاية، آثر بارودي الرحيل، معتبراً أن هذه العوامل المتراكمة تجعل الحياة تبدو وكأنها «هروب من سجن كبير، حيث يشعر المهاجرون بعدم الانتماء والاستبعاد، ويعيشون في حالة من التوتر والقلق المستمرين، ما يزيد من الشقاق والتمييز ضدهم».
معضلة النمو السكاني
وهناك مفارقة تكمن في اعتماد السويد على الهجرة الوافدة للحفاظ على نموها السكاني والإبقاء على شريحة عمرية شابة ومنتجة اقتصادياً، لكنها تبدو أمام معضلة حقيقية؛ فلا هي قادرة على الحفاظ على الوافدين أو اللاجئين إليها ولا على نسبة ولادات معقولة، كما أنها قامت برفض آلاف طلبات الإقامة.
وكشفت بيانات هيئة الإحصاءات أن 100 ألف و100 طفل فقط وُلِدوا في 2023، أي أقل بـ4 آلاف و700 ولادة من عام 2022. ومقارنة بعام 2021، يقل العدد بنحو 14 ألف ولادة. وتقول غوادالوبي أندرسون، خبيرة الإحصاءات السكانية في هيئة الإحصاء السويدية: «لدينا إحصاءات شهرية حول الولادات لكل امرأة منذ عام 1990. وجاء عدد الولادات لكل امرأة في سن الإنجاب لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي الأقل منذ بداية تدوين الإحصائيات».

كذلك تُظهر أرقام مصلحة الهجرة السويدية انخفاض عدد تصاريح الإقامة الممنوحة بنحو 40 ألفاً مقارنة بعام 2022. وفي المجمل، وافقت وكالة الهجرة على 102 ألف طلب تصريح إقامة في 2023، مُنحت بغالبيتها للعمل والأقارب والدراسة، في حين أن الفئة الكبيرة تاريخياً من طالبي اللجوء مستمرة في الانخفاض.
وفي الوقت نفسه، كثفت السلطة العمل على إلغاء تصاريح الإقامة الممنوحة؛ إذ تم إلغاء ما يقرب من 11 ألف إقامة في 2023.
واللافت أن بلدان الاتحاد الأوروبي تشهد ارتفاعاً في عدد طلبات اللجوء وسجلت زيادة بنحو 18 في المائة في 2023، بينما يتناقص عدد طلبات اللجوء إلى السويد؛ إذ تراجعت بنسبة 26 في المائة خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تقرير من «معهد دراسة المستقبل» يرى أن هذا يترك تأثيراً على المجتمعات الصغيرة والمناطق الريفية والأجزاء الشمالية من البلاد، أو ما يُسمى «نورلاند» المكونة من 5 مقاطعات (نوربوتن، فاستربوتن، جامتلاند، فاسترنورلاند، جافليبورج). تغطي هذه المقاطعات معاً 58 في المائة من مساحة السويد، ويعيش فيها نحو 1.2 مليون شخص، وتبلغ الكثافة السكانية بين 3 و5 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد. لذلك بدأت تظهر مشاكل التوظيف، وتراجع التجارة، وتباطؤ البناء، والزيادات الكبيرة في الضرائب بالبلديات التي تعاني من انخفاض عدد السكان، وشيخوختهم.
محمد برهمجي (اقتصادي) يرى أن تأثير الهجرة العكسية يظهر بأشكال مختلفة على الاقتصاد السويدي، منها: «نقص اليد العاملة، وتأثر بعض القطاعات الإنتاجية التي تقوم على المهاجرين؛ ما يعيق الاقتصاد في النهاية».
ويضيف محمد: «يساهم المهاجرون في الابتكار والتنوع الثقافي والاقتصادي. وفقدانهم يقلل من التنوع في سوق العمل، بالإضافة إلى الأثر البالغ على الديموغرافيا، خصوصاً مع الشيخوخة السكانية».
وكانت السويد شهدت، في عام 2015، ما عُرِف بـ«أزمة لاجئين»؛ إذ وصل عدد طالبي اللجوء إلى أكثر من 160 ألف شخص، بينهم 50 ألفاً من سوريا وحدها.
ويعتبر هذا العدد أكثر بضعف ونصف من عدد المتقدمين في 2010 فيما تُقدَّر زيادة السوريين بنحو 20 ألفاً عن عام 2014، الذي سجل 30 ألف طلب من السوريين وحدهم. ومنذ ذلك الحين، استمرت الطلبات السورية في تصدُّر القائمة حتى عام 2021، عندما ارتفعت أعداد الأفغان بعد انسحاب الولايات المتحدة من بلدهم.
وقبل ذلك، كانت السويد سجلت ذروة في عام 2007، مع وصول عدد طالبي اللجوء إلى نحو 36 ألف شخص، نصفهم من العراقيين.
العيش في هوامش الشأن العام
«تجربتي مختلفة في نواحٍ كثيرة عن أزمة اللجوء في 2015، وإن كانت أسباب الرحيل عن البلد الأصلي متشابهة»، يقول حسام موصللي كاتب ومترجم سوري حاصل على إقامة الكتابة الأدبية في عام 2016، بعد انتهاء منحته، تابع موصللي دراسته العليا في إحدى الجامعات السويدية بتخصص العلاقات الدولية، واختار منذ فترة وجيزة الانتقال إلى مصر.
ويقول: «لم أحتكَّ كثيراً مع (السيستم) الخاص باللجوء وتعقيداته وفترات انتظاره الضبابية واللانهائية. قضيتُ في السويد قرابة 7 أعوام، لدي فيها أصدقاء يُعدّون على الأصابع، لكن قد يستغرق الوصول إلى بعضهم 7 ساعات من حيث كنت أقيم في مالمو، جنوباً».

ويضيف حسام: «بحكم عملي ودراستي أنا معنيّ بشؤون عربية متنوعة، وفي السويد كان شعوري الدائم بعدم الإنجاز، وبأنني في الهامش. وقد زال ذلك في لحظات، وبمجرد زيارة لأول مكتبة في بلاد ناطقة بالعربية وإدراك أهمية الاعتراف بك وبمساهماتك وعملك مهما كان بسيطاً، وهي أشياء تكاد تغيب في بلاد يكون المرء فيها وحيداً، وبعيداً عن أي حاضنة اجتماعية أو روابط مهنية، وعاجزاً عن التفاعل الحقيقي مع دوائرها الثقافية والفكرية وليس فقط في الهوامش وضمن الأطر المعزولة أو الموازية التي نخلقها لأنفسنا بوصفنا مهاجرين».
كذلك يلفت حسام إلى أن عامل الطقس كان حاسماً في اتخاذ قراره بالرحيل. ويقول إن «البحث عن الشمس، عن الدفء الفعلي والاجتماعي والألفة الثقافية. بالطبع تحضر العنصرية كأحد أسباب الرحيل المباشرة»، وهي تعمق تلك الغربة الاجتماعية وتزيد من حدتها، لأن الأفراد والعائلات يضطرون إلى «الاختفاء»، كما يقول حسام، تفادياً لأن يصبحوا هم «الآخَر». ويختم حسام بالقول: «المثير للذعر حقاً أن صندوق الاقتراع يحمل حكومة يتحكم اليمين المتطرف بكل مفاصلها، لما يكشفه من مؤشرات اجتماعية صادمة، لكون هذا الصندوق عملياً انعكاساً حراً وديمقراطياً».