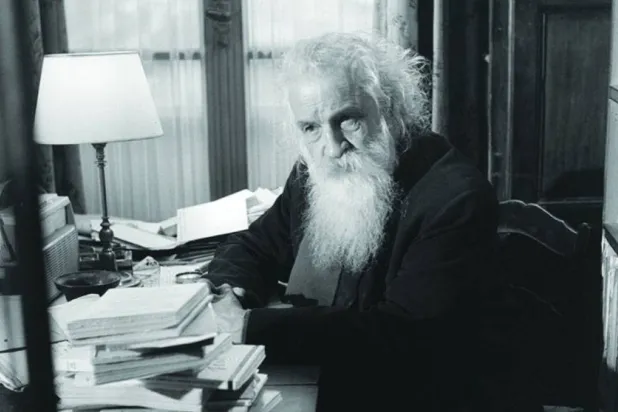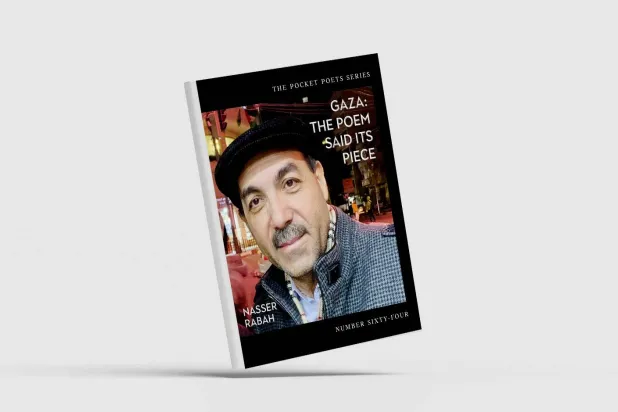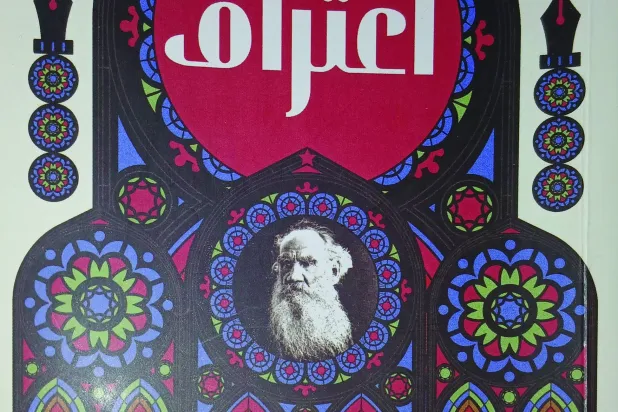اللذة حسية مادية واضحة، لا يمكن التشكيك في وجودها؛ لأنها تُعاش مباشرة قبل أي تفسير أو حكم، وتعمل بوصفها محركاً خفياً للسلوك، حتى قيل إن حركات الإنسان كلها جبرية تحكمها اللذة والألم. واللذة ليست محصورة في الأكل والشرب والجنس، كما درج الخطاب الأخلاقي على اختزالها، بل تتخلل الجسد كله، وتتشكل وفق خريطة دقيقة من الاستجابات العصبية والتوترات والانفراجات. وهذه الملذات، وكذا الآلام، تتفاوت في القوة. لنا أن نتخيل لذة نيوتن عندما اكتشف قانون الجاذبية. ولنا أن نتذكر أنك عندما تنظف أذنك، لا تكون المسألة مجرد إزالة للشمع، بل هناك لذة حقيقية، ذات قوة، تدعو الإنسان إلى تكرار الفعل، حتى بعد تحقق الغاية الوظيفية. هذه الملذات، كبيرها وصغيرها لا تحتاج إلى تبرير، ولا إلى خطاب أخلاقي؛ لأنها ببساطة تحدث.
جغرافية اللذة تمتد لمساحات أوسع بكثير مما يتصور العجلان. وبإمكان القارئ أن يستكشف هذه التضاريس ويتوسع في دراستها. فاللذة، في معناها الجوهري، ليست بالضرورة نشوة عالية أو إثارة قصوى، بل غالباً ما تكون إحساساً دقيقاً بزوال اختلال، أو بعودة الجسد إلى الراحة. ولهذا السبب نغيّر المِرفق الذي نتكئ عليه بمجرد أن نشعر بأدنى انزعاج. لا ننتظر ألماً حقيقياً، ولا نفكر في القرار، بل تتحرك أجسادنا كالآلات لتجنّب الألم، ولو كان في بدايته. هذا السلوك اليومي البسيط يؤكد أن حياتنا تُدار، في مستواها الأعمق، وفق ميزان اللذة والألم، لا وفق المفاهيم الكبرى التي تخترعها عقولنا لاحقاً.
هنا يبرز سؤال السعادة. إذا كانت اللذة بهذا الوضوح والحضور، فما السعادة إذن؟ وهل هي شيء نعيشه فعلاً؟ حين نزعم أننا سعداء، فإننا لا نصف تجربة حاضرة، بل نصدر حكماً عاماً على فترة أو على حياة كاملة. لكننا في الواقع لا نلتقي بشيء اسمه السعادة في الشارع. ما نعيشه دائماً هو لحظات، لذة وراحة وانشراح وزوال توتر، أو على العكس ألم وضيق وحزن. السعادة ليست إحساساً نشعر به، بل تلك هي اللذة. السعادة بناء ذهني، أشبه بعنوان يُوضع على سلسلة من الوقائع بعد مرورها، وقد يكون وهماً.
ولا بد من التفريق بين اللذة الحسية واللذة العقلية ضرورياً. اللذة الحسية قصيرة العمر، مرتبطة بالجسد واستجابته المباشرة، لا يمكن للطعم أن يدوم ساعات، ولا للمس أن يبقى متوهجاً إلى ما لا نهاية، فجميع الملذات الحسية لا تتجاوز الدقائق المعدودة. أما اللذة العقلية فهي أبطأ وأطول نفساً؛ لأنها لذة المعنى والحديث والذاكرة. حين نقول إننا قضينا ساعات ممتعة على العشاء مع أصدقاء، فإن اللذة الحسية للطعام انتهت في وقت قصير، وما استمر هو لذة النقاش والضحك واستعادة الذكريات والشعور بالقرب الإنساني.
من هنا يمكن القول إن اللذة هي الحقيقة الوحيدة التي لا يمكن إنكارها؛ لأنها تُعاش دائماً في الحاضر. أما السعادة فليست سوى مفهوم اخترعه الإنسان ليمنح حياته شكلاً كلياً، وليحكي عنها قصة متماسكة. الحياة، كما تُعاش فعلاً، ليست سعيدة ولا تعيسة، ولا ذنب لها في إنشاء تلك المفاهيم الحالمة، بل هي سلسلة من الاستجابات الدقيقة للذة والألم.
ما نسميه سعادة ليس إلا الاسم الذي نطلقه، بعد مرور الوقت، على تتابع لحظات لذة غلب فيها الانسجام على الاختلال. في هذا السياق، يظهر تصور أرسطو للسعادة بوصفه المثال الأوضح على تحويل اللذة من حقيقة معيشة إلى عنصر ثانوي. أرسطو لا ينكر اللذة، لكنه يرفض أن تكون أساس الحياة الجيدة، ويعرّف السعادة بأنها «نشاط النفس وفقاً للفضيلة في حياة تامة». غير أن هذا التعريف ينقل معيار الحياة من مستوى التجربة المَعيشة إلى مستوى الحكم العقلي، وهذا ديدن أرسطو في كل حقل.
الإنسان لا يشعر بما يسمى «نشاط النفس»، ولا يختبر «الفضيلة» بوصفهما إحساسين مباشرين. ما يعيشه فعلاً هو لذة أو ألم، راحة أو توتر، انشراح أو ضيق. أما الفضيلة والنشاط فليستا كيفيتين حسيّتين، بل تسميتان ذهنيتان تُستخلصان بعد الفعل، حين يُعاد ترتيب ما عِيش، ووضعه تحت عنوان أخلاقي عام. كما أن اشتراط «الحياة التامة» يكشف الطابع النظري والسردي لهذا التصور. لا أحد يعيش حياته بوصفها كُلاً مكتملاً، بل يعيشها لحظة بلحظة، في توازن هش. السعادة، بهذا المعنى، ليست تجربة، بل قصة تُروى عن حياة بعد مرورها. وما لا يُعاش في الحاضر لا يمكن أن يكون موجهاً فعلياً للسلوك.
إن الزعم بأن اللذة مجرد نتيجة تابعة للفعل وليست غايته يتعارض مع ما نعيشه يومياً. فالأفعال لا تستمر إلا بقدر ما تمنح صاحبها نصيباً من اللذة، مهما كان ضئيلاً أو مؤجلاً. وحين تغيب اللذة، ينهار الدافع، مهما بدا الفعل نبيلاً في الخطاب الأخلاقي. فاللذة ليست زينة تُضاف إلى الفعل، بل شرط بقائه واستمراره.
بهذا المعنى، يتضح أن جغرافية اللذة ليست موضوعاً ثانوياً، بل مفتاح لفهم الإنسان كما هو، لا كما يراد أن يُرى في المرآة الأخلاقية. السعادة، إن كان لها معنى، فهي ليست شيئاً نبحث عنه، بل تقرير عن مهمة بعد انتهائها. بينما اللذة هي الشيء الوحيد الذي نعيشه حقاً، هنا والآن.
الحديث عن مركزية اللذة في توجيه السلوك يصطدم بالحسّ الأخلاقي التقليدي؛ لأنه لا يصوّر الإنسان كما ينبغي أن يكون، بل كما هو في واقعه. فالإنسان لا يعيش وفق مخطط مثالي، ولا يسير موجَّهاً بصورة ذهنية عن «الحياة الجيدة»، بل يتحرك داخل شبكة دقيقة من الاستجابات الحسية، يختار فيها ما يخفف توتره، ويؤجل ألمه، ويمنحه قدراً من الراحة، حتى وإن غلّف كل ذلك بأغلفة من المفاهيم الفلسفية التي لا تنتهي.