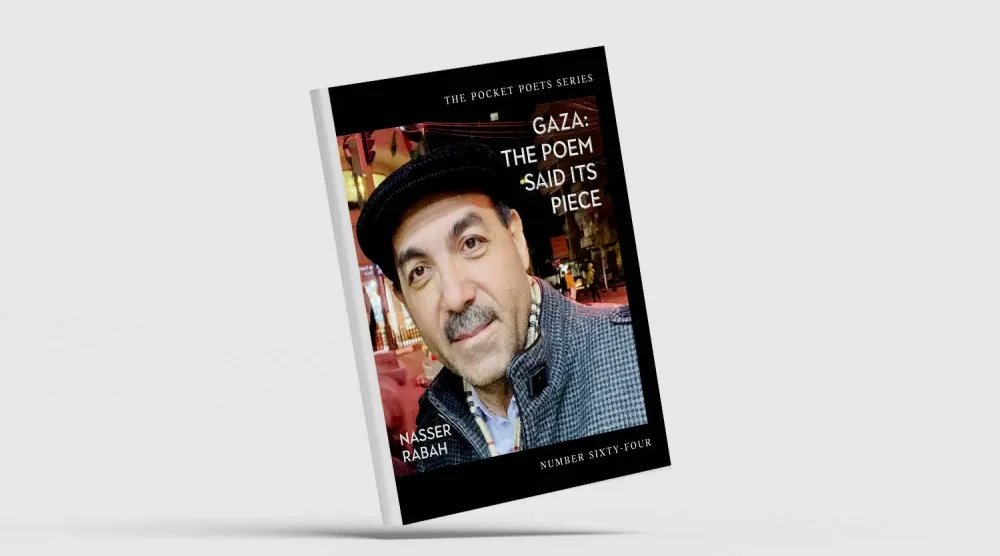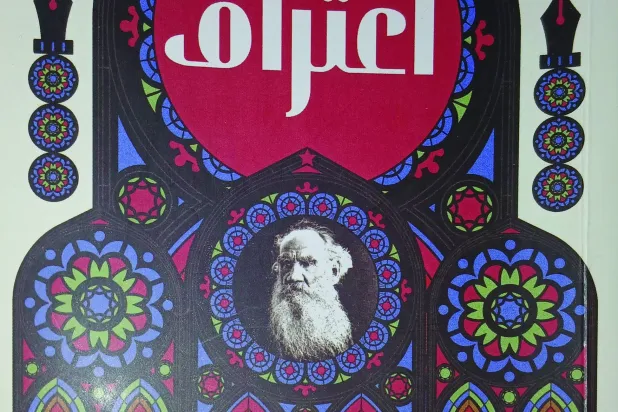نحن لا نحب من دون استعداد فطري لتحويل مشاعرنا إلى النقيض، لهذا غالباً ما نصوغ من نحب في صورة تتواءم مع الرغبة لا الإمكان، ونستبعد كل التقاسيم النقيضة، الناسفة للصورة؛ محبة الآخر، في هذا المقام، ليست إلا قناعاً لافتتان أزلي بالذات... إذ لا محبة دون صراع واصطفاء: اصطفاء للوجه والجسد والروح والأسلوب من سديم التفاصيل المعقدة، هي جبلته وأصله، وصراع نكد مع نزوع كل تلك التجليات الأصلية لأن تنطق بحقيقتها، دون مساحيق ولا ادعاء... وبناء على هذا الافتراض لا مفر من أن تكون المحبة محنة، بمعنى ما، مثلما هي البغضاء سواء بسواء.
في مدار هذا الاعتقاد تتجلى علاقتنا بالكتب والصور والشخصيات المتخيلة، على نحو مشابه للصيغة التي تتشكل عبرها علاقاتنا بالبشر، وبالعقائد، والرموز، فينجذب توقنا إلى النهايات، متلبساً العواطف المتناقضة. ولأن القراءة مبنية على قدر جم من الأنانية، فهي تنتقي، ولهذا تختلف تلك المقاطع التي يوضع تحتها سطر، بقدر ما تختلف تفاصيل الصور التي تنصرف إليها العين، لأننا نبحث دوماً عن التواؤم، والحفاظ على سكينة اعتقادنا واختيارنا وأسلوبنا، وهو ما يجعل النظرة إنتاجاً للمعنى.
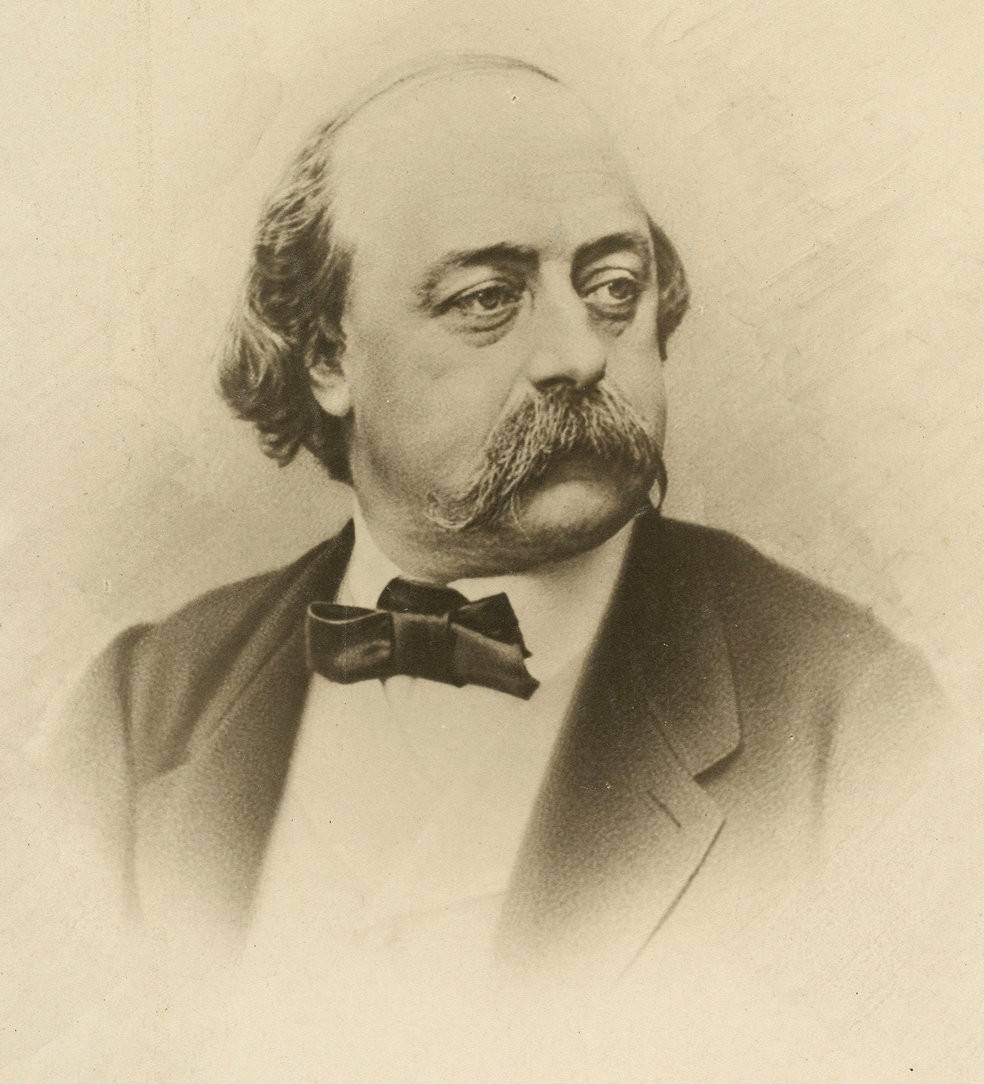
حين شاهدت للمرة الأولى فيلم «آنا كارنينا»، التبس في ذهني معنى رواية تولستوي الخالدة مع ما تقوله ملامح «صوفي مارسو» التي تنبت في كل تقاسيمها معاني طفولية بادية الوضوح. قبل مشاهدة الفيلم، كانت «آنا كارنينا»، من دون ملامح، امرأة روائية تنوب عن معنى الرواية، أي أن التحفة التبست بجسد الكائن وأضحت لها عواطف. وقد تترسخ هذه القناعة عبر مئات النصوص التي تحولت لأفلام، وأخرى باتت حكايات يومية، وأمثلة، ومسكوكات كلام. بحيث يمكن استعادة رواية «مدام بوفاري» لفلوبير على الدوام في هذا السياق بوصفها تحفة لها عواطف، تولد تناقضات الحب والكراهية لدى جمهورها، وقد تقول ما اختزنه المجتمع والتاريخ والمعرفة الاجتماعية في أسطر معجونة بكيمياء امرأة، حولت النهم العاطفي والجنسي إلى مفتاح لعالم كبير من التفاصيل النفسية والتطلعات الدرامية التي تجعل الفرد اليوم يشبه ما كانه في القرون التي خلت. ومرة أخرى بالعودة لرواية «لوليتا» لنابوكوف، يمكن الإحساس أن الرواية أشبه ما تكون بكيان أنثى، بكل ما يعنيه جوهرها من اكتناز لسحر الالتباس وعدم اليقين، حين نطيع العواطف ولا نتأكد من كنهها، ندرك مجدداً ذلك الشيء الذي لا يكف عن منحنا صورة الخلود في الأشياء المشكوك فيها... «لوليتا» أنثى مراهقة استغلها زوج أبيها، لكن الرواية تتركك حائراً (تماماً كأي امرأة) لأن الاستغلال لا تدرك مغزاه الشخصية المعذبة، تبدو في شبه خدر مسترسل، رهينة لخطيئة من دون ندم.
وعلى ذكر الندم، الرواية لا تدعونا للتكفير ولا للمراجعة، تدعونا للتفكير في الماهيات، تلك الحقائق التي تتجلى اليوم مختصرة في جوهر صاعق مجازه «سيدة» في وضع الكلام، فمنذ الأزل كان الحكي ولعاً نسائياً، لهذا كان تأنيث الرواية دالاً، ونحن نقرأ الروايات ليلاً، وقد تستغرق ليلنا كله، ومثلما توقعنا الأنثى من النظرة الأولى، فإن الأسطر الروائية الأولى كفيلة بقلب قدرنا، وفي البدايات الأولى كانت الرواية فناً مضطهداً تماماً مثل النساء، كانت فناً هامشياً ومقموعاً، وغير مأخوذ مأخذ الجد، وكانت رحلة الحضارة في إدراك الظلم التاريخي للنساء موازية لفقه بلاغة الرواية.
في مقطع دال من كتاب «في جدوى القراءة»، يرى شارل دانتزيغ أنه: «إن كان ثمة معنى وحيد قصده الكاتب، فإن كل قارئ يتلقف صداه على نحو خاص»، ومن ثم فإن مشاعر القبول والاستبعاد داخل النص الواحد تولد قدراً جماً من أحاسيس النفور والتولّه، وسرعان ما تتجلى عبارات من قبيل «يبهرني بقوة ولا أطيقه» التي أوردها ماريو بارغاس يوسا في معرض تعليقه على نص «مدار السرطان» لهنري ميلر، دالة على صلاتنا بأعمال تتغلغل إلى الداخل العميق مولدة طاقة الكراهية الموحية.
ولعل من أكثر الاستعارات البصرية للكراهية تلك التي تقرنها بالنار الملتهبة، التي تلتهم أقرب الكتب واللوحات والتماثيل إلى الخاطر، عندما يقلب لها القلب ظهر المجن، يمكن أن يكون أبو حيان التوحيدي أقرب مثال إلى التطهر من الحب بالنار، حين اختار أن يعدم ذخيرة حياته، وأن يحولها إلى كتلة رماد، لكن ليس قبل أن تتحول تلك المؤلفات ذاتها إلى علة ومحنة وقدر مرزئ، لا يستثير إلا الحسرة والألم. وإن لم تكن النار وسيلة، فتحويل الأثر إلى حطام، إذ لا تحصى اللوحات والمنحوتات التي دمرت في فورة جنون، داخل ورشات رسامين حقيقيين ومتخيلين من إميل كلوديل ورودان وماتيس ورايبورن إلى فرينهوفر في رواية «التحفة المغمورة» لبلزاك.
والظاهر أن تغير الخاطر تجاه «الأثر» والمنتَج، شبيه بمشاعر الخذلان من العقب، حيث تولد من رحم المودة الجريمة، بطمأنينة وإصرار، فالأمر هنا لا يتعلق بعقاب، وإنما بتطهر له جوهر مقدس، على نحو شبيه بما يفصله فولتير في كتابه «قول في التسامح»، حين يعرض لحادثة قتل «جان كالاس»، عندما قررت المحكمة إعدام الأب اعتماداً على اقتناعها بأن الأمر يتعلق بجريمة ضحى فيها الأب بابنه حماية لمعتقده البروتستانتي.

هل للإبداع جوهر لاهوتي؟ ذلك ما يؤكده تاريخ الأدب والفنون، في جزء كبير منه، كما يثبته المعجم المستعمل بصدد القبول والرفض، حينما تعتمد مفردات: «الإيمان» و«الكفر» عند وصف الصلات المنتسجة بالتعبير الفني والروائي والشعري والمسرحي، وكأنما الكتابة والتشكيل لا تتحققان دونما استعباد وتملك للمصير. ولكم كانت محاورة أندري مالرو لأبيه، التي أوردها في الفصل الأول من «المذكرات المضادة»، دالة في كشف قدر الاستعباد الذي تمثله الرواية، حيث يقول في مقطع منها: «لاحظوا أن الروايات الثلاث الكبرى التي صورت فتح العالم من جديد، إنما كتبها عبد سابق هو سيرفانتس، والثانية سجين سابق في الأشغال الشاقة هو دوستويفسكي، والثالثة محكوم عليه بالشنق سابقاً هو دانييل ديفو».
في النهاية تثبت هذه الصلات التي تنتسج بين الكتاب والرسامين وإبداعاتهم أنها ليس شيئاً آخر إلا صورة لتصالحهم أو خصامهم مع ذواتهم الدفينة كما تمثلوها في مسارات مختلفة، وأن الإبداع لا يمكن أن يكون إلا جدلاً مطرداً للحب والكراهية، للإيمان بالجدوى والكفر بالأثر، لا بديلاً عن ذات تواقة إلى التحرر، ويمكن في أي لحظة أن يتحول الولع العريق بالحكي والصور إلى نقمة وندم ورغبة في الانعتاق، واستخلاص ما فضل من رصيد العمر.
يحلو لي دائماً أن أختصر جدل الحب والكراهية، في مظهر الكتب، حيث تتلف الكتب الأثيرة والقريبة إلى النفس من كثرة الاستعمال، تتوه في أرجاء البيت، وتسوَد صفحاتها بالخطوط والهوامش، وتهترئ أغلفتها، وقد تنسى في محطات عابرة، فالكره لا يمكن أن يتجلى إلا بوصفه نتاجاً لالتحام مؤبد، يستهلك فيه التوق والشهوة، من الكتب إلى الصور إلى الأجساد.